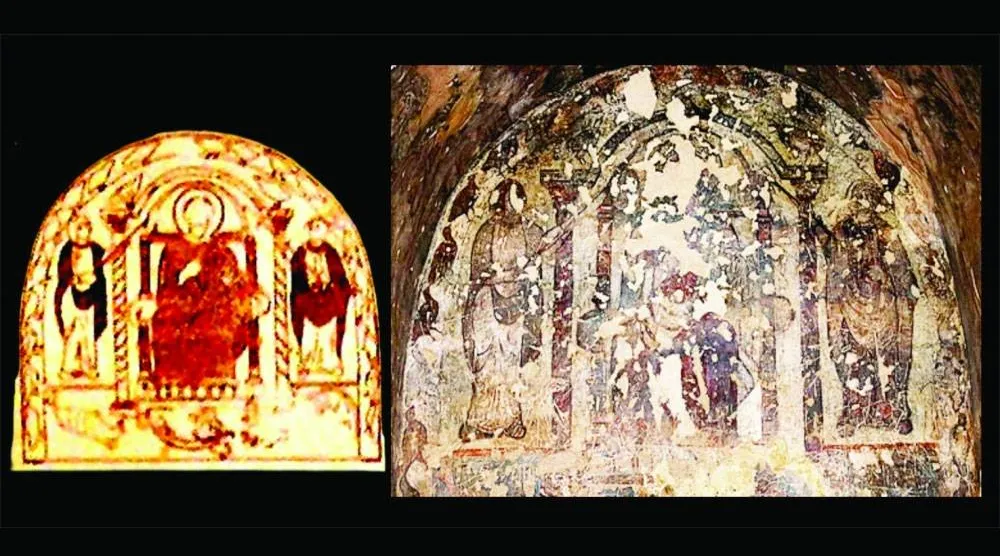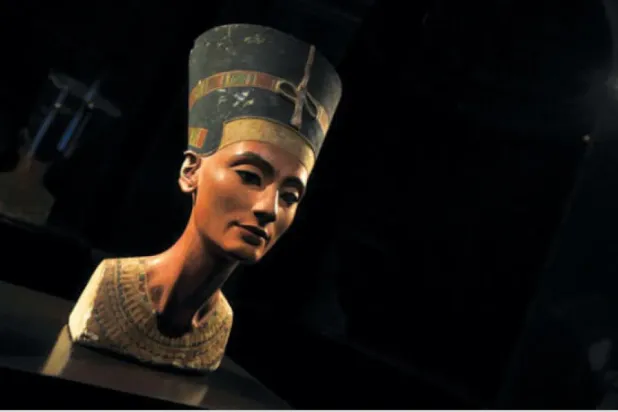يقع وادي الحِجر في محافظة العُلا، ويُعدّ من أبرز حواضر مملكة الأنباط التي قامت في شمال شبه الجزيرة العربية، وكانت عاصمتها البتراء في الشمال الشرقي من رأس خليج العقبة شرق الأردن. برزت هذه المملكة في القرن الأول قبل الميلاد وامتدّت شمالاً من دمشق إلى وادي الحِجر، ونجحت في الحفاظ على استقلالها إلى أن دخل الرومان سورية في عام 64 قبل الميلاد، فاضطرت إلى مهادنتهم، ثم خضعت لنفوذهم، وتحولت في مطلع القرن الثاني للميلاد ولاية سُمّيت «الولاية العربية - الرومانية».
شكّل وادي الحِجر جزءاً من هذه الولاية، غير أنه لم يتخذ طابعاً رومانياً، كما تشهد أعمال المسح والتنقيب المتواصلة في هذا الموقع. لم ينشئ الرومان في هذه البقعة من هذه الولاية طرقاً بريّة تتبع النسق الذي ابتكروه، ولم يبنوا فيها جسوراً وعبّارات. لا يحوي وادي الحِجر أي أثر لمسرح أو لمدرّج روماني، أو أي أطلال لمؤسسات رومانية، غير أنه يضمّ ثكنة عسكرية ظهرت معالمها أثناء حملة المسح الذي قام بها فريق مشترك فرنسي - سعودي منذ بضع سنوات. جعل الأسياد الجدد من هذه الواحة كما يبدو حصناً حدودياً، وبنوا في القرن الثاني ثكنة عسكرية فوق تلة تقع في الجهة الجنوبية من المدينة التي أطلقوا عليها اسم «حيجرا».
ازدهر وادي الحِجر في زمن الأنباط، وهم «عرب رحّل لا يُعرف على وجه التدقيق الموطن الذي أتوا منه، وربما كان مجيئهم من شمالي الحجاز أو من أواسط الجزيرة العربية»، أقاموا دولة عاشت أكثر من خمسة قرون، «واستمدت نسغ الحياة والقوة من التجارة، وكان لموقعها الحصين أثر كبير في بقائها على قيد الوجود مدة طويلة»، كما يذكر الباحث السوري توفيق برو في «تاريخ العرب القديم». ويضف أن لهم «حضارة عريقة تميزت بطابعها التجاري والعمراني. وهي عربية في لغتها، آرامية في كتابتها، ساميّة في ديانتها، يونانية - رومانية في فنها وهندسة عمارتها؛ لذلك فهي مزيج حضارة مركبة، سطحيّة المظهر الهليني، ولكّنها عربية الأساس».
في زمن الأنباط، شُيّدت في وادي الحِجر سلسلة من القبور المنحوتة في الصخر، تتبع النسق الذي ساد في البتراء، وحمل ما يقارب ثلث هذه القبور كتابات تذكارية بالخط النبطي، نُقشت في إطارات منحوتة فوق الأبواب. وتضمنت نصوصها أسماء الراقدين في القبور، وفي بعض الأحيان أسماء القبائل التي ينتمي إليها هؤلاء، وأسماء المعبودين الذين تعبّدوا لهم، واسم النحات الذي زين القبر. ويُجمع أهل الاختصاص على القول بأن الأنباط وأسياد قبائل منطقة العلا التابعة لهم هم على الأغلب من نحتوا الواجهات الصخرية وجعلوا منها مدافن لهم.
في المقابل، خرجت من وادي الحِجر مجموعة محدودة من اللقى الأثرية الرومانية، تمثّلت في قطع نقدية بلغ عددها زهاء المائة في موازاة أكثر من ثلاثمائة قطعة نبطية، وبعض النقوش الكتابية التذكارية، أهمّها نقش لاتيني على لوح من الحجر الرملي عرضه 110 سنتمترات، يحمل نصّاً من عشرة أسطر أُنجز بين عامي 175 و177، كما يتضح من الأسماء المذكورة فيه، ومنها «الإمبراطور قيصر مرقس أوريليوس أنطونينس»، «يوليوس فيرمانوس مبعوث أغسطس الوالي الروماني»، و«عمر بن حيان رئيس قوم المدينة».
إلى جانب هذه القطع النقدية وهذه الكتابات التذكارية، تحضر مجموعة متنوعة من اللقى الأثرية، تحوي بضعة تماثيل برونزية من الحجم الصغير، عُرضت في معرض أقيم في «معهد العالم العربي» بباريس في خريف 2019، تحت عنوان «العُلا واحة العجائب». في هذه المجموعة التي تتبع الأسلوب الروماني الكلاسيكي الصرف، يظهر النسر والجدي والجمل، كما يظهر شاب أمرد عاري الصدر يحمل بين يديه قطعة من الجلد تلتف من خلف ظهره.
يحتل النسر مكانة رفيعة في الموسوعة الحيوانية الرومانية، كما يحتل مكانة مماثلة في وادي الحِجر، حيث تحضر صوره الحجرية على واجهات القبور المنحوتة في الصخر، في صياغة فنية يغلب عليها طابع الاختزال والتحوير الهندسي. يختلف النسر البرونزي الصغير الذي خرج من وادي الحِجر بشكل جذري عن هذه الصور، ويظهر منتصباً في حلة واقعية تتجلّى في نقش ريشه، كما في إبراز ملامح وجهه.
يلقي هذا المقال الضوء على أحد الكشوف الأثرية في «وادي الحِجر» في محافظة العُلا بالسعودية، وذلك إبان خضوعها للاحتلال الروماني وتسميتها باسم «الولاية العربية - الرومانية». ويشير المقال إلى أن تمثال الشاب العاري يجسّد الجمالية الكلاسيكية بإتقان شديد.
وللماعز كذلك مكانة مماثلة في الفن الروماني، وهو من العناصر التصويرية المعتمدة في سائر أنحاء الجزيرة العربية، حيث يظهر في حلل تجمع بين التصوير والتجريد الهندسي. تتبع معزة الحِجر البرونزية النسق الروماني بأمانة تامة، كما يُستدلّ من طول القرنين وسماكتهما. ويظهر الأسلوب الروماني في إبراز مفاصل البدن، كما في حركة القوائم الأربع.
يتبع جمل الحِجر البرونزي كذلك هذا النسق الواقعي، ويتميّز بالسرج العريض الذي يعلو سنامه. والجِمال معروفة في جزيرة العرب، وهي «سفائن البر»، كما أشار الدميري في «حياة الحيوان الكبرى»، و«من الحيوانات العجيبة، وإن كان عجبها سقط من أعين الناس لكثرة رؤيتهم لها». هذا الحيوان العجيب معروف في العالم اليوناني - الروماني، كما يُستدلّ من قول هيرودوت في الكتاب الثالث من تاريخه: «ولا حاجة إلى أن أصف الجمل، فالإغريق يعرفونه».
أما تمثال الشاب العاري، فيجسّد كذلك الجمالية الكلاسيكية. يشكّل الجسد البشري أساس هذه الجمالية ومحورها، ومثاله هو الجسد الحي السليم من كل عيب، والفنان مدعو إلى إظهار كل جارحة من جوارح هذا الجسد، مظهراً كل حركة من حركات الجسد المرن.
يمثّل هذا التمثال البرونزي فتى يحمل قطعة من جلد تتدلّى على كتفه اليمنى، ممّا يوحي بأنه واحد من «الساتير»، والساتير في القاموس الإغريقي جنّ الغابات، يؤلفون حاشية سيّد المراعي الذي عُرف باسم بان، وسيّد الكرمة الذي عُرف طوراً باسم ديونيسوس، وطوراً باسم باخوس.