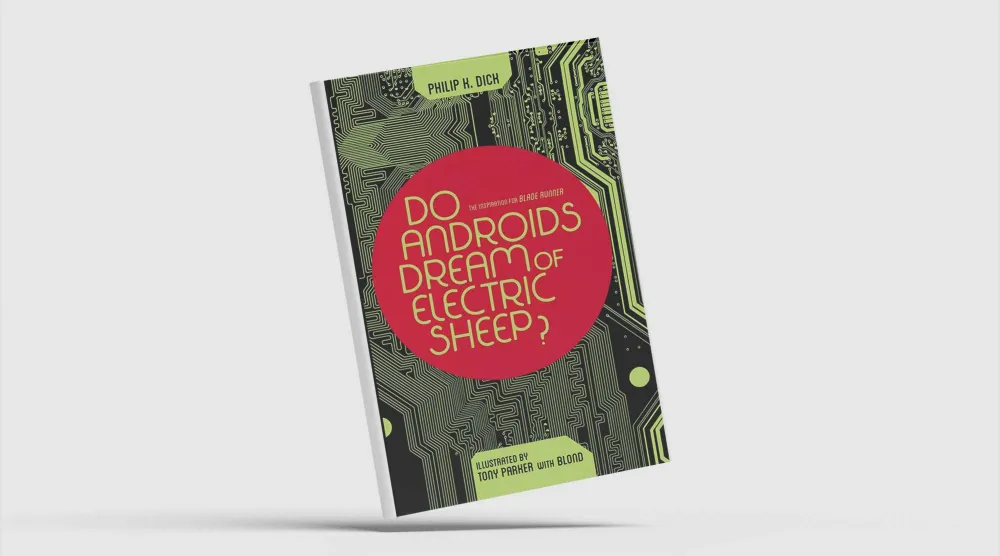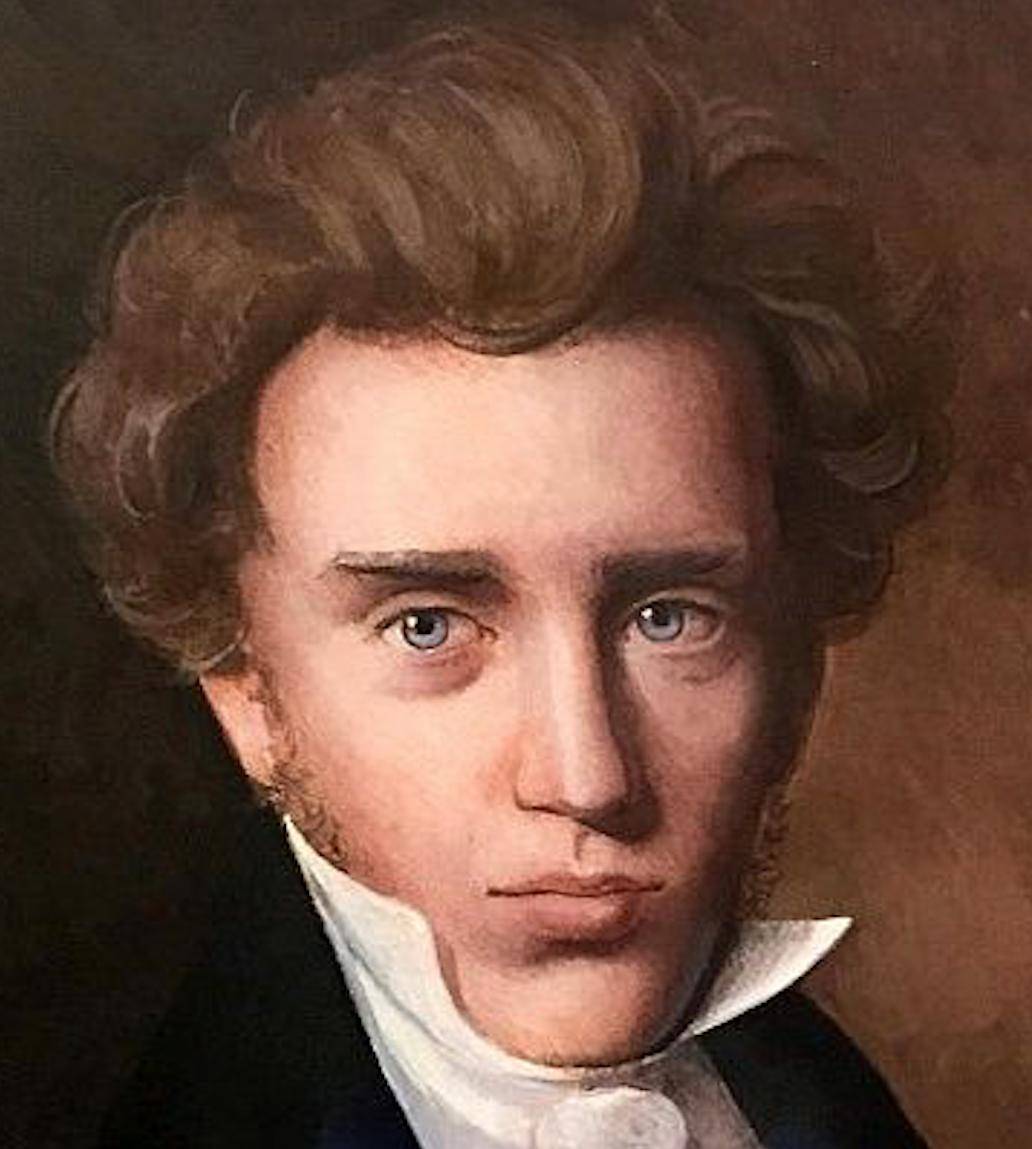على مدى أربع حلقات، تنشر «الشرق الأوسط» فصلاً من كتاب «رومنطيقيّو المشرق العربيّ» لحازم صاغيّة، والذي سيصدر قريباً عن دار «رياض الريّس للكتب والنشر» في بيروت. الحلقة السابقة تناولت ثنائيّتي «العروبة والإسلام» و«القوميّة والاشتراكيّة». هنا الحلقة الأخيرة.
ما لا شكّ فيه أنّ التطوّرات التي شهدها الوعي الوطني المصري اختلفت عن مثيلتها في العراق وسوريّا، تبعاً لعاملين على الأقلّ. فمن جهة، انحسر مبكراً الأثر العثماني فالتركي عن مصر، وذلك مع الاحتلال الإنجليزي في 1882، وإن عبّرت الوطنيّة المصريّة المبكرة، لا سيّما مع «الحزب الوطنيّ» بقيادة مصطفى كامل ومحمد فريد، عن هوى عثماني أُريدَ استثماره في مواجهة البريطانيين. أمّا الآخر، فيطال تفاوت التجربتين فيما خصّ الأقلّيّات المسلمة غير العربيّة، بين مصر وكلّ من العراق وسوريّا. فمنذ حركة أحمد عرابي في 1881، والتي قامت جزئيّاً ضدّ نفوذ الضبّاط الشركس، لم يعد هؤلاء، وهم ذوو الوجود العسكري العريق الضارب في الحقبة المملوكيّة، يُعرّفون بصفتهم الجمعيّة هذه. لقد اندمجوا في نسيج مصر وسياساتها على النحو الذي يرمز إليه كون علي ماهر، أحد أبرز سياسييهم القوميين، وعزيز علي المصري، أبرز ضبّاطهم القوميين، هما نفسهما من ذوي أصل شركسيّ. أمّا في العراق وسوريّا، فيمكن رسم خطّ فاصل ونافر بين حقبة الضبّاط العثمانيين، غير العرب، والذين برز منهم قائدا الانقلابين الأوّلين في العراق وسوريّا، الكرديّان بكر صدقي وحسني الزعيم، وحقبة الضبّاط العرب ممن ولدوا في أواخر عهد السلطنة العثمانيّة أو بعده بقليل، وتخرّجوا من الكلّيّات الحربيّة في ظلّ الاستقلال العراقي الناقص والانتداب الفرنسي على سوريّا. وهذا، فضلاً عن النسيج المصري الأعلى انسجاماً من مثيليه العراقي والسوريّ؛ ما جعل اقتران الإسلام بالقوميّة، أكانت مصريّة في البداية أم عربيّة لاحقاً، أشدّ سلاسة منه في البلدين المشرقيين الآسيويين.
على أنّ القاسم المشترك هو أنّ هؤلاء جميعاً أطلّوا على الحياة العامّة قُبيل هزيمة النازيّة في الحرب العالميّة الثانية ومعها، وهو ما لبث أن فتح الباب للقطبية الأميركيّة - الروسيّة، ومعها الرأسماليّة/الديمقراطيّة - الشيوعيّة.
فجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وأنور السادات، أبرز نجوم العهد الجمهوري في مصر، ولدوا بين 1918 و1919، وتخرّجوا ضبّاطاً بين 1937 و1939. وأدوار هؤلاء جميعاً كانت من ثمار توسّع الجيوش الذي سبق الاستقلالات أو تلاها مباشرة، مستدعياً إليه أبناء البيئات الشعبيّة العميقة في المدن، وخصوصاً في الأرياف. وقد شهد الجيش في مصر، عشيّة الحرب العالميّة الثانية، توسّعاً صاروخيّاً رفع عدده أضعافاً مضاعفة، ما شكّله على هيئة أداة سلطة غير مسبوقة عربيّاً في قوّتها وحجمها، كما في عضويّة ارتباطها بمجتمعها الأهلي العميق. وفي المعنى هذا، انتمى كثيرون من «الضبّاط الأحرار» ممن دخلوا الكلّيّة الحربيّة في الثلاثينات، إلى الطبقة الوسطى على تعدّد شرائحها، دون أن يكون بينهم أي ضابط قبطيّ. وفيما خلا الوطنيّة، بمعنى المناهضة الحصريّة للإنجليز، كان هؤلاء انتقائيين آيديولوجيّاً، فيهم الإسلامي والبراغماتي على شيء من الليبراليّة، والشوفيني المصري على أنواعه.
وكما سبق أن رأينا في حالة العراق، شهدت الثلاثينات، وبتأثير واضح من الحركات الفاشيّة الأوروبيّة، نزوعاً حادّاً إلى تجمّعات وتيّارات قوميّة ووطنيّة مشابهة في المشرق العربيّ، يقف على رأسها زعماء يقلّدون هتلر وموسوليني. وربّما كان الأبرز، فضلاً عن العراقي سامي شوكة، المصري أحمد حسين، مؤسّس «مصر الفتاة»، واللبناني أنطون سعادة الذي أسّس في 1932 «الحزب السوري القوميّ» وذهب بعيداً في انتفاخه الأنويّ، مانحاً نفسه لقب «الزعيم» مدى الحياة، ومتجاوزاً في علمويّته وخطابيّته الرومنطيقيّة سائر نظرائه.
غير أنّ الفرصة التي أتيحت للجيش المصريّ، كمصنع للزعاميّة الجديدة، لا سيّما بعد انقلاب يوليو (تموز) 1952، لم تُتح للبيئات السياسيّة والحزبيّة والعسكريّة الأخرى. ففضلاً عن موقع مصر المركزي في العالم العربيّ، والذي زاده الاحتلال البريطاني مركزيّة وأهميّة، وعمّا أشير إليه من توسّعٍ عرفه جيشها الوطنيّ، ضُغطت في التجربة المصريّة المرحلتان العثمانيّة - الألمانيّة والسوفياتيّة على نحو لم تعرفه التجارب الأخرى، في حين شكّل عام 1956 جسر الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية تحت تسمية «الاشتراكيّة الديمقراطيّة التعاونيّة» التي تغيّرت لاحقاً. ذلك أنّ هزيمة النازيّة الألمانيّة حوّلت الشيوعيّة السوفياتيّة، المندفعة باتّجاه الشرق الأوسط بعد رحيل جوزيف ستالين، مصدراً متقدّماً في استلهام النظام الجديد، والطوبى التي تراءى أنّ إراديّة الذات وتصميمها يستطيعان استحضارها إلى الواقع.
- إنّها أفعال الأجانب
فجمال عبد الناصر هو «أتاتورك مصر»، كما أسماه محمد نجيب نفسه، وهذا إنّما يصف محوريّة القائد ومصادرته الحراك الاجتماعي والسياسي في بلده. ومن دون أن يلغي تشابُهُهما الفوارقَ الكثيرة التي ينبع معظمها من اختلاف الأوضاع والقوى الدوليّة المؤثّرة؛ مما سنتطرّق لاحقاً إليه، يحضر التكوين الذاتي والرومنطيقي بقوّة في الزعيمين.
ويقدّم كتيّب «فلسفة الثورة»، الذي شاع أنّ عبد الناصر أملاه على الصحافي محمد حسنين هيكل، بعض الإحاطة بمخيّلته ووعيه إبّان استيلائه على السلطة وبُعيده. فـ«لقد كنت أتصوّر قبل 12 يوليو (تموز) أنّ الأمّة كلّها متحفّزة متأهّبة، وأنّها لا تنتظر إلا طليعة تقتحم أمامها السور، فتندفع الأمّة وراءها صفوفاً متراصّة منتظمة تزحف زحفاً مقدّساً إلى الهدف الكبير». ولئن تكرّرت صورة «الصفوف المتراصّة» التي أتى على ذكرها سامي شوكة وأنطون سعادة وسواهما بعبارات مختلفة، فإنّ الجنديّة هي ما يجعل «للجيش واجباً واحداً هو أن يموت على حدود وطنه». أمّا مشاكل مصر، «البلد الطيّب الوديع»، فلا تظهر عند عبد الناصر إلا بوصفها نتاج أفعال الأجانب. ذاك أنّ الشعب «شاءت له الظروف أن يعاني الذلّ تحت سنابك خيول الطغاة القادمين من المغول والشركس. كانوا يجيئون إلى مصر عبيداً فيفتكون بأمرائهم ويصبحون هم الأمراء. وكانوا يساقون إليها مماليك فلا تمضي عليهم فترة في البلد الطيّب الوديع حتّى يصبحوا ملوكاً (...) وكانت أرواحنا وثرواتنا وأراضينا هي الغنيمة». وهنا أيضاً يكرّر عبد الناصر التهم التي كان قد وجّه مثلَها قومي عربي آخر، هو السوري ميشيل عفلق، الذي أسّس «حزب البعث العربيّ» في الأربعينات، إلى الأتراك والفرس. ومثل الأجانب والأغراب، هناك التعدّد الذي يفتك بالوحدة الأصليّة للشعب، ويستوطن المدينة الكوزموبوليتيّة غالباً، حاضاً الوطنيين على صهره وتذويبه. فعبد الناصر الشابّ إذ ينظر «إلى أسرة مصريّة عاديّة من آلاف الأُسر التي تعيش في العاصمة»، يجد أنّ «الأب مثلاً معمم من صميم الريف، والأمّ منحدرة من أصل تركيّ، وأبناء الأسرة في مدارس على النظام الإنجليزيّ، وفتياتها في مدارس على النظام الفرنسيّ، كلّ هذا بين روح القرن الثالث عشر ومظاهر القرن العشرين». وإذ يفهم حينذاك «الحيرة التي نقاسيها والتخبّط الذي يفترسنا»، يقول لنفسه «سوف يتبلور هذا المجتمع وسوف يتماسك، وسوف يكون وحدة قويّة متجانسة».
وعمليّة كهذه، مقرونة بتوسّع الإدارة والجيش والاقتصاد البضاعي الصغير، في مقابل تفاقم الأزمة الزراعيّة في الريف، تتطلّب الزعيم بالضرورة، حيث يُلحّ البحث عمّن يقود هذه المجتمعات المختلطة والمشوّشة وحديثة النشأة فيما هي تباشر الخروج من كنف الاستعمار إلى أفق الصيرورة التاريخيّة المرتجاة. فزعيم كاريزمي كهذا هو من يسدّ النقص الكامن في خلائط التكوين الآيديولوجي البسيط والمتناقض ذاتيّاً، والذي حين يتحوّل، بعد إحراز السلطة، إلى آيديولوجيا رسميّة، كالقوميّة العربيّة في مصر الناصريّة أو البعثيّة في العراق وسوريّا، تتفاقم أزمته من غير أن تتنامى جاذبيّته الشعبيّة.
وكان أحد القواسم المشتركة بين أتاتورك وعبد الناصر (والذي يطيب للمحلّلين الماركسيين إسباغه على جميع القادة «البورجوازيين الصغار» تبعاً لتمثيلهم مصالح طبقيّة متنافرة بعيداً عن الأبعاد الأخرى التاريخيّة والثقافيّة والشخصيّة) هو ملء هذا الفراغ بخليط من الانتهازيّة والضجيج الخطابي اللذين يعزّزان التعويض الزعامي المطلوب.
فمنذ أشاع جمال عبد الناصر تلك العبارة التي وردت في «فلسفة الثورة»، عن «دور هائم على وجهه يبحث عن بطل»، والطلب على «البطل» يعادل إعلان التمرّد على حقائق الواقع الموضوعيّ، بالسلبي منها والإيجابيّ. وهذا «البطل» الذي استعيد معه رونق البطولة كاملاً بعدما شوّهته الخيبة بأتاتورك، هو من سيقود «عائلته» على طريق «تحدّي القدر». فهو، بالتالي وبالضرورة، «الأب» القوي والمحبوب في آن معاً، والذي على رغم تشدّقه بثوريّة تطيح الكثير من القيم السائدة، إنّما يرسّخ إحدى أكثر القيم التقليديّة، بل الرجعيّة، صلابة بإسباغه المنطق المحافظ المستَمدّ من حياة العائلة الأبويّة على الحياة السياسيّة والعامّة. وهذا ما رأيناه لاحقاً على نحو أشدّ توسّعاً وشدّة في حالة زعماء كصدّام حسين وحافظ الأسد في العراق وسوريّا. غير أنّه في الحالات جميعاً، وخصوصاً في استهدافه الأطفال وتلامذة المدارس، أو البالغين بوصفهم «أبناء»، إنّما يلبّي ذاك الحنين الرومنطيقي إلى العائلة الأبويّة المنسجمة التي شرعت الحداثة تتهدّدها وتقضم أطرافها.
وهنا يحضر «الحب» الذي كان عبد الناصر أوّل من نقله، في المشرق العربيّ، «من مجال العلاقات الشخصيّة إلى مجال الدولة والسياسة، و(يحضر) توقّعُ أن يكون الرئيس محبوباً كأنّما هو أب أو حبيب، والمثابرة دونما كلل على إشهار ذلك عبر وسائل الإعلام العامّة». فعبد الناصر، وفق الكاتب السوري ياسين الحاج صالح، كان «حبيب الشعب، حبيب الملايين وأمل الملايين، يُغنَّى له في الإذاعات، ويُهتَف باسمه في المسيرات، وتتكرّس إذاعات وصحف لا منافس لها لتعظيمه والإشادة به وبحكمه»، علماً بأنّ الخلط «عظيم الضرر»، كما ينبّه الحاج صالح، بين الحبّ الذي يُزاوَل في الدوائر الخاصّة والشخصيّة، والسياسة، حيث ينبغي في السياسي أن يكون موثوقاً، لا محبوباً. فإذا كان ماكيافيللي قد فضّل في توصيته الشهيرة إخافة الحاكم على محبوبيّته، فإنّنا هنا حيال الإخافة والمحبوبيّة معاً. ولربّما كان من أبرز نتائج تغليب هذا الحبّ في السياسات العسكريّة المصريّة وأشدّها أذى علاقة عبد الناصر بـ«صديق حياته» و«حبيب قلبه» عبد الحكيم عامر، التي لعبت دورها الذي بات معروفاً في هزيمة 5 يونيو (حزيران) 1967.
بيد أنّ إعلاء الحبّ بالمعنى المشار إليه لا يكتفي باستبعاد الاختلاف كشرط للسياسة، بل يخوّنه أيضاً، كما يخوّن حامليه ويجيز إنزال أقصى العقاب بهم. وبهذا الخليط من سحر الحبّ كآيديولوجيا مهيمنة والخوف من التبعات الأمنيّة التي ترتّبها خيانة الحبيب، يتعطّل النقد وتتعطّل الحياة العامّة، التي لا تعود تتّسع إلا للخضوع.
وهكذا، فالموثوقيّة التي يقترحها الحاج صالح بديلاً من الحبّ، هي ما يغيب عن سلوك الزعيم، بل هي بالضبط ما تلافتْه محاولاته النظريّة والفكريّة. فعلى رغم تشديد الناصريّة على «التنظيم» وإقامتها ثلاثة «تنظيمات» (هيئة التحرير، والاتّحاد القوميّ، والاتّحاد الاشتراكي العربيّ)، ففي «الباب الأوّل» من «الميثاق» الذي أُقرّ عام 1962، نقرأ الاعتداد التالي بـ«الإرادة» المنفلتة من كلّ قيد: «إن قوّة الإرادة الثوريّة لدى الشعب المصريّ، تظهر في أبعادها الحقيقيّة الهائلة إذا ما ذكرنا أنّ هذا الشعب البطل بدأ زحفه الثوري من غير تنظيم سياسي يواجه مشاكل المعركة. كذلك، فإنّ هذا الزحف الثوري بدأ من غير نظرة كاملة للتغيير الثوريّ». وهذا الإكبار للعفويّة التي تنتجها بطولة الشعب والزحف الثوري «من غير تنظيم»، هو ما حرّر، منذ البداية، مواقف الزعيم وسلوكياته من كلّ قيد قد يندرج في المبدئي والموثوق. فوفقاً للمؤرّخ المصري طارق البشري وآخرين، «كانت لعبد الناصر سابقة اتّصال سياسي بالحركات الحزبيّة. اتّصل بـ(مصر الفتاة) تلميذاً في الثلاثينات، ثم اتّصل بالإخوان المسلمين في بداية الأربعينات، ثم اتّصل بالحركة الشيوعيّة في منتصف الأربعينات». وإذا كنّا سنتناول لاحقاً علاقة عبد الناصر بالإخوان، وهي كما يبدو تتعدّى منتصف الأربعينات، يكفي هنا استرجاع ما يذكره أحد كبار «الضبّاط الأحرار»، عبد اللطيف البغدادي، عن تجربة انضمام بعض أولئك الضبّاط إلى التنظيم الإسلامي المذكور: «كنّا نحضر حديث الثلاثاء (الإخوانيّ) كلّ أسبوع، واتّبعنا نظام الأُسَر (الذي يعتمده الإخوان تنظيميّاً)، كلّ أسرة من خمسة». بل إنّ موعد الانقلاب نفسه أُجّل من 22 إلى 23 يوليو (تموز) كي يُتاح «استطلاع رأي قيادة الإخوان المسلمين في الموافقة على قيام حركة الجيش». ووفقاً للكاتب المصري شريف يونس، كان الضبّاط «يستعملون خطاباً إسلاميّاً كجانب من محاولتهم بناء شرعيّتهم»، وقد جاء قَسَم «هيئة التحرير»، أي التنظيم السياسي الأوّل الذي أنشأه الانقلابيّون، متأثّراً باللغة الإخوانيّة والدينيّة. فحين شرح جمال عبد الناصر الانقلاب في خطبة له، رأى أنّها «كانت غضبة لله، وصدى للشعور الشعبي المكبوت، ومن هنا تولّتها العناية الإلهيّة»، كما أكّد «أنّنا نحقّق ما ينادي به القرآن».
وترافقت هذه اللغة البسيطة، المتحرّرة من كلّ إلزام، مع إرساء الأسس لتعطيل النقاش، حيث بلغة البغدادي، «لم نكن نشأ الدخول في تفصيلات هذه الأهداف العامّة خشية اختلاف الرأي بيننا، وحتّى لا يتسبب عنه فرقة وانقسام». وبدوره، اكتفى يوسف صدّيق، أحد «الضبّاط الأحرار» البارزين، «بأن يذكر لجنوده أنّهم سيقومون بعمل خطير لصالح الوطن، ولم يدركوا من ذلك بطبيعة الحال أنّهم يقومون بانقلاب عسكريّ، وأنّه يستهدف السلطة وخلع الملك». ثمّ جاءت البيانات التي صدرت في الأيّام الأولى للانقلاب تناشد «الجماهير أن تخلد إلى الهدوء والسكينة والنظام دون دعوة للتحرّك، ودون طرح أهداف سياسيّة محدّدة يمكن أن تساهم الجماهير في صنعها مع القيادة». ويمضي البشري: «وقد جاء في البيان الذي أذيع ويحمل نبأ تنازل الملك عن العرش في 26 يوليو 1952، «إن نجاحنا للآن في قضية البلاد يعود أوّلاً وأخيراً إلى تضافركم معنا بقلوبكم، وتنفيذكم لتعليماتنا، وإخلادكم إلى الهدوء والسكينة».
لكنّ «التضافر بالقلوب» و«تنفيذ التعليمات»، أي الحبّ والخضوع، كانا مطلوبين لنشر الضباب حول مجريات الواقع الفعلي والأدوات المطروحة لتغييره. هكذا يروي «ضابط حرّ» بارز آخر هو أحمد حمروش، أنّه في اجتماع عُقد في 17 يوليو (تموز)، «تأرجحت الآراء (بين الضبّاط) وظهرت فكرة الاغتيالات الجماعيّة لقادة الأحزاب ورجال السراي وبعض كبار الساسة الآخرين. وشاعت الفكرة بين عدد من المجموعات، وتشكّلت فعلاً مجموعة للقيام بذلك. ثمّ تراجعت هذه الفكرة بعد أن جدّ ما استدعى التعجيل بالحركة إلى 22 يوليو، ووضّح صعوبة ضمان تنفيذ الاغتيالات بصورتها الجماعيّة واحتمال قيام حملة اعتقالات واسعة بعد تنفيذها». ويرى البشري أنّ مذكّرات عبد اللطيف البغدادي «تكشف عن مادّة ثريّة في موضوع الاغتيالات، الذي لم يُعدَل عنه نهائيّا إلا في 17 يوليو 1952. ويشير من قبل ذلك إلى الاتّصال بعبد العزيز علي والتفكير في إعداد تنظيم فدائي وصنع القنابل وإعداد الأسلحة، مع مغامرة عزيز علي المصري التي ساهم فيها بعض الضبّاط للاتّصال بالألمان، ومع اقتراح إنشاء خلايا سرّيّة لقتل من يعتبرونهم ساسة منحرفين بعد حادث 4 فبراير (شباط) 1942، وعرضهم على رئيس الديوان الملكي وقتها قتل مصطفى النحاس احتجاجاً على ذلك الحادث».
ما هو أبعد من ذلك وأوسع دلالة، أنّ عدد «الضبّاط الأحرار» الذين أسهموا في انقلاب 1952 لم يزد على تسعين ضابطاً، «وكان ثلثاهم، وفقاً للإحصاء الفعليّ، من الضبّاط الأصغر من رتبتي النقيب والملازم. وهذه النسبة لا تزيد على 4 في المائة من مجموع ضبّاط الجيش... كما أنّ الوحدات التي اشتركت لم تكن تشكّل إلا نسبة صغيرة من أسلحة الجيش وتشكيلاته ووحداته المنتشرة في مختلف المناطق العسكريّة». وهكذا تغدو إرادة 4 في المائة من مجموع ضبّاط الجيش هي، وفق أدبيّات الانقلاب، إرادة الله والشعب التي لا تُردّ.
ويذهب شريف يونس خطوة أبعد، فيخفض نسبة تمثيل «الضبّاط الأحرار» إلى 3 في المائة من مجموع الضبّاط، لكنّ الأهمّ تدليله على ضعف مجمل القوى الراديكاليّة، المتقاطعة يومذاك على نحو أو آخر مع «الضبّاط الأحرار». ذاك أنّ «الإخوان لم يسبق لهم رغم قوّتهم أن حصلوا على مقعد في البرلمان، وكذلك الشيوعيّون. وحصلت (مصر الفتاة) على مقعد واحد بعصبيّة إبراهيم شكري العائليّة».
وبالاستناد إلى مصادرة التمثيل هذه، تمنح القيادة العليا نفسها، هي التي لا تملك حتّى تلك اللحظة أي تاريخ، تفويضاً شاملاً ومنزّهاً، فتُصدر بياناً في 31 يوليو (تموز)، أي بعد أسبوع فقط على الانقلاب، «يرفع شعار التطهير لكلّ المؤسسات، ويدعو الأحزاب إلى تطهير نفسها والإعلان عن برامجها».
وهذا الاعتباط الذي تُمليه إرادة شخص واحد، أو بضعة أشخاص من المتآمرين، إنّما ولد مع تفرّد عبد الناصر «منذ البداية (...) بقرارات وإجراءات لم يُعلِم بها زملاءه، كإدخال أنور السادات تنظيم الضبّاط الأحرار وتسميته أحد أعضاء هيئته التأسيسية أو انفراده بتخطيط وتنفيذ محاولة اغتيال اللواء حسين سري عامر، مدير سلاح الحدود، يوم 8 يناير (كانون الثاني) 1952».
وهو ما كان له مقابله المكمّل في العلاقات الخارجيّة. فقبل طوره السوفياتي البادئ في أواسط الخمسينات، عرف عبد الناصر طوراً أميركيّاً لم يحل قصره الزمني دون عمقه وتشعّبه، وذلك بالاستناد إلى أنّ الولايات المتّحدة لم تكن «استعماراً قديماً» كبريطانيا، بل تناقضت مع هذا الاستعمار وسعت إلى إزاحته والحلول محلّه.
فلم يعد سرّاً، أقلّه منذ صدور كتاب «لعبة الأمم» لضابط «سي آي إيه» مايلز كوبلاند، الذي عُرف بعلاقاته الوثيقة مع الزعيم المصريّ، حصول تعاون واسع بين الأخير ووكالة المخابرات المركزيّة الأميركيّة (سي آي إيه) يعود إلى ما قبل انقلاب يوليو، وكان صلة الوصل حسن التهامي، أحد «الضبّاط الأحرار» المقرّبين من عبد الناصر، ولاحقاً من أنور السادات (حيث رافقه في رحلته الشهيرة، عام 1977، إلى تلّ أبيب) في تحوّل لا يقلّ عن تحوّلات السادات نفسه.
وقد شملت الاتّصالات بين عبد الناصر والأميركيين كيرميت روزفلت، مدير الـ«سي آي إيه»، الذي سافر إلى القاهرة، علماً بأنه هو نفسه ما لبث أن أشرف على إطاحة محمد مصدّق في إيران، الذي يُفترض، تبعاً للأدبيّات النضاليّة، أنّه حليف موضوعي لعبد الناصر في مواجهة الإمبرياليّة. وعلى العموم، خُلّد اسم روزفلت سلباً بوصفه أحد أكبر «المتآمرين» على الشعوب وحركات تحرّرها. أمّا موضوع الاتّصالات الثنائيّة المصريّة - الأميركيّة، فدار حول إقناع الأميركيين حلفاءهم البريطانيين بالابتعاد عن مصر مقابل ضمانة من عبد الناصر بتحديث الاقتصاد وقمع الشيوعيين. وأمّا الشخص المكلّف استئناف هذه الاتّصالات مع مساعد الملحق العسكري الأميركي ديفيد إيفانس فلم يكن سوى علي صبري، الذي بات لاحقاً «رجل السوفيات»، في تبدّل للأدوار الوظيفيّة يعاكس التبدّل الذي طرأ على أدوار التهامي. وفي مطلق الأحوال، سارع الرئيس الأميركي هاري ترومان إلى الترحيب بانقلاب 1952 المصري محذّراً البريطانيين من التدخّل، في حين كان السفير الأميركي في القاهرة يسمّي «الضبّاط الأحرار» «صُبياني» (my boys). وقد ذكر لاحقاً خالد محيي الدين، وهو بدوره من قادة «الضبّاط الأحرار»، أنّ الأميركيين ضغطوا على القاهرة للإسراع في إنجاز الإصلاح الزراعيّ، لقناعتهم بأنّ الثورتين البلشفيّة والصينيّة اعتمدتا على الفلاّحين المحرومين من الأرض. وكان جون فوستر دالاس، وزير الخارجيّة، أوّل رسمي أميركي كبير يزور الجمهوريّة الجديدة، بحيث احتجّ رئيس حكومة بريطانيا ونستون تشرشل، في رسالة إلى الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور، على العلاقة الأميركيّة الجديدة مع عبد الناصر.
وكانت «سي آي إيه» قد طوّعت بعض رجال الـ«إس إس» والـ«غستابو» السابقين لمساعدة النظام المصري الجديد، جرياً على السياسة التي اتّبعتها واشنطن في الاستفادة من خبرات النازيين، وقد هُزموا وشُرّدوا، ضدّ السوفيات في الحرب الباردة. وبالفعل، وصل إلى القاهرة وفد كبير من الضبّاط والخبراء النازيين، كان في عدادهم ألواس أنطون برونّر، مساعد أدولف أيخمان الذي انتقل لاحقاً إلى دمشق وبقي ومات فيها.
وقد لا يكون عديم الدلالة، في الطور السوفياتيّ، أن تتولّى ألمانيا الشرقيّة وجهازها الأمني الشهير «شتازي»، دوراً مميّزاً في العلاقة بمصر الناصريّة، ولاحقاً بالعراق وسوريّا البعثيين؛ ما يوحي باحتمال استمراريّة ألمانيّة، ولو رمزيّة، مُسيطَر عليها هذه المرّة، وفّرتها العلاقة مع واشنطن ثمّ مع موسكو.
الحلقة (1): الطريق إلى الزعامة الراديكاليّة... من الخيبة بأتاتورك إلى التجربة العراقيّة المبكرة
الحلقة (2): الطريق إلى الزعامة الراديكاليّة... «صناعة الموت» ودورها التأسيسي
الحلقة (3): الطريق إلى الزعامة الراديكاليّة... ثنائيتا «العروبة والإسلام» و«القومية والاشتراكية»