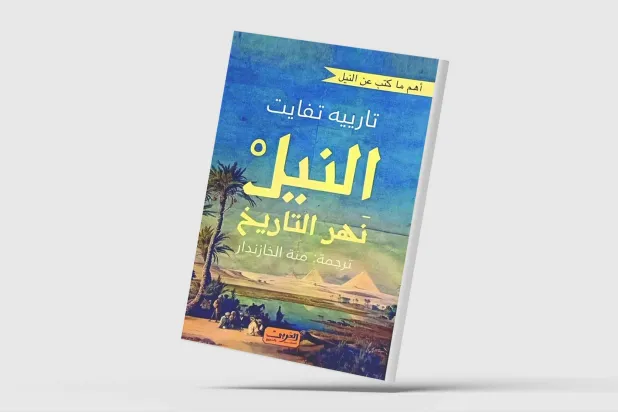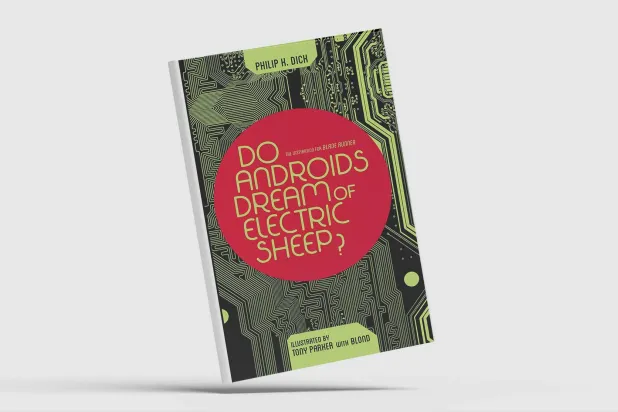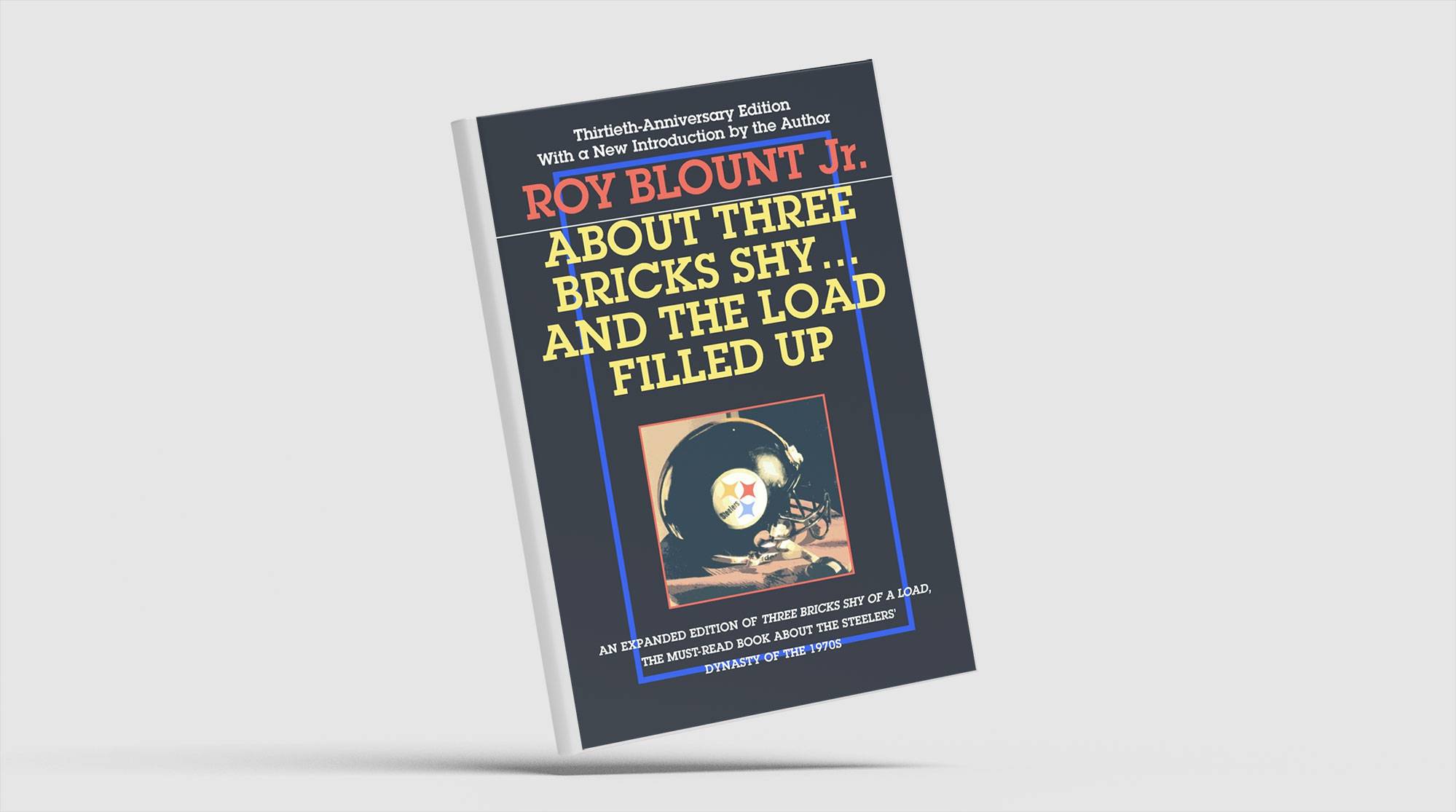يتناول حازم صاغية، في هذه الحلقة الثالثة من كتابه «رومنطيقيّو المشرق العربيّ»، ثنائيّتي «العروبة والإسلام» و«القوميّة والاشتراكيّة»، فيقول إن أتاتورك دمج مسألة الإسلام في القوميّة التركيّة، بينما اتّجه عبد الناصر إلى مزاوجة الاثنين عبر ثنائيّة «العروبة والإسلام». لكنه يضيف أن الزمن السوفياتي وفّر للزعيم المصري ثنائيّة أخرى بات مطلوباً التعامل معها، وهي القوميّة والاشتراكيّة التي تستطيع أن توفّر للنظام قاعدة لا تقلّ عرضاً عمّا توفّره الثنائيّة الأولى.
ويرى صاغية أيضاً أن سيرة الناصريّة، أهمّ سِيَر الزعامات في المشرق العربيّ، تشفّ عن ملمح أساسي في الوطنيّات المعهودة، هو «تعرّيها من كلّ آمر عقلانيّ؛ وهو ما يدعم فعليّاً تحرّرها من كلّ مساءلة ديمقراطيّة تحدّ من نزوعها إلى الاستبداد».
على مدى أربع حلقات، تنشر «الشرق الأوسط» فصلاً من كتاب «رومنطيقيو المشرق العربي» لحازم صاغية الذي سيصدر قريباً عن «دار رياض الريس للكتب والنشر» في بيروت. الحلقة السابقة تناولت «صناعة الموت» ودورها التأسيسي.
ربما كانت سيرة المناضل الكاتب المصري فتحي رضوان الأدق تمثيلاً لثقافة النظام الناصري في تكامل أدوارها ووجوهها، وبالتالي لانطوائها على استمرارية وطنية تحاول أن تبرر تهافتها وانقطاعاتها، كما تبرر مصادرة الحقيقة والتمثيل الشعبي انطلاقاً من فشل سياسي جلي.
فرضوان، بحسب غيرشوني وجانكوفسكي اللذين درسا مصر الثلاثينات والأربعينات كان أحد أولئك المثقفين والدعويين الشبان الذين تفرعوا عن الأفندية الجدد، وكانوا يرسمون لمصر صورة تتعدى حدود الوطن المصري. وفي مباشرتهم بروزهم العام في الثلاثينيات، كانت لهم مساهمة أساسية في التشكل الفكري للمفاهيم الدمجية ضمن سياق مصري.
ولئن تقرب هو أيضاً من عزيز علي المصري، فقد شارك أحمد حسين في تأسيس «مصر الفتاة» عام 1933، وكانت له حينذاك آراء في التعليم والتربية لا تبتعد كثيراً عن آراء زميله العراقي سامي شوكة؛ ذاك أنه ينبغي استلهام التعليم في مصر من «روح قوية»، وجعل ذاك التعليم يدمج فيه «أخلاقاً قوية»، كأن تتحلى الشبيبة بـ«النظام والطاعة والسيطرة على النفس وتحمل الشدائد». وهو لم يكتم كرهه المبكر للنظام البرلماني الذي «يمنع العمل ويعيقه، ويحول الوطن إلى خشبة للخطابة والمسرحيات، فالناس يجوعون بينما النواب يتباهون بالبلاغة، والبلد مهدد بالخطر من الداخل والخارج، ومع هذا فإن محاضر جلسات المجلس لا تتضمن إلا الجدالات الفارغة». ولم تختلف كثيراً عن هذه الحجج حجج انقلاب 1952 في تعطيلها المؤسسات الدستورية وحلها الأحزاب.
على أن رضوان انشق عن «مصر الفتاة»، لينضم إلى «الحزب الوطني»، ثم انشق عنه أيضاً ليؤسس حزباً ضئيل الوزن والأهمية سماه «الحزب الوطني الجديد». ولئن اعتقلته القوات البريطانية غير مرة، كما اعتُقل بعد حريق القاهرة في 26 يناير (كانون الثاني) 1952، فقد أفرج عنه الانقلابيون، وحملوه معهم إلى الوزارة، علماً بأنه كان قد فشل مرتين في الحصول على مقعد نيابي. فهو بالتالي «لا يستطيع بجهوده أن يحصل على أصوات دائرة (انتخابية) واحدة. فكان سنده الوحيد هو ثقة الضباط في ولائه لهم، واشتراكه معهم في الكراهية العميقة للأحزاب البرلمانية القديمة»، وفقاً لشريف يونس. هكذا، شغل رضوان وزارة الإرشاد القومي التي يقول بلسانه هو نفسه إنه من أسسها. وفي الحالات جميعاً، كان المدني الوحيد الذي يتولاها لمدة طويلة، حتى بات أقرب ما يكون إلى جدانوف الناصرية، كما تولى وزارات ومسؤوليات أخرى في السلطة، منها العضوية في المجلس الأعلى لـ«هيئة التحرير».
وفي دراسة يونس عن الحياة الثقافية والفكرية في مصر الناصرية، يتوقف عند رضوان بصفته «شخصية فاعلة رئيسية» في الخمسينيات. فالسياسات التدخلية التي أرساها في أثناء توليه وزارة الإرشاد القومي استمرت بعده، وكان من تلك النظريات التي كافحت السياسة التدخلية لإحلالها ما قاله في أواخر 1955 عن ضرورة «حماية عقل الشعب وروحه»، أو في أواسط 1956 من أن «الثورة لها أهداف روحية تتطلب توجيه الثقافة القومية وتخليصها من الشوائب التي بثها الاستعمار (في الثقافة)». وبالطبع، كما يضيف الكاتب، كان فتحي رضوان «من الرواد في اتهام المثقفين السابقين على عهده»، فلم ينج طه حسين وأحمد لطفي السيد وعباس محمود العقاد من وصمة «خدمة الاحتلال لتحصيل القوت». وهو، إلى هذا، كان من رموز التيار المسمى «شخصيتنا» القومية والدينية في الحياة الثقافية، حتى أنه رفض تصوير فيلم سينمائي عن خالد بن الوليد لأنه «يتعرض لفترة ما قبل إسلامه وسلوكه في أثنائها». بلغة أخرى، وبالتوازي مع الحكم الانقلابي، بدأ «الإرشاد القومي» يستهدف التأسيس من الصفر، جرياً على إرادية رومنطيقية تجمع بين تطهير التاريخ وتطهير الواقع وقواه الحية.
وفي غضون ذلك، لم يتورع رضوان عن تشبيه العاملين في الحقل الفني والثقافي، ممن تشرف وزارته على عملهم، بـ«حشرات المنازل»، وعن نشر بعض التصورات اللاسامية في أكثر أشكالها بدائية وفظاظة، حيث إن «دُهاة السياسة العالمية الذين هم، في الأغلب الأعم، يهود ذوو أنياب زرقاء يحسنون الدس والوقيعة والتآمر الدولي». وقد توج رضوان حياته السياسية بالتطوع محامياً للدفاع عن أيمن الظواهري، نائب أسامة بن لادن وخليفته.
موضوع الشرعية وثقافتها
تشف سيرة الناصرية، أهم سِيَر الزعامات في المشرق العربي، عن ملمح أساسي في الوطنيات المعهودة، هو تعريها، على ما سبقت الإشارة إليه، من كل آمر عقلاني. وهو ما يدعم فعلياً تحررها من كل مساءلة ديمقراطية تحد من نزوعها إلى الاستبداد. وفي خضم عملية كهذه تحتل رومنطيقية التغلب على الأقدار، بقيادة زعيم مصطفى، موقعها ودورها في صوغ شرعية النظام الذي يُفترض أنه كامل الجدة.
ذاك أن إحدى أبرز وظائف الرومنطيقية في نموذج الزعماء القوميين والاستقلاليين لبلدان «العالم الثالث» في النصف الثاني من القرن العشرين تتصل بموضوع الشرعية وثقافتها. فالزعامات التقليدية، من بورجوازيين وملاكي أراضٍ، ورثوا خليطاً من الأدبيات والإملاءات السياسية للبلدان الاستعمارية والديمقراطية، وعملوا على تطبيقها بقدر من الالتواء والفساد. أما الحكام الجدد، فكان عليهم أن يطوروا نظرية مستمدة انتقائياً من نظريات عدة، تمتد من الفاشية إلى الديمقراطية، قبل أن تتدخل الحاجة الجديدة إلى العلاقة بالاتحاد السوفياتي في ضبط المقادير والنسب لصالح تعظيم حصة «الفلاح» و«العامل» في «الشعب»، وإعادة النظر بالقومية على نحو أشد تصالحاً مع التأويل الطبقي، وأكثر تصادماً مع الإمبرياليات الغربية.
على أنه في هذا الخلط عديم التجانس، راح الحكام الجدد يطبقون النسبية الثقافية قبل عقود على صعودها في الجامعات ومراكز البحث الغربية، تحت عنوان «ما بعد الحداثة». ولئن قاد زعماء المرحلة الأسبق، كأتاتورك ومقلديه العرب، إلى ممانعة مبكرة للعقل والعقلاني أريد تمويهها بإثارة التعبئة الدائمة، فهذا ما تعاظم مع الزعماء الجدد، باستدخالهم هذا القدر أو ذاك من الاشتراكية السوفياتية، فضلاً عن الذهاب -هم أيضاً- خطوات بعيدة في المشهديات البصرية الحادة، وما يرافقها من تعويل على الخطابة بصفتها أداة لممارسة الزعيم سحره على الجماهير.
وفي مصر تحديداً، وبعدما حمل انقلاب 1952 بذور نزعة رومنطيقية صريحة (الزعيم، الذاتية، عفوية المبادرة...)، شهدت حقبة أواسط الخمسينيات نقلة أخرى بدأها «الانتصار» القومي على «العدوان الثلاثي» في 1956 الذي بالغت الرواية الناصرية في تضخيمه وتعميمه، علماً بأنه يملك بذاته مواصفات نموذجية للرواية المضخمة ملحمياً: التغلب على ثلاث دول، اثنتان منها إمبراطوريتان عظميان، فيما الثالثة، وهي «دولة عصابات»، سبق أن تمكنت في أزمنة الانحطاط والغفلة من إلحاق الهزيمة بسبعة أنظمة عربية «فاسدة».
وقبل شهر واحد على تأميم قناة السويس، في يوليو (تموز) من ذاك العام، أجرى النظام الجمهوري استفتاءه الأول حول رئاسة عبد الناصر ودستوره، فنال 99.99 في المائة لرئاسته، و99.98 في المائة لدستوره، مؤكداً صلاحه لقيادة الأمة نحو مغادرة ما قبل التاريخ.
لكن، لئن وجد أتاتورك نفسه مواجَهاً بمسألة الإسلام الذي دمجه في القومية التركية، ثم اتجه عبد الناصر إلى مزاوجة الاثنين عبر ثنائية «العروبة والإسلام»، فإن الزمن السوفياتي وفر للزعيم المصري ثنائية أخرى بات مطلوباً التعامل معها، وهي القومية والاشتراكية التي تستطيع أن توفر للنظام قاعدة لا تقل عرضاً عما توفره الثنائية الأولى. وبدوره، كان الظرف السياسي ملائماً لرفع الثنائية الثانية إلى موقع متصدر، وإشراكها مع الثنائية الأولى في صياغة الشرعية الجديدة وتمتينها. ذاك أن جماعة الإخوان المسلمين كانت قد تلقت الضربة القاضية بعد الأخرى، وبدا أن التأميم القومي الناصري للإسلام قد أنجز غرضه، فيما كانت المصالحة الناصرية - السوفياتيّة، بعد خلاف 1959 - 1963، قد استتبعت حل التنظيمات الشيوعية المصرية واستيعابها داخل «الاتحاد الاشتراكي العربي».
وإلى ذلك، فإن هزيمة 1948 أمام إسرائيل أفقدت الجيل الوطني الأسبق وزنه وجاذبيته، لا سيما أنه لم يكن قد طور أي موقف إصلاحي واجتماعي يُعتد به في مواجهة الأنظمة والأوضاع القائمة. فتركيزه شبه الأحادي على العناصر الخارجية (الاستعمار، الأجانب، اليهود...)، وفق وعي قومي أولي مبسط، وصِلته العضوية بالملوك والحكام «الرجعيين» (رؤساء حكومات العراق، وعزيز علي المصري، وساطع الحصري)، فضلاً عن عدم فهمه العلاقات الدولية الجديدة لما بعد الحرب العالمية الثانية، وانهيار عالمه الضمني بانهيار النازية الألمانية؛ كل هذا جعله يبدو شريكاً في التسبب بهزيمة 1948، والانتساب -بهذه النسبة أو تلك- إلى ما قبل التاريخ.
وهذا ما أوكل إلى حاملي الثنائية الجديدة (قومية واشتراكية) مهمة إنقاذ أسوأ المراتبيات والسلطويات التي عرفها النظام القديم، بعد إحداث بعض التغيير في تركيبها الطبقي لمصلحة الطبقة الوسطى بسائر شرائحها، على حساب الأعيان التقليديين على اختلافهم. أما البدايات البرلمانية التي دشنها النظام القديم، بعدما أسستها ديمقراطية الانتدابات الأوروبية، فهي أكثر ما عرضه حاملو الثنائية الجديدة للسحق والاستئصال.
هكذا، دُمجت الثنائيتان معاً على نحو زاد الآيديولوجيا الناصرية تشوشاً، كما أمعن في تآكل انسجامها الضئيل، بعد أن ضُرب الممثلون الأصليون لمكوناتها أو دُجنوا. فهناك إسلام محرر من الإخوان المسلمين القابعين في السجون، واشتراكية محررة من الشيوعيين الذين ذاقوا السجون قبل أن يتوبوا بتشجيع سوفياتي، وقومية عربية لم يعد يمثلها القوميون العرب الأوائل المشوبون برواسب العهد القديم. وعلى العموم، فمثلما وُصف إسلام الثنائية الأولى بـ«العربي» (وهو ما جُعل نعتاً إيجابياً، بعدما كان في القاموس الكمالي نقيصة استبعادية)، وُصفت الاشتراكية بـ«العربية» في الثنائية الثانية، بحيث بدت القومية (=العروبة) المصب الذي ينتهي عنده رافدا الإسلام والاشتراكية، من دون أن يُغني ذلك عن زيجات فرعية أخرى، كاعتبار الإسلام اشتراكياً، واعتبار الاشتراكية من تعاليم الإسلام.
وفي خلط ما قد يبدو عصياً على الخلط، أنشئ في مصر «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» عام 1960؛ أي إبان الوحدة مع سوريا، للتعريف بالإسلام وإحياء تراثه، وصدر المرسوم رقم 57 الذي ضم المساجد الأهلية إلى وزارة الأوقاف. وفي 1961، سنة صدور القوانين الاشتراكية، صدر القانون الذي أسفر عن إلحاق الأزهر برئاسة الجمهورية، وتعيين وزير لإدارة شؤونه، بعدما كان قد جُرد في 1957 من استقلاله المالي بتأميم الأوقاف الخيرية. ثم كان دستور 1964، في ذروة العروبية والاشتراكية، فأُعلن للمرة الأولى أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وتعاظم بالتالي التركيز على بناء المساجد، وإنشاء المحطات الإذاعية الدينية، والتوسع في نشر التراث الديني، وصدر القانون رقم 89 عاهداً إلى الحكومة تعيين الأئمة والعاملين في المساجد الأهلية، فضلاً عن كتابة وزارة الأوقاف خطبَ الجمعة وتوزيعها على خطباء المساجد. وغدت برامج التعليم الديني أكثر تسييساً وتبعية للرؤية العامة التي تحملها الناصرية للمسائل المطروحة.
السلطة حين تقضم الواقع
هنا، لا بد من استبعاد أي تقسيم خطي بسيط يرسم العلاقة بين القومية والدين، خصوصاً في التاريخ العربي الحديث، بصفتها علاقة نفي وتناحر. فهذا ما أنكره، قبل الناصرية، أبرز رموز الدين المسيس الذين عدوا القومية جزءاً من مهمتهم، كما أنكره أبرز الرموز القوميين ممن وسعوا مساحات التقاطع بين العروبة والإسلام. ذاك أن القومية والدين، إذا نظرنا إليهما نظرة جذرية في تأويلها مجردة عن السياق العربي المحدد، يشتركان في تسبيق الفكرة على الواقع، كما يُسبقان الماضي على الحاضر، و«الكرامة» على المصلحة. إنهما، بعبارة أخرى، خطابان ثقافيان قبل أن يكونا أي شيء آخر. وهما، منظوراً إليهما على ضوء تلك المعاني، ينطويان على استعداد رومنطيقي حاد ثقيل سبق تناوله في الفصل الأول. وهذا، بطبيعة الحال، لا يلغي الصراعات الحادة بينهما التي عرف عرب المشرق كثيراً منها، لا سيما منها النزاع الناصري والبعثي مع الإخوان المسلمين، إلا أنه يُدرج تلك الصراعات في خانة لا تبعد كثيراً عن خانة النزاع على السلطة فيما بين القوميين أنفسهم (الناصرية والبعث، والاثنان وحركة «فتح» الفلسطينية)، أو خانة النزاع فيما بين الإسلاميين (الإخوان والسلفيين مثلاً، كي لا نذكر الإسلاميتين السنية والشيعية).
ومع هذا، فإن المطابقة بين الدين والقومية تسيء، فضلاً عما تنطوي عليه من خطأ معرفي، إلى الاثنين، إذ تمعن في تسييس الأول، بما يستبعد مئات الملايين من المسلمين غير العرب، إمعانها في تديين الثانية، بما يستبعد بضعة ملايين من العرب غير المسلمين، جاعلاً طردهم إلى خارج السياسة ممكناً. وكنا قد لاحظنا في وقت لاحق، في التسعينيات، وبذريعة إنشاء جبهات مناهضة للإمبريالية، كيف ازدادت هذه الثنائية انحطاطاً من خلال المقولة البائسة عن «الأمة العربية الإسلامية» التي تُعمي عن كل معرفة وكل واقع.
أما الثنائية الأخرى، وإن لم يقتصر الأخذ بها على التجربة الناصرية وشقيقاتها العربية، على ما سوف نعود لاحقاً إليه، فتنطوي على تناقض أفدح مصدره توهم التغلب الإرادي على خلاف فلسفي بالغ العمق بين القومية بصفتها نظرية للجمع والتوحيد قفزاً فوق تباينات الواقع، والاشتراكية بصفتها نظرية للتفريق و«الصراع» استناداً إلى مقدمات طبقية. وهذا فضلاً عن صعوبة ربط القومية بمقدمات تنويرية مقابل السهولة النسبية لربط الاشتراكية بها.
على أن هاتين الثنائيتين المدمجتين للقومية والإسلام، والقومية والاشتراكية، وإن وفرتا لصاحبهما نوعاً من الاطمئنان السعيد، وتوهم السيطرة على الدنيا، ضاعفتا تمكين الوعي الرومنطيقي، ليس فقط بتوسيعهما المسافة الفاصلة عن الواقع، بل أيضاً بتأسيسهما استحالة فعلية في رؤية الواقع. أما فهم الاستحالة هذه فينبع من وضع الواقع في موضع النقيض للأولوية المطلقة الجديدة الحاجبة له: اكتساب شروط الحد الأقصى لبلوغ السلطة، والبقاء فيها أطول مدة ممكنة، والتخلص تالياً من الخصوم والخصوم المحتملين؛ أي إزالة مَن لا تكتمل من دونهم حقيقة الواقع الذي يغدو، والحال هذه، مطابقاً مساوياً لزعامة الزعيم.
على أي حال، بقي العنصر الرومنطيقي حاداً في الخطاب الناصري على تقلباته، وإن ازداد حدة منذ 1956، خصوصاً منذ الوحدة مع سوريا في 1958، أتعلقَ ذلك بثنائية «العروبة والإسلام» أو بثنائية «القومية والاشتراكية».
والمشكلة، وفقاً ليونس، أن النظام الذي أقامه انقلاب يوليو (تموز) «يملك النوايا، ولكن لا يملك الوجهة أو الخطة». ويستخدم يونس في وصف العملية هذه ما يعين بالضبط العفوية الرومنطيقية للانقلاب والانقلابيين. ذاك أن الضباط أتوا بصفتهم «أنبياء أرسلهم (اسم الشعب) ليقيموا في ساحة المعبد التي أخلوها على شرفه (مجتمع المؤمنين)... لكنهم لم يتلقوا كتاباً، بل سمعوا نداء فحسب تحركوا بموجبه».
لكن عبد الناصر والمقربين منه أنفسهم لم يتفوهوا بما هو أقل رومنطيقية. فمع قيام «الجمهورية العربية المتحدة» عام 1958، رأى الصحافي أحمد بهاء الدين، المقرب من الزعيم المصري، أنها دعوة، وليست مجرد دولة، فيما عبد الناصر، في خطاب له في مجلس الأمة عامذاك، تجاوز كل حد في انتهاك المعاني والحقائق، معتبراً أن الوحدة مع سوريا تدخل «ضمن محاولات الوحدة في المنطقة (التي) لم تتوقف منذ أربعة آلاف سنة طلباً للقوة»، وبالمعنى نفسه: «دُبرت المؤامرات ضد القومية العربية من أجل تفتيتها منذ مئات السنين». وحينما استقبل الزعيم المصري استقبالاً جماهيرياً كبيراً في سوريا، تأكد للصحافي محمد حسنين هيكل «أن هذه الأمة كانت تبحث عن (بطل). فلما عثرت عليه... تفجرت المشاعر المكبوتة في أعماقها منذ قرون طويلة... لقد أحسستُ في دمشق أن كل سجل جمال عبد الناصر من الأعمال لم يكن... انتصارات وطنية فحسب، وإنما كانت هذه كلها في مشاعر الأمة العربية (إشارات). إشارات معناها أن اليوم قد جاء، وأن (البطل) قد ظهر».
لكن بعد عامين، ومن اللاذقية، خاطب عبد الناصر السوريين المنفعلين بأن «قوتكم أيها الإخوة المواطنون إنما تظهر من انفعالكم الدائم».
وفي 1959 و1960، ساد الكلام الرسمي عن «اشتراكية القرية» و«ديمقراطية المصطبة»، فيما «الشعب»، وفقاً لأحد قادة انقلاب يوليو (تموز)، كمال الدين حسين، هم «رفقاء المصطبة والدوار ورواد المندرة»، و«الديمقراطية الحقيقية هي التقاء أبناء الشعب نفسه على المصاطب أو مضايف القرية أو أندية المدينة، كما يلتقي كل ذي أهل بأهله».
ولئن تشكلت أعمدة الآيديولوجيا الناصرية من مفاهيم «الدعوة» و«الزحف» و«المجد»، فهذا لم يحل دون اجتهادات في الاشتراكية، كأن يستعيد أنور السادات عام 1964 «النظرية القروية في الاشتراكية» التي لازمت انقلاب يوليو (تموز) منذ أيامه الأولى، مؤكداً أن «اشتراكيتنا... يجب ألا يتبادر إلى الذهن أبداً أنها اشتراكية مادية... نشأت الاشتراكية أول ما نشأت في القرية على أصول راسخة من الدين والإيمان (...) أما (العلمية) في هذه الاشتراكية... فليست إلا تنظيم وتخطيط هذه المشاركة البدائية، بحيث نستطيع أن نحقق لمجتمعنا أعظم فائدة ممكنة حسبما أنتج العلم... فمثلاً نستطيع أن نستبدل المحراث البدائي بماكينة حرث».
وعلى هذا النحو، وعلى مدى زمني يمتد منذ 1952، وتتخلله هزيمة 1967 المطنطنة، أجاز الموقف الوطني والقومي، بصفته ما يساوي العداء للغرب، ويحض على طلب القوة، قدراً من امتهان العقل والحرية والواقع في وقت واحد.
الحلقة (1): الطريق إلى الزعامة الراديكاليّة... من الخيبة بأتاتورك إلى التجربة العراقيّة المبكرة
الحلقة (2): الطريق إلى الزعامة الراديكاليّة... «صناعة الموت» ودورها التأسيسي
الحلقة (4): الطريق إلى الزعامة الراديكاليّة... من عبد الناصر إلى مرحلتي الوعي الانقلابي