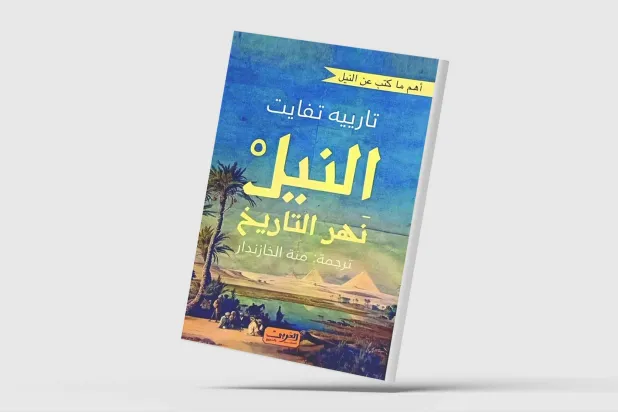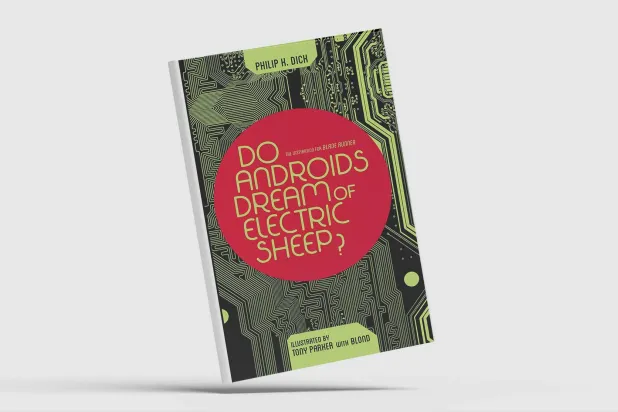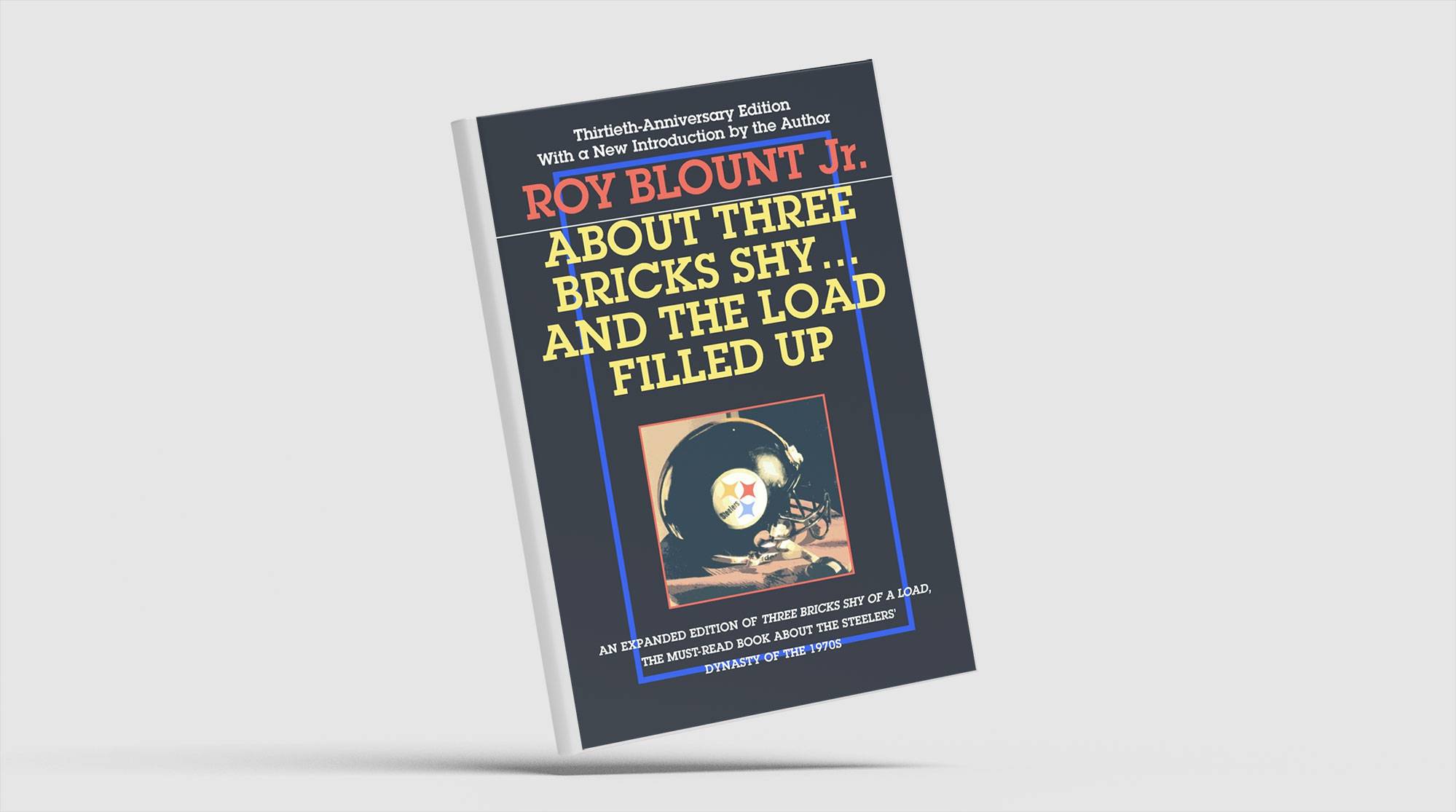تتناول الحلقة الثانية من كتاب «رومنطيقيّو المشرق العربي» لحازم صاغيّة مسألة الترويج لـ«صناعة الموت» ونشرها بين الشبان العرب، مشيراً إلى استشهاد المروجين لهذه الفكرة، مثلاً، بمصطفى كمال في الأناضول وبضبّاطه الذين تدرّبوا على صناعة الموت، فحصدوا النصر، وبموسوليني الذي لو لم يكن لديه عشرات الآلاف من «ذوي القمصان السوداء» الذين احترفوا صناعة الموت، لما كان قادراً على أن يبعث تاريخ روما العظيم والقديم.
ويتحدث صاغية عن «الهوى الألماني» الذي استولى على «الأكثرية الساحقة من النخبة العسكرية» في البلدان العربية، معتبراً أن المنظّر القومي العربي ساطع الحصري: «لم يُبدِ أي اكتراث بالواقع العربي وجماعاته وانقساماتها وثقافاتها الفرعيّة، مركّزاً على طوبى قوميّة، ألمانية المصدر وإيطاليته، رغب في إسقاطها على العراق والعالم العربي».
في ذاك العهد نفسه، عهد غازي، دعا سامي شوكة، مدير المعارف العامّ في العراق، طلاّب الثانويّات إلى اعتناق «صناعة الموت»، والتي إن لم تحترفها الأمّة بـ«الحديد والنار»، أُجبرت على الموت تحت حوافر أحصنة الأجانب. ذلك أنّ الغاية من «نظام الفتوّة» الذي أنشأه غازي هي «تعويد الفتيان على خشونة العيش وتحمّل المشاقّ والمُفاداة وبثّ الروح العسكريّة وصفات الرجولة والفروسيّة وما يتبعها من خصال».
وبالطبع، استشهد شوكة (الذي لقّبه السياسي الديمقراطي كامل الجادرجي بـ«أوزوالد موسلي العراق»، قاصداً الزعيم الفاشي البريطانيّ) بمصطفى كمال في الأناضول وبضبّاطه الذين تدرّبوا على صناعة الموت، فحصدوا النصر واستعادوا أمجاد السلطان سليم. كما استشهد بالشاه رضا بهلويّ، الذي احترف وضبّاطه تلك الصناعة «المقدسة»، ما جعلهم يستعيدون مجد داريوس. أمّا في إيطاليا، فلو لم يكن لدى موسوليني عشرات الآلاف من «ذوي القمصان السوداء» الذين احترفوا صناعة الموت، لما كان قادراً على أن يبعث تاريخ روما العظيم والقديم. وهكذا، فإنّ روح هارون الرشيد والمأمون تريد للعراق أن يمتلك في فترة قصيرة نصف مليون جندي ومئات الطائرات.
وربّما جاز القول إنّ كتاب شوكة هذا، لا سيّما مقالته الأولى «صناعة الموت»، من أبلغ وأبكر النصوص العربيّة في التعبير الرومنطيقي العنيف والإرادي والأعمى عن كلّ واقع. على أنّ التوجّهات هذه لم تَحُل دون جرعة علمويّة حادّة هي الأخرى، تتوافق بدورها مع الرومنطيقيّة، بالمعنى المشار إليه في الفصل السابق. ذلك أنّ العلم «برهن (...) أخيراً على أنّ المرأة لا تصل إلى مرتبة الكمال النسبيّة التي تنتظرها من حيث الصفات العقليّة والنفسيّة والجسميّة إلاّ بالزواج والولادة والرضاعة، وأنّ المرأة التي تَحول بعض الأسباب دون زواجها وولادتها وإرضاعها أطفالَها من ثدييها لا بدّ من أنّها تبقى بعيدة عن السموّ إلى المرتبة التي كانت تنتظرها فيما لو تزوّجت وولدت وأرضعت»، ثمّ يستشهد بعبارة ينسبها إلى فيكتور هوغو من «أنّ الطبيعة قد خلقت مهداً فوق صدر المرأة لا يستطيع أن يبقى فارغاً».
وعلى العموم، فإنّ شوكة في خطاباته ومحاضراته التي نُشرت في 1939 بعنوان «هذه أهدافنا»، دائم التوكيد على ضرورة الانبعاث العربي المرتكز إلى الماضي المجيد وأهميّة العسكرة والنزعة الحربيّة لصدّ أعداء الداخل والخارج. لكنّه أيضاً يضيف إلى رجعيّته حيال المرأة اختياره أبطاله من رجالات الأسرة المَلَكيّة الهاشميّة، ابتداءً بمؤسّسها في العراق الملك فيصل الأوّل، انسجاماً مع تقليد ملَكي وسلالي هيمن على معظم العقول القوميّة العربيّة حينذاك.
وبدوره سبق لناجي شوكة، شقيق سامي، وأحد وزراء حكومة الكيلاني الانقلابيّة وأحد مبعوثيه إلى برلين، أن درس في كلّيّة الحقوق في جامعة إسطنبول وقاتل في الجيش العثمانيّ. وهو من يصفه رئيس حكومة عراقي سابق بالتالي: «كان ناجي شوكة قوي الطموح، ضعيف المادّة في العلم والتتبّع الفكريّ. لذلك كان يسعى للتعويض عن ضعفه العلمي بذكائه ومناوراته وشطاراته وتحريكاته، حتّى بات زملاؤه يخشون بأسه ويحترسون من شرارات مقالبه (...) كان... عيياً في الخطابة وضعيفاً في الكتابة وقليل البضاعة في التفكير الرصين».
أمّا زميل سامي شوكة، الدكتور فاضل الجمالي، مفتّش التعليم العامّ، والذي ربطته بالمنظّر القومي العربي ساطع الحصري خصومة شخصيّة وسياسيّة، ففاق خصمه تشدّداً وجذريّة في مواقفه القوميّة. هكذا نعى كونَ العراق لا يملك ما يقارَن بشبيبة هتلر أو منظّمات كومسومول الشيوعيّة، التي تطلب من الشبّان «الإيمان والنظام والعمل الموحّد – الشروط الأساسيّة للنجاح السياسيّ».
وقد ازدهرت تلك التصوّرات وسط النخبة العراقيّة في المناخ الذي أوجده الحصري، الحلبي الأصل، والموظّف العثماني السابق الذي انتقل من سوريّا إلى العراق بصحبة الملك فيصل، حيث تولّى مديريّة التعليم، فكان أبرز ناقلي الدعوات القوميّة العربيّة الشديدة التأثّر بالفكر القومي الألمانيّ. وفي مجمل جهده الفكري والتربويّ، لم يُبدِ الحصري أي اكتراث بالواقع العربي وجماعاته وانقساماتها وثقافاتها الفرعيّة، مركّزاً على طوبى قوميّة، ألمانيّة المصدر وإيطاليّته، رغب في إسقاطها على العراق والعالم العربيّ.
ووفقاً للباحث العراقي البريطاني سامي زبيدة، فإنّ صِدام الحصري والسياسيين السُّنة مع الرموز السياسيين والثقافيين للشيعة حينذاك، إنّما اندرج في تصديع المشروع الوطني العراقي الناشئ. فالصِّدام المذكور، وفي وجه أساسي منه، جاء ردّاً على محاولات فيصل الأوّل دمج الشيعة في النسيج الوطنيّ. ذاك أنّه حتّى الأمس القريب، كما يقول زبيدة بوضوح حاسم، كان «الخطّ الفاصل» في السياسة العراقيّة بين القوميّة العربيّة والوطنيّة العراقيّة.
كذلك أحدث الحصري نقلة أخرى في فهم القوميّة التي ظهرت بداياتها في لبنان وسوريّا بوصفها مشروعاً ثقافيّاً يرادف العلمانيّة و«الإخاء» بين مسلمين ومسيحيين، أي مشروعاً لبناء الوحدات الوطنيّة ينهض على قواعد من الاستنارة وأفكار التقدّم. هكذا دفعها الحصري بعيداً عن ذاك المصدر، الذي ينطلق تعريفاً من الإقرار الصريح بالتعدّد، ليقرّبها من القوميّة النضاليّة كما سنراها لاحقاً في عهدة الضبّاط العسكريين العراقيين والسوريين.
على أنّه بعد انقلاب الكيلاني، المدعوم من الألمان، في 1941 نزع الإنجليز من الحُصري جنسيّته العراقيّة وطردوه من البلاد، فتولّى مسؤوليّات تربويّة كبرى في سوريّا، ثمّ رأس الدائرة الثقافيّة في الجامعة العربيّة بالقاهرة، حتّى ليمكن القول إنّه المربّي العربي الأكبر الذي استمرّت تعاليمه، منذ أوائل الأربعينات، تُخرِّج الأجيال تلو الأجيال. وهو، في هذه الغضون، نشر عديد الكتب عن القوميّة العربيّة، شرحاً أو سجالاً، حتّى تردّد أنّ كتبه هي مما جعل جمال عبد الناصر يتحوّل إلى تلك القوميّة ويجعلها العمود الآيديولوجي الأهمّ لنظامه في مصر.
لقد بدا الهوى الألماني مستولياً على الأكثريّة الساحقة من النخبة العسكريّة، التي صارت النخبة السياسيّة في العراق المستقلّ، بحيث شكّل نوري السعيد، المُدرِك لواقع العلاقة مع بريطانيا، والمحبِّذ لنموذجها، حالة نافرة. فلم يكن عديم الدلالة مثلاً أنّ جعفر العسكري، الذي حضر كضابط عثماني دورات تدريبيّة ومناورات للجيش الألمانيّ، بات أوّل رئيس حكومة تُشكّل من العسكريين عام 1923، وأوّل وزير دفاع في العراق بعد الاستقلال، وأنّ الضبّاط العثمانيين السابقين ممن شاركوا في الثورة الهاشميّة، خصوصاً منهم جميل المدفعي، هم الذين سبق أن قادوا الأعمال العسكريّة ضدّ البريطانيين.
هكذا انطوت تجربة أولئك الضبّاط، منذ لحظة انحيازهم إلى الثورة الهاشميّة في 1916 حتّى تعاونهم اللاحق مع الانتداب البريطاني في حكم العراق، على شعور مُرّ ومتشائم بخيانة أصولهم التي أسّستْهم كتلامذة للألمان وكارهين للبريطانيين، ما أسهم في رفع جرعة الذنب العاطفيّة والشعوريّة التي تطفح بها المذكّرات الكثيرة التي كتبها لاحقاً ساسة العراق العسكريّون.
وربّما كان لهذا الإرث، على اختلاطه، أن زوّد التاريخ العراقي اللاحق بحافز إضافي إلى العنف، كذاك الذي مورس مراراً حيال الأكراد، كما انفجر متفلّتاً من كلّ قيد مع الطريقة الوحشيّة التي صُفّيت بها الأسرة الملكيّة عام 1958، ثمّ مع عهد عبد الكريم قاسم والتذابح القومي – الشيوعي الذي انفجر مجدّداً بعد وصول حزب «البعث» إلى السلطة في 1963، قبل أن يستقرّ له الحكم ثانية على يد صدّام حسين.
- عزيز علي المصري
بيد أنّ التأثّرات الألمانيّة والعثمانيّة - التركيّة، لم تقتصر على العراق، وإن شكّل الأخير أكثر محطّاتها اكتمالاً وتبلوراً. وربّما كان عزيز علي المصري الرمز الأبرز في التعبير عن هذا الهوى، وعمّا انجرّ عنه من تداعيات عاطفيّة، سياسيّة وآيديولوجيّة. وهذا إنّما يسمح بالقول إنّ العناصر الزعاميّة التي امتلكتها تجربته فاقت مثيلاتها عند القادة العراقيين ممن عاصروه اكتمالاً، لا سيّما وأنّ ياسين الهاشمي توفّي مبكراً في 1937، والملك غازي في 1939، وفي 1941 كُتبت النهاية السياسيّة للكيلاني بعد إحباط انقلابه.
والحقّ أنّ الاهتمام بالمصري، بوصفه ناقل تلك التجربة إلى مصر، وجسر الانتقال داخل المؤسّسة العسكريّة من جيل إلى جيل أصغر، ظلّ أقلّ كثيراً من وزنه وتأثيره الحقيقيين في التاريخ العربي الحديث، وهو ما يستدعي وقفة أكثر تفصيليّة حيال حياته وأعماله.
فعزيز علي هو الذي حاول في 16 مايو (أيار) 1941 أن يهرب بطائرة حربيّة إلى ليبيا للتواصل مع القوّات الألمانيّة هناك، ما أشاع تشبيهه برودولف هِسّ، نائب أدولف هتلر الذي كان قبل ستّة أيّام فقط قد توجّه في رحلته الجويّة التعيسة إلى اسكوتلندا. لكنْ لئن كان الهدف الساذج لهسّ تمهيد السبيل إلى محادثات سلام مع البريطانيين، فإنّ هدف المصري كان جرّ بلده مصر إلى الحرب ضدّ بريطانيا، إلى جانب الألمان. والمصريّ، الستيني يومذاك، والذي بات بطلاً أسطوريّاً لبيئة القوميين العرب، درس منذ كان في الثانية عشرة في المدرسة الداخليّة التابعة للكلّيّة الحربيّة العثمانيّة، وتخرّج في 1904 متأثّراً بمُدرّسيه الألمان. وقد خدم، حتّى 1907، في البلقان، مشاركاً كضابط عثماني في قمع انتفاضاته، ثمّ انتسب إلى «الاتّحاد والترقّي» ولعب دوراً بارزاً في استعادة إسطنبول، إلى جانب محمود شوكت، من قوى الثورة المضادّة. أمّا أمله يومذاك فكان أن تمنح «تركيّا الفتاة» الحرّيّة للعرب، بحيث تنشأ مملكة ثنائيّة القوميّة، تركيّة – عربيّة، على غرار تلك الهبسبورغيّة، النمساويّة – الهنغاريّة. لكنّه إذ تيقّن من أنّ «تركيّا الفتاة» بالغة التعصّب لتركيّتها، بدأ العمل ضدّها مشاركاً في تأسيس جمعيّة «القحطانيّة» السرّيّة، التي ضمّت مثقّفين مدنيين وضبّاطاً عرباً، غير أنّه استمرّ كضابط عثماني ينفّذ الأوامر من جهة، ويخوض، من جهة أخرى، المعارك التي ظلّت تجمعه بالأتراك في مواجهة التمدّد الغربيّ. ففي 1910 نُقل إلى اليمن ليشارك في إخماد انتفاضة الإمام يحيى، ثمّ تطوّع للقتال ضدّ الغزو الإيطالي لليبيا في 1911، فدافع عن بنغازي إلى جانب أنور ومصطفى كمال. وفي 1913 عاد إلى إسطنبول وقد صار من مؤسّسي جمعيّة «العهد»، وهي تنظيم سرّي للضبّاط العرب في الجيش العثمانيّ، معظمُ أعضائه عراقيّون، ومعهم قلّة من السوريين والفلسطينيين. بيد أنّه اعتُقل في شباط 1914. وفي أبريل (نيسان) حُكم بالإعدام، ما أثار موجة سخط واعتراض في مصر وسوريّا وبين عرب المَهاجر. وإذ أُطلق سراحه وسُمح له بالتوجّه إلى مصر، رُحّب به هناك كبطل قوميّ. فحينما اندلعت الحرب، طلب منه الحاكم البريطاني لمصر، اللورد كيتشنر، أن ينضمّ إلى القتال ضدّ الأتراك، ومن ورائهم الألمان، فلم يُبد استعداداً لذلك، وهو الذي كان دوماً، في مواقع قتاله الكثيرة، يقاتل البريطانيين متحالفاً مع الألمان. وفي 1916 راودت عزيز علي فكرة الاتّصال بألمانيا، إذ ربّما تمكّنت من إقناع حلفائها الأتراك بمنح العرب حكماً ذاتيّاً ضمن الإطار الجامع للإمبراطوريّة العثمانيّة. لكنْ فقط بعدما وعد البريطانيّون، في رسائل مكماهون، العرب بالاستقلال، وبعد أن رفع الشريف حسين، شريف مكّة، راية التمرّد، انضمّ المصري إلى الثورة العربيّة. وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه عُيّن رئيس أركان الجيش الشريفي بطلب من البريطانيين، رغم تحفّظ الشريف حسين نفسه. وبالفعل تفاقمت الخلافات بينه وبين الشريف. فحين أمر الأخير بالهجوم على المدينة، حيث تتمركز القوّات العثمانيّة في الحجاز، عارض الخطّة كلّها، لتحبيذه انتفاضة داخل الإمبراطوريّة العثمانيّة، وليس عملاً يفضي إلى تقسيمها. ولأنّه، فوق هذا، بقي على تفضيله التحالف مع ألمانيا، بدل بريطانيا، استقال من أدواره العسكريّة وعاد إلى القاهرة قبل نهاية 1916.
لكنّ الصحافي اللبناني أسعد داغر، المقرّب إلى المصري والمعجب به، بحيث سمّاه «أبا الفكرة العربيّة وحامل لوائها»، يضيف سبباً آخر إلى خلافه مع القيادة الهاشميّة. فعزيز علي لم يُخفِ منذ البداية احتقاره للبداوة وقدراتها العسكريّة، وكان يتساءل: «هل تعتقدون أنّنا نستطيع تحقيق هذه الأمنية بالقوّات التي لدينا الآن؟ هل تقبلون بأن تدخلوا سوريّا بهذا الجيش الذي لا قوّة له ولا نظام فيه؟ وكيف يقابلنا سكّانها إذا نحن جئناهم للسلب والنهب والتدمير والتخريب؟ فقبل التفكير في الزحف إلى الشمال يجب علينا، على الأقلّ، أن نعمل على إيجاد جيش منظّم».
وعلى أي حال، انتقل المصري من القاهرة إلى سويسرا، ومنها إلى ألمانيا، فسُمح له بالتوجّه إلى إسبانيا حيث بقي حتّى نهاية الحرب، وبعد ذاك توجّه إلى برلين التي بقي فيها قرابة أربع سنوات. وفي 1922، وقد حصلت مصر على الاستقلال الناقص، عاد إليها من دون أن يُقبَل في الخدمة العسكريّة. إلاّ أنّه بعد سنوات من التبطّل، انضمّ إلى بلاط الملك فؤاد وعُيّن في 1935 مرافقاً لفاروق، الأمير والملك اللاحق، الذي كان حينذاك يدرس في بريطانيا. ولئن حال اختلاف طباعهما دون بقائه طويلاً في خدمته، إلاّ أنّه ظلّ يمتلك ما يكفي من التأثير عليه لدفعه في وقت لاحق إلى التعاطف مع المحور.
- «الضبّاط الأحرار»
ما بقي ثابتاً لا يتزحزح كان ولاء عزيز علي لحبّه القديم، ألمانيا، وهو حبّ يصعب التغافل عن مضمونه العاطفي الحادّ والمحتدم. هكذا زار الرايخ الثالث في 1938 كموفد من الدوائر المصريّة المناهضة للبريطانيين، كي يناقش عمليّة تزوّد سرّيّة بالسلاح. وفي صيف 1939 حين تولّى علي ماهر رئاسة الحكومة، وهو الموالي للألمان، عيّنه رئيسَ أركان الجيش، ثمّ سقط بسقوط ماهر الذي أُجبر على الاستقالة في يونيو (حزيران) 1940. ولئن تقاعد في 1 أغسطس (آب) نهائيّاً، فإنّ شوقه الغالب لرؤية انتصار ألماني في 1941 حمله على تغيير خططه الشخصيّة. وفي هذا، لم يكن عزيز علي وحيداً بين الضبّاط المصريين الملتفّين حوله، وكان أحدهم وأصغرهم سنّاً يومذاك أنور السادات، ابن الثالثة والعشرين. هكذا قرّر المصري أن ينضمّ إلى قوّات رومل في الصحراء الغربيّة، ووافق الألمان على الفكرة، كما أُجريت محاولات فاشلة عدّة لنقله، انتهت باعتقال البريطانيين له، ومعه ضابطان أحدهما الطيّار عبد المنعم عبد الرؤوف، الذي سيصبح لاحقاً عضواً من جماعة الإخوان المسلمين في قيادة «الضبّاط الأحرار».
وبدورهم لم يكن الألمان مخطئين في تقييمهم الذي شدّد على أنّ الملك والضبّاط المصريين الشبّان يميلون إليهم. فقد ظهر بين الضبّاط المصريين مَن ينشقّ ويحاول الانضمام إلى قوّات رومل في ليبيا، ومنهم حسن إبراهيم، الذي غدا، هو الآخر، أحد قياديي «الضبّاط الأحرار». ومع حادثة 4 فبراير (شباط) 1942، حين تدخّل البريطانيّون بالقوّة كي يفرضوا على الملك فاروق حكومة وفديّة موالية لهم، بدل الحكومة الموالية للألمان، وكان الأخيرون وحلفاؤهم اليابانيّون ما زالوا يحرزون انتصارات عسكريّة باهرة، تعاونت مع العملاء الألمان شبكة ضبّاط على رأسها السادات الذي اعتُقل وانضمّ في سجنه إلى عزيز علي.
وعلى العموم، كان لواقعة 4 فبراير التي أصابت الوطنيّة المصريّة برضّة لم تبرأ منها، أن هندست تحالفاً غير معلن ضمّ، إلى المصري، جماعة الإخوان المسلمين، وحزب «مصر الفتاة» شبه الفاشي، وعلي ماهر، وشيخ الأزهر مصطفى المراغي، ممن جمعهم العداء للوفد والإنجليز. ولم ينظر أطراف هذا التحالف بأي عداء إلى الملك والمَلكيّة إلاّ في وقت لاحق، إذ من الأدقّ القول إنّ القصر منح بركته لهذا التحالف الوطني والرجعي معاً، والذي تغيّرت مكوّناته من غير أن تتغيّر توجّهاته. ذاك أنّ نشأته رسمت خطّاً للانقسام حَكَمَ السياسات التالية لمصر وباقي المشرق العربيّ، يضع الوطنيّة والقوميّة والإسلام مقابل الديمقراطيّة والاستعمار، كما يصطفّ في العلاقة بالقوى الدوليّة في مواجهة الدول التي هي استعماريّة وديمقراطيّة في الوقت نفسه.
أمّا بعد الحرب العالميّة الثانية، ولدى التفكير في إطاحة النظام الملكيّ، فكان المصري أوّل الأسماء التي فكّر فيها ضبّاط الانقلاب اللاحق كي يلعب الدور الذي لعبه محمد نجيب، وهو ما يُرجّح أن يكون تقدّمه في السنّ سبب الاعتذار عنه. لكنْ يبقى أنّ الضبّاط الشبّان هؤلاء الذين التفّوا حوله، وكان السادات همزة الوصل بينه وبينهم وبين الإخوان المسلمين، رأوا فيه «رغم شيخوخته، دور الأب الروحيّ، بما يمثّله تاريخه السياسي من كراهة للإنجليز ومن النشاط من خلال المؤسّسة العسكريّة».
ذاك أنه بعد فشل التعويل على دفع الملك إلى مصادمة البريطانيين وتزعّم العمل الوطني المناهض لهم، وفي مناخ ما بعد هزيمة 1948 وما نُسب إلى «الفساد» و«الأسلحة الفاسدة» في التسبب بها، تجمّع هؤلاء، عام 1949 في تركيبة «الضبّاط الأحرار».
فإذا دقّقنا في عناصر سيرة المصري تبدّت لنا قوّة الخلفيّة العثمانيّة – التركيّة، والهوى الألمانيّ، والسلوك التآمريّ، وكذلك الوعي البالغ المحافظة في العلاقة بالملك ومؤسّسة القصر، معطوفاً على المراتبيّة التنظيميّة الحديثة والكارهة للبداوة و«التخلّف». كما تبدّى لنا، في المقابل، قوّة العداء لبريطانيا واستعمارها، ولكنْ أيضاً للديمقراطيّة وحزب الوفد البرلمانيّ. والراهن أنّ توزّع المشاعر والمواقف على هذا النحو، والذي لم يأتِ صدفة، صبغ لاحقاً معظم العمل الوطني والقومي في المشرق العربيّ، على ما يوضحه التحالف العريض الذي مثّله «الضبّاط الأحرار» المصريّون.
الحلقة (1): الطريق إلى الزعامة الراديكاليّة... من الخيبة بأتاتورك إلى التجربة العراقيّة المبكرة