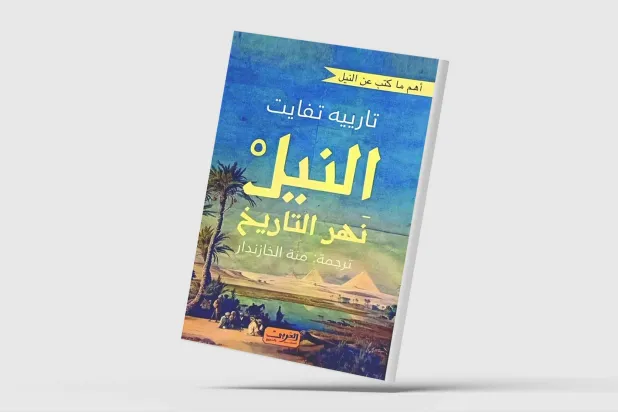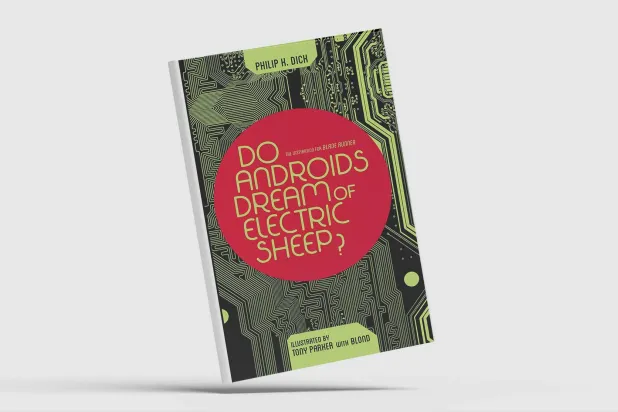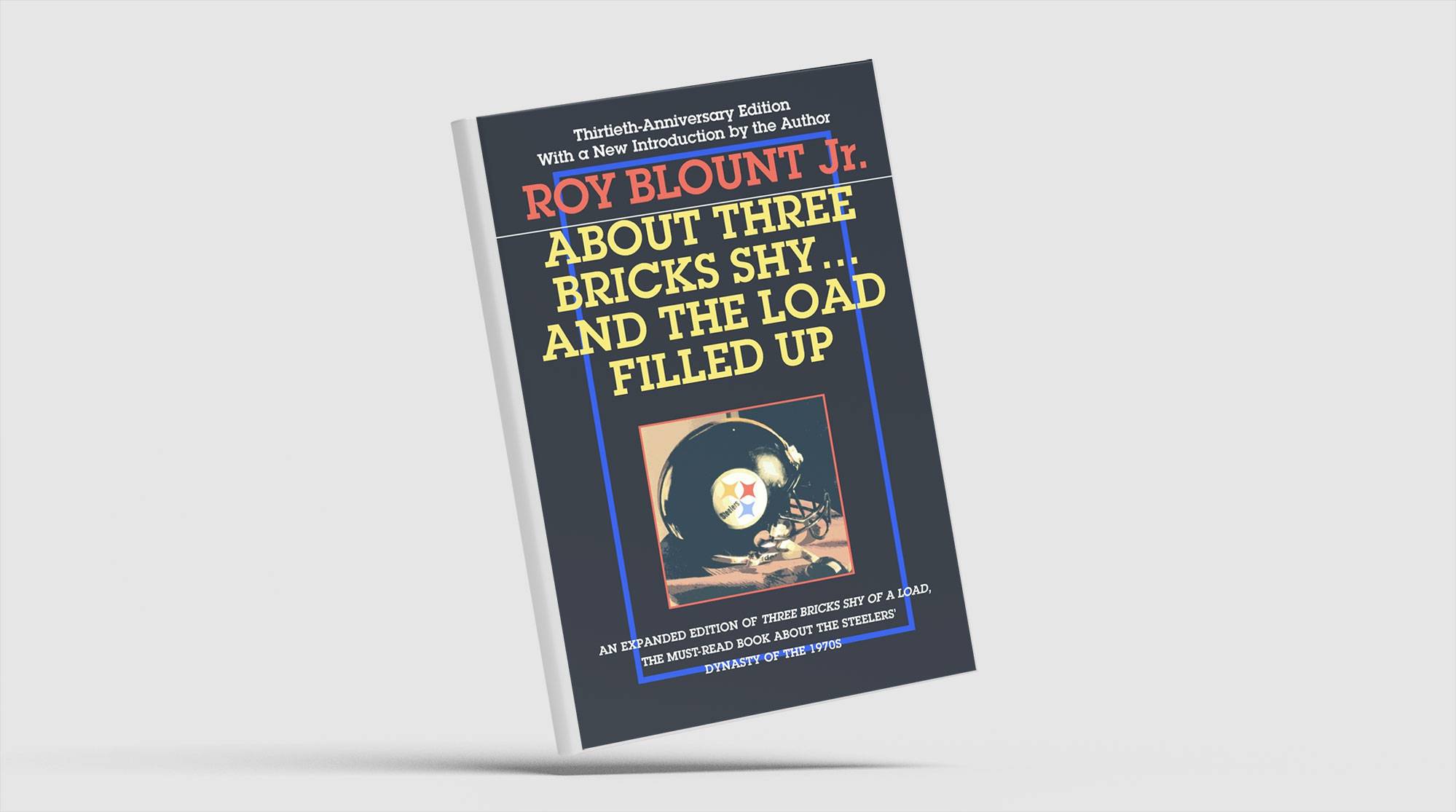على مدى أربع حلقات، تنشر «الشرق الأوسط» فصلاً من كتاب «رومنطيقيو المشرق العربي» لحازم صاغية الذي سيصدر قريباً عن «دار رياض الريس للكتب والنشر» في بيروت.
يرصد صاغية، في هذا الفصل من كتابه الجديد، التغيرات التي طرأت في المنطقة بعد انهيار السلطنة العثمانيّة وولادة الدول العربيّة الجديدة، وكيف تحوَّل كثيرون من الضبّاط والموظّفين العثمانيّين السابقين حكّاماً لتلك الدول، و/أو قادةً للعمل المسلّح، أو السياسيّ أو الثقافيّ، المناهض للانتدابين البريطانيّ والفرنسيّ عليها.
ويتحدث صاغية، في هذا الإطار، عن التأثر العربي بمرجعيّة التجربة العثمانيّة، ومن ثمّ التركيّة، المتأثّرة بدورها بالضبّاط الألمان «فبالبناء على تلك المرجعيّة، أُرسِيَت المقدّمات التأسيسيّة للكثير من النشاط والتفكير السياسيّيْن اللاحقيْن في المشرق العربيّ». وفي ما يأتي الحلقة الأولى من فصل الطريق إلى الزعامة الراديكاليّة:
بعد انهيار السلطنة العثمانيّة وولادة الدول العربيّة الجديدة، تحوَل كثيرون من الضبّاط والموظّفين العثمانيين السابقين حكّاماً لتلك الدول، و- أو قادة للعمل المسلّح، أو السياسي أو الثقافيّ، المناهض للانتدابين البريطاني والفرنسي عليها.
ففي العراق، ومنذ إعلانه مملكة في 1921، ثمّ استقلاله الاسميّ في 1932، حتّى انقلاب 1958 الجمهوريّ، كانت الأغلبيّة الساحقة من رؤساء الحكومات من أولئك الضبّاط. أمّا في سوريّا وجوارها، فكان منهم علي رضا الركابي وسلطان الأطرش ويوسف العظمة ومحمد عزّ الدين الحلبي وسعيد العاص، كما وفد إلى الحياة العامّة ممن زاولوا الوظيفة الإداريّة العثمانيّة لفترة تطول أو تقصر، إبراهيم هنانو وهاشم الأتاسي ونسيب البكري وحسن الحكيم وساطع الحصري، وهذا فضلاً عمّن كانوا، في هذه السنة أو تلك، ضبّاطاً مجنّدين (كجك ضابط)، كسعد الله الجابري وفوزي الغزّي وعبد الرحمن الكيّالي. والشيء نفسه يصحّ في الضابط اللبناني فوزي القاوقجي، والموظّف اللبناني – الأردني رشيد طليع، والموظّفَيْن الفلسطينيين محمد عزّة دروزة ورفيق التميمي. وهذا فضلاً عن أنّ جميع الضبّاط المشارقة الذين نفّذوا الانقلابات العسكريّة والمحاولات الانقلابيّة المبكرة سبق أن خدموا في الجيش العثمانيّ، ما ينطبق على بكر صدقي (انقلاب 1936) وضبّاط «المربع الذهبيّ» العراقيين (انقلاب 1941)، انطباقه على حسني الزعيم وسامي الحنّاوي السوريين (انقلابي 1949).
والحقّ أنّ التأثّر بمرجعيّة التجربة العثمانيّة، ومن ثمّ التركيّة، المتأثّرة بدورها بالضبّاط الألمان، عزّز عربيّاً سائر الاتّجاهات التي رأيناها مع السلطنة المتأخّرة و«الاتّحاد والترقّي» قبل أن نراها في الأتاتوركيّة. فبالبناء على تلك المرجعيّة، أُرسِيَت المقدّمات التأسيسية لكثير من النشاط والتفكير السياسيين اللاحقين في المشرق العربيّ.
- اِنتصارات لم يحرزها العرب
بيد أنّ ما أضافته الأتاتوركيّة إلى هذا المُجمَّع السلوكي والعاطفي كان بُعداً آخر وأقوى. فقد شارك العربُ الأتراكَ أسباب احتقانهم ومراراتهم حيال الغرب والحداثة، لكنّهم فاقوهم مرارة: فإذا أدرج المتذمّرون الأتراكُ التاريخَ العثماني وأمجاده في قائمة مهزوميهم في الحرب العالميّة الأولى، بوصفها التتويج الصارخ لأزمات دولتهم واجتماعهم السياسيّ، كان في وسع المتذمّرين العرب أن يضمّوا إلى قائمة مهزوميهم تاريخاً أقدم من التاريخ العثماني وأشدّ تواصلاً مع المقدّس الإسلاميّ، بحيث يتبدّى التاريخ العثماني نفسه مجرّد شطر من أشطاره. وهذا ربّما زوّدنا بأحد الأسباب التي تفسّر خلوّ الردود العربيّة على الحداثة من القطع الراديكالي الأتاتوركي مع التراث. ذلك أنّ المهزوم عربيّاً هو الأصل التأسيسي، فيما المهزوم تركيّاً هو الفرع، وإن كان فرعاً كبيراً ومهمّاً. ثمّ إنّ الأتراك عثروا على تعويض جزئي عن محنتهم لم يعثر العرب على مثله: فالتجربة الكماليّة، تحديداً، إنّما انبثقت من انتصارات عسكريّة لم يحرز العرب ما يعادلها، قبل أن تتمكّن من إنشاء دولة – أمّة تركيّة ليس ثمّة من ندٍّ لها في المشرق العربيّ، باستثناء مصر ذات الوجود التاريخي العريق. ورغم توفّر عدد من المقدّمات الثقافيّة واللغويّة التي أوحت لبعض القوميين العرب بسهولة مشروع كهذا، فإنّ التجارب كلّها جاءت تؤكّد العكس مرّة بعد مرّة.
ولئن سبق لثورة «تركيّا الفتاة»، ومن بعدها انتصارات مصطفى كمال، أن وجدت الحماسة والتأييد لدى الضبّاط العرب عموماً، ثمّ أصبحت حافزاً إضافيّاً لنشاطهم بعد حصول بلدانهم على استقلالها، وتوسّع الإدارات والجيوش التي ضاعفت طموحاتهم، فإنّ تفاوت الواقعين التركي والعربي أضاف إلى الإعجاب حسداً جارحاً لنرجسيّة «الذات». وعلاقة الحسد هذه، التي ربطت العرب بالأتراك، والضبّاط العرب الذين خدموا سابقاً في الجيش العثماني بمصطفى كمال، قد ترمز إليها حادثة رواها فوزي القاوقجي، أحد قادة الثورة السورية في 1925 والقائد اللاحق لما عُرف بـ«جيش الإنقاذ» في فلسطين (1947 - 1948). فيوم 1 يوليو (تموز) 1927، سافر القاوقجي إلى إسطنبول، فيما الثورة السورية تتصدّع وتذوي، مراهناً على العودة من رحلته مُحمّلاً بدعم يمحضه إيّاه زميله السابق في الجيش الذي صار زعيم تركيّا. غير أنّ يوم 1 يوليو 1927 كان أيضاً اليوم الذي زار فيه أتاتورك المدينة الإمبراطوريّة نفسها، وكانت تلك زيارتَه الأولى لها بوصفه رئيس دولة يقيم في عاصمته الجديدة أنقرة. لكنْ، بينما دخلها «أب الأتراك» من البحر، على ظهر يخت «أرطغرل» المَلكيّ، وسط أبّهة ساطعة وعارمة، دخلها القاوقجي بهويّة مزوّرة تحمل اسم «عمر فوزي عبد المجيد»، وبوصفه تاجراً ينوي إقامة معمل للنسيج في إسطنبول. ومن وسط الحشود، راقب القاوقجي، النكرة والمتخفّي، وصول أتاتورك، فكتب لاحقاً عن تأثّره العميق بالاحتفال المهيب، وأنّه لم يستطع إلاّ أن يقارن، بحزن بالغ، «وضعنا بوضع الأتراك».
لكنْ، فيما كان القاوقجي في إسطنبول، أُسدل الستار الأخير على الثورة السورية. فالبريطانيّون طردوا سلطان الأطرش من الأزرق في الأردن إلى وادي السرحان في الدولة السعودية الجديدة، أمّا معظم قادتها الآخرين فشُتّتوا بين عمّان والقدس والقاهرة: هكذا كانت حال محمد الأشمر ومحمد عزّ الدين الحلبي وسعيد حيدر وسعيد العاص، وكذلك كانت حال القاوقجي الذي انتقل من تركيّا إلى الحجاز ليعمل مدرّباً للجيش السعودي الناشئ.
ولم يكن مصطفى كمال غريباً عن الضبّاط العرب الذين خدموا في الجيش العثمانيّ. فعزيز علي المصري وياسين الهاشمي، وسواهما ممن لعبوا أدواراً سياسيّة لاحقة في بلدانهم، كانوا زملاءه في الكلّيّة الحربيّة التي مثّلت واحداً من المراكز الرئيسة للمعارضة السرّيّة ضدّ الحكم الحميديّ. كذلك انضمّ عدد كبير من هؤلاء الضبّاط العرب إلى «الاتّحاد والترقّي»، وكان في عدادهم العراقي محمود شوكت الذي قاد، كما رأينا قبلاً، عمليّة إحباط الانقلاب الرجعي في إسطنبول عام 1909، وكان مؤهّلاً للعب دور سياسي أكبر لولا اغتياله في 1913.
غير أنّ أتاتورك لم يكتفِ بالتجاهل، إذ خطا خطوة أبعد في تعميقه مرارة العرب المشارقة. ففي حربه على الاحتلال الفرنسي لبلاده، استخدم قادة التمرّدات المشرقيّة ضدّ الانتداب الفرنسيّ، كالسوري صالح العلي واللبناني أدهم خنجر، لمجرّد تحسين مواقعه التفاوضيّة حيال فرنسا. ذاك أنّ هدفه الفعلي كان إقناع الأخيرة بأنّه ليس في مصلحتها أن تعارض القوميّة التركيّة ودولتها الجديدة، بل يمكن، على العكس تماماً، ضمان اعتراف الأتراك بالانتداب الفرنسي على سوريّا وحماية المؤسّسات والمعاهد الدينيّة والتعليميّة الفرنسيّة في تركيا، إذا ما اتّبعت باريس سياسة أخرى. أمّا العرب، فلم يدعم أتاتورك انتفاضاتهم إلاّ بوصفها مادّة في مقايضاته السينيكيّة.
غير أنّ تلك التجربة المؤلمة في علاقات الدول لم يتوقّف عندها العرب المشارقة ولا استوعبوها بصفتها الفعليّة هذه، فلم تتحوّل تالياً إلى مصدر لوعي أو ثقافة سياسيين عربيين على درجة من الواقعيّة. هكذا انضاف إلى جرح العلاقة بالغرب جرح العلاقة بتركيّا، مما تُرك تأويله، تماماً كما أُوّل سابقه، لخليط من المشاعر المحتقنة المصحوبة بالتعويل على الخيانات والمؤامرات وما يُنسب إليها من أفعال. فقد عزّزت صدمة أتاتورك، في المشرق العربيّ، الانتقال من موقف المتماهي الممتلئ إعجاباً، إلى موقف عاطفي كاره وشوفينيّ، إن لم يكن عنصريّاً. ولئن استنجدت البيئات الأشدّ تقليديّة وارتباطاً بالعالم السلطاني القديم بأدوار تُعزى إلى الماسونيين و«يهود الدونمة»، وبها فُسّر انقلاب 1908، ومن بعده الأتاتوركيّة وإلغاؤها الخلافة الإسلاميّة، فإنّ البيئات النخبويّة الأكثر تعلّماً ممن استهوتها الطروحات القوميّة الجديدة، اعتمدت رواية بسيطة عن «عصر النهضة» العربي في مواجهة تتريك «الاستعمار التركيّ» و«الانحطاط» الممتدّ على قرون أربعة من «الظلام» الذي نشره ذاك «الاستعمار».
فإذا صحّ تالياً أنّ الأتاتوركيّة أحدثت في بلدها نقلة نوعيّة في الاتّجاه العنصريّ، فإنّ الارتداد العربي ضدّها لم يملك في جعبته إلاّ ردّاً من الطينة ذاتها، لا سيّما وقد عزّزه لاحقاً، عام 1939، ضمّ لواء إسكندرون السوري إلى تركيّا.
بلغة أخرى، لم يستطِع الانشقاق الكبير الذي قادته الأتاتوركيّة عن باقي العالم الإسلاميّ، بعدما مهّدت له «تركيّا الفتاة»، نقل الفكر السياسي المشرقي إلى صعيد سياسي محوره الدول ومصالحها، والعلاقات التي يستقرّ عليها عالمنا، بل قدّم لذاك الفكر السياسيّ، في المقابل، جرعة عاطفيّة أخرى ذات تعبيرات شوفينيّة حيال مَن انفصلوا عن «ذات» كانت واحدة وجامعة في الماضي.
بدوره اتّسم التعبير الآخر عن تلك الجرعة العاطفيّة بالمكابرة: فقد عوملت «الذات» العربيّة المفترضة، التي صمدت بعد «الانفصال» التركيّ، بالإنكار الكامل لانشقاقاتها، والإصرار الكامل على وحدتها وقدرة الإرادة على ضمان ديمومة ذلك. وهذا مع العلم بأنّ الواقع المعيش والتجريبي كان يعلن العكس تماماً، على ما دلّت مثلاً صراعات الضبّاط السوريين والعراقيين في دمشق بُعيد قيام الدولة الفيصليّة قصيرة العمر فيها.
وفي العراق تحديداً، والذي تشكّلت من أبنائه الكتلة الكبرى من الضبّاط العثمانيين السابقين، كان الاصطدام بحاجز التفتّت الأهلي برهاناً نافراً على مصاعب تكرار المشروع الأتاتوركيّ، ولو في حدوده العراقيّة فحسب. فبالتلازم مع نشأة العراق الحديث، نشبت انتفاضتان كرديّتان قادهما محمود البرزنجي (الحفيد) (1919 - 24)، ثمّ في 1931 قاد أحمد البارزاني انتفاضة أخرى. وفي 1933 كانت مذبحة سميل التي نزلت بأشوريّي العراق، ثمّ في 1941 حلّ باليهود العراقيين البوغروم الذي عُرف بـ«الفرهود». وفي هذه الغضون بدت العلاقة السنّيّة – الشيعيّة دائمة التردّي، وهو ما بلغ ذروته في 1927، مع القمع العنيف الذي تعرّض له ممارسو شعائر عاشوراء الشيعية. وإلى ذلك، لم يكن الجوار العراقي – الفارسيّ، فالإيرانيّ، بمحموله التاريخي المتعادي وحمولته القوميّة – المذهبيّة المتنافرة، سوى سبب آخر للشعور بعدم استقرار كامن، إنّما عميق ومثقل بالمنازعات والمخاوف القديمة.
وفي أغلب الظنّ، كان فائض التفتّت في النسيج المجتمعي للعراق هو ما ينعكس، في الفكر والسلوك السياسيين العراقيين، فائضاً في توكيد الوحدة العربيّة والعزم على إنجازها، بوصفها مهمّة قوميّة و«حضاريّة»، مع ما ينجرّ عن ذلك من عنف محض.
وكان تغييب هذا الواقع يبلغ ذروته مع وقوع السلطة في قبضة عسكريين انقلابيين كبكر صدقي، أو مع تولّي قوميين عرب متشدّدين كياسين الهاشمي أو رشيد عالي الكيلاني رئاسة الحكومة، حيث تتنامى ميول الصَّهر، الوطني في حالة صدقي، والقومي في حالتي الهاشمي والكيلاني، مصحوبة بإرادة تذليل «التخلّف العشائريّ»، أكان كرديّاً في الشمال أم شيعيّاً في الجنوب. وغنيٌّ عن القول إنّ التذليل المقصود هو الصيغة التي تتعايش مع إخضاع الجماعات المختلفة والمتعدّدة لسلطة سنّيّة، وغالباً، لا سيّما منذ اغتيال صدقي، عربيّة أيضاً.
ولئن اكتسب الضبّاط العراقيّون، العثمانيّون سابقاً، من تجربة «تركيّا الفتاة»، ما يمكن تسميتها ثقافة المؤامرة وتمجيد العنف وعدم أخذ القانون بعين الاعتبار، فهذا ما تعزّز، منذ الثلاثينات صعوداً، بانتشار الآيديولوجيّات الراديكاليّة الأوروبيّة، التي ما لبثت أن وجدت استحساناً كبيراً وواسعاً في العراق، ما يصحّ كثيراً وخصوصاً في النازيّة. فإلى جانب الماضي العاطفي المتوارَث عن التجربة العثمانيّة - الألمانيّة، كان للشعور بالخديعة البريطانيّة للعرب بعد الحرب العالميّة الأولى، ثمّ الهجرات اليهوديّة المتعاقبة إلى فلسطين، أن ضاعفت الافتتان بألمانيا، خصم الانتدابين الفرنسي والبريطاني في سوريّا والعراق، ومن ثمّ الافتتان بنظامها النازي الذي تراءى أنّه يقدّم للعرب ما يشبه البديل المحبب والمرغوب. وقد تجسّد هذا في الصلات التي عقدها مع برلين قادة قوميّون كمفتي فلسطين أمين الحسيني، المقيم في العراق بين أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات، ورشيد عالي الكيلاني، وفي التماهي الواسع مع الأحزاب والحركات الشبابيّة الفاشيّة. ودائماً كان العداء الذي كنّته ألمانيا النازيّة لليهود، يكمّل، في نظر القوميين العرب، العداء الذي ربطها بالدول الاستعماريّة والديمقراطيّة، ما يجلو مواقف ألمانيا في هيئة ناصعة. ولا بدّ، هنا، من إضافة بُعد أقلّ منظوريّة، هو أنّ رفض النُّخب القوميّة في المشرق لـ«دول التجزئة» التي أنشأها الانتدابان البريطاني والفرنسي، إنّما انطوى ضمناً على رفض لنظريّة تسبيق الدولة على الأمّة، المعروفة بـ«النظريّة الفرنسيّة»، والتجاوب تالياً مع «النظريّة الألمانيّة» في تسبيق الأمّة على الدولة، وهو ما سيكون له في التجربة العربيّة نتائج كارثيّة سوف نتطرّق لاحقاً إليها. وفي موازاة ذلك كلّه، عزّز التأثّرُ بالنازيّة ذاك التصوّر العنيف والإلغائي للسياسة بوصفها، قبل كلّ شيء آخر، اجتثاثاً للخصم وللمختلف.
ففي 1936 نفّذ صدقي الانقلاب العسكري الأوّل في العالم العربيّ، لكنّه اغتيل بعد عام في عمليّة كان وراءها ضبّاط يأخذون عليه، وهو الكرديّ، نقص عروبته. وهذا ما أضعف، عبر الانقلاب ثمّ الاغتيال، وحدة الدولة وولاء القوّات المسلّحة للحكومة، لا سيّما وقد شرع العسكريّون ذوو الهوى العروبي يشكّلون الحكومات ويفرضون توجّهاتها السياسيّة المُلزمة.
لكنّ تلك الفترة نفسها كانت قد شهدت العهد المَلَكي لغازي الأوّل، الذي حكم العراق بين 1933 و1939، والذي رأى فؤاد عارف، الضابط المتقاعد المقرّب منه، أنّه، منذ مطلع شبابه، «كانت عيناه تغرورقان بالدموع وهو يتذكّر ما فعله الإنجليز بجدّه الحسين».
وقد أُطلق على العراق في عهد غازي لقب «بيمونت العرب» ليكون ما كانته تلك المقاطعة الإيطاليّة في الوحدة الإيطاليّة، كما يكون هو ما كانه كافور وفيكتور إيمانويل (عمانوئيل) الثاني. وفي عهده ظهر التعبير العراقي الأوّل عن الطموح إلى ضمّ الكويت، واستشراء عبادة القوّة، تعبيراً عن تعاظم الطابع القومي العربي للدولة، وهو ما تأدّى عنه توسيع حجم الجيش، فصار يضمّ 800 ضابط و19500 جندي في 1936، ثمّ 1426 ضابطاً و26345 جنديّاً في 1939. ولئن لم يضمّ الجيش هذا سوى قلّة من الطيّارين في 1933، فقد ارتفع عددهم إلى 37 في 1936 وكان المتوقّع ارتفاعه إلى 127 عند نهاية السنة التالية. وفي خطوة تنمّ عن إدراك مبكر لأدوات التواصل والتأثير الإعلاميّة الحديثة، ثبّتَ غازي في قصره محطّة الإذاعة العراقيّة التي تبثّ آراءه القوميّة الأكثر تشدّداً.
لقد اعتقد الملك الشابّ، حسب صحافي عرفه عن كثب، أنّ «إعداد البلاد عسكريّاً لا يتمّ عن طريق الاهتمام بالجيش وحده، وإنّما أيضاً بغرس الروح العسكريّة بين الشباب ورصّ صفوفهم باتّجاه ذلك الهدف. وقد اتّخذ من اهتمامه بهوايات الشباب وأنشطتهم الرياضيّة غطاءً لبلوغ تلك الغاية. فقد حثّ الشباب على الانصراف إلى الدرس والرياضة لتقوية أجسامهم، وتعويدهم على الطاعة والتضامن والشمم والجرأة»، بحيث أصبحت الكشّافة في عهده «حركة إعداد قومي وعسكريّ»، و«فرصة سانحة لإدخال الروح القوميّة بين الشبيبة، وتعويدهم على الحياة الخشنة التي ألفها الأجداد، وغرس حياة الجنديّة الحقيقيّة في نفوسهم». وقد لاحت ملامح هذا التوجّه عندما أخذت الكشّافة تهزج، بحضور الملك لاستعراضاتها، أهازيج مثل «بالوحدة يموت الصهيونيّ» و«اسم الوحدة عنوان الله».
وفي خطوة أخرى على الطريق المديد إلى تطوير أدوات عنفيّة موازية للدولة، وهو ما عرفناه لاحقاً وعلى نطاق أعرض تحت مسمّى «الميليشيات»، رأى غازي «أنّ الكشّافة بمثابة احتياط للجيش، على أساس أنّ الألمان والروس والإيطاليين قد استخدموهم فعلاً لهذا الغرض. وعلى هذا الأساس كلّف مدير التربية البدنيّة في 1934 بأن يضع له تقريراً مختصراً عن إمكانيّة إعداد 25 ألف كشّاف مدرّب تدريباً جيّداً». وكان غازي من شرّع في 1935 «نظام الفتوّة» لعسكرة شبّان العراق للنضال في سبيل الوحدة العربيّة، علماً بأنّ «المشرفين على الفتوّة كانوا متأثّرين بحركة الشباب الهتلري ومخيّمات العمل الألمانيّة».
لكنّ غازي، الذي يُقرّ المقرّبون منه أنفسهم بانفعاليّته وضعف رجاحته العقليّة، لم يكن أقلّ قوميّة من منافسه ورئيس حكومته ياسين الهاشمي، الضابط العثماني السابق والقومي العربي الذي لُقّب، هو الآخر، بـ«بسمارك العرب»، إيحاءً بدور الأخير في توحيد ألمانيا وبإمكان تكراره عربيّاً على يديه. فالهاشمي، الذي أراد تحويل غازي إلى مجرّد رمز ذي منصب احتفاليّ، تقليداً لما فعله موسوليني بالملك إيمانويل الثالث، حلّ المجلس النيابي في أبريل (نيسان) 1935 وألغى الأحزاب السياسيّة «بغرض إدماجها في هيئة واحدة»، كما صفّى «الصحف المعارضة ولاحق أنشطة جماعة (الأهالي) وذوي الاتّجاهات اليساريّة»، وراح ينافس غازي على العسكرة والاهتمام بالجيش وتعزيزه، مع التركيز على القوّات الجويّة تيمّناً بروسيا.
الحلقة (2): الطريق إلى الزعامة الراديكاليّة... «صناعة الموت» ودورها التأسيسي