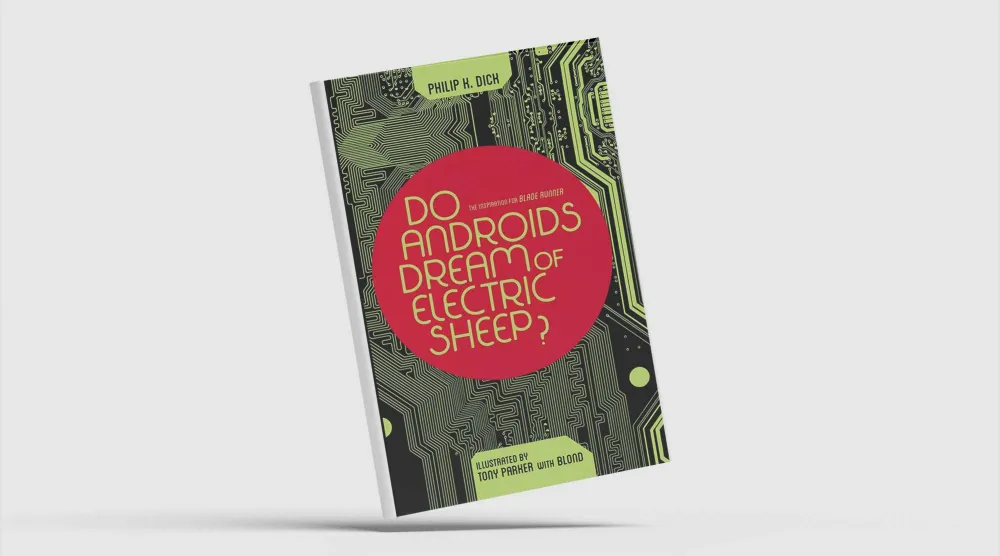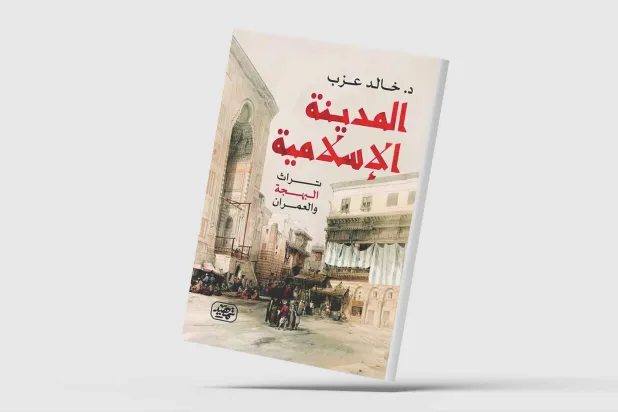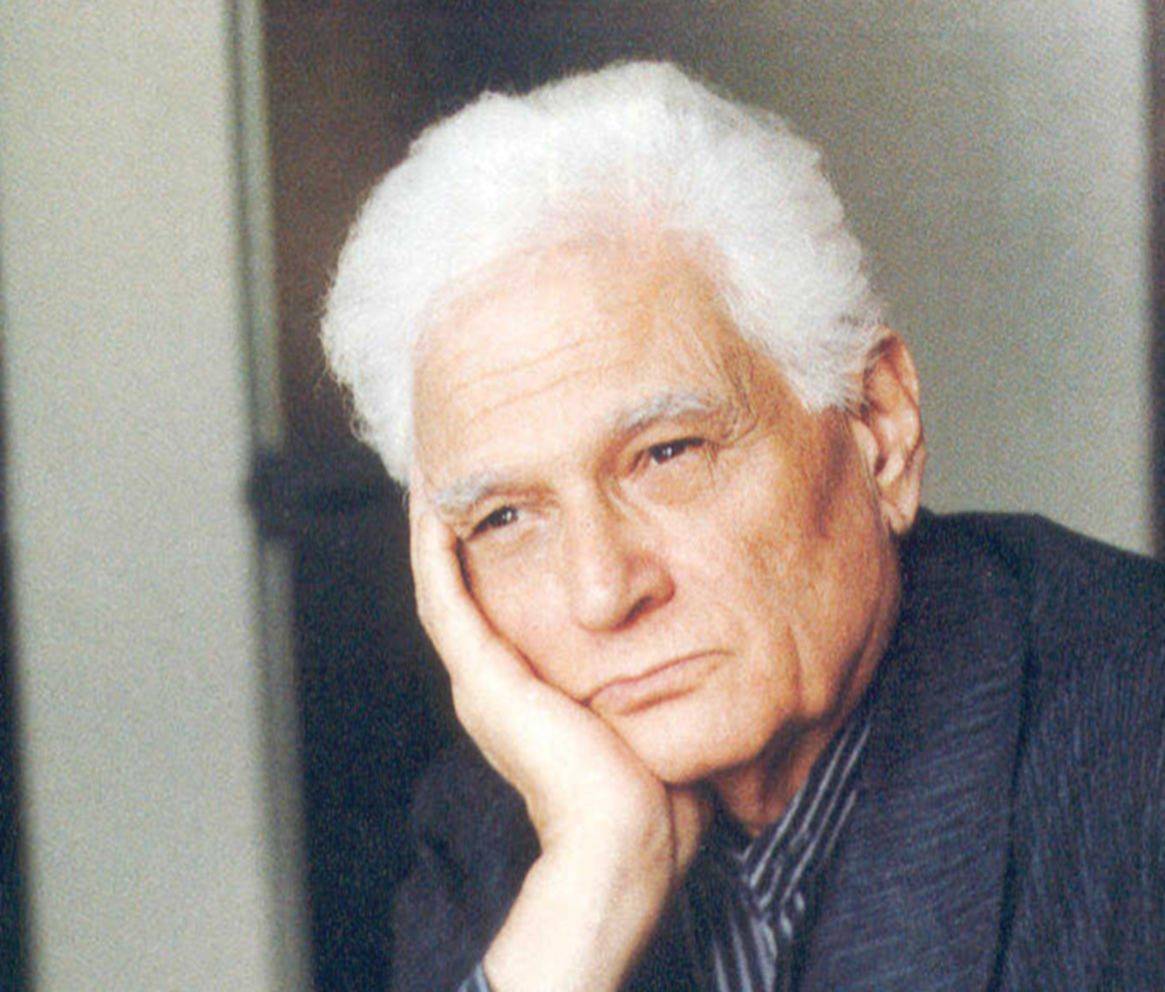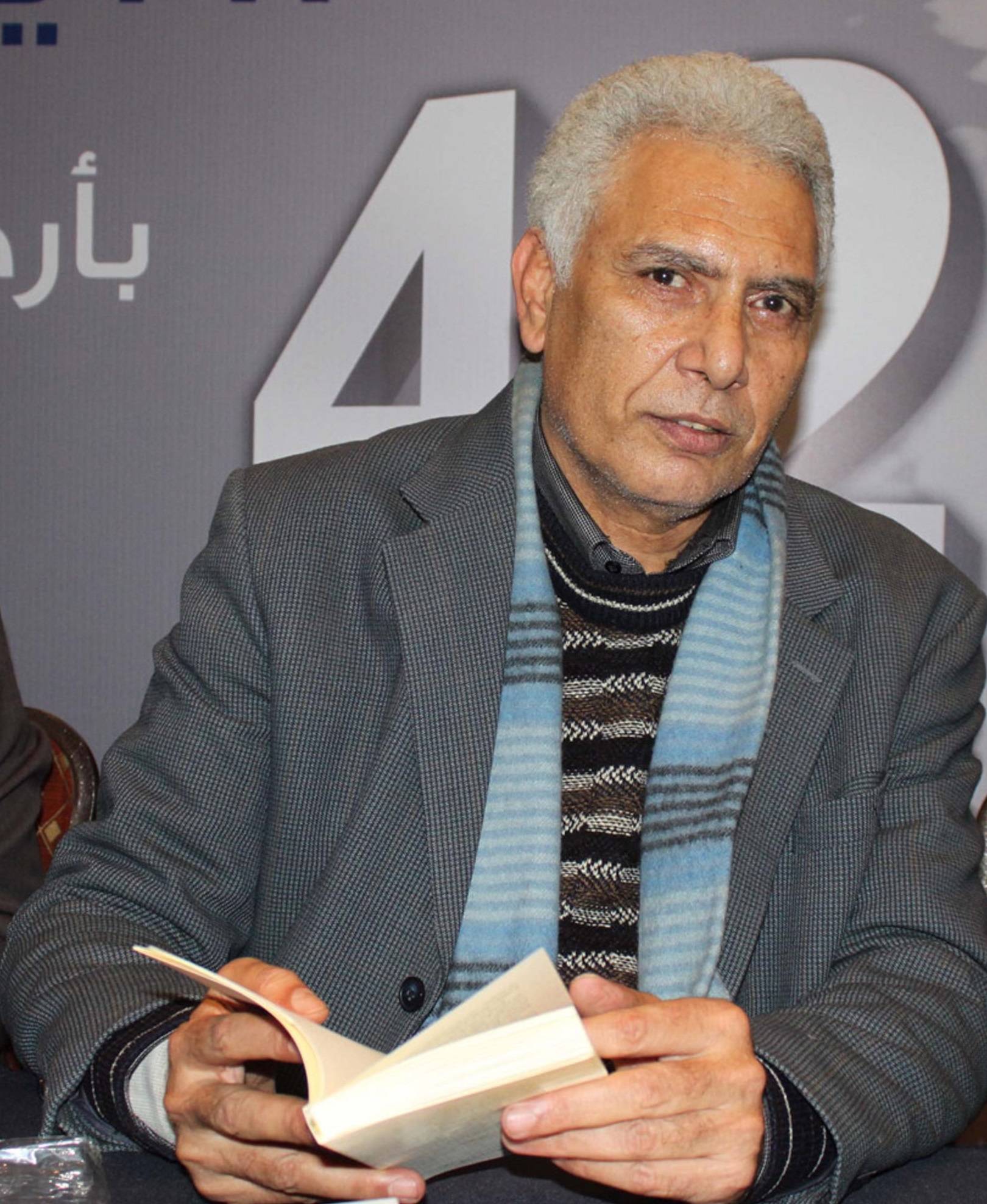ليس يسيراً على القاصّ أن يُطوِّع موضوعه فنياً، ليكون نصاً سردياً يتمازج فيه محتواه بشكله، بطريقة لا يتغلب فيها أحدهما على الآخر، فهذا ما يقتضي اتقاناً وتمرساً كافيين. أمّا الموهبة فلها دور التعزيز والتعضيد اندفاعاً نحو الأصالة والتفرد.
وما من كاتب تبلغ عنده القصة بناءً ومحتوياتٍ مستوى التجريب، ما لم يتمظهر البناء السردي بين يديه كنمط من أنماط الاشتغال الثقافي وشكل من أشكال التحول في المعاني الثقافية والتفسير للعلاقات الاجتماعية المنغمسة فيها، فاسحاً المجال للبنى الثابتة في النصوص السردية جملاً وأشكالاً لغوية لأن تتبدل إلى ما يشبه البنى المتغيرة في سياقاتها الثقافية، سواء أكان هذا التبدل عميقاً أو متشظياً، مشتتاً أو متقوقعاً، مشوشاً أو منتظماً.
ولعل القصة القصيرة هي أكثر السرديات ما بعد الحداثية قدرة على استيعاب هذا التحول وتمثيله، معطية للمحتوى صوتاً ومحققة للحبك أبعاداً جمالية خاصة قد لا تتحقق في النصوص السردية الأخرى، وهذا ما يجعل القصة القصيرة بحقّ فنَّ العصر الراهن لا من ناحية أنّ الزمن الإنساني، كما يقول باشلار، ليس إلا لحظة، تمدنا بنسخ إنسانية فردية وحقيقية وبأشكال محلية تتموضع في أطر ثقافية شمولية فحسب، بل من زاوية أنّ السرد فيها يأخذ صوراً شتى، والمقصد من وراء ذلك تصوير الإنسان متكلماً وهو واقع تحت تأثير الصدفة وضغط الضرورة.
بهذا يتمكن الوعي الفردي من أن يعكس الوجود الاجتماعي، مجسداً الشعور والتجربة أسلوباً ودلالة، وبسمات خاصة تفصح عن نفسها من خلال السرد، فلا تغدو القصة القصيرة مجرد خيال وتلفيق، بل هي تعبير وموقف فيها صراع وتضادّ ونفي ونسخ وتهشيم وتحييد وسطوة وانفلات، يمكنها أن تحرك العالم كما يمكنها أن توقفه.
وبهذا التحكم تتأكد قدرة القصة القصيرة على المراوغة الكتابية التي بسببها تختلف عن غيرها من السرديات الأخرى وهي تجمع بين العبث والسكون والحرمان والتملك، جاعلة الذات تتفرد وتتعدد صوتاً وكياناً. وواحدة من مراوغات الكتابة في القصة القصيرة قدرتها على المزامنة بين الضمائر («الأنا» و«ألأنت» و«الهو») والتلاعب في استبدالها تمثيلاً للشكل وتعميقاً للموضوع معاً، فيغدو الفاعل السردي ممتداً بامتداد اللحظة ومقتطعا باقتطاعها، وقد تقولبت صورته محتواةً في صوته، متمشكلة في ضمير بعينه. وما بين الاحتواء والتمشكل تتمظهر الذات كياناً فريداً يستوعب هامشية وجوده الواقعي بمركزية تقولبه السردي، معوضاً دونيته في الواقع بفاعليته في السرد، صانعاً له عالماً خاصّاً، فيه الهامشي مالك زمام المركزي، والتابع مهيمن على المتبوع، متغلّب عليه بصدمة ما تصنعه المفارقات الفنية داخل كل قصة قصيرة، ولا سيما تلك التي بها تختتم سردية اللحظة الحياتية المقتطعة من الواقع المعيش.
وهذا ما نلمسه بجلاء في المجموعة القصصية «رمادي داكن» للقاص الكويتي طالب الرفاعي، الصادرة عن «ذات السلاسل للنشر والتوزيع» بالكويت، 2019، وفيها تراوغ الضمائر بعضها بعضاً تزامنا وتبادلاً، عاملة فنياً على استيعاب تفاصيل الحدث القصصي.
وبسيرورة الصوت السردي الذي يحققه تزامن استعمال ضميرين في القصة الواحدة، تحتدم محنة اللحظة الشعورية، لتنفرج كصحوة فيها يصبح للهوامش فاعلية، كأن تكون لعامل النظافة سيادته، وللموظف الصغير حضوره، وللزوجة كرامتها، وللخادمة أحاسيسها، وعندها لا يعود الآخرون جحيماً في حساب العلاقات الاجتماعية.
وفي المراهنة على تبادل الضمائر تجريب فني، يحاول جعل القارئ يتحسس ألم السارد، وهو يقدم له حلماً يودّ أن يشعر به معه، وقد تحوّل هذا الحلم إلى واقع نابض بالحياة، كنوع من الإيهام بالتمكُّن الفردي من استعادة اللحظة، وذلك برؤيتها ملفوظة كتابةً وليس فعلاً.
وما إبدال ضمير بآخر وإحلال واحد جنب الآخر إلا نوع من الرهان السردي الذي يريد للصوت أن يتمشكل في صيغة تهذيبية، كما يقول ميشيل بوتور والغاية أن «نعوض عن نقص في الشكل أو لنبتدع ضميراً لا وجود له في تصريف الأفعال»، ففي أول قصة قصيرة من المجموعة وعنوانها «لحية وشارب»، نجد أن ضمير «الأنا» يريد أن ينقلنا إلى داخل كيان الزوجة المهانة، لكنه سرعان ما يتبدل إلى ضمير الجمع «نا» ليفتح لنا مغالق الغرفة السوداء التي فيها لا تتحمض الصور كأفلام، بل تتكلم كأشباح كاشفة لنا عن دواخل الأنثى التعيسة التي هي قبل الزواج تحت سلطة الأب وبعده تحت رحمة الزوج. والنتيجة التي تتولد من هذا التبدل في الضميرين، مفارقة فنية تتمثل في فطنة الزوجة لنفسها، وقد أدركت أن هناك طفلة في داخلها هي التي ستعيد لها حقها وتحقق حلمها في السعادة.
وفي هذا الاستبدال بين الضميرين اشتغال لفظي يعكس بحثاً حثيثاً عن حقيقة اللحظة المسرودة كتابياً، وبشكل قد يسهِّل أو يصعِّب سرد القصة، كونه قد يمتد بها زمنياً وقد يقلصها.
والامتداد والتقليص هما اللذان يَسِمان القصة القصيرة التي تراهن على استبدال ضمير بآخر بحالة من الانقطاع السردي الذي يحول دون أن يتقدم الزمن خطياً للأمام، كما لن يمنح خيط الأحداث تسلسلاً تتابعياً، بل سيمهره بالقفز الإيقاعي بشكل حسي، معيداً رسم الزمن في أزمنة تتخذ شكل دفعات هي تعبير منطقي عن الحياة العصرية في قساوة انقطاع العلاقات الاجتماعية فيها.
وإذا كان التواصل الحياتي يعتمد على استعمال الضمائر بأنواعها، فإن هذه الضمائر في السرد تتعمق أكثر جاعلةً القصة تنظر إلى الجميع من الداخل والخارج. وهكذا تتفاعل الكتابة مع الكلام منتجة شكلاً صوتياً يتحرَّك في سلاسل متشابكة من الجمل السردية، وهذا التجريب على صعيدي الاحتواء والتمشكل هو بحد ذاته نوع من الإيهام الذي يخيّم على الواقع النصي فيجعله متحركاً بطريقة فيها السرعة هي البطء، والبطء هو السرعة. وكأن الصوت أياً كان متكلماً أو مخاطباً أو غائباً هو النهر أو الذاكرة أو قطعة السكر التي تذوب في كأس ماء، على حد وصف ميشيل بوتور، الذي يرى أن استعمال الضميرين (أنا وأنت) ليس بالأمر اليسير، لأن (أنت) يؤدي بالمخاطب إلى أن يكون الشخص الذي نروي له قصته الخاصة به، بينما ينغلق (أنا) على الفرد المتكلم بشهادته التي تنتزع منه إفادته انتزاعاً.
وهذا التزامن ما بين انغلاق صوت «الأنا» وتحرر صوت «الأنت»، سنجده متحققاً في قصة «قرب المدخل»، وغيرها من القصص التي فيها للحوار المباشر والحوار الحر غير المباشر والمونولوغات الداخلية حضور مهيمن يجعل الفاعل السردي يتوزع بين حاضر وغائب ومتكلم ومنصت وكاتب وقارئ وفرد وجماعة، وكأن وراء صوت «الأنا» تختفي رغبة ملحّة في ارتياد ظلمات وخفايا عن لحظات تتجلى في صور تتداعى داخلياً من خلف النفس أو تستحضر تلقائياً بمعية نفس أخرى، قد تكون قريباً حميماً كزوجة وأخت وبنت وصديق وقد تكون شخصاً غريباً هو غريم وقرين ورئيس عمل وعديل ونِدّ. وبهذا تغدو القصة القصيرة صورة مرآتية لنوع من الحرية الإنسانية، وقد تميز فيها مستوى الوعي عن مستوى اللاوعي، والأشخاص في أوضاعهم اللحظوية المختلفة.
أمّا المراهنة على ضمير المخاطب تأنيثاً وتذكيراً، فلها عند طالب الرفاعي خصوصية تجريبية تجعل قسماً من القصص متموضعة في إطار بنائي، فيه الذات لا تعرف نفسها إلا من خلال الآخر الذي يقف قبالتها وجهاً لوجه، وهو يستبطن خفاياها ساخراً منها وقد يباغتها مفاجئاً لها وقد يوبخها متندراً عليها. والذي يقرأ بقية قصص المجموعة الأخرى سيجد كيف أنّ استعمال الضمير «أنت» يعطي صيغة خطابية تجعل المتلقي داخلاً في القصة.
ونقف عند القصة القصيرة «لوحة للهواء» التي من موضوعها استمدّ القاصُّ العنوان الرئيس لمجموعته «رمادي داكن»، وفيها يتغلب الخوف على الشاب وهو يتأمل اللوحات الفنية في صالة العرض والفنان صاحب اللوحات يرقبه بحذر.
ويسهم استعمال ضمير الخطاب في جعل الشاب مرئياً من قبل السارد الذي يقابله وجهاً لوجه مذكراً إياه بأن خوفه لن يمكّنه من التعبير عن رأيه في الألوان لا سيما اللون الرمادي الذي شغل خلفية اللوحة وجعله لا يرى سواه من الألوان. وهذا الأمر يجعله في النهاية واهماً أن عينيه هما السبب، غير واعٍ بأن السبب هو خوفه من التعبير عن حقيقة أن الرمادي تسيد حياتنا وغيّب جمالها.
وتتفرد القصة القصيرة «رسائل موج» بأن التبادل بين ضميري «الأنا» و«الهو» أحال القَصّ إلى شكل اعتراف مسجّل من إفادة غير واعية تشبه الموج أو شهادة مقتطعة من ذاكرة واعية تشبه الرسالة التي فيها يودع أسرار لقاء فانتازي مع حلمه الذي سيظل مجهولاً يطلب منه أن يتبعه، وليس أمامه إلا أن يسايره، فيتمازج الاعتراف بالشهادة ليشكلا صورة موج جارف بإزاء حلم لا يريد أن يهدأ، وليس سوى الصحوة منقذاً من هذا الانجراف.
وتجدر الإشارة إلى أن لمجازية اللغة التي تؤنسن الأفكار وتجعلها حية محسوسة ومرئية رهاناً تجريبياً آخر تفردت به المجموعة رمادي داكن، من قبيل الجمل «خمشت جملته وجهك/ تشخص أبصار القاعة إليك/ مواء نبرتها بادرته/ خمش خوف فأر وجهها/ فأر صدرك يتقافز/ فأر ضيق يحوس في صدرك/ تراب ضيقك / نبرة صلعاء»، وهذا ما سنرجئ الحديث عنه إلى مقال آخر.
تبادل الضمائر... وتزامنها


تبادل الضمائر... وتزامنها

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة