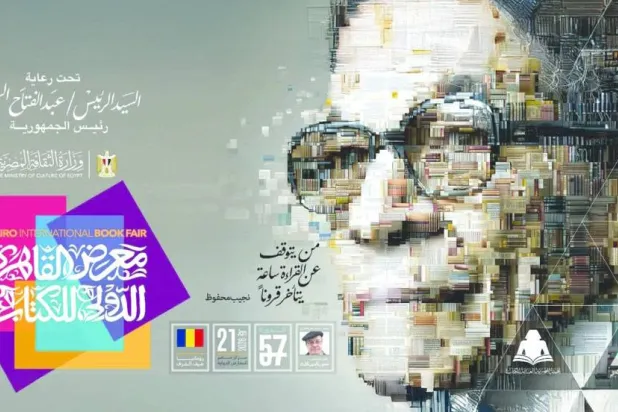في أوائل شهر فبراير (شباط) 2022. أعلنت وزارة الثقافة العراقية أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المعروفة باليونيسكو، أدرجت «درب زبيدة» وهو طريق الحج القديم على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي، وهو طريق مشترك بين العراق والسعودية، وسجلت كل دولة أربعة مواقع أثرية من كل جانب على خط سير الدرب التاريخي الذي يمتد من مدينة الكوفة إلى مدينة مكة المكرمة.
في كتاب «طريق الحج البري القديم بين العراق والسعودية» الصادر في بغداد، يتحدث المهندس الاستشاري المعروف هشام المدفعي عن دور والده حسن فهمي المدفعي، أحد بناة الدولة العراقية الحديثة، الذي تولى مناصب رفيعة في الشرطة وإدارة الدولة العراقية. الذي قام به في اكتشاف طريق الحج البري بين العراق والجزيرة العربية، وهو الطريق المشهور بدرب زبيدة بين الكوفة في العراق والديار المقدسة في الحجاز في السعودية. فقد جرت هذه المهمة في ثلاثينات القرن الماضي في ظروف طبيعية صعبة وقاسية في تلك الفترة.
يقدم هذا الكتاب، تعريفاً لطريق الحج البري القديم بين العراق والسعودية الذي سعت إلى فتحه السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد في العصر العباسي الأول، وما جرى عليه حتى أصبح نسياً منسياً، وبدأت مظاهر الاندراس تظهر على محطاته وآباره وبركه، لكن الحكومتين العراقية والسعودية، نظراً لأهميته التراثية، أخذتا في ثلاثينات القرن العشرين بالسعي إلى إحيائه وتجديد محطاته، وكانت بعثة حسن فهمي المدفعي إحدى مظاهر هذا السعي، إلى أن أخذ الأمر أهميته الكبيرة في السنوات الأخيرة، وشرعت الجهود الحثيثة والأعمال الهندسية تتوالى لإظهاره كأحد رموز التعاون العربي والإسلامي، وأحد المعالم التاريخية الجديرة بالتذكير والتقدير.
أدار حسن فهمي المدفعي فريقاً من هواة البحث والمتبرعين من مختلف الاختصاصات للقيام بهذه المهمة الصعبة في ثلاثينات القرن المنصرم. وقد أسفرت المهمة عن نجاحها في إعادة كشف طريق الحج البري ومعرفة مواقعه ومحطاته وآباره وبقايا آثاره، والعلامات الدالة عليه. ولا شك أن المهمة كانت صعبة للغاية في تلك الفترة في مناطق واسعة وطويلة وأراضٍ قاحلة في عمق الصحراء. والمعروف أن هذا الطريق قد تركته قوافل الحجاج واتخذت مسارات أخرى، رغم أنه كان أقصر الطرق بين الكوفة والديار المقدسة. وكان ذلك لأسباب عديدة انتهت بإهماله واندثار الكثير من مواقعه، أهمها إهمال الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد سقوط الدولة العباسية بيد المغول عام 1258م في رعايته وتجديده، مما جعل من مهمة اكتشافه تكتنفها مصاعب لا تخفى.
كان طريق الحج البري بين الكوفة في العراق والديار المقدسة في الحجاز معروفاً منذ أوائل نشوء الدولة العربية الإسلامية، ثم عرف بدرب زبيدة، نسبة إلى السيدة زبيدة بنت أبي جعفر المنصور وزوجة الخليفة هارون الرشيد، وهي التي جهدت في رعاية الطريق وتوفير كل المستلزمات المطلوبة له حتى أصبح أشهر الطرق، وقد ذاعت شهرته كثيراً وتوزعت أخباره في مختلف المصادر والمراجع. ولا شك أن دقة مساره واتجاهاته ومحطاته، إضافة إلى العناية الفائقة بأمره في سنوات الخلافة العربية الإسلامية، كانت من أسباب ذيوع أخباره في التاريخ الإسلامي، وكان أوج ازدهاره في العهد العباسي الأول.
غير أن عوامل مختلفة جعلت الطريق يتجه إلى الاندثار وضياع الكثير من معالمه، ومن هذه الأسباب ضعف الدول التي حكمت العالم الإسلامي بعد سقوط بغداد، مما أدى إلى اختلال وضعه الأمني وتعرض العديد من مواقعه للتخريب والتدمير، واستمر الأمر إلى سنوات قريبة خلت. فدرب زبيدة يحكي ازدهار الحضارة العربية الإسلامية وانكساراتها، فكلما استقرت الدول سالت المياه في محطات درب زبيدة وانتقل إليه الحجاج والتجار بلا مصاعب.
ويعد طريق الحج بين الكوفة ومكة المكرمة هو أهم طرق الحج البري السبعة التي تربط الحجاز بأنحاء العالم الإسلامي، وهي: طريق الحج الكوفي وطريق الحج البصري وطريق الحج الشامي وطريق الحج المصري وطريق الحج اليمني وطريق الحج اليمني الداخلي وطريق الحج العماني، وتتصل هذه الطرق مع بعضها بعضاً بطرق فرعية. ولا شك أن هذه الطرق لقيت على مر الزمن عناية كبيرة من قبل الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والأعيان والتجار، فأقيمت عليها منشآت مختلفة، من محطات ومنازل وبرك وآبار وعيون وسدود ومساجد وأسواق، إضافة إلى وسائل إرشادية من منارات وأميال.
في السنوات العشر الأخيرة تجدد الحديث عن هذا الطريق الذي يبلغ طوله نحو 1400 كم، ويعد من أشهر الطرق الأثرية في العالم، ولم تزل بقاياه وآثاره الشاخصة تحكي للإنسانية جهداً هندسياً وإنسانياً فائقاً، تم إنجازه من قبل نحو ألف ومائتي وخمسين عاماً في صحراء قاحلة قاسية. ولما كانت بقاياه وآثاره ماثلة إلى يومنا، فقد كان أهلاً لأن يرفع إلى قائمة التراث العالمي في منظمة اليونيسكو، رغم أن العمل تعطل عليه قبل قرون عديدة، وشحت أخباره التاريخية إلا بإشارات سريعة.
ويذكر الكتاب أن نجاح المدفعي وفريقه كان مدعاة سرور الجانب السعودي الذي أثنى على جهود الفريق العراقي، كما استقبل العاهل السعودي الملك عبد العزيز الفريق العراقي برئاسة حسن فهمي المدفعي، وشكرهم على جهودهم الكبيرة.