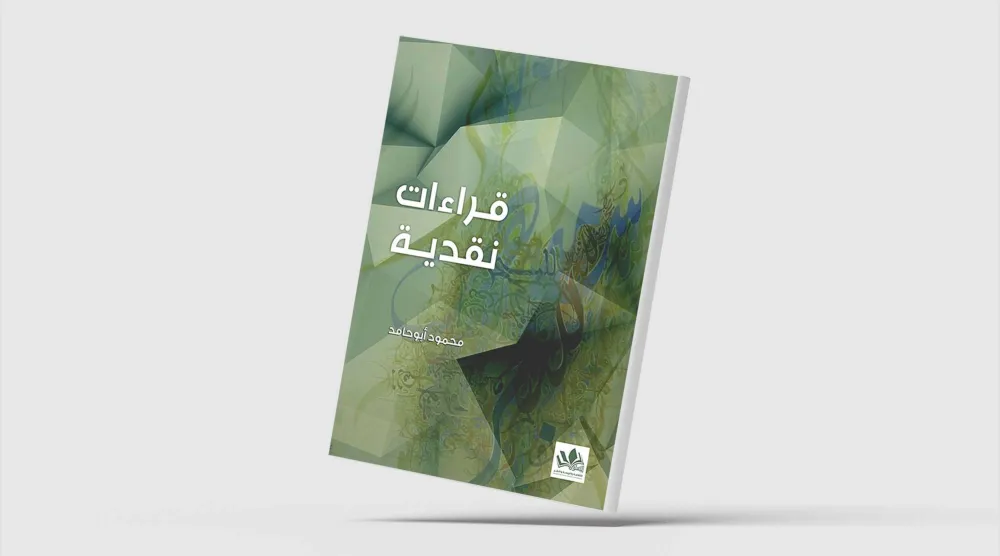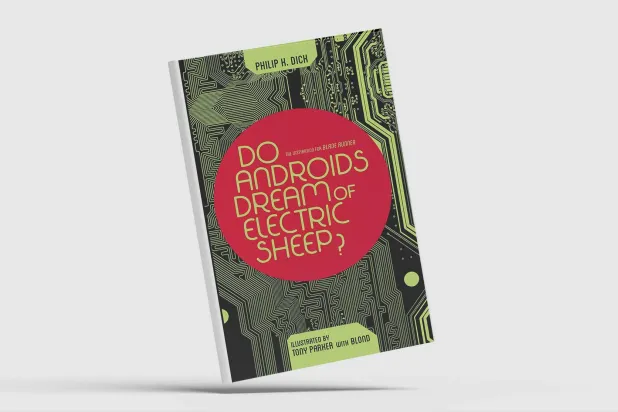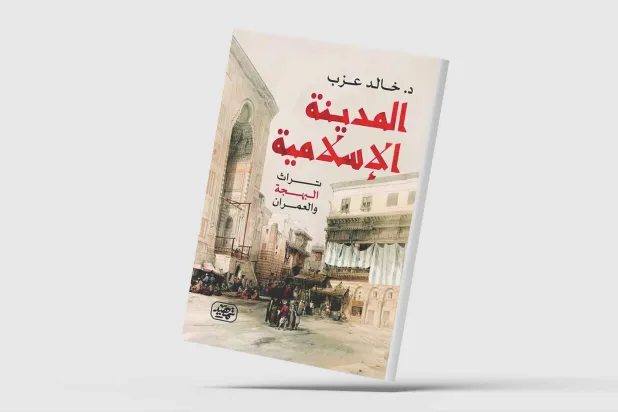جاءت مبادرة الكاتبة والأكاديمية المغربية زهور كرام في استذكار عالِم المستقبليات؛ المهدي المنجرة، لتسلط الضوء على مفكر مغربي حظي طوال سنوات حياته المهنية بتقدير واعتراف كبيرين على المستوى العالمي، فهو إضافة إلى احتلاله موقع نائب المدير العام لمنظمة اليونيسكو، والتدريس في كثير من المؤسسات الأكاديمية العريقة مثل «مدرسة لندن للاقتصاد والأعمال» SLE، التي سبق له أن حصل على شهادة الدكتوراه منها خلال عقد الخمسينات من القرن الماضي، مُنح جوائز وأوسمة عالية من كثير من الدول والمؤسسات، مثل «وسام الشمس المشرقة» باليابان عام 1986، و«جائزة السلام» عن معهد ألبرت آينشتاين الدولي عام 1990، و«وسام ضابط» للفنون والآداب بفرنسا عام 1976... وغيرها.
صدر هذا الكتاب حديثا عن «دار دلمون الجديدة» في دمشق، وقد قسمت الدكتورة كرام بحثها إلى 4 أقسام؛ ضمنها الملاحق التي تسلط الضوء فيها على مسيرة الراحل المنجرة العلمية، وعلى بعض مواقفه من القضايا ذات الشأن الخطير على الوضع العربي.
ويعد المهدي المنجرة واحداً من مؤسسي علم المستقبليات والمنظرين له، فقد ساهم فيه بصياغة منهجية علمية تتضمن مجموعة من المفاهيم والتعريفات والمسلّمات وتتبنى حقولا معرفية كثيرة لمنح المتخصص في هذا الحقل القدرة لا على توقع ما يخبئه المستقبل؛ بل المساهمة في رسم الخطوط العريضة لصياغته.
وبالطبع، هذا لا يعني أن توقعات عالم المستقبليات ستتحقق بالكامل، فهو ليس عرافا أو رائيا، بل هو ينطلق من الحاضر بتفكيكه ليستكشف ما سيؤول إليه المجتمع خلال فترة زمنية محدودة. فالمنجرة توقع في أواخر الثمانينات من القرن الماضي حدوث ما عرف لاحقا بـ«الربيع العربي» ومنذ بداية التسعينات توقع ازدهارا هائلا لصناعة الأسلحة في العالم، خصوصا في الولايات المتحدة بعد زيادة التوظيف المالي الكبير لها، كذلك فهو قد توقع انهيار «قيمة القيم» على الصعيد العالمي منذ ذلك الوقت ووقوع حروب كثيرة في القرن الحادي والعشرين داخل بلدان العالم الثالث.
تعرّف الدكتورة كرام طريقة بحث المنجرة بأنها تعتمد «على تحليل الواقع بمنهجية واضحة تعتمد الجرأة في التناول والعلمية في التفكيك والإحصائيات في القياس والتجارب في المقارنة مع الانطلاق من أهداف محددة نحو استشراف مستقبل حاضر هذا الواقع».
ووفق هذه المنهجية، يرى المفكر المنجرة أنه «لا يمكن الانطلاق برؤية واضحة تجاه المستقبل، كما لا يمكن التحكم في المستقبل باعتباره موضوعا للتفكير إذا لم يكن الماضي حاضراً في التفكير في إطار رؤية تحليلية واضحة وموضوعية ممنهجة».
غير أن الماضي الذي نعرفه عبر معطيات محددة يتطلب تأويلا متواصلا، وهذا ما يجعل المهدي المنجرة يتبنى مفهوما موجودا في الدراسات المستقبلية، وهو ما يسمى «مستقبل الماضي». من هنا يفسر فشل مشروعات اقتصادية كثيرة في الدول العربية، مثل موضوعي القطاعين العام والخاص، ونقل الأفكار حولها من دون اعتماد دراسة البيئة التي تتطور فيها الأفكار.
كم تذكرني هذه الفكرة بما جرى في العراق عام 1964 حين قامت الحكومة آنذاك بتأميم المشروعات الخاصة التي تعد على أصابع اليد آنذاك لتئد بذلك أي نمو للقطاع الخاص، وهذا بالطبع تقليدا لما جرى في بلدان أخرى، ولأغراض محض شعبوية.
يعطي المنجرة مثالا آخر على الكيفية التي يقام بها كثير من المشروعات في العالم العربي على أساس مبدأ الارتجال، فيقول في إحدى دراساته إن «إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا وأميركا يتم وفق دراسات البيئة المحتضنة لأفكار المشروع وتحليل حاجات السوق وتبني رؤية الاستشارة المعتمدة على معطيات واقعية...». لذلك فهو يرفض تلك القناعة السائدة لدى كثير من أبناء العالم الثالث بأن الحداثة تعني تقليد الغرب، فهو يعدّ النموذج الياباني الذي حافظ على ثقافته وفي الوقت نفسه حقق تطورا علميا وصناعيا هائلا، خير مثال يمكن للبلدان النامية أن تحتذيه. وهو ضمن هذا السياق يرى أنه لم تتحقق أي نقلة نوعية في حياة أي مجتمع تخلى عن لغته وتبنى لغة أجنبية أخرى محلها في مجال العلوم والتكنولوجيا.
تسلط الدكتورة كرام في كتابها «الفكر التنويري في الرؤية المستقبلية عند المهدي المنجرة» الضوء على موضوع «الثقافة» الذي كرس له المفكر المغربي الراحل مساحة واسعة في رؤيته الشمولية، فهي بالنسبة إليه ليست مجرد أفكار وشعارات، لذلك فهو «ينتقد العلاقات الحضارية بين المجتمعات عندما لا تعتمد على التواصل الثقافي المبني على احترام الخصوصيات، فالثقافة لا تُستنسَخ ولا يمكن نقلها بشكل أعمى، وبالتالي، فإن ما يحقق فاعليتها الحضارية هو احترام خصوصيات كل ثقافة على حدة».
يقول المنجرة ضمن هذا السياق: «في نظري أن تشكل الثقافات أساس وعماد السلام والبذرة الوراثية للسلام، فليس ثمة من ثقافة تولد أصلا عدوانية أو لتصارع ثقافة أخرى. وقد علّمنا التاريخ بأن ثقافة ما حين تأخذ مقاليد السلطة تسعى إلى فرض نظام قيمها على ما عداها».
مع ذلك، فهو يراهن على التفاعل السلمي بين الثقافات، فهو يرى أن «الثقافات لا تُستنسخ ولا يمكنها أن تتواصل في ما بينها ولا تغني بعضها البعض إلا إذا اعتبرنا هذه القاعدة أساسية».
لذلك هو يقترح مفهوماً آخر لهذا التلاقح الثقافي أطلق عليه مفهوم «نسبية الكونية». وبالنسبة له، فإن «الكونية هي تلك التي تكون نتاج تداخل وتفاعل للاختلافات، تلك التي ترتكز (لوغاريتماتها) على العدالة والإنصاف المطبّق بدون تمييز عرقي أو عقائدي أو جنسي أو اجتماعي. أؤمن بكونية الجمال والحب كما نحس به فرديا، وأؤمن بكونية الإبداع والخلق حين نطلق لها العنان... الكونية هي نتيجة لتفاعل بين الثقافات بانحيازها للاختلافات لأن الاختلاف هو الذي يطور القيم الثقافية».
يكرس المهدي المنجرة جهده المعرفي كذلك للتحولات التي طرأت على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، فهو قد تنبأ بظهور ما سماها «الإمبريالية الجديدة»، وتوقع أنها ستخوض ما سماها «الحروب الحضارية» في كثير من البلدان. وإذا كانت الإمبريالية في القرن التاسع عشر استخدمت القوة والعنف لفرض سيطرتها على بلدان آسيا وأفريقيا، فإن الامبريالية الجديدة ستستخدم «اللغم الدلالاتي (السيميائي)» لكسب قطاع مهم من مثقفي ومفكري هذه البلدان المستهدفة. وما يعنيه المنجرة هو صياغة المفاهيم بالشكل الذي يسهل قبولها لدى الطرف المستهدَف.
ولعل من أهم المفاهيم التي تحقق هذا المنظور الاستعماري الجديد مفهوم العولمة الذي «تصدى له المنجرة بتفكيك وتحليل حمولاته الدلالية، غير مهتم بالخطابات الإغرائية التي تجعل من العولمة مفهوماً مغرياً».
مع ذلك، فإنه توقع خمود العولمة بعد عقود قليلة، وهذا ما نراه اليوم في أوروبا والولايات المتحدة بتصاعد الروح القومية وتصاعد قوى سياسية تعاكس تيار «العولمة».
هذا الكتاب ملهم ومحفز للمؤسسات الأكاديمية وصناع القرار في العالم العربي لتأسيس معاهد معنية لا بالتنبؤ بالمستقبل فحسب؛ بل المساهمة في صياغته، بدلا من أن نبقى معتمدين في التنبؤ به على المنجمين الذين أصبحوا اليوم من أبرز نجوم الشاشة الصغيرة وأكثرهم جذبا لملايين المشاهدين في العالم العربي.
8:25 دقيقه
المستقبل لا يزال صناعة غير عربية
https://aawsat.com/home/article/1469901/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9



المستقبل لا يزال صناعة غير عربية
رؤية المهدي المنجرة للحداثة والثقافة والحروب «الكونية» المقبلة


المستقبل لا يزال صناعة غير عربية

مواضيع
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة