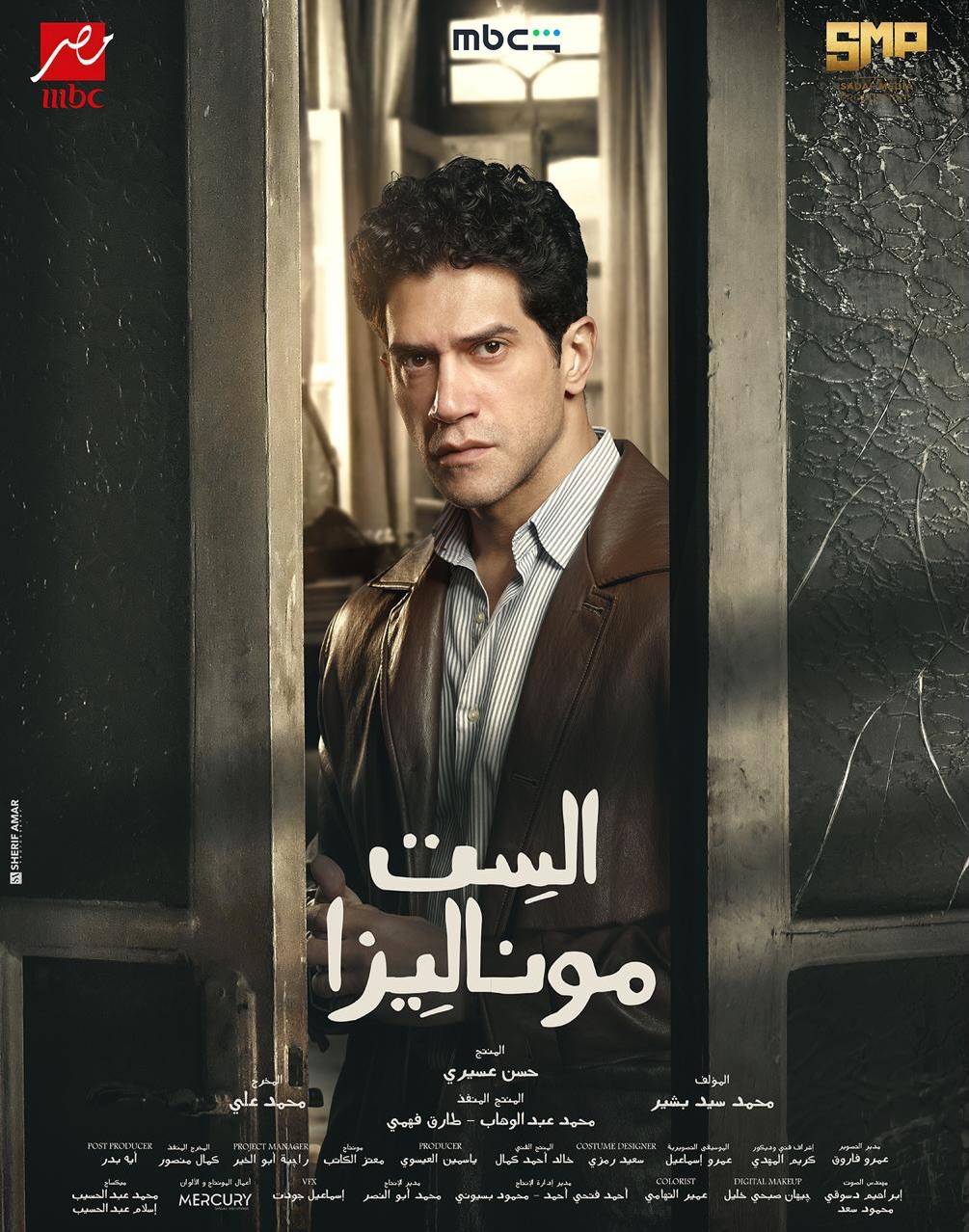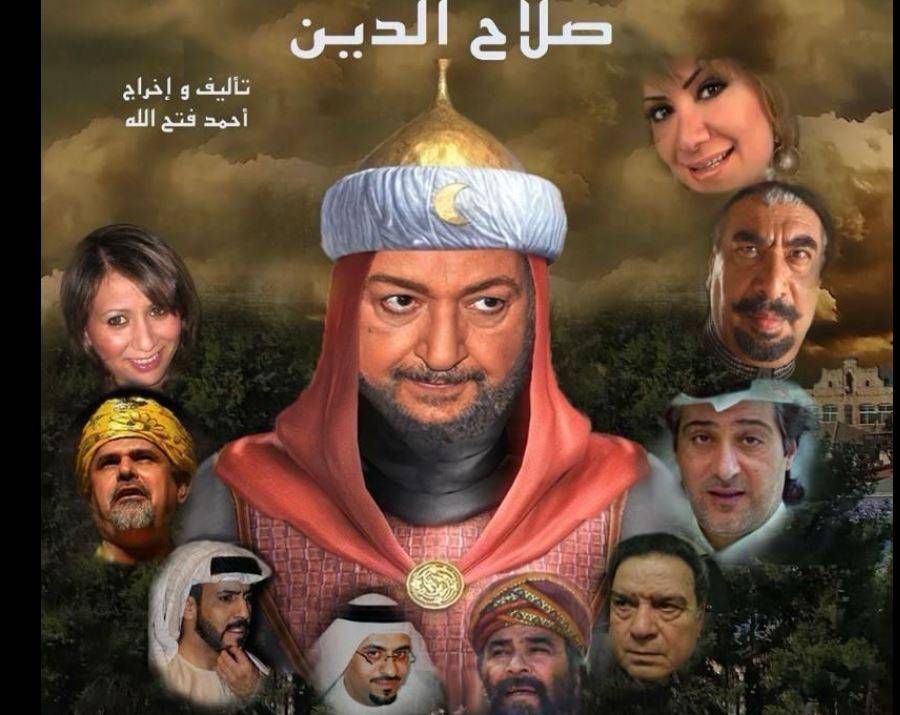طرح مثير للجدل تقترحه الدكتورة المصرية سهير السكري كحل لإنقاذ اللغة العربية من التدهور، يناقض الطروحات الحديثة، ويعيدنا إلى زمن «الكتّاب» مع تعديلات طفيفة، مما يفتح سجالاً واسعاً، حول إذا ما كان وضع اللغة المتردي والذي يزداد سوءاً في المدارس، يمكنه أن يرجعنا إلى أكثر الأساليب كلاسيكية. وهو ما ترفضه د. السكري معتبرة أنها تعتمد على دراسات علمية، وعلى معارفها كأستاذة لغويات، وكخريجة لجامعة «جورج تاون».
وتتلخص طريقة د. السكري في نقاط محددة وواضحة، وهي تعليم إلزامي يبدأ من سن الثالثة ويتركز حتى السادسة على الحفظ والتغييب والتكرار لآيات مختارة من القرآن الكريم بالتجويد المصري الذي به إيقاع موسيقي، ولجميع الأطفال بصرف النظر عن أديانهم، ولا يسمح وفق هذه الطريقة للمحفّظ، بتقديم أي شرح أو تفسير للأطفال. وهو في رأيها ما يساعد على بناء النطق السليم وإتقان مخارج الألفاظ وتعلم المفردات والتراكيب. كما يتم تحفيظ أبيات من ألفية ابن مالك عبر أغنيات وبنغمات سهلة لمعرفة قواعد اللغة العربية معرفة تامة. وبدءاً من سن الخامسة حتى السادسة يتم تعليم الكتابة. وفي رأيها أن هذا يقضي على الأمية بشكل كامل ويوفر الميزانيات التي باتت تهدر دون طائل.
وترفض الدكتورة السكري الاتهامات الموجهة إلى طريقتها بأنها قديمة، وعفى عليه الزمن وتقول في حديث لنا معها: «دعوا الطفل يتعلم هذا حتى سن السادسة. وكي لا يقال عن طريقتي أنها قديمة يمكن في هذه الفترة أن نعلم الطفل الإنجليزية والفرنسية وأي لغة نريدها وصولاً إلى ست لغات مختلفة وفي وقت واحد، ولا ضير في ذلك. وبعد أن يتم التلميذ السادسة اعملوا ما تشاءون، لأنه يكون قد اكتسب ما هو بحاجة إليه». وتوضح: «أنا لا أريد تغيير المناهج وإنما استباقها في الفترة التي يكون فيها الطفل مهيأ لتعلم اللغة وامتصاصها بتلقائية».
عادت الدكتورة السكري إلى مصر، وهي تسعى للترويج لطريقتها وتقوم بتطبيقها حالياً على 700 مدرسة من مدارس «مؤسسة مصر الخير» وتطمح لأن تتبنى وزارة التربية فكرتها، فما هو حظها من النجاح وأي مغامرة يمكن أن تؤدي إليها هذه التجربة، خاصة وأن آراء الاختصاصيين متباينة جداً، ليس فقط حول فكرة الحفظ غيباً التي تتناقض مع النظريات التربوية المطبقة حالياً، وإنما أيضاً حول الفصل التام بين الفصحى والعامية حيث تعتبر د. سكري أن هناك «طلاقاً رسمياً» بينهما، وأن الطفل العربي يعاني من مرض «الازدواجية اللغوية»، حسب تعبيرها. فإن تقول «إرم الورقة في الزبالة» بالعامية المصرية تختلف عن الفصحى «إرم الورقة في الزبالة» لأنها تعني هنا كوماً من الزبالة وليس سلة مهملات كما تشرح لنا، غير آخذة بعين الاعتبار، أن المفردة يمكن أن تعبر عن جزء من كل، في بعض الأحيان.
تختلف الدكتورة هنادا طه، أستاذة كرسي الأدب العربي، في «جامعة زايد» في الإمارات، وخبيرة تربوية وهي أيضاً خريجة جامعات أميركية مع د. السكري في التشخيص والعلاج. وتقول: «لم أقرأ أي بحث علمي يتوافق مع ما تطرحه، ولا أجد له أي سند في الدراسات الحديثة. ليس هناك أي بحث يقول إن الإنسان يكتسب مفردة وتبقى في الذاكرة لأمد طويل بمجرد الحفظ، ودون أن ترتبط بمعنى. أشعر أن ثمة تناقضاً بين المشكلة والحل المطروح. أعتقد أن تجريب هذا النهج في 700 مدرسة دفعة واحدة، هي مخاطرة كبيرة. ثمة عوامل كثيرة ستلعب دورها، وما يجب أن يقاس لدى الأطفال هو فقط نتائج تحفيظ القرآن والألفية، لأن هذا الطرح وحده هو الذي سيكسب قلوب الناس وليس عقولهم».
كما يعترض الدكتور بلال عبد الهادي، أستاذ الألسنية في «الجامعة اللبنانية» على الفصل الحاد بين العامية والفصحى عند د. السكري، بحيث إنها تعتبر الطفل العربي يدخل المدرسة بزاد من المفردات لا يتجاوز «3 آلاف كلمة تحتوى عليها مفردات اللغة العامية. أمّا حصيلته من اللغة الفصحى، أي اللغة التي سيستخدمها في القراءة والكتابة بعد سن السادسة، فتكاد تكون صفراً».
ويقول د. عبد الهادي: «ثمة للأسف خطأ شائع يقوم على تحقير العامية، وهذا يسيء إلى الفصحى ويشوش على الطفل علاقته بلغته. نحن نعتبر العامية فاسدة، وعاجزة وهذا غير صحيح». ويرى ضرورة البناء على الجسور التي تربط بين الفصحى والعامية، عند دخول الطفل إلى المدرسة بدل اعتبارها غير موجودة ويضيف: «علينا أن ننطلق من مسلمات جديدة، لا من تصورات لا سند لها في الواقع. الطفل عندنا، يعيش مع لغة عربية عامية وقليل من الفصحى. هذا القليل يتسرب إلى ذاكرته من وسائل الإعلام، ويأتيه أيضاً، من عاميته نفسها، من خلال وجود كلمات فصيحة فيها مثال كلمات (سبيل)، (طفل)، (ولد)، (بنت). هذه المفردات لا تتغير في الفصحى ومثلها الكثير. وأجد أنه يمكننا إدخال التلامذة إلى عالم العربية من خلال هذه الكلمات الموجودة في عاميتهم. وهذا يحتاج إلى جهد جماعي يقوم على جمع كل هذه الألفاظ وتركيب نصوص لحمته وسداه من هذه المفردات. وعلينا أن نرصد تأثير ذلك عند الطفل، حيث سينتابه الفرح لأنه لن يشعر بالغربة في انتقاله إلى الفصحى، بل سيجدها مألوفة وقريبة إلى قلبه ولسانه. وحين أتكلم عن الفصحى في العاميات، فهذا يعني أيضاً أن لكل لهجة مفردات مختلفة، ويتوجب العمل على مختلف العاميات». ويضيف عبد الهادي: «وفي اللهجة العامية تراكيب جزء كبير منها موجود في الفصحى. في حال تم التركيز عند الأطفال على التراكيب المشتركة نكون قد بنينا جسراً للصغير يسمح له باللعب بهذه الفصحى تماماً كما يفعل بالعامية. أما سلخ الطفل عن رصيده اللغوي القوي والانطلاق إلى الفصحى باعتبار أنه لا يملك شيئاً هو نوع من الهدر المعرفي».
وهو رأي يشابه ما تقول به د. هنادا طه، إذا ترى أن قول د. السكري بأن الناطقين الأصليين باللغة الإنجليزية يدخلون المدرسة وفي جعبتهم بين 16 و25 ألف كلمة، يستطيعون استخدامها فوراً فيما الطفل العربي يدخل وفي جعبته صفر، هذا أمر غير مثبت لأسباب كثيرة، والأبحاث كثيرة حول الموضوع». وتضيف بالقول: «المستوى الاجتماعي للأهل يلعب دوراً كبيراً. الأطفال الغربيون أحياناً، قد يدخلون المدرسة وليس في جعبتهم عدد كبير من المفردات بسبب تدني المستوى الثقافي للعائلة. هذا أمر مرتبط بالغنى والفقر. فابن عائلة متعلمة تكون خلفياته أغنى من المتحدر من والدين بسطاء. الأمر مشابه في مجتمعاتنا. لكن ثمة ظاهرة مختلفة عند العرب هي أن العائلات الميسورة لا تتحدث مع أولادها العربية وثمة تأثير للخدم الذين يوكل لهم الأولاد، لذلك فهم يذهبون إلى المدرسة كأبناء الفقراء في شح معرفتهم اللغوية». وتستدرك د. طه: «المستوى الأفضل للأطفال عندنا هو للذين يتحدرون من طبقة متوسطة ولوالدين متعلمين، ويدركون أهمية قضاء وقت مع الأولاد، والتحدث معهم لإغناء معرفتهم اللغوية».
تتحدث د. السكري عن نظرية علمية لا يبدو أنها تقنع آخرين من الاختصاصيين وتعتبر أن «الطفل يولد وثلث دماغه خلايا وراثية أما الثلثان الآخران فينتظران الامتلاء. وهي فترة نمو محمومة وجنونية تريد الاستفادة منها، وتسميها فترة التعليم التلقائي، وهي التي يجب اغتنامها. وتتحدث أيضاً عن الشق الأيمن من الدماغ الذي هو معني بالعواطف والمشاعر الذي يتعاطى مع الموسيقى والذي يجب الاستفادة منه في هذه الفترة، فيما الشق الأيسر يكون مشحوناً بالمعلومات. وترى أن بعض الآيات مثل «إن الله غفور رحيم»، كما «كان الله غفوراً رحيماً» هي تراكيب ستبقى في ذهن الطفل حين يغيبها لمدة 10 دقائق ثم يترك ليستريح ويعاود الحفظ.
د. هنادا طه تسأل: «هل هناك في الغرب من يحفّظ التلامذة جزءاً من الإنجيل أو الإلياذة على سبيل المثال. هذا أمر لا يمكن أن يحدث أبداً. كل ما يكتسبونه هي مفردات لها علاقة بالتواصل»، وتستدرك: «ليس من ثلاث سنوات بل من صفر إلى أن يدخل الطفل إلى المدرسة أي خمس سنوات، يجب أن نقرأ له كل يوم نصوصاً يستطيع أن يتماهى معها، مثل أدب الأطفال على سبيل المثال، التي فيها قصص تشبهه أو لها علاقة بما يعيشه في يومه. أنا مثلاً حفظت أجزاء من القرآن في فترة المراهقة، ولا بد أنها كانت مفيدة جداً، لكن هذا جاء في فترة متأخرة. أما في السنوات الأولى فالطفل بحاجة للاستماع إلى حديث الكبار وأفلام الكارتون ونصوص تجيب على تساؤلاته وتخاطب اهتماماته بلغة بيضاء، لا تكون مغرقة في العامية». تميز د. طه بين «الفصحى» التي هي لغة القرآن الكريم والمعلقات التي لا نتداولها بمفرداتها في يومياتنا، و«الفصيحة» التي هي لغة الصحف والروايات ولغة هذا الزمن التي نتواصل بها. وتشرح: «إذا سرنا في طريقة د. السكري سينشأ جيل لديه مفردات لا يفهم شيئاً منها ولا تستخدم. في عمر الست أو سبع سنوات أرى الأنسب تعليم الطفل سورة (الرحمن) من القرآن الكريم مثلاً. إذ ماذا يتعلم طفل صغير في الثالثة حين يحفظ (العرجون القديم) أو (والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا)، أين ترى سيستخدمها، وفي أي مناسبة، وأي سياق؟» كما تعتبر د. طه «أن طرح د. السكري لا يأخذ بعين الاعتبار المسيحيين، والأقباط والكلدان والأرمن. «ماذا نقول لهم، يتوجب عليكم حفظ القرآن؟ أنا مسلمة لكن علينا أن نراعي التنوع في مجتمعاتنا، وثمة مسلمون ربما لا يرون جدوى من تحفيظ أولادهم دون شرح. لكنه بالطبع طرح يحدث صدى، ويمس وتراً حساساً وعاطفياً في بلدان كثيرة، ولدى فئة كبيرة من الناس، نظراً لأنه يدغدغ مشاعر دينية وعاطفية».
أما د. عبد الهادي فيرى أن «الحفظ ضروري ولكن أيضاً يجب أن يخضع لمعايير هدفها تعزيز القوالب اللغوية في ذهن الطفل، ولكن ليس عن طريق نصوص قديمة، وإنما باعتماد نصوص يراها على الشاشة، في الشارع في ملعب المدرسة، عن طريق الأغنيات المشوقة والجميلة. ويذكر بعبارة عربية مأثورة تقول: «لكل زمان بيان» والبيان العربي في القرن الحادي والعشرين هو غيره في الأزمنة السابقة. فيما يخص تعليم اللغة العربية الفصحى.
لإنقاذ العربية عودوا إلى الكتاتيب أو تصالحوا مع العامية
باحثة تدعو إلى تحفيظ القرآن وألفية ابن مالك قبل بلوغ السادسة

سهير السكري - هنادا طه - د.بلال عبد الهادي

لإنقاذ العربية عودوا إلى الكتاتيب أو تصالحوا مع العامية

سهير السكري - هنادا طه - د.بلال عبد الهادي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة