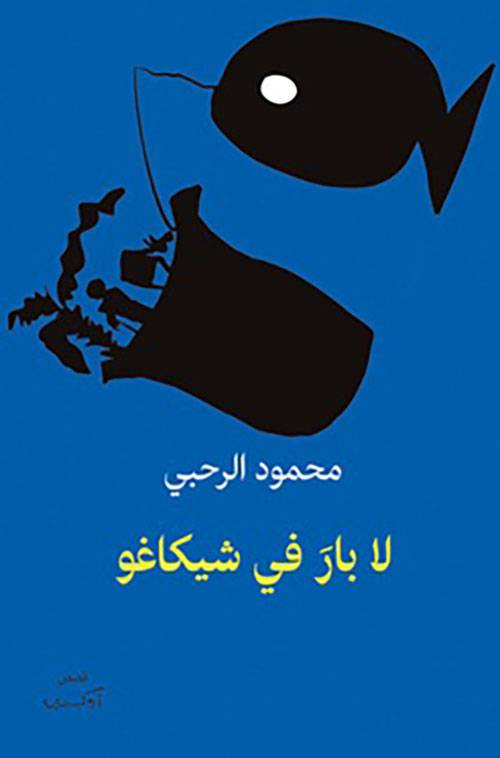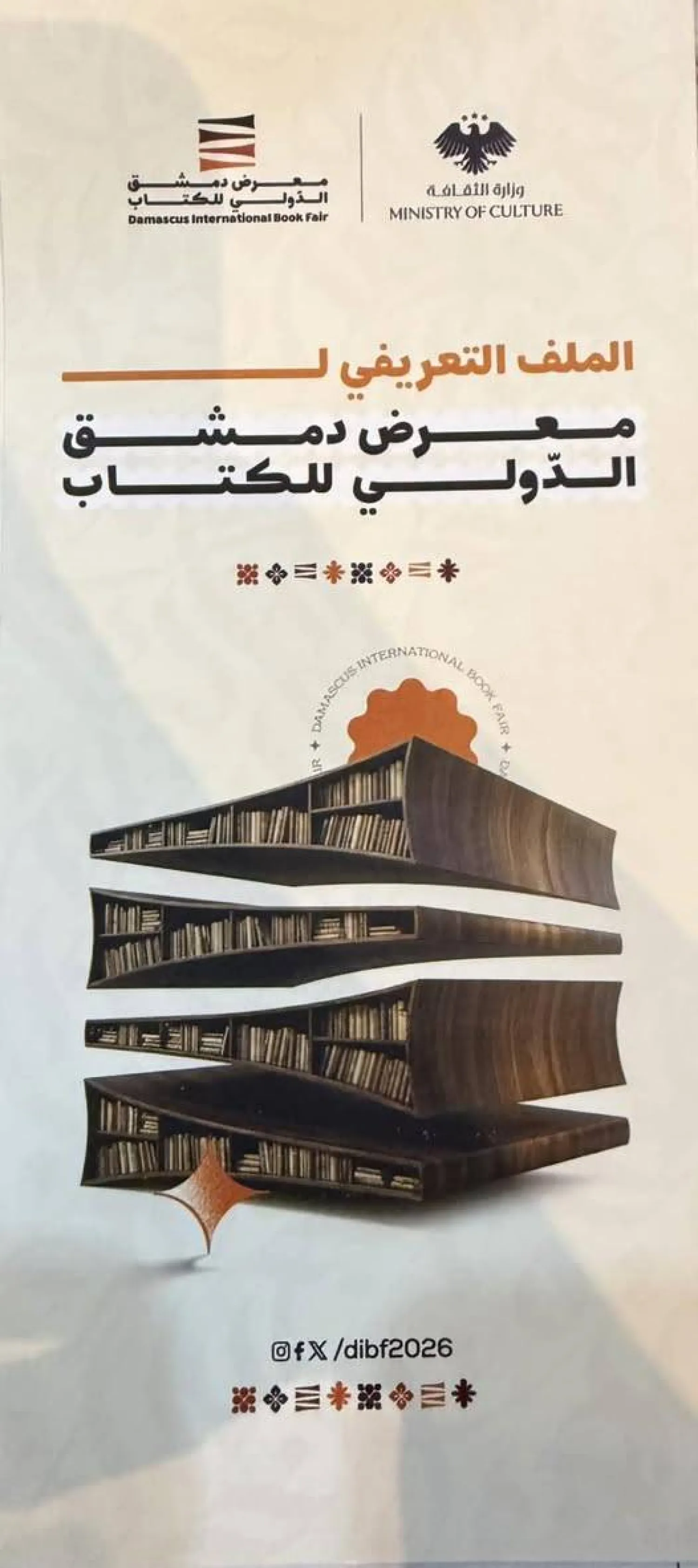تجمع الإماراتية ميسون صقر القاسمي بين كتابة الشعر والرواية والفنون التشكيلية والسينما أيضا، إذ حصل فيلم تجريبي لها على جائزة الإمارات. لكنها تعتبر أن أهم إنجازاتها قيامها بتجميع وتحقيق الأعمال الكاملة لوالدها الشاعر الشيخ صقر بن سلطان القاسمي في أربعة أجزاء. وقد حصلت ميسون صقر أخيرا على جائزة «كفافيس» الدولية لعام 2013 في الشعر. هنا حوار معها أجري في القاهرة حيث تقيم:
> في رأيك هل أثرت ثورات الربيع العربي على النتاج الإبداعي.. هل نجح المبدعون في التعبير عنها أدبيا؟
- لا شك أن الأحداث العربية تؤثر بشكل كبير على المبدع العربي، فهذا الشتات الرهيب في سوريا ومن قبله العراق وتوتر الأوضاع في ليبيا وتونس واليمن لها تأثيرها على الكتابة والكاتب، فالمبدع الحقيقي لا يستطيع أن يعيش بمعزل عما يدور حوله من أحداث خاصة تهم بلده أو البلد العزيز، الذي يعيش فيه، وإلا سيكون غير صادق في توجهاته. هذه الأحداث تنعكس على الإبداع سواء في الشعر أو الأدب أو الكتابة بصفة عامة ولكن من الصعب أن يعبر المبدع عن مشاعره تجاه تلك الأحداث في الوقت ذاته، لأنه قد يكون منشغلا بمتابعتها أكثر من انشغاله بالكتابة. فمثلا لم يكن من الممكن لأي إنسان في مصر أن يترك شاشة التلفزيون التي تعج بالأحداث الساخنة ويذهب للكتابة فكان ما يحدث هو الشغل الشاغل للجميع بمن فيهم المبدعون، وقد عشت شخصيا تلك التجربة الخاصة جدا على نفسي بحكم إقامتي بالقرب من مقر قصر الاتحادية. عايشت الأحداث بكل سخونتها وتأثرت بما شاهدته وهو ما سينعكس على بعض الأعمال فيما بعد.
وبالنسبة لي، تأثرت مثلا بصور شهداء الثورة الأولى التي علت البسمة وجوههم وكأنهم أحياء لكنها في النهاية كانت ابتسامة ميتة ومؤلمة أثرت في نفسي بعمق فجاء ديواني: «جمالي في الصور» يعكس تأثري بهذه الوجوه، وكان جزء منه يميل للتصوف بحكم تلك النظرة التي هي ما بين الحياة والموت. ولا ننسى أيضا أن الفترة الماضية أثرت أحداثها في ظهور فنون جديدة مثل فن الجرافيتي، كما ساهمت الثورات العربية في دخول جيل جديد في عالم الكتابة. يعنى الثورة أنتجت حالة أثرت على الإبداع.
> هناك من يرى أن هذه الثورات كشفت فشل النخبة المثقفة وتراجعها عن أداء دورها. ما رأيك؟
- المثقف هو أولا وأخيرا إنسان وهو ليس الشاعر أو الأديب فقط وإنما السياسي والمفكر والقاضي كلهم مثقفون وأعتقد أن المثقف لم يفشل، بل بالعكس فقد ساهم في الثورة المصرية على سبيل المثال لكن خبرة المثقف ليست سياسية بحتة، لذلك تنحى حين بدأت السياسة تتحرك، وذلك لأن الخبرة السياسية والتشكيل الحزبي ما زال جديدا على المجتمعات العربية.
> ألم يدفعك الخوف من الأحداث الساخنة إلى ترك مصر؟
- لا لم أفكر قط في مغادرة مصر لأننا عشنا فيها جميع أوقاتنا الطيبة. لقد عاصرت أوقاتا أصعب من ذلك بكثير خلال وجودي بمصر أثناء حربي 1967 و1973 لذلك لم تكن تلك الأحداث بغريبة أو مقلقة لي. لكن ما أثارني حقا هو ذلك الخروج الكبير للناس بدافع الرغبة في التغيير وصولا للحظة الفرح الجماعي. لكن كانت أصعب اللحظات التي عشتها بمصر هي تلك الفترة التي حدث فيها تأجيج للفرقة بين المصريين، وهذا ما أزعجني أثناء حكم الإخوان، لأنهم للأسف لم يعرفوا المجتمع المصري جيدا ولم يفهموا أن الدين والحياة في مصر شيء واحد ولذلك لم يتحملهم المصريون.
> بحكم أنك مبدعة عربية كيف تنظرين لواقع المرأة عامة والمبدعة بشكل خاص في عالمنا العربي؟
- بالنسبة للمرأة العربية كان النزاع بين محاولة الحفاظ على موروثات ثقافية سابقة مع التقدم خطوة للأمام.. بينما كانت هناك أخريات يتحركن بمفهوم الحرية فكان هناك نزاع. وفى منطقة الخليج أتصور أن هناك تقدما كبيرا في وضع المرأة ودورها الذي صار أقوى في كثير من المجالات الجديدة التي خاضت العمل فيها، فأصبحت هناك دبلوماسيات وهناك من دخلن البرلمانات، ولدينا أيضا وزيرات، هذا بالإضافة إلى ظهور كاتبات كثيرات أثبتن أنفسهن، كما أن من الظواهر اللافتة للنظر ظهور مبدعات سينمائيات ومصورات خليجيات وبعضهن حصد جوائز هامة. المرأة الخليجية لم تعد قاصرة على العطاء والإبداع في المجالات التقليدية كالتدريس وخلافه ولكن ظهرت نساء أثبتن جدارتهن في شتى المجالات وهو مؤشر طيب على تحسن أوضاع المرأة العربية بشكل كبير.
> كيف تكتبين؟
- في البداية كنت أكتب بحرية تامة لكن بعد فترة اكتشفت وأنا في فرنسا أن ما ترجم لي كان أكثر جرأة مني على المستوى الشخصي وما كنت أكتبه من كتابات عن الذات والجسد والحرية كموضوعات للشعر لم أكن أستطيع قراءتها على الملأ، خصوصا وأن المجتمع العربي يفتش في ضمير المرأة وهى غائبة ويقرأ ما بين السطور وليس ما فوق السطور! ومن هنا بدأت ألاحظ أن هذه الكتابات التي قد تعبر عن حالة الجنون التي تصحب الكتابة لا بد أن أكون رقيبة عليها وعلى نفسي. ومن أعمالي التي تنتمي لتلك المرحلة «رجل مجنون لا يحبني» و«عامل نفسه ماشي» تلتها مرحلة أخرى مختلفة بحكم أن الإنسان يتغير أيضا من فترة لأخرى ولا يظل على حال في الكتابة، وفى كل مرة يغير في كتاباته ورؤيته للعالم ولغته.
> هل معنى ذلك أنك تحاسبين نفسك على ما تكتبين؟
- أنا أقول دائما أن من يقف تحت الشجرة لا يراها كاملة، لذلك لا بد أن أنسحب قليلا عنها لأراها، كما أن مسألة النقد سواء من الأهل أو الأصدقاء أو خلافه لا بد من النظر إليها لا بعين الحنين والحب، ولكن أيضا كمحاولة لرؤية القادم واستشراف المستقبل كما أنني لا بد أيضا أن أنظر من عين الأمل وليس الإحباط فلا أرى النقص، بل أسعى لكيفية تحقيق الكمال. وأعتقد أن المسؤولية تكون أصعب بالنسبة للكاتب صاحب الخبرة والتجارب المتعددة بمعنى أن من كتب أعمالا كثيرة عليه أن يحاسب نفسه أكثر ممن كتب عملا أو عملين فقط على سبيل المثال ولذلك أحاسب نفسي دائما حرصا على عدم التكرار.
> وكيف تخططين لتفادى ذلك التكرار؟
- لا أخطط بشكل كامل في كتاباتي، لكن لا بد أن تكون هناك وقفة عقب كل فترة لتقييم ما تم خلالها والتفكير بالتجربة الجديدة بما يضمن عدم تكرار النفس. وأنا دائما أبحث عن جديد ما في كل عمل، فكنت أعمل على القصيدة السردية القصيرة جدا ثم انتقلت لتفاصيل البيت وبعدها انتقلت لمرحلة أخذ مفهوم معين لأشتغل عليه، وبعد ذلك بدأت في مرحلة العلاقات كما في «أرملة قاطع طريق» وصولا لمرحلة الصور المتعددة.
> ما الذي يشغلك حاليا؟
- أنا مشغولة حاليا بين عدة أمور منها متابعة الأنشطة الفنية والثقافية بمصر بعد استئنافها عقب فترة طويلة من التوقف كما أستعد لعودتي أنا أيضا للفن التشكيلي والتحضير لتجربة جديدة في عالم الأبيض والأسود، هذا إلى جانب أنني أعكف على كتابة رواية جديدة لتكون أختا لـ«ريحانة» روايتي الوحيدة. وفى نفس الوقت فإنني مشغولة أيضا بتجميع مادة عن مقهى ريش الثقافي العريق والشهير بمصر باعتباره ذاكرة وطنية وإنسانية في منطقة وسط البلد بالقاهرة، ومكانا يرتبط بكثير من الأحداث والشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر.
> بين الفن والشعر والأدب أين تجدين نفسك؟
- أنا أؤمن بتداخل الفنون لكنها تختلف في وسيلة التعبير عنها، وإن كانت كلها تنبع من لحظة إبداعية يمر بها المبدع، لكن ربما كان لنشأتي أثرها في التحيز للشعر خاصة في ظل مكتبة والدي الشاعر أيضا، التي كانت تزخر بالكتب التراثية والشعرية والتي نهلت منها الكثير بما ساهم في عشقي للشعر.