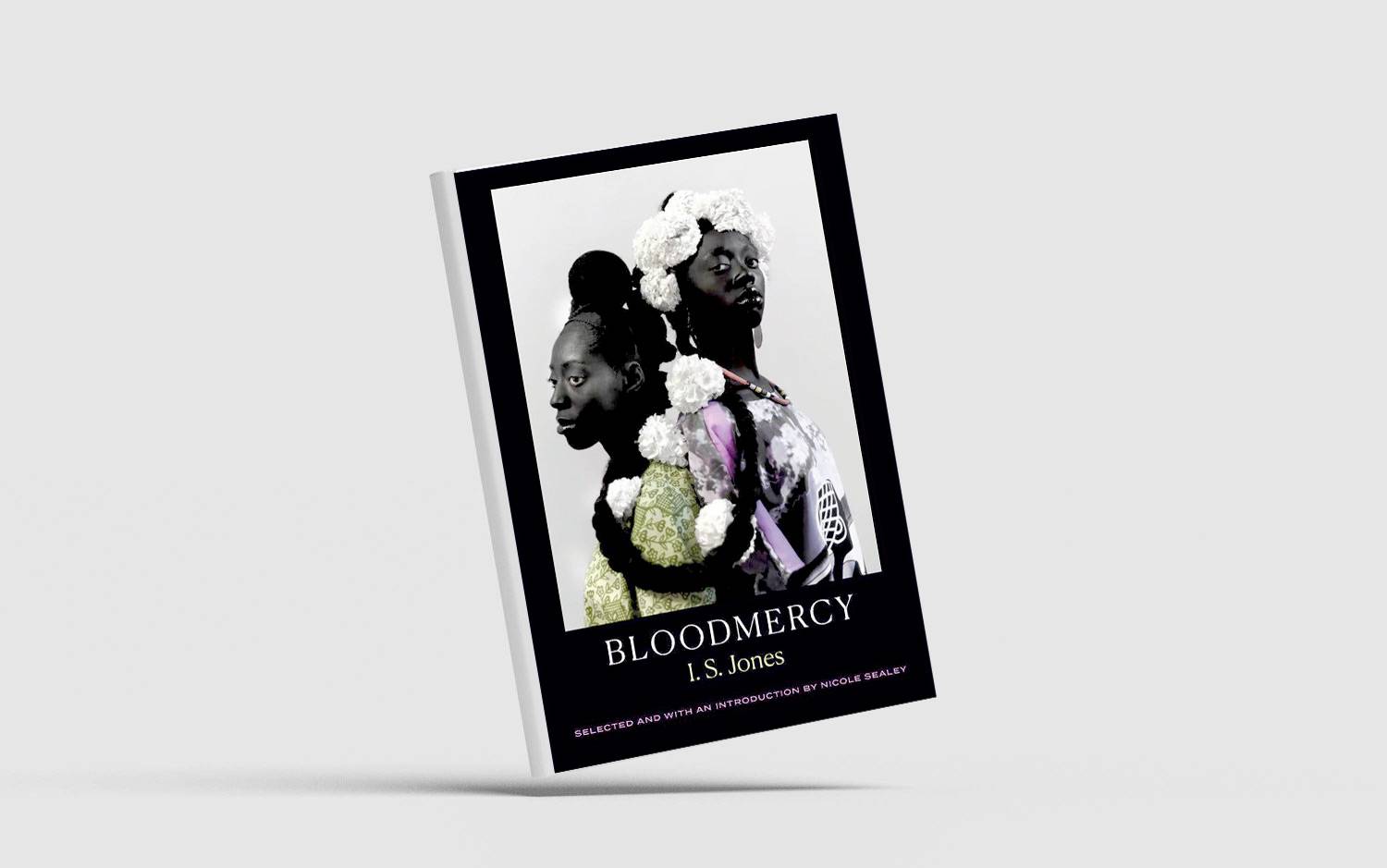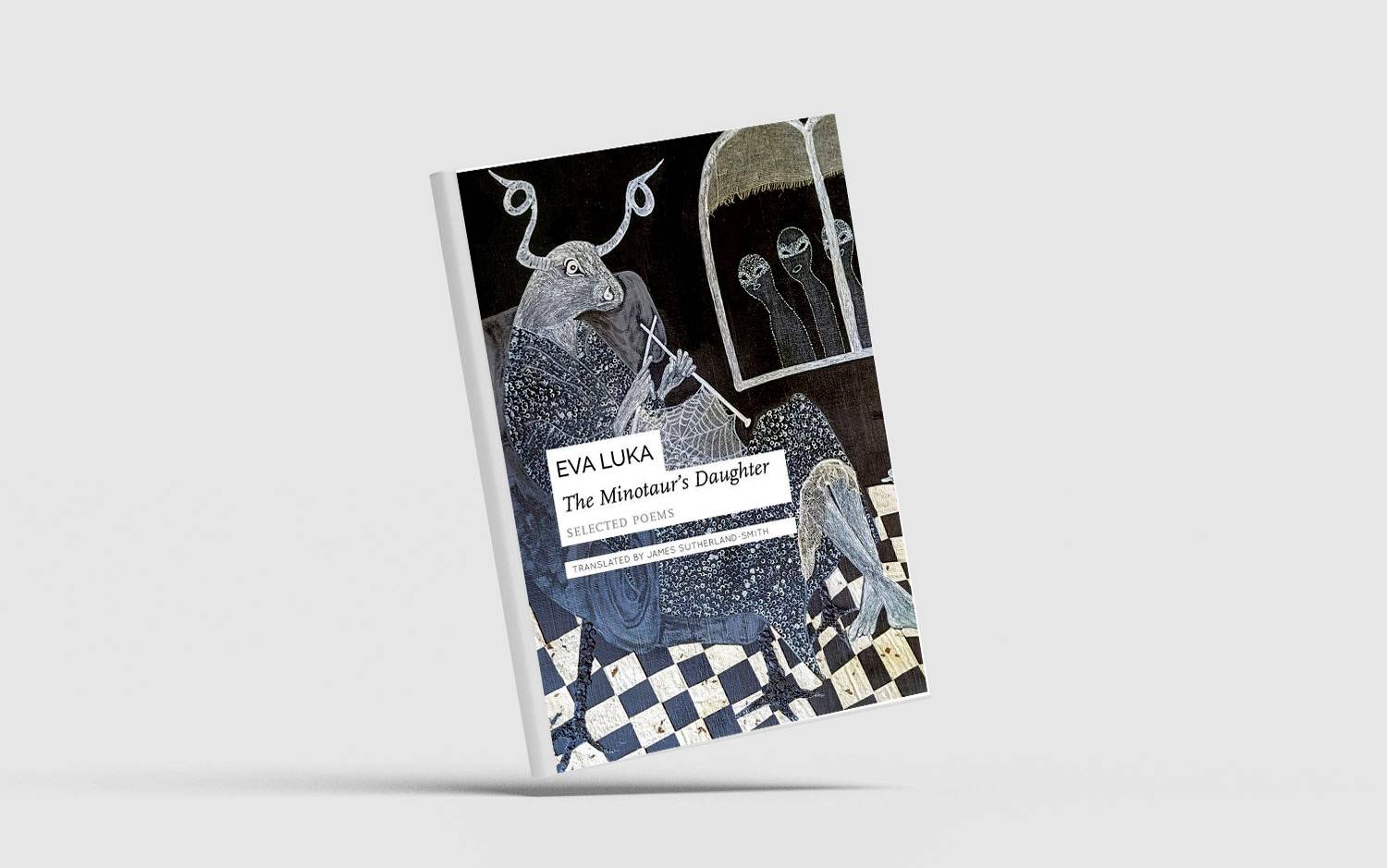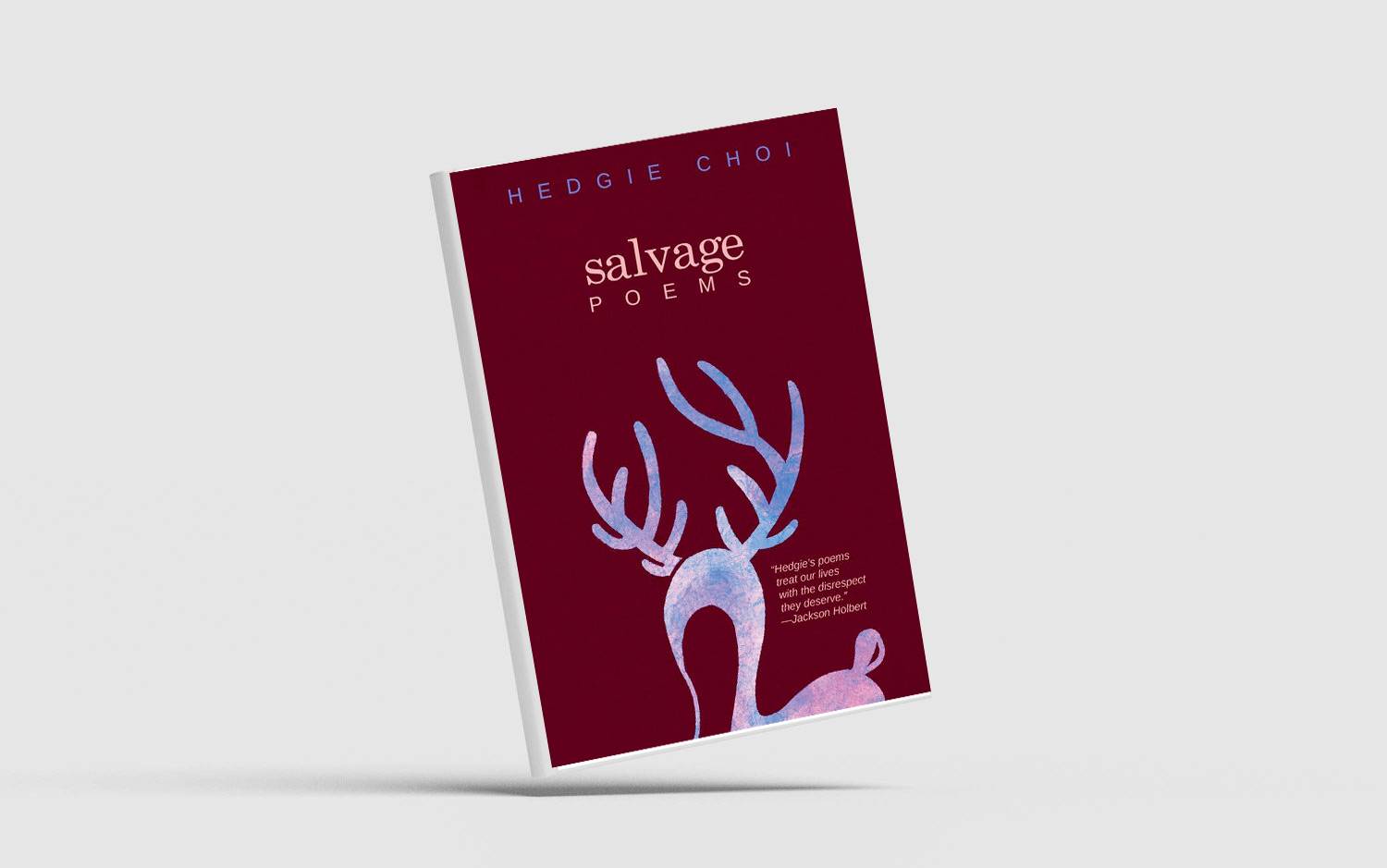شكل مفهوم الكذب، موضوعا بالغ الأهمية في الفكر الفلسفي مند بداياته الأولى. فالفلسفة بحث عن الحقيقة وسعي إليها. ولا يمكن بلوغ هذه الغاية إلا عن طريق تعرية أضدادها، المتمثلة في الوهم، والزيف، والأسطورة، والخيال. ولعل في الحوارات السقراطية ضد السفسطائية، والكهف الأفلاطوني، والتمييز بين الحقيقة والدوكسا (الفكر اليومي)، والحقيقة والدوغما، أبلغ مثال على هذا الأمر. يصنف الكذب في إطار اللاحقيقة. وهو مفهوم زلق متقلب، من الصعب الإمساك به وتصنيفه وتخليص الحقيقة منه. فنقيض الحقيقة له ألف وجه ووجه. ولا يمكن الإلمام به كليا، وبالحقل الذي يشغله، كما يعبر عن ذلك مونتيني، لأنه يشتغل في المناطق المظلمة، بين الذات والموضوع، الحقيقة والواقع، الحقيقة والوهم، النية الحسنة والنية السيئة. فيصبح الكذب أحيانا، أكثر الحقائق صدقا ويقينا، ويصدقه حتى أولئك الذين يعتقدون في قرارات أنفسهم، بأنهم أكثر الناس تحصنا ضده.
يحاول الفيلسوف الفرنسي، جاك دريدا (1930 - 2004) في كتابه تاريخ الكذب، الذي عمل على ترجمته وتقديمه الأستاذ أحمد بازي، عن المركز الثقافي العربي 2016. أن يعود إلى هذا المفهوم، من خلال مختلف المرجعيات الفلسفية التي قاربته على مدار تاريخ الفلسفة، بغية مساءلتها، والاحتفاظ بما يساعد على فهم منطق اشتغال الكذب في زمننا المعاصر، وفي الوقت نفسه، نقد مختلف التصورات التي لم تفلح في أن تحيط بهذا المفهوم إحاطة تامة.
عرض جاك دريدا لمقاربات كثيرة للكذب في تاريخ الفلسفة، باحثا فيها عما يمكن أن يساعده على فهم جيد له. لكنه في النهاية، يؤكد على أن هذه المقاربات، لا تحيط بالكذب كما أصبح معقدا في زمننا المعاصر. ليس الكذب خطأ كما ارتأى ذلك نيتشه. فقد نخطئ من دون أن نكون كاذبين. وليس الكذب phantasma، الذي يعني بالنسبة لليونان الخيال والخرافة. وهو ليس pseudos الذي يجمع بين الخطأ والخداع والتزوير بشكل معقد، كما هو وارد في محاورة هيبياس. كما أن الكذب ليس لا قصدية، كما هو وارد عند أفلاطون. فمن المستحيل أن نجد كذبا غير مقصود. وهذا ما يصححه أرسطو بتحديد أدق، حيث لا يعني الكذب عنده فقط فعل الكذب، وإنما نية إحداثه. إنه فعل ضد إيمان الشخص، أي أن الشخص يكذب، على الرغم من أنه مؤمن بعكس ذلك. والإيمان قدسية بالنسبة لأوغسطين، والصدق مقدس، والكذب ضد هذا المقدس. وبالتالي، يصبح قول الحقيقة بالنسبة لأوغسطين مقدسا. وهذا ما يتبناه الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، جاعلا هذه القدسية عقلية وليست دينية فقط. وهو أكثر فيلسوف مؤثر في نظر دريدا في هذا المجال، حيث توقف عنده كثيرا. ربط كانط بين الحقيقة والصدق. الصدق ضد الكذب. والكذب ضد الحقيقة. قول الصدق واجب مقدس بشكل قطعي إلزامي ولا مشروط. فلا وجود حتى لكذب نافع. بل إن الكذب النافع جريمة في حق الواجب والأخلاق والإنسانية. لأن الكلام مع الآخرين أصلا وعد بقول الحقيقة، والكذب إخلاف لهذا الوعد، وفي الوعد توجد الحرمة والقداسة التي تطبع الوصية الأخلاقية لقول الصدق.
رغم الإغراء الذي تقدمه المقاربة الكانطية، إلا أنها بالنسبة لدريدا غير كافية لتقديم طرح واف للكذب وتعقيداته. فقد أعاد كانط الصدق إلى الذات. فالصدق أخلاق نابعة من الذات. والكذب هو الآخر، كذب نابع من الذات. الذات هي المركز. إلا أن هذه الذات في نظر دريدا، لا تعيش معزولة محصنة في قلعتها، تحلل وتحرم. بل إنها تنخرط في واقع وسياق ومجتمع وتاريخ. أي أن الجوانب التاريخانية للكذب، هي أكثر الجوانب المؤثرة فيه. ليس الكذب مرتبطا بالذات فقط، بل بالواقع والتاريخ والظروف. هكذا، من الضروري في نظر دريدا، أن نتجاوز طرحين اثنين غير دقيقين لمفهوم الكذب: الطرح الأول ينظر إلى الكذب كفعل مسيطر - كما هو وارد عند حنة آرندت التي اعتبرت أن هناك تحولا تاريخيا على مستوى الظروف والبنية والتجارب المشتركة المؤسسة لهذا المفهوم، حيث ترى أن الكذب قد اكتمل في هذا العصر بشكل كبير جدا، وتحول التاريخ، بشكل عام، إلى كذب بالمطلق. وكظاهرة أضحت شمولية مميزة للعصر، تنعزل عن الذوات التي تمارسها، كأن المسألة أضحت خارج قدرات الفرد الواعية، والطرح الثاني، أن ننظر إلى الكذب كفعل محصور في الذات الحرة المؤمنة، التي يجب أن تحتفظ بقدسية الحقيقة كما سبقت الإشارة لذلك عند كانط.
يتجاوز دريدا طرح إيمانويل كانط، وينطلق من طرح حنة آرندت، ليعمل على تخطيه هو الآخر بعد ذلك، ليربط بين الكذب وفعل الكذب. ففعل الكذب يتوجه إلى الآخرين، ولا يمكن الكذب إلا على الآخرين، قصد خداعهم وتضليلهم وإلحاق الأذى بهم، ودفعهم إلى الاعتقاد بأشياء يعرفون أنها غير صحيحة؛ حيث إن الكاذب يعرف حقيقة ما يعزم قوله، ويعرف كذلك الفرق الموجود بين ما يفكر فيه وما يقوله ولمن سيقوله، والنتائج المترتبة عن هذا، وإلا فلا نقول إن الكلام ينتمي إلى خاصية الكذب. وبالتالي، فالمقصد هنا، أولا وأخيرا، هو الأهم، حيث يتوفر على بعد إنجازي، ويرمي إلى خلق الحدث والدفع إلى الاعتقاد به. هكذا يمكن أن نجد منطقة حرة من السهل علينا أن نمسك فيها بالكذب، في ارتباطه، ليس بالأخلاق فقط، وإنما بالثقافة والمعتقد والسياسة، حيث ينبغي الكشف عن الأقنعة والتقنيات والوسائل الموظفة للقيام به.
انطلاقا من هذا التحديد، يدخل دريدا إلى صلب الموضوع ليربط الكذب بالسياسة، فالكذب وسيلة للحكم، والديماغوجية يمتهنها كل من في سدة الحكم؛ حيث أصبح بالإمكان التلاعب بالوقائع، حتى في العالم الحر، من طرف تنظيمات ضخمة تخدم مصالح أطراف معينة، تعمم العقلية المرتبطة بمصلحة الدولة. فيتم التلاعب على مستوى واسع بالآراء والأحداث، وحتى بحقائق معروفة من طرف الجميع. والرسم غير مطالب منه أن يطابق الواقع بل أن يحل محله. وبعبارة أخرى، غالبا ما يكون الفرق بين الكذب التقليدي والكذب العصري، هو الفرق ذاته الذي يوجد بين الحجب والنقض. لقد أضحى الكذب السياسي في هذا العصر، دراسة واستراتيجية. كما أن قول الحقيقة هو الآخر يخضع للمعايير نفسها، وبالتالي لا بد من البحث في الخصوصية التاريخية والسياسية والتقنية الإعلامية للكذب. فليست كل الحقائق صالحة للإفصاح. والأمر ليس مقدسا ولا مشروطا بالشكل الذي يريده كانط. أي أنه يجب الأخذ بالحسبان لكل الإكراهات التي يمكن افتراضها، والمراعاة بكل براغماتية للفرص المواتية، والعواقب المحتملة، وأشكال التعبير البلاغية المستعملة، ومشاعر المتلقي، سواء كان خاسرا أو مستفيدا. فيصبح من الضروري الاشتغال بمنطق جديد، وتجاوز الثنائية القائمة على الصدق والكذب عن طريق استحضار منطق الوعي والإنجازية. ولنأخذ على سبيل المثال، رفض بيل كلينتون الاعتراف بأن إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما كان من دون مبرر، على الرغم من الشهادات المناقضة لذلك. ولنأخذ مثالا آخر: التصريح الذي أدلى به الوزير الأول الياباني موراياما لما عبر باسمه الخاص، عن أسفه الصادق والعميق، وبحداده الشخصي، عن الجرائم المرتكبة من طرف اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، في جميع أنحاء آسيا، من دون أن يلزم الدولة، ومن دون استحضار الإمبراطورية اليابانية. والأمثلة كهذه كثيرة جدا. فهل نطالب هنا بيل كلينتون بالالتزام بقول الحقيقة كواجب مقدس كما يرى كانط؟ وهل نقول إن اعتراف موراياما حقيقة أم كذب؟ وهل نرجع إلى الشخص الفاعل الذي يقصد بدقة ما يقول، أم نمضي كما ترى آرندت، ونربطه بالمشهد السياسي الكاذب بمجمله؟ هل تسعفنا ثنائيات الصدق والكذب، والنية السيئة والحسنة، لفهم كل هذه المظاهر؟ هكذا يصبح الكذب مختلفا تماما عن الخطأ، أو النقص الذي قد يعتري المعلومات أو الخبرات. وهو يستدعي العزم المقصود على إلحاق الأذى، وبالتالي لا بد من إعادة مساءلة الشهود والتواريخ والأرشيفات، حيث تنخرط وسائل الإعلام، إضافة إلى الجامعات والأساتذة والمثقفين. وبالموازاة مع ذلك، إعادة كتابة تاريخ للتزوير والنفي والإنكار. ولا بد من الكشف من داخل الدولة على مختلف التعبيرات والتعديلات الإنكارية، وكل عبث بالصور والمشاهد.
لم يعد الكذب هنا، ادعاء مناقضا للحقيقة فقط. كما أنه لا يمكن اعتباره جهلا. ولا يمكن كذلك إلحاقه بالكذب على الذات. فهو ينتمي إلى صنف آخر، بحيث لا يمكن اختزاله في مختلف المقولات التي ورثناها من أفلاطون إلى أوغسطين وروسو حتى كانط وآرندت. وبالتالي، من الضروري التفكير بطريقة جديدة لمقاربته، حتى لا نفتح الباب أمام انحرافات ذات طابع شمولي، ونتسلح بالأدوات الملائمة لفهم هذا الإشكال، فقط لأن الكذب كما يعرفه عصرنا، لم يسبق له مثيل. إنه كذب أكثر تطابقا مع الحقيقة، وملتصق بالصورة الواقعية التي تبرز الواقع وتلغيه في الوقت نفسه.
جاك دريدا ومقاربة جديدة لمفهوم الكذب
أكثر تطابقًا مع الحقيقة وملتصق بالصورة التي تبرز الواقع وتلغيه


جاك دريدا ومقاربة جديدة لمفهوم الكذب

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة