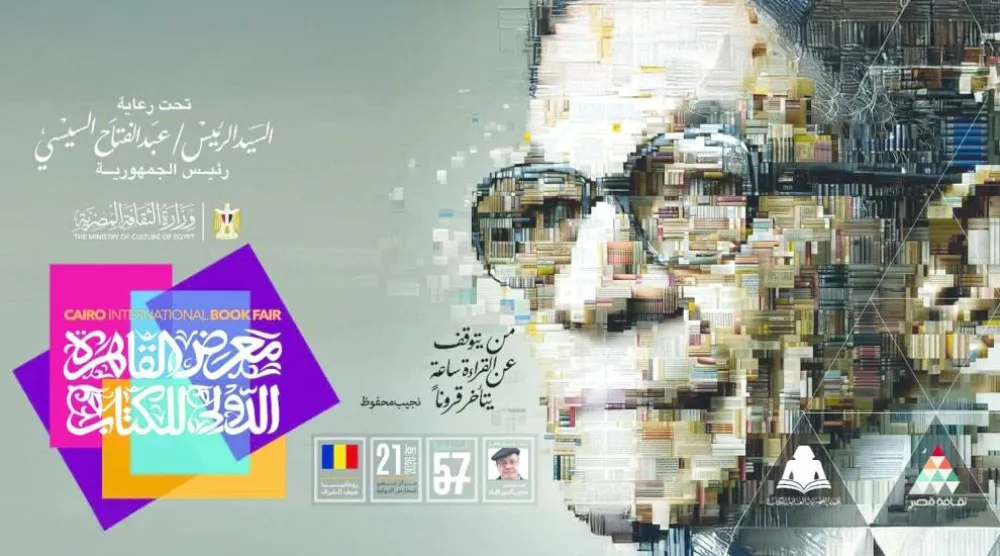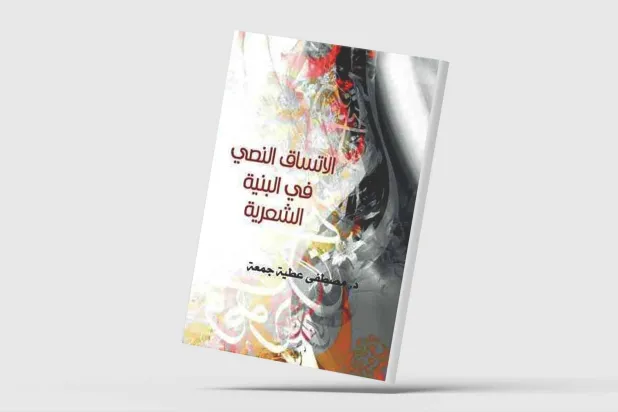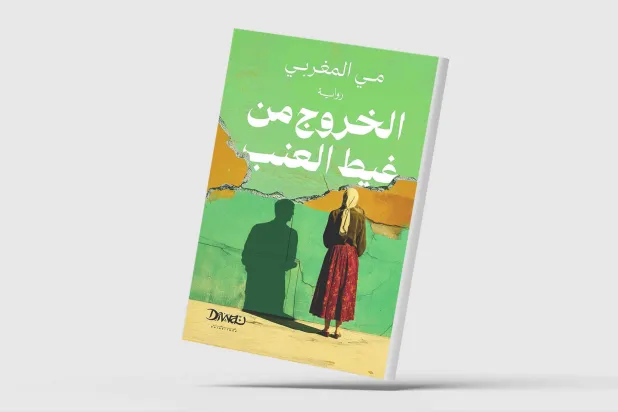حصل الباحث التونسي زهير الذوادي على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون بفرنسا، وعمل سفيراً لتونس لدى العديد من البلدان الأفريقية والآسيوية والأوروبية، وله العديد من المؤلفات المهمة التي تتناول تاريخ تونس والحركة الإصلاحية التحديثية التونسية والعربية الإسلامية، ومنها «الفكر الإصلاحي العربي الإسلامي ومسألة الاستبداد»، و«الخروج من نسق الدولة الدينية»، و«نقد الفكر الجهادي»، و«إصلاح الفقهاء»، و«صناعة الرعب»، وهو أحدث إصداراته.
على هامش زيارته أخيراً للقاهرة، هنا حوار معه حول المشهد الثقافي والفكري في تونس ارتباطاً بالتغيرات السياسية في البلد، ودور المثقف النقدي في مواجهة تأثيرات الفكر الديني المتزمت، ومشكلات الثقافة العربية عموماً.
> ما هي ملامح أزمة الثقافة والمثقف في العالم العربي برأيك؟
- حالياً يواجه المثقف العربي وضعاً مأزوماً إلى درجة غير معهودة، يكمن في تراجع تأثير الفكر النقدي في الثقافة العربية، بداية من تأثير الفكر الديني المحافظ والماضوي من ناحية، وتراجع منطق الالتزام الفكري في ممارسة وأعمال رموز الثقافة والفن من ناحية أخرى، هذا إلى جانب هشاشة وركاكة المشاريع الثقافية للدولة الوطنية التي أصبحت في بعض جوانبها تعتمد الترفيه بدل التثقيف، والقبول بالرداءة والاستهلاك بدل الامتياز والإبداع، فضلاً عن ضمور المشاريع الفكرية والنقدية الكبرى والملهمة من الساحة الثقافية العربية، وتسرب المنطق التجاري والسلعي لقطاعات الإنتاج الفكري والثقافي والإعلامي، وتراجع مكانة المثقف بالمجتمع في خضم التحولات التي عرفها، ناهيك بالاقتصاد والسياسة، ومجالات التواصل الاجتماعي والاتصالي.
> ما هي الحلول التي تراها إذن؟
- الحقيقة أنه على ضوء التجربة التي عرفتها البلدان المتقدمة «الغرب والشرق الآسيوي» تبقى مجالات تدخل المثقف العربي واسعة ولا متناهية، شريطة التجذر في توظيف التراكم المعرفي، وربطه بجذوره الفلسفية والواقعية، مع الالتزام بروح النقد والإبداع دائماً. فلا يمكن أن نفشل حيث نجح غيرنا. والمسألة هنا رهينة المبادرة والمثابرة.
> لكن ماذا عن الحالة الثقافية في تونس تحديداً؟
- شكل المجال الثقافي في تونس ميداناً للصراع بين الحداثيين وأنصار المشروع الإخواني، وقد تحول ذلك إلى قلعة صمود، رغم تسلل بعض الإداريين التابعين للإسلام السياسي إلى بعض الهيئات أو المواقع المؤثرة، محاولين اختراق الهياكل الثقافية، وجمهورها من خلال بعض المثقفين المتكيفين أو «المطبعين» مع الوضع الذي نتج عن أحداث 2011، أما عن القطاع الثقافي التونسي فيتعافى اليوم من الخطر الإخواني، لكنه يواجه تحديات جديدة، منها غياب المشروع الوطني الجديد في المجال الثقافي وعلاقته مع تقييم البرامج السابقة لسنة 2011 واللاحقة لها، وضعف الدعم المالي العمومي بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية والمالية السائدة في البلاد، الأمر الذي يضعف دعم الدولة للفاعلين والمتدخلين والمبدعين.
> وماذا على صعيد الفنون؟
- هناك نجاحات باهرة في مجال السينما، بخلاف قطاع الأغنية، وهناك تراكم في مجال الرواية والنقد والقصة القصيرة في مقابل الشعر الذي لا يزال رغم تزايد الإنتاج يفتقد قامات بارزة جديدة. أما قطاع النشر فهو «الرجل المريض» الذي ما انفك يتخبط في صعوبات خانقة.
> ما أثر حركة «النهضة» على أجهزة المؤسسات الثقافية التونسية؟ وما سر الفوضى النسبية وسط النخب الحداثية ما بعد بورقيبة؟!
- بعد سنة 2011 عرف المثقفون الحداثيون في تونس تحديين: الأول يتمثل في فقدان السند السياسي الذي كانت توفره الدولة لمشروع التحديث (رغم أنه كان قسرياً)، والثاني تنامي الخطر ضد مشروع الحداثة الذي ظهر مع وصول الإسلام السياسي للسلطة، وتنامي تأثيره في المجتمع، لذلك تبعثرت جهود الفصائل المثقفة الحداثية، وارتبكت تحت تأثير المحاصرة التي فُرضت عليها من طرف خصومها المفكرين والسياسيين والأكاديميين الذين غزوا منابر الإعلام والنشر، مدعومين من بعض المثقفين، غربيين ومسلمين وعرب، وقد أحدث ذلك شرخاً عميقاً في جسد نخبة مهشمة بفعل التسلطية السياسية السابقة ليناير (كانون الثاني) 2011، والمترددة إزاء قوة الهجمة الآيديولوجية والثقافية المتأسلمة والقادمة من المشرق ومن مراكز دعمها الجيوسياسي القادم من الغرب.
> لكن ألا ترى بارقة أمل للخروج من هذا الوضع؟
- هناك حراك يقاوم آيديولوجية الإسلام السياسي، وقد أفرز شيئاً فشيئاً جمهوراً مدنياً وتحررياً شكل في نهاية الأمر عبر «اعتصامات باردو 2013» حزام أمان للمشروع المجتمعي المدني والتقدمي وقيمه الحداثية، وساعد على تراكم جهود الأعمال الفكرية والنضالات المدنية التي شرعت في الانصهار التدريجي، مبشرة على المدى المتوسط بآفاق واعدة قادرة على تجاوز مواطن الضعف في أعمال النخبة خلال بعض الانحرافات التي أضرت الفكر والنشاط المجتمعي، وكان مصدرها بعض أفكار منظورة ليبرالية الفوضى الخلاقة والثورات المصطنعة، والتي مفادها أن الإسلام السياسي أصبح قوة ديمقراطية وثورية وحداثية، وأن التحالف معه ومساندته والانصياع له أمر مفيد تاريخياً ومجتمعياً وفكرياً، وهو ما يشكل طعنة قاتلة لمشروع التحرر الوطني والاجتماعي والثقافي الذي يشكل القاعدة الأساسية لعمل الدولة الوطنية.
> تحدثت في كتابك «إصلاح الفقهاء» عن جهود الفقيه التونسي شيخ جامعة الزيتونة، محمد الطاهر بن عاشور ودوره في مجال الحقوق المشروعة للمرأة... كيف تنظر الآن لما تحقق في هذا المجال؟
> وبرأيك، ما المكاسب في فترة ما بعد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي؟
- في زمن الرئيس بورقيبة وبن علي تحقق الكثير من المكاسب في صالح المرأة التونسية، لكن بعد سنة 2011 تعرضت لبعض مخاطر التراجع، لكن يقظة قوى المجتمع المدني، والحركة النسوية التونسية نجحت في التصدي لها، بل عززت بعض المكاسب من خلال تكريس آليات التناصف في كل أصناف الانتخابات، وآليات التمييز الإيجابي في بعض المناصب السياسية والإدارية على أساس الكفاءة، والمسألة تبقى ثقافية ومجتمعية في الأساس؛ أي إنها لا تزال تحتاج إلى دعم ومساندة لمواجهة الدعوات المحافظة المشدودة إلى قيم الماضي المتزمتة. إن ربط الحركات النسوية العربية بعضها بعضاً على مستوى أنشطتها وبرامجها وتوافقاتها الفكرية يمكن أن ينتج تصورات مشتركة لمفهوم عمل حداثي وتقدمي لتحرير المرأة العربية والإسلامية في إطار التفاعل الإيجابي والمدروس مع تيارات الفكر والثقافة والنضال النسوي التقدمي في العالم.
> في كتابك «صناعة الرعب» تحدثت عن الذهنية المحرّكة للممارسة الإرهابية... كيف ترى هذه الذهنية؟
- بخصوص ذهنية الإرهابي فهي متمحورة حول إلحاق الضرر بالغير، سواء كان «المجتمع أو الدولة»، وذلك ليس نتيجة مرض نفساني، كما أنه لا يندرج تحت سطوة غريزة الموت أو العدوان أو التدمير، وإنما يأتي تكريساً لمبدأ الانشقاق والتمرد على المجتمع بهدف إصلاحه أو تغييره أو معاقبته وفق نظرة استعلائية وسلطوية واستبدادية تنبع من أولوية مصالح ومعتقدات أصحابها في الدنيا «والآخرة»، ومن دونية الباقي، وذهنية الإرهابي تنطلق من قدسية خيارها ورفعة شأنه المعنوي، خصوصاً إذا اقتحمت مجال ممارسة «الرعب ضد الرعب» حسب عبارة جان بودياز، وممارسة «الانتحار» على أساس «الشعور بالذنب، والشعور بالعجز»، حسب عبارة فتحي بن سلامة، وحيث يصبح التحدي قاعدة للسلوك يكون الموت ردّاً على الموت.
> لكن ما هي الأسس التي تقوم عليها ذهنية الإرهابي؟
- تقوم على اعتبار أنه ينتمي إلى طليعة الأفاضل، وهو أحد عناصر «الفرقة الناجية» أو الملة المختارة والمنتصرة آجلاً أو عاجلاً، أو ملة شعب الله المختار «اليهودية»، أو جماعة المؤمنين «المسيحية»، وهي ذهنية قطيعة مع المجتمع على أساس أنها تمتلك الحقيقة المطلقة، والرأي الصواب. ولا تعرف ذهنية الإرهابي صلة بمبادئ التسامح والديمقراطية، وحق الاختلاف؛ لذلك فهي مقدمة للاستبداد في المجتمعات، كما أنها نتيجة له في مستوى كل من الآيديولوجيا أو التنظيم الذي يساعد على تكوينها وإفرازها، وترافق ذهنية الإرهابي ثقة ميتافيزيقية في حتمية النصر الذي تحتمه إرادة ربانية أو حتمية تاريخية، في حين أن الهزيمة تجعل الإرهابي أكثر عزلة في المجتمع وأكثر دموية ويأساً، الأمر الذي يسقط كل إمكانية للحوار والتفاوض السياسي معه.
> لكن على ماذا تتأسس هذه الدموية ورفض الحوار؟
- على كونه يرى نفسه مؤمناً صادقاً، ما يجعله منفتحاً على فكرة التضحية بالنفس، حسب عبارة ايريك هوفنز في كتابه «المؤمن الصادق»، من هنا لا يقبل التفاوض أو التجادل أو الحوار، وهو لذلك منتج لممارسة مطلقة للشر، ويظل في قطيعة مطلقة مع الواقع، وكل ما يخالف عقيدته؛ أي «العقيدة الأبدية» المفرزة لذهنية «اللاتفاعل» التي ترفض نصف الحلول أو المراجعة للمواقف.