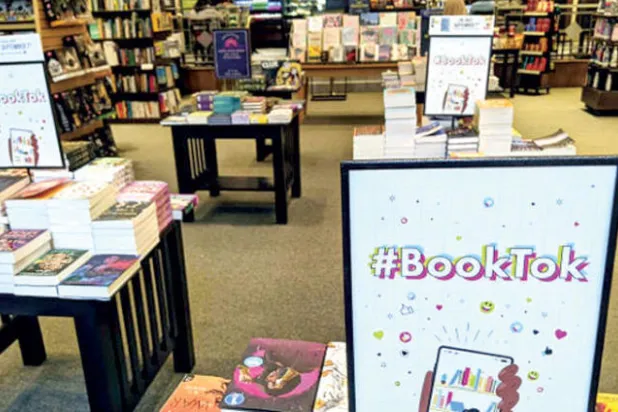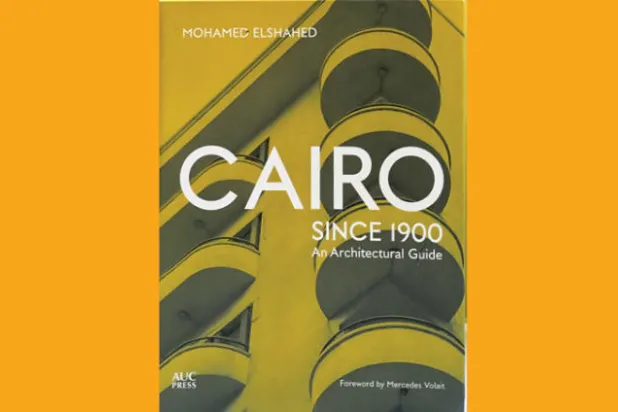ينقل الناقد المصري عمار علي حسن في كتابه «النص والسلطة والمجتمع» عن نجيب محفوظ قوله إن انحسار عهد عبد الناصر جرد الكتّاب من مصدر كان يمد الكتابة بالحيوية، كما تمثلت في مخاتلة الرقيب بغية تناول موضوعات لم يكن من المسموح تناولها. يقول محفوظ: «إن المبدعين في السبعينات كانوا أحراراً في أن يقولوا ما يشاءون في أحاديثهم ومقالاتهم، وهو ما جنى على الجانب الإبداعي لديهم، حيث لم تكن أمامهم تحديات كتلك التي وجدت في الستينات، والتي قادت إلى إنجاز الأعمال الإبداعية، بما فيها من رموز وإسقاطات للتعبير عما يريدونه».
هذا الرأي صحيح إلى حد بعيد، أي ليس على إطلاقه، ولا أظن محفوظ قصد الإطلاق، ذلك أن في مصر، كما في كل البلاد العربية ودول أخرى كثيرة في العالم، ظل هامش الكتابة مقيداً بأطر تتسع أو تضيق، لكنها ظلت قائمة. صحة الرأي في نسبيته، أي أنه بالقياس إلى ما كان عليه الوضع يمكن القول إن هامشاً قد اتسع. ذلك الاتساع مهم في كل الحالات، حتى حين نسلّم بنسبيته. وهو مهم أيضاً للتعرف على الأثر الذي يتركه في طبيعة الكتابة الأدبية والإنتاج الثقافي بأنواعه المختلفة من الفكر إلى الفن إلى العلم.
ملاحظة نجيب محفوظ مطروحة اليوم على بيئات اجتماعية وثقافية تعيش عهداً غير مسبوق من الانفتاح الاجتماعي؛ حيث اتسع هامش المسموح به اتساعاً لم يكن من المحلوم به لدى معظم الراغبين فيه المنادين إليه. ولعل البيئة السعودية هي التي ستخطر ببال من يقرأ هذا الكلام. ذلك أن المملكة منذ سنوات قلائل كانت تعيش حالة اختناق اجتماعي وثقافي قد يسميه البعض ضوابط أو التزاماً، وهناك من سيسميه محافظة، ومن المؤكد أن هناك من يراه الطريق القويم الذي ضل عنه المجتمع. لكن هناك من سيراه الطريق المطلوب منذ أمد بعيد، أي الابتعاد عن طرق التشدد غير المبرر، والقسر الاجتماعي الذي لا تقره سماحة الدين واتساع مساحة الاختلاف وتعدد الآراء في كثير من المسائل.
الأدب السعودي منذ بدايته هو قصة التفاعل وسط بيئات اجتماعية وثقافية محافظة، ومساعي الكتّاب للوصول إلى منطقة من التوازن التي تسمح بإنتاج أعمال تحقق معادلة الجمال والقيمة الدلالية ضمن القيم والضوابط السائدة. ولكن تلك البيئات لم تكن متماثلة في درجة الانفتاح أو المحافظة. كانت دائماً بيئات مختلفة باختلاف مناطق المملكة التي جمعت أطراف الجزيرة العربية؛ من الحجاز المتاخم لمصر والسودان حتى الأحساء الخليجية، ومن الشمال القريب من الشام حتى عسير ونجران وجيزان في جنوب الجزيرة العربية، وصولاً إلى نجد التي ظلت معزولة نسبياً وسط الجزيرة إلى أن اتسعت صلاتها مع تطور الدولة وتعدد مشارب التأثير وقنوات الاتصال. تنوع جغرافي وسكاني وثقافي انعكس بالضرورة على المنتج الفكري والثقافي، وأفرز من ثم صوراً مختلفة من التفاعل البيئي على امتداد ما يقارب القرن من النشاط والإنتاج المتعدد والمتأثر ببيئات قريبة؛ مصر والشام والعراق واليمن، بل الهند وإيران، وغيرها.
ذلك التعدد أو التنوع في الإنتاج وما صاحبته من حريات وقيم متفاوتة هو الذي تأثر بصورة مباشرة بما مرت به المملكة في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، أو بالتحديد بعد حادثة الحرم المكي على يد جماعات حملت لواء التشدد والاعتراض على ما كانت المملكة تحققه على مستويات تنموية شملت الفنون والحياة الاجتماعية والاقتصادية. الأعمال الأدبية التي صدرت في تلك الفترة كانت مرايا لما كان يحدث بقدر ما كانت محاولات متواصلة لاختراق القيود الصماء التي أقامها جهاديون وبعض المنتمين لهيئة الأمر بالمعروف، أو من قدموا أنفسهم إلى المجتمع على أنهم حماة للفضيلة. في روايات لكتاب مثل تركي الحمد وبدرية البشر ويوسف المحيميد، وقصائد لشعراء مثل فوزية أبو خالد ومحمد الثبيتي وعبد الله الصيخان، ومقالات وروايات لكتاب مثل عبد الله بن بخيت، وقصص قصيرة لمحمد علي علوان وصالح الأشقر، وأعمال لغازي القصيبي، من بينها ردوده على خطاب التشدد الديني ومساجلاته معهم، في كل ذلك وغيره كثير قلق وغضب ومحاولات متصلة لاستعادة صوت الاعتدال والانفتاح النسبي، بغية اختراق القيود التي لم تفرضها الدولة بقدر ما أقامتها تلك الجماعات المتطرفة على اختلاف توجهاتها.
ذلك الخطاب المناهض للتشدد لم يكن بطبيعة الحال هو كل ما هنالك، فقد أنتج كثيراً مما ليس له صلة بالتشدد الديني، فما أنتجه من أساليب لمواجهة ذلك الخطاب وفي مسعى لمناهضته وتجاوزه، تحول إلى سمة لأعمال أدبية كثيرة حتى صار جزءاً أساسياً لفهم المشهد الثقافي والإبداعي السعودي. بمعنى أننا لكي نعرف الأعمال الأدبية من سرد وشعر علينا أن نتذكر أنها كتبت وفي خلفيتها رفض ضمني لما انتشر من تطرف ديني. والسؤال الآن: بانحسار ذلك التطرف، إلى أين سيتجه أولئك الذين تشكل خطابهم الإبداعي على مناهضة تلك التوجهات الجهادية والوعظية المتطرفة؟
لن تكون المشكلة بطبيعة الحال نضوب القدرات الإبداعية، وإنما ستكون نضوب مفردات التعبير الشعري واستراتيجيات السرد والبلاغة التي تشكلت ضمن تلك المواجهات. أي أن تلك المفردات والاستراتيجيات قد تصاب بما سمّته سلمى الخضراء الجيوسي «الإرهاق الجمالي»، أي افتقارها للقيمة الإبداعية. وفي تقديري أن من بين سمات الخطاب الذي تشكل من تلك المفردات والسمات سمة الغموض أو الرموز الشعرية المتخفية، لا لأسباب فنية فحسب وإنما أيضاً للالتفاف على خطاب التطرف. من أمثلة ذلك قول الشاعر عبد الله الصيخان مخاطباً الوطن:
وأنت البسيط
البسيط، فقل للعصافير
إن الفضاء مديح اتساع لعينيك كي لا تطير
فإن العصافير خائفة،
فكن وطني ممعناً في الهدوء
لكي تعتلي ذروتك.
أو في قول محمد الثبيتي:
«صب لنا وطناً في الكؤوس
يدير الرؤوس»،
أو قوله في موضع آخر:
فارتبت في الأوطان
«لا تحمي العليل من الردى»
وارتبت في الشطآن
«لا تروي الغليل من الصدى»
فذهبت في بحر الجنون عميقا.
إنه النداء لوطن أحس أولئك بأنه مختطف وغريب. ذلك الاختطاف هو الذي جعل محمد العلي -أحد رواد الحداثة الشعرية- يقول: «لا ماء في الماء»، أي لا وطن في الوطن. لكن وقع الاختطاف كان أشد ما يكون على المرأة. وقد وجدت الشاعرة فوزية أبو خالد اختصاراً مجازياً له في عنوان ديوانها «إلى متى يختطفونك ليلة العرس؟» كما في خطاب الاحتجاج الشعري الفائر في تضاعيف ذلك الديوان.
في مجاميع شعرية صدرت بعد الألف الثانية، استطاع الخطاب الشعري لدى فوزية أبو خالد نفسها ولدى غيرها مثل علي الدميني ومحمد الدميني وأشجان الهندي وأحمد الملا، وشعراء تلك الألفية مثل محمد إبراهيم يعقوب وعبد اللطيف بن يوسف وهيفاء الجبري وعبد الوهاب أبو زيد وغيرهم، أن يفتحوا أفقاً لشعرية أكثر رحابة في انفتاحها على الإنساني والعاطفي، مثلما حدث لدى روائيين مثل أميمة الخميس ومحمد حسن علوان وعبده خال وآخرين. لكن ذلك الانفتاح على المختلف من الهموم والانشغالات لم يشمل الجميع أو الأكثرية بعد. وحين يحدث ذلك فسيصل المنتج الأدبي إلى فضاءات مغايرة؛ لكنها لن تخلو من تحديات أخرى وهموم مرحلة مختلفة. ذلك أن خفوت حس التطرف وسطوته لا يعني الوصول إلى «يوتوبيا» موعودة، بل إن لهذه المرحلة مشكلاتها أو تحدياتها التي نرى كثيراً منها حولنا. وفي طليعتها التشظي الاجتماعي أو تراخي العلاقات الأسرية، وطغيان الفردية والعلاقات السائلة. كما أن منها تراجع الهوية الثقافية تحت ضغوط العولمة؛ سواء تمثل ذلك في طغيان الإنجليزية في التواصل اليومي، أو تبني عادات وأنماط سلوكية ومظهرية غربية. ولنتذكر هنا أن الحداثة الأدبية التي انتشرت في الثمانينات لم تنحصر في مواجهة التزمت الديني، وإنما تضمنت أيضاً مواجهة لبعض النتائج السلبية للحداثة نفسها، بطغيان المدن التي «بلا قلب»، بتعبير أحمد عبد المعطي حجازي. تلك المدن هي عنوان المرحلة اليوم بإيجابياتها وسلبياتها، وليس أكثر من الأدب وعياً بتلك المتغيرات وتفاعلاً معها. السؤال هو: أي لغة سيطورها الأدب لمواجهة تلك المتغيرات؟ وأي موقف سيتخذ؟
إن الأدب الجاد ليس ناتجاً للبهجة ولا لليأس، وإنما هو ناتج للتفاعل الشفاف والمعمق، أي المركّب، مع ما يحدث داخل الإنسان وخارجه، ولعل عبارة للشاعر الآيرلندي ييتس تختصر بعض ذلك، حين قال: «من خصومتنا مع الآخرين تنتج البلاغة، ومن خصومتنا مع أنفسنا ينتج الشعر».
الأدب السعودي أمام متغيرات المرحلة
في مجاميع صدرت بعد الألف الثانية انفتح أفق لشعرية أكثر رحابة


الأدب السعودي أمام متغيرات المرحلة

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة