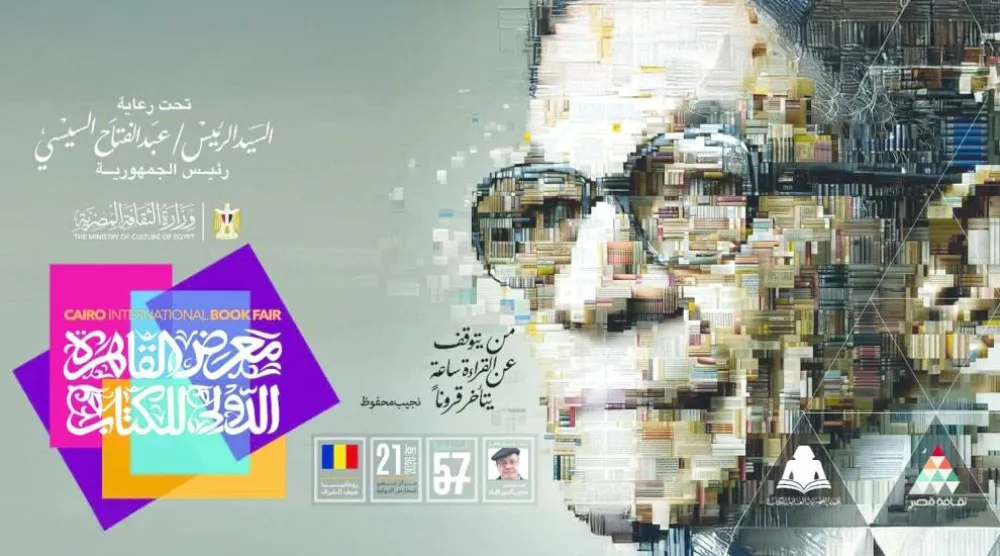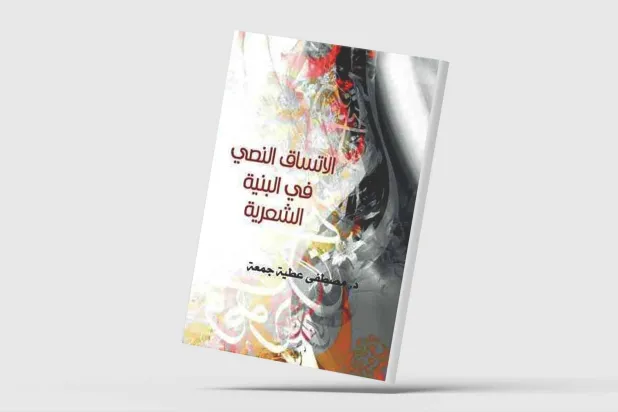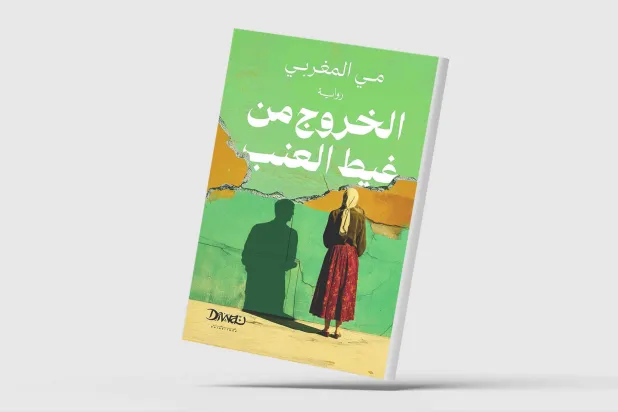ودّع المستعرب الإسباني بيدرو مارتينيز مونتابيث، عاشق اللغة العربية، الذي شغف بالعرب ولغتهم وتاريخهم منذ صباه، في صبيحة يوم 14 فبراير الحالي، عالمنا عن عمر 89 عاماً.
اختفى ذلك الصوت الذي كان يدافع بحماس عن إبراز «أهمية الأندلس ورمزه» بوصفه كياناً فريداً من نوعه في الفضاء العربي والإسلامي، كما يقول، واكتشف آفاقاً أخرى كانت خافية على العرب أنفسهم: فردوس الأندلس.
حفر بعيداً في دراساته الاستشراقية، من دون أن يقع في القوالب النمطية السائدة، بل على العكس من ذلك قدَّم نموذجاً لفهم العالم العربي والإسلامي، وأزال الغشاوة عن عيون الغرب في رؤية تراثنا من خلال اكتشافه الثروة الهائلة الكامنة في الحب لكل ما هو أسباني وعربي مشترك، وكان يفضّل الحديث باللغة العربية التي تعلّمها في تطوان والقاهرة وبغداد؛ لأنه «عشق سحر كلماتها ونكهة حروفها». ترك المستعرب الراحل وراءه إرثاً كبيراً ليس من الكتب والمراجع، بل من البصمة الإنسانية التي غلفت حروفه، وجِدّيته في فهم العرب ومعارفهم.
ولكل هذا، كان لرحيله صدى كبير، وخصوصاً في الأوساط الجامعية التي احتفت ببحوثه وأعماله، فقد جاء النعي الأول من جامعة مدريد المستقلّة التي عمل فيها لسنوات، وكذلك من جامعة جيان الإسبانية التي قلّدته الدكتوراه الفخرية في 2003، بناء على اقتراح من قسم اللغات والثقافات المتوسطية؛ تقديراً لعمله الأكاديمي.
تتراوح جهوده بين ترجمة الشعر العربي ودراسته والتعريف به على نطاق البلدان الناطقة باللغة الإسبانية، والتعمّق في دراسة علاقة العرب بالبحر الأبيض المتوسط، ومعاني الأندلس ورموزها، وشعر المقاومة الفلسطينية، كما عرَّف بكبار الكُتّاب والشعراء العرب، ونقل آثارهم إلى اللغة الإسبانية؛ من أمثال نجيب محفوظ، ونزار قباني، ومحمود درويش، وفدوى طوقان، وسعدي يوسف، وصلاح عبد الصبور، وجبران، والسيّاب، والبياتي، وأدونيس، وغيرهم، وشارك في عدد من اللجان العلمية والثقافية العربية وجمعية الصداقة العربية الإسبانية، وحلقات الحوار بين الثقافتين. وبإيجاز، قدَّم خريطة الأدب العربي في اللغة الإسبانية.
في مقابل ذلك انهالت عليه التكريمات والجوائز الأدبية من الجامعات والأكاديميات من أنحاء العالم، نذكر منها جامعة المعتمد بن عباد في أصيلة، وجامعة جيان، وجامعة مدريد المستقلة، ومن الجوائز: جائزة القدس، وجائزة الشيخ زايد شخصية العام الثقافية، والميدالية الذهبية للأندلس، وغيرها الكثير.
التقيتُ المستعربَ الإسباني الراحل مونتابيث مرتين؛ أولاهما في أصيلة في 1985 أو 1986 ضمن مهرجانها، وفي أبوظبي في 2009 أثناء منحه جائزة الشيخ زايد لشخصية العام.
في اللقاء الأول رافقته إلى زيارة طنجة، التي اعتبرها المنفى الذهبي لعدد من الكتّاب والفنانين، إذ تحدَّثنا عن بول باولز وزوجته جين، وهنري ماتيس، ويوجين ديلاكروا، وبوريس جيسان، ورولان بارت، وجان جينيه، وتينسي وليامز، ومحمد شكري، ومحمد مرابط، الذين تركوا بصماتهم على هذه المدينة وتاريخها. جلسنا في فندق «المنزة» المطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وتذكّر بحنين الماضي العربي الغابر في قرطبة وغرناطة وأشبيليه... أيْ روح الأندلس، إذ ظلت عبارته عالقة في ذهني: «إنني أفضِّل أندلس الحوار على أندلس الحنين»ـ فقد وُلد المستعرب الراحل بالأندلس في قرية صغيرة اسمها شودر، وهو يدرك جيداً أن «كل إنسان يولَد في الأندلس يحمل في أعماقه بذور الحضارة العربية...».
تكمن أهمية ما قام به في التعريف بالأدب العربي وترجمته؛ ليس من الناحية التسجيلية فحسب، بل الجمالية باعتبارها تجربة شخصية وجماعية.
من المعروف أن الأدب العربي المعاصر في الخمسينيات والستينيات كان مجهولاً لدى الغرب، من كان يكتب عن الأدب العربي أو العالم العربي آنذاك قلة قليلة. وفاجأني بقوله: «تصوَّرْ أن القراء الإسبان عندما قرأوا رواية الياطر لحنا مينا، دهشوا لوجود بحر في العالم العربي؛ لأن العرب في أذهانهم هم سكان الصحراء وأصحاب الجِمال». وأضاف: «لماذا؟ لأن الإنسان الغربي يجمع بين كلمة العرب والصحراء بكل سهولة. لو سألت، على سبيل المثال، طالباً جامعياً في إسبانيا عن ذكر أسماء المدن التي تطل على البحر المتوسط، فإنه لا يذكر أبداً اسم أية مدينة عربية؛ لأنهم يذكرون مدن الشمال وليس الجنوب».
المستعرب الراحل، من خلال ترجماته الجادة، غيّر هذه الصورة النمطية وغيرها من الصور التي اعتادها الغرب، لكن هذا التغيير جاء بطيئاً. والأسباب معروفة؛ «لأن ما يمثل العرب في أذهانهم هو البترول والإرهاب؛ وذلك بسبب وسائل الإعلام الغربية التي تعمل على تشويه هذه الصورة».
لكن المستعرب الراحل تساءل عن الجوهري في هذا الأمر؛ وهو: «كيف يكافح العرب هذا النفوذ الإعلامي الخاطئ... ولا يوجد حل سحري آخر سوى ترجمة الأدب العربي إلى اللغات الأجنبية، كردّ حاسم على ذلك. ما ينقله الغرب أحياناً هو ما ينقله العالم العربي؛ ذلك لأن معظم الصور العالقة في الذهن الغربي شكلية ولا تمثل حقيقة الحياة اليومية، ولا الروح النابضة في أعماق هذه الشعوب. لهذا قلت في نفسي إنه من واجبي أن أقوم بتعريف العالم العربي للقراء الغربيين، لذا تركت الدراسات التاريخية والعصور الوسطى، ودخلت الحاضر؛ أي ترجمة الأدب العربي المعاصر».
سألته عن أبرز شاعر عربي عرفه وأحبَّ ترجمته إلى الإسبانية، أجابني: «أجيبك، بلا تردد: بدر شاكر السيّاب أعظم شاعر ترجمته إلى الإسبانية، رغم صعوبة شعره؛ لأنه يتميز بالتكثيف. أما ترجمة الشعراء الآخرين: عبد الوهاب البياتي، ومحمود درويش، ونزار قباني، وغيرهم، فلا تصعب ترجمتهم. هنا لا أتكلم عن القيمة الشعرية لأولئك الشعراء، بل عن ترجمة نصوصهم وما يواجهني فيها من صعوبات».
أتذكّر كتابه القيم «الأدب العراقي المعاصر»، الذي صدر في مدريد وطُبع مرتين، وهو كتاب ضخم، في ستمائة صفحة، يتضمن إنتاج الأدباء العراقيين منذ مطلع القرن العشرين حتى الآن، لكنني اندهشت، وفرحت، في آن واحد، حين عثرت على اسم الكاتب علي الوردي الذي صنّفه مونتابيث بوصفه واحداً من أهم الأدباء العراقيين.
عاش المستعرب الراحل مونتابيث ليس مع اللغة، بل مع الواقع العربي منذ الخمسينيات والستينيات إلى آخِر لحظات حياته. عاش في تطوان لعامين، والقاهرة لست سنوات في المركز الثقافي الإسباني ودرس العربية وكتب أطروحته «عن العصر المملوكي». وهكذا توالت كتبه المهمة؛ مثل كتابه «الموضوعات الأندلسية في الأدب العربي المعاصر»؛ أي لجوء الشعراء العرب إلى المدن الأندلسية وتناول آثارها واستخدام رموزها.
يقول المستعرب الراحل: «أخبرني الطاهر بن جلون، ذات مرة، أنه كتب عن غرناطة، وتحدَّث عن الصراعات الداخلية التي وقعت في الأندلس، وقارن بين ما وقع في فترة ملوك الطوائف، وما يقع حالياً في العالم العربي! وكأن الصورة نفسها تتكرر».
لم ينقطع المستعرب الراحل عن دراسة العالم العربي وأدبه، وهو القائل: «في الغرب، لا تزال فكرة التفوق الأخلاقي على العالم العربي هي السائدة». وظلّ إلى آخِر ساعاته يكافح ضد هذه الفكرة وتداعياتها من خلال حسه النقدي الملتزم بالموضوعية، كما لم يتوقف عن إقامة الحلقات والدراسات، مؤسساً «دائرة الثقافات العربية الإسبانية» في 2016 التي يَعتبر فيها نفسه عضواً فحرياً.
إنه آخِر المستعربين الإسبان العظام ممن يمتلك سلطة نقدية وأدبية لا جدال فيها بين المتخصصين، تميَّز بمسيرته العلمية، وبريادته في ترجمة الشعر العربي الحديث، إذ فتح عيون الغرب على الواقع المعاصر لعالم عربي معقد وحيوي، وقدم تحليلاته العميقة، لا كمستشرق، بل كمستعرب، كما كان يحلو له أن يطلق على نفسه؛ لأنه أراد أن يعيش الحاضر.
اختار دراسة اللغة العربية تحت تأثير معلمه الأول اللامع دون إميليو غارسيا غوميز، إذ اكتشف أنه ليس على دراية بهذا العالم عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وانجذب إلى عشق هذه اللغة؛ لأنها «غنية بالمفردات والتعبيرات، في جمالياتها المتعددة».
ثم بدأ منذ ذلك الوقت ينكبّ على الدراسات العربية، فدرس الأدب الكلاسيكي وتاريخ الأندلس «لوضعها في قلب العالم المعاصر». وكان الجوهري في ذلك هو فتح عالم الدراسات على مصراعيه في الجامعات الإسبانية.
يعتقد مونتابيث أن الترجمة بين اللغتين العربية والإسبانية غائبة رغم اتساعها إلى بلدان أميركا اللاتينية، وفي نظره كان الشعر الأندلسي مرفوضاً لسنوات طويلة، والآن نجد شعراء مثل ابن زيدون والمعتمد بن عباد، أو الشعر الشعبي الأندلسي أو ما يسمى الزجل والموشحات مثلاً، قد أعيد له الاعتبار مؤخراً. وكل ذلك بفضل الترجمة.
لم ينس مونتابيث شعراء المهجر الشمالي؛ لأن أول كتاب نُشر له في عام 1956 كان عن جبران خليل جبران، وإيليا «أبو ماضي»، وميخائيل نعيمة، وغيرهم، كما حاول أن يرصد «الإنتاج الأدبي والفكري لدى الكتّاب العرب في المهجر الجنوبي» في بلدان أميركا اللاتينية كالمكسيك والأرجنتين وكوبا. وفي عام 1968 أصدر كتاباً عن شعراء المقاومة الفلسطينية، وهو أول كتاب يصدر باللغات الأوروبية، ولا يمكن إهمال كتابه المتميز «خمسة عشر قرنًا من الشعر العربي» الذي يتضمن ترجمة للمختارات الشعرية يتعرف فيه قارئ اللغة الإسبانية على بانوراما للشعر العربي في شموليته، كما ترجم قصص نجيب محفوظ، والشاروني، ويوسف إدريس، وتوفيق الحكيم من أجل وضع الشعر مقابل النثر.
في عام 2009 التقينا ثانية عندما فاز بجائزة الشيخ زايد، وتُوّج بلقب «شخصية العام الثقافية»؛ «تكريماً لدوره الرائد في بناء جسور التواصل بين الثقافتين العربية والإسبانية».
لقد منح المستعرب الراحل الاستعراب الإسباني الأهمية نفسها التي يتمتع بها الاستعراب الفرنسي أو الإنجليزي أو غيرهما.
بيدرو مارتينيز مونتابيث... غيّر الصورة النمطية عن العرب في الغرب
رحيل «المستعرب» الإسباني عاشق اللغة العربية

بيدرو مارتينيز مونتابيث

بيدرو مارتينيز مونتابيث... غيّر الصورة النمطية عن العرب في الغرب

بيدرو مارتينيز مونتابيث
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة