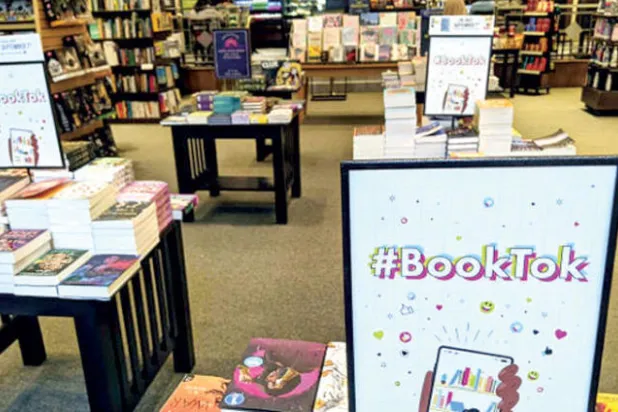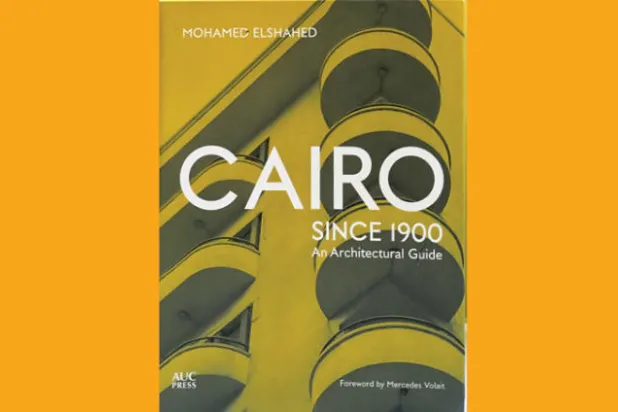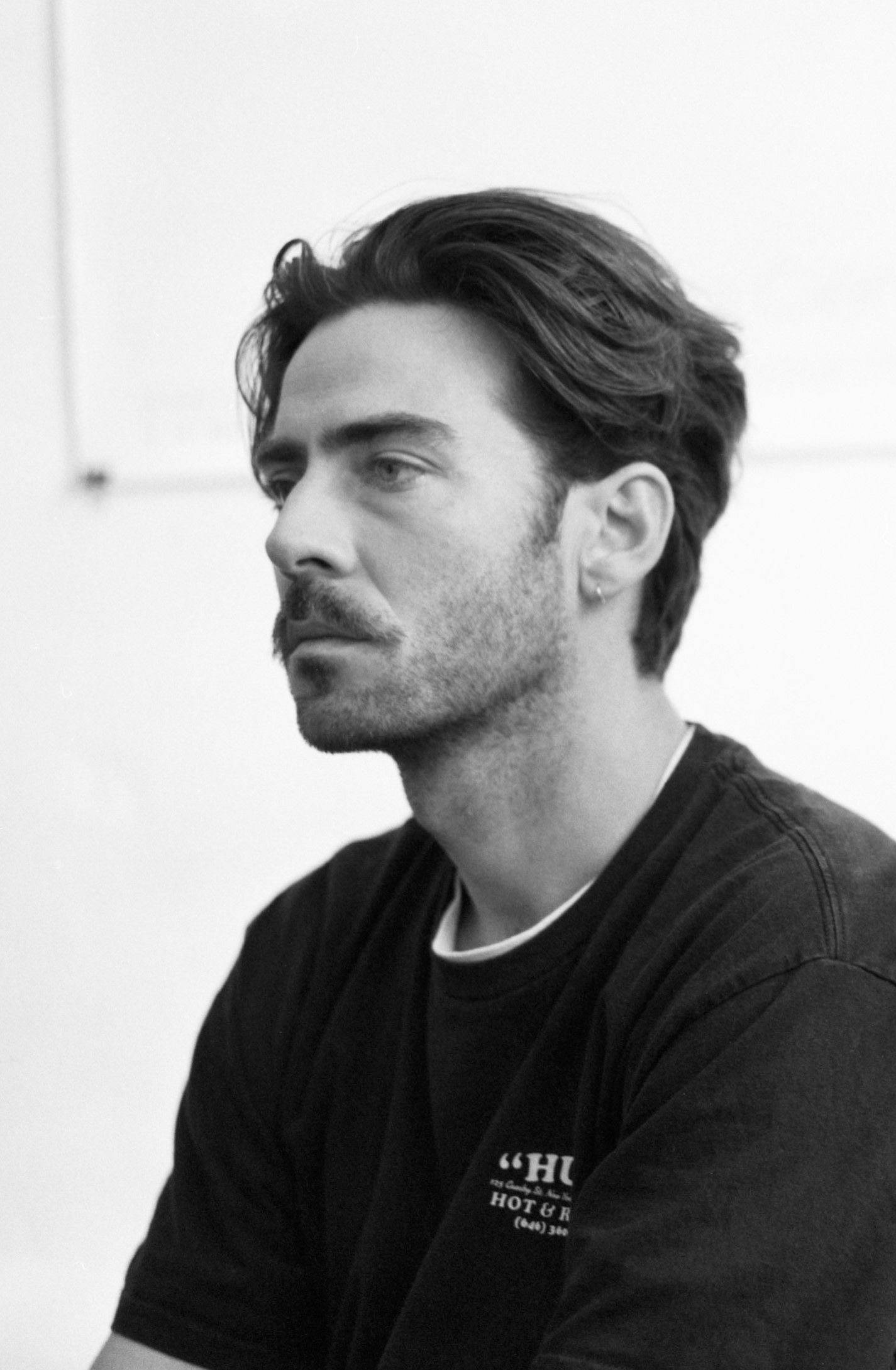ثمّة أسباب كثيرة تدفع القارئ العاديّ للابتعاد عن قراءة أعمال الفيلسوف الألمانيّ الشهير فريدريك نيتشه (1844-1900)، لا سيّما في الجزء الأنجلوساكسونيّ من العالم حيث تأخرت ترجمة أعماله إلى الإنجليزيّة لعقود مديدة بعد غيابه.
فالرّجل كان مفتقداً بشّدة لفضيلة التواضع، وتتسم نصوصه (التي وضعها بالألمانيّة) بكثير من التعقيد اللغوي والفكريّ على نحو يجعل من عبورها رحلة ليست بالهيّنة حتى على الألمان أنفسهم، وتناقضت مواقفه من الفلاسفة والمفكرين الذين سبقوه بين التمجيد النهائيّ إلى اللّعن والتشنيع، وانتقد الألمان واليهود وتولى جلد الضعفاء والمساكين، واختط لنفسه نمط كتابة يعتمد على الشّذرات القصيرة بحيث خرجت أعماله من نطاق النصوص الأكاديميّة المُحكمة والموثقة دون أن تدخل في إطار الثقافة الشعبيّة لأنها لا تقرأ على غرار النصوص المتتابعة كالروايات مثلاً. وحتى قبل سقوطه التدريجيّ المحزن في قبضة الجنون العصابيّ، تبنى مواقف تبشّر بنوع أعلى من البشر، ورفض إدراج مفاهيم قريبة من الوجدان المسيحيّ الغربيّ كالرحمة ونكران الذات في مصادر الأخلاقيّات ما سهّل دمج أفكاره بشكل أو آخر في سياق الأيديولوجيّة النازيّة - رغم أنّه بالطبع لم يكن نازيّاً وكره المتعصبين -، لدرجة أن الفوهرر النازي أدولف هتلر حضر بنفسه جنازة شقيقة نيتشه عند وفاتها عام 1935.

ولذلك فإن الدّعوة للاستفادة من أفكار نيتشه للقرن الحادي والعشرين تبدو مسألة مثيرة للاستغراب إن لم يكن الاستهجان – أقلّه في خارج دوائر تدريس الفلسفة في الجامعات الألمانيّة -. لكن نيت أندرسون، المتخصص بالتكنولوجيات الحديثة، يزعم في كتابه الجديد «عند الطوارئ، اكسر الزّجاج: ما يمكن أن يعلمنا إياه نيتشه عن الحياة السعيدة في عالم غارق بالتكنولوجيا»*، أن هنالك الكثير لنتعلمه في وقتنا الرّاهن من هذا الرّجل العبقري المثير للجدّل، وأن بعضاً من نصائحه ذات صلة لعالمنا الغارق في لجة التغوّل التكنولوجيّ على حياة الأفراد.
أول دروس كتاب أندرسون قد يكون أن كل مفكّر بارز لديه ما يعلمنا، حتى لو كنّا نختلف معه على العموم، وأن التفاعل النقدي مع نصوص المؤلفين دون اتباع كل ما يقولونه يتطلب مهارة ثمينة تقود لا محالة إلى النضج الفكري. وهو يدعونا إلى احتضان نيتشه ليس بالضرورة كمعلّم ومرشد، بل كشريك حوار ومحرّض على النظر نقدياً في المسلمات أيّا كان مصدرها، بما فيها أفكار نيتشه ذاتها، وهو أمر يقول المؤلّف أن الفيلسوف الكئيب كان ليثمنه عالياً.
ينطلق أندرسون في مقاربته نيتشه للقرن الحادي والعشرين من فكرة مركزيّة في فلسفته بأنّ الدّعة والراحة والمتعة والأمان هي طرق ضعيفة وسهلة للحياة، تُفقد الإنسان، في غياب أهداف وغايات أكثر طموحاً، فرص تجربة الفرح الحقيقيّ الذي يأتي من الكفاح الإبداعي في خضمّ السّعي لتحقيق تطلعات أعلى والسمو بمجمل التجربة البشريّة.

وبالطبع فإن الصراع الإبداعيّ هذا ليس مجانيّاً، ويأتي غالباً بالترافق مع الألم والتعب، كما أنّه يتطلّب وقتاً وجهداً وتوجهاً لتبني أفكار قويّة من خلال القراءة والمشاهدة والاستماع للمفكرين والفنانين والأصدقاء الذين لديهم شيء ذي قيمة ومعنى ليقولوه، إلا أن نيتشه يدعونا إلى احتضان ذلك كجزء لا يتجزّأ من تجربة العيش، بدلاً من السعي لتجنّبها.
من هذا الجانب الأكثر إيجابية من فلسفة نيتشه، يقدّم أندرسون محاولة معاصرة تستحق الثناء لتطبيق النظريّ على واقع عالمنا المتشبع بالتكنولوجيات الحديثة، والتي مع إيجابياتها العديدة تتضمن أيضاً نوعاً من سهولة تسحق الأرواح تماماً وفق الصيغة التي حذرنا منها فيلسوفنا العتيد. فمع نموذج الارتباط الدائم بالإنترنت، تشجع التكنولوجيا الرقميّة الجديدة ترفيهاً رخيصاً مستمراً، وتدفع إلى الانفصال عن أجسادنا وعالمنا الماديّ وواقعنا الفعليّ إلى عوالم افتراضيّة، وتنتصر للتحفيز العقلي على النشاط البدني، وتمنح من خلال التحكم الرقمي الكامل القدرة اللحظيّة للوصول إلى كم معلومات غير محدود.
وتطرح كلّ من هذي الجوانب المرتبطة بتبني التكنولوجيّات الحديثة مشاكلها الخاصة. فمثلاً فيما يتعلق بالوصول اللامحدود إلى المعلومات فإن مفكرين قدماء مثل سينيكا اشتكوا من وجود الكثير من الكتب للقراءة، واقترحوا طرقاً لضمان قضاء المرء وقته المحدود في رفقة عدد أقلّ من أفضل الكتب والمؤلفين الممكنين، ولدينا اليوم، بفضل تطبيقات مجانيّة متوفرة بكثافة على كل شاشاتنا الإلكترونيّة، ربط شبه فوري مع كتلة لا نهائيّة من تراكم الإنتاج الأدبي والفني البشري، بالإضافة إلى دفق مستمر من الأخبار ومقاطع الفيديو والتعليقات. ومع ذلك، يقول أندرسون إن أغلبنا لا يصبح باحثاً متعمقاً - فنحن ندع الأعمال الخالدة لشكسبير لمشاهدة الحلقة الأحدث من برامج تلفزيون الواقع الشعبويّة التافهة، وتضعنا كثرة المعلومات تحت ضغط الشعور بالحاجة إلى مواكبة كل الأشياء والاطلاع المحدّث لحظيّاً عليها، ما يمنع التعمّق في أي موضوع أو التخصص في مجال واحد، ناهيك عن أننا عندما نعتاد على مجرد تكرار وجهات نظر الآخرين والتفاعل معها، فإننا توازياً نخنق أصواتنا الذاتيّة وإمكاناتنا الإبداعية ودربتنا على التفكير المستقلّ.
منهج نيتشه لمواجهة هذه الأحمال الزائدة هو في التخلي عن حياة السهولة والتحفيز اللحظيّ المفرط، وأن يكون المرء انتقائياً فيما يختار قراءته والاطلاع عليه - نيتشه قال بأنّه يكتفي بالقراءة لثمانية مؤلفين -، وتجنّب الأمور التي لا تخلق تأثيراً إيجابياً في حياته، وتقبّل تحديات إبداعية تتطلب النّضال والتخلّي عن الراحة في السّعي لتحقيق تجارب عيش أعمق.
لكن لا شك أن هذه التّوجيهات قد تكون على نحو ما غير عمليّة عند محاولة تطبيقها على ما يتعلّق بعاداتنا التكنولوجية الحديثة، إذ سيجد كثيرون صعوبة في التزام حياة ترتكز إلى النضال المستمر وتذوّق المتع البسيطة، وقضاء وقت مكثّف مع العائلة والأصدقاء، وتجنّب المتعة اللحظيّة للأخبار والتحديثات، والاكتفاء بالقراءة البطيئة - وإعادة القراءة - لعدد محدود من المؤلفين. بل إن البعض قد يجادل مثلاً بأنّ الوصول إلى اختيار «المؤلفين الثمانية» يحتاج أصلاً إلى قراءة عشوائيّة واسعة بداية – ولا بدّ أن نيتشه نفسه قرأ لكثيرين قبل أن يستقر على كل من أبيقور، مونتين، غوته، سبينوزا، أفلاطون، روسو، باسكال، شوبنهاور -، لكن المغزى المقصود من وراء قراءة أندرسون لنيتشه هو تبني الانتقائيّة في التعامل مع ما تقدمه لنا التكنولوجيّات، وهذا يعني بالضرورة التخلّي عن التسرّع والاستجابات اللحظيّة وشراهة الاستعراض الشامل لمصلحة التمهّل والتنحي والاختيار والقراءة المتأنيّة العميقة بالعيون واليدين معاً.
كتب آرثر شوبنهاور، الذي كرس نيتشه لقراءته كثيراً من الوقت لا سيّما في شبابه، يوماً في مديح «فن عدم القراءة»، ووجهة نظره أن معظم الكتب الشعبية كانت متخمة بالهُراء، وأن «من يكتب للحمقى يجد دائما جمهوراً كبيراً»، وبما أنّ الحياة قصيرة، فلا بدّ من تجنّب ذلك المحتوى الرديء والاكتفاء بقراءة الكتب الجيّدة. ويبني نيتشه على نظريّة «عدم القراءة» الشوبنهاوريّة تلك، ويحولها إلى مبدأ جذريّ بالانتقائيّة والحرص على تجنّب العشوائيّة والتشعب في كل شيء، لا بشأن الكتب وحدها، بل وحتى البشر الذين ننعم برفقتهم، والأماكن التي نقضي الوقت فيها، حيث كل قبول هو فعل ثقة وتكريم وخيار أخلاقيّ معاً. فإذا كنا سنضع أنفسنا في أيدي كاتب أو روائيّ أو مخرج سينما أو حتى شريك محادثة شخصيّة، وسنمنح هذا الشخص اهتمامنا الكامل لبعض الوقت، ولأننا في النهاية نتشكل من خلال ما نستهلكه خلال أعمارنا القصيرة، فلنستهدف أن تكون التجربة جديرة بالاهتمام من جانب الذائقة الفنيّة والحس القيمي معاً.
يصبح نظام الانتقائيّة النيتشويّ هذا ضرباً من ضروب المقاومة ضدّ نظام تكنولوجي غير إنساني، وسلوكاً ذا بعد سياسيّ وأخلاقيّ في مواجهة تغوّل عمالقة التكنولوجيا على حياة الأفراد. «هناك الكثير الذي لا أريد أن أعرفه» يقول نيتشه، «فالحكمة تضع حدوداً، حتى للمعرفة». كم نحن بحاجة لمثل تلك الشجاعة في مواجهة العالم الجديد.
* Nate Anderson
In Emergency, Break Glass: What Nietzsche Can Teach Us About Joyful Living in a Tech-Saturated World
2022