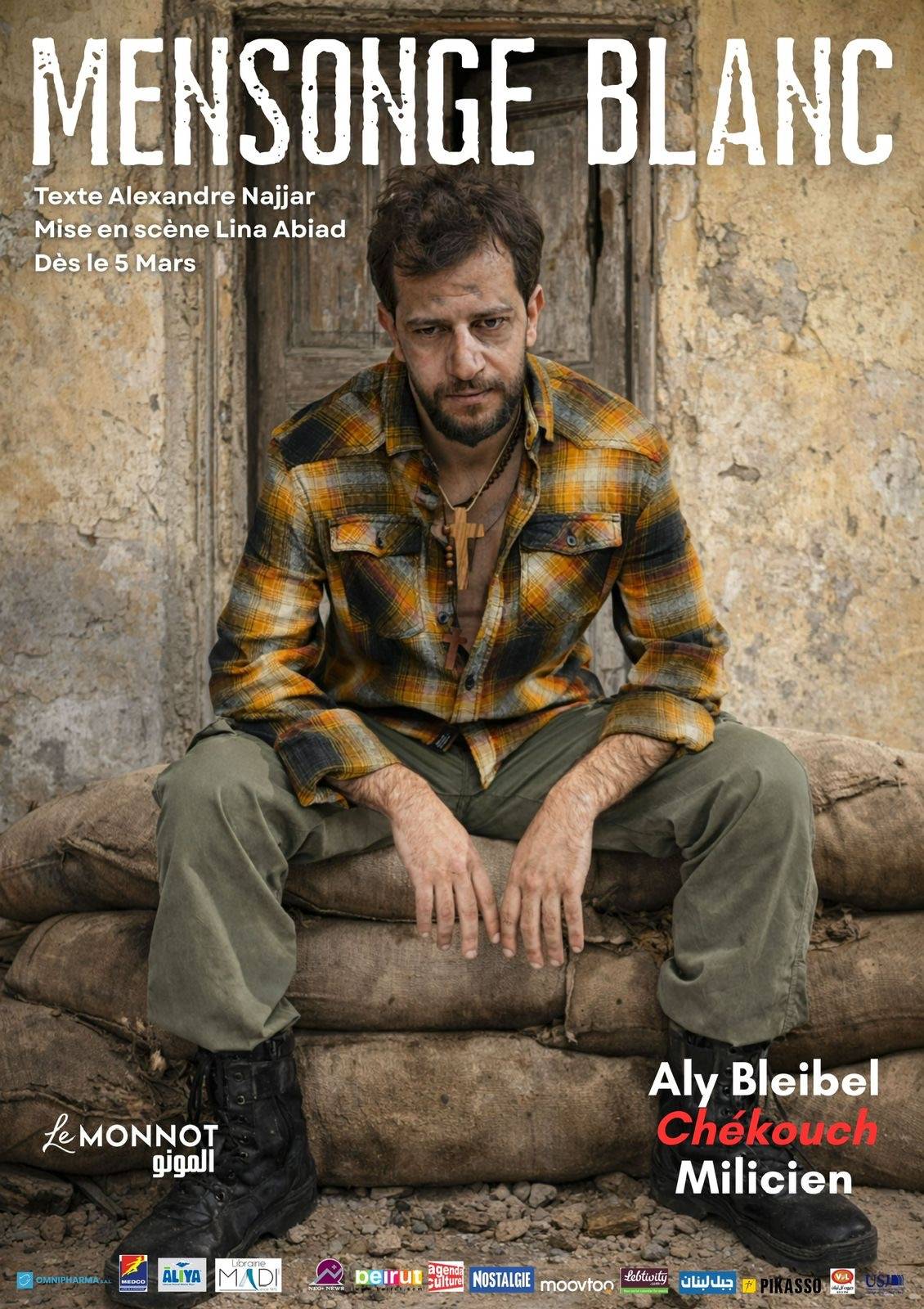عن عمر يناهز ثمانين عاماً، وألق شعري بقي يلازمه وكأن كلماته لا تشيخ ولا تتعب، غادرنا الشاعر محمد علي شمس الدين، فجر أمس الأحد، ملوحاً لأصدقائه من بعيد، أن لا بد من لقاء آخر. وقد نعته ابنته رباب، على صفحتها على «فيسبوك» مؤكدة الخبر، ليعم حزن كبير الأوساط الثقافية العربية. فشمس الدين، كان شاعراً عربياً أولاً، عرفته المنابر والمهرجانات واللقاءات والندوات، ولبنانياً، ابن الجنوب، وحامل همومه وأحزانه وكفاحه الطويل من أجل حياة أفضل.
ولد عام 1942 لأسرة متواضعة في قرية بيت ياحون، في قضاء بنت جبيل، وفيها تعلم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، قبل أن ينتقل إلى بيروت ويكمل دراسته الثانوية، ويحصل بعدها من الجامعة اللبنانية على إجازة في الحقوق، ومن ثم ماجستير ودكتوراه في التاريخ. هذا التاريخ الذي سيبحر فيه منتشياً، وينهل من رموزه في أشعاره الفياضة بالصور واندغامات الروح بالشجر والبحر والريح، وما خبره في حقول الجنوب ومياهه ومناخاته العاشورائية. فمنذ طفولته وهو يتفتح على معان روحانية «في مكان مفتوح للشمس والغبار ومساحات التبغ». الابن البكر لعائلته، هو «ابن المآذن الجنوبية والأجراس والتراب والحجارة والصخور» التي كان يحفظها غيباً، ويعرف أشواكها وتضاريسها. أما جده لأبيه فهو الذي زوده بمفاتيح الصوفية وبعض أسرارها، كما يروي في إحدى مقابلاته: «الشيخ قارئ الأوراد، والمتمتع بصفات بين الدين والسحر. كما قراءاتي لأقطاب الصوفية كابن عربي في (الفتوحات المكية) والحلاج والبسطامي والشبلي وذي النون المصري وجلال الدين الرومي والعطار النيسابوري وحافظ الشيرازي».
محمد علي شمس الدين، كان يعرف أن الشعر صنعة كما هو إحساس عارم ونحت في صخر الكلمات، وأن حمايته من الانزلاق والتزلف تحتاج أن يسيج نفسه بالكفاية المالية، فبقي في وظيفته مفتشاً في الضمان الاجتماعي، حتى خروجه إلى التقاعد. وكان له دوره الفاعل في اتحاد الكتاب اللبنانيين، وحاول تكراراً الدفاع عن آخر سياج لاستقلاله، قبل أن يستسلم لانهياره كما قلة من المثقفين والكتاب معه.
تمنى منذ صغره أن يصبح قائد أوركسترا، ولم يبتعد عن حلمه كثيراً بثلاثة وعشرين كتاباً من الشعر تركها لنا رنانة بالإيقاع والنغم والمعاني ذات الصدى العذب. كتب القصائد الموزونة، كما قصيدة النثر والتفعيلة، فأولويته إيقاعه الخاص، ومعناه الداخلي، فلا شيء عنده يخسره.
«أنا الخاسر الأبدي. فلماذا إذن، أشتري بالمواعيد، هذي الحياة؟ قلت تأتين في الثامنة، وها عقربان، يدوران حولي، ولا يقفان. عقربان يدوران في معصمي، يلدغان دمي، ولا يقفان. كأن لم تكن ثامنة، في الزمان».
منذ ديوانه الأول «قصائد مهربة إلى آسيا» عام 1974 (دار الآداب) لم يخف شغفه الموسيقي في الشعر. «يعتقد كُثُرٌ أنني سميتُ ديواني الأول على اسم ابنتي، والعكس هو الصحيح. فقد سميت ابنتي على اسم الديوان، وسمَيت الديوان على أساسٍ من الإيقاع المُبكر الذي لا أعرف له سبباً في العقل أو المنطق أو الجغرافيا أو علْم الأسماء».
من بعد ديوانه الأول جاءت مجموعات «غيم لأحلام الملك المخلوع» (1977)، و«أناديك يا ملكي وحبيبي» (1979)، و«الشوكة البنفسجية» (1981)، و«طيور إلى الشمس المرة» (1984)، «أما آن للرقص أن ينتهي» (1988)، و«كتاب الطواف» سيرة ذاتية (1987). كما لشمس الدين دراسات عدة، وقراءات لدواوين ونقد. وهو مع نكرانه لقراءاته وتحليله لشعره الخاص، إلا أنه تمتع بوعي كبير في فهم أسلوبه الشعري واللغوي، وكان يوجه الطلاب الذين يأتونه لعمل دراسات على دواوينه، خير توجيه، إن في اختيار الموضوعات، أو في التحليل.
تفتح دواوين محمد علي شمس الدين، تحسب أنه كان يتلف الكثير، ولا يترك سوى ما يجتلب لقارئه أو سامعه المتعة الشعرية الخالصة. لم يتعب «أنا شاعر التجريب بامتياز»، ويقول أيضاً إنه «شاعر الأقنعة» الذي يستعير مرة وجه الحلاج، وأخرى المتنبي، ومرات غيرها سلفادور دالي. لكنك إذا ذهبت في عمق أكبر وجدته شاعراً مشغولاً بالوجود والموت، ومعنى الحياة، واندغام جسده هو بعناصر الكون وذوبانه فيها، وأنسنة الأشياء «كلما جرحت هذه البرتقالة تبتسم». وهذا ربما ما جعله قريباً للأطفال، حيث كتب لهم شعراً صار أغنيات ملحنة.
وربما أن ما لم يغب يوماً عن قصائد شمس الدين، هو الحب الذي جمع 89 من قصائده المختارة حوله في كتاب «للصبابة للبلبل وللملكوت» ليصدر قبل سنة من وفاته.
رحل محمد علي شمس الدين، هو الذي ليس غريباً عن الموت بل صديقاً للألم، كما كتب ذات يوم:
«هذا ألمي
قُرباني لجمالكَ لا تغضبْ!
فأنا لستُ قوياً كيْما تنهرني بالموت!
يكفي أن تُرسلَ في طلبي
نسْمة صيفٍ فأوافيكْ...
وتحرك أوتار الموسيقى
لأموت وأحيا فيكْ!
هذا ألمي!
هذا ألمي!
خففْ من وقعِ جمالِك فوقَ فمي...».