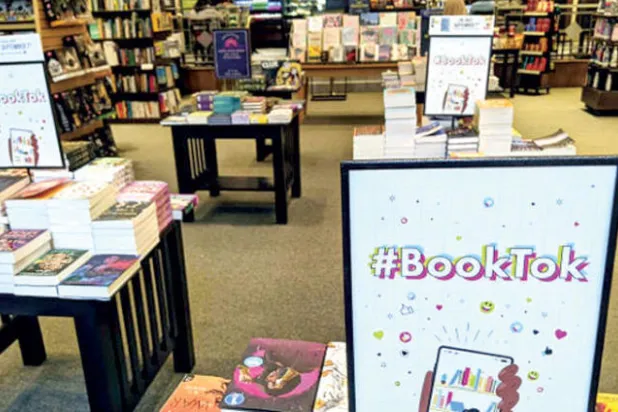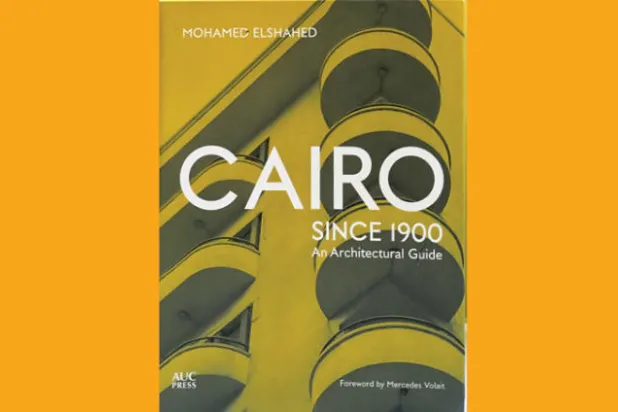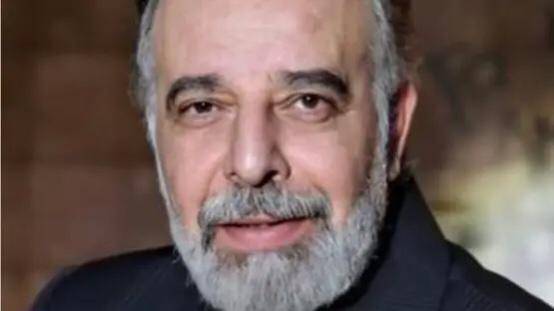تقول أمثولة شائعة إنّ «من يرى ليس كمن يسمع»؛ لذا فإنّ من يتحدّثُ عن العملية الترجمية - بكلّ حيثياتها المشتبكة – من داخل المشغل الترجمي ليس كمن يتحدّثُ حديثاً عاماً من غير مسؤولية أو مرجعيات عمل حاكمة.
الفعالية الترجمية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع اللغة التي نترجم منها (اللغة الأصل) وإليها (اللغة الهدف). اللغة هيكل إطاري يشكّل قاعدة لرؤيتنا المميزة للعالم؛ العربي مثلاً يرى العالم بطريقة تتمايز عن رؤية الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني أو الياباني أو الصيني. اللغة بهذا المفهوم حاملٌ لهذه الرؤية، وكلّ لغة جديدة نتعلّمها هي إعادة تشكيل رؤيتنا للعالم بسبب إعادة تشكيل أدمغتنا على المستوى البيولوجي الدقيق. وفقاً لهذا السياق، ثمة اختلافات أساسية لا يمكن اختزالها بين طرق التعبير عن فكرة واحدة في سياقات لغوية مختلفة؛ وعلى هذا الأساس يجب أن نقبل بوجود اختلافات حتمية بين النصوص المترجمة. لا أحبّ الحديث عن (الخيانة الحتمية في فعل الترجمة)؛ فهو ليس أكثر من تعبير درامي عن حقيقة أساسية، وبخلاف هذا الحديث لا بأس من التأكيد على البديهيات التالية...
- البديهية الأولى؛ الترجمة تفاوض بين لغتين (كما يعبّر أومبرتو إيكو)، تتنازل فيه كلّ لغة عن شيء من كيانها التعبيري.
- البديهية الثانية؛ كلّ إنسان له لغته الوجدانية الخاصة التي لا تشبه أي لغة لشخص سواه.
- البديهية الثالثة؛ الإنسان الذي لا يعرف سوى لغة واحدة يجهل لغته الأم لأنه يفتقد المرجعيات التي يقارن بها، ومن خلالها ثراء السياقات النحوية والدلالية غير التقليدية للغته الأم. هذا ما يراه غوته.
- البديهية الرابعة؛ كل نصّ مترجَم هو نصٌّ موازٍ للنص الأصلي. فكرة المطابقة الترجمية وهمٌ خالص لأسباب جوهرية لا علاقة لها بمدى احترافية المترجم.
- البديهية الخامسة؛ كلّ نصّ مترجَمٍ يحملُ بصمة المؤلف والمترجِم معاً. لا يمكن فكّ الاشتباك بين أي نصّ مترجَمٍ ومترجمه.
لا يمكن الحديث جدياً عن الترجمة في غياب القراءة التأصيلية للفعل الترجمي وارتباطه بالهياكل النحوية syntactic والدلالية semantic للغة. أرى أنّ عالم اللغويات والإنثروبولوجيا الثقافية جورج شتاينر هو أفضل من تناول هذه الموضوعات في كتابه «بعد بابل... جوانب من اللغة والترجمة» After Babel Aspects of Language and Translation المنشور في طبعته الأولى عام 1975 (وهو غيرُ مترجمٍ إلى العربية). أما الجوانب التقنية في الترجمة فيمكن الرجوع فيها لمراجع عدّة، منها كتاب «فن الترجمة» للدكتور محمد عناني، وكتاب «عن الترجمة» للفيلسوف الراحل بول ريكور، وكتابان للدكتور الراحل صفاء خلوصي، أحدهما بعنوان «الترجمة التحليلية»، والآخر عنوانه «الترجمة في ضوء الدراسات المقارنة».
سأتناولُ في الفقرات المحدّدة التالية تفاصيل مقترنة بالعمل الترجمي، أحسبُ أنّ كل مشتغل بالترجمة لا بد اختبرها في عمله؛ لكن لا بأس من الإشارة قبل هذا إلى أنّ الترجمة فعالية عقلية مرتبطة باللغة. لا أريد هنا ترديد العبارة المكرورة من أنّ كلّ مترجم متمكّن من أدواته الترجمية لا بد أن يكون ممسكاً بقياد كلّ من اللغة التي يترجمُ منها واللغة التي يترجمُ إليها. لن ينفع الإمساك بواحدة منهما فحسب. هذه بديهية نتفق عليها، ولا ضرورة لتكرارها.
أتناول قبل كل شيء مسألة الثقة في المادة المترجمة. كيف السبيل إلى ذلك؟ سأقدّمُ جوابيْن لهذا السؤال؛ الأول عام يمكن أن نجد نظيراً له عندما يسأل أحدنا؛ كيف تثق بطبيب أسنانك؟ أو كيف تثق بأستاذك الجامعي؟ أو كيف تثق بأحد الباعة؟ نتداولُ كثيراً مثلاً يقول «التجربة أعظم برهان». جرّب وقدّرْ نتيجة تجربتك. لا أحسبُ أنّ من يغشّ أو يكذب يمكن أن يستمرئ اللعبة إلى مدى لا نهائي. لا بد أن تتكشف لعبته المعيبة في نهاية المطاف. سيقولُ بعضنا إنّ لكلّ مهنة أخلاقياتها وقوانينها الحاكمة؛ لكنّ هذا لا يكفي. الضمير الحي والنزاهة الشخصية خصائص ثمينة وهي الفيصل النهائي في كلّ ممارسة بشرية. على هذا الأساس يمكن أن تقرأ نصوصاً مترجمة جرى تزكيتها من قبل كثرة من القرّاء؛ لكنّ التزكية وحدها لا تكفي، لا بد من معيار شخصي. هنا ننتقلُ إلى الجواب الثاني لسؤال؛ كيف نثق في الترجمة؟ وهذا الجواب ذو معيار إجرائي.
جرّب أن تأخذ نصاً مترجماً وحاول مقارنته مع مرجعه الأصلي، وربما الأفضل (والأكثر سهولة) هو مقارنة مقالة مترجمة لمترجم ما مع نصها الأصلي. قلّب الترجمة من جميع جوانبها ودقّق في السياق الذي اعتمده المترجم وكيفية هيكلته للعبارة المترجمة. ادرُس السياق النحوي والدلالي للعبارة المترجمة ولاحظ مدى تصاديه مع روح العبارة الأصلية.
لا بد أن تبذل جهداً لكي تتأكّد من مصداقية ونزاهة عمل أي مترجم، وإلا فليس من سبيل سوى الثقة المزكّاة من قبل أغلبية القرّاء والمتخصصين. سيكون من قبيل البداهة القول إن هذه المقاربة الإجرائية تتطلب معرفة مقبولة باللغة الأصل التي يترجم منها المترجم الذي يُرادُ التأكّد من دقّة عمله.
تستدعي هذه الرؤية في الترجمة مساءلة واستكشاف بعض الموضوعات المتأصّلة بكلّ مشغل ترجمي حقيقي. هاكُمْ بعضاً من هذه المساءلات والاستكشافات...
* خصوصية الترجمة الأدبية واختلافها عن سائر الترجمات؛ هذه حقيقة مؤكدة ليس هناك من يختلف عليها. الترجمة الأدبية أكثر تعقيداً من الترجمات في سائر الموضوعات الأخرى؛ لذا تتطلبُ جهداً ومصابرة ومكابدة ومقدرة. السبب واضح: الأدب بوصفه اشتغالاً بشرياً أكثر توظيفاً للقيمة الدلالية من القيم الأخرى بالمقارنة مع سائر الموضوعات. من المتوقّع أن تقود هذه الحقيقة إلى تخصّص بعض المترجمين بالترجمات الأدبية دون سواها؛ لكن يجب الإشارة إلى أنّ الإشارة التقنية هنا تعنى بالنصوص الأدبية (الشعر تحديداً، ثم النصوص الأدبية الأخرى) وليس الدراسات الأدبية التي تنتمي لقطاع الأعمال الفكرية والثقافية العامة. ليس كلّ الأدب شكسبير أو جويس أو فوكنر في نهاية المطاف.
* موضوع ضرورة المعايشة الجغرافية؛ هذه أخدوعة يريدُ بعضُ المتكاسلين إشاعتها بقصد كسر شوكة المترجمين الواعدين. حجّة هؤلاء أنّ بعض الأعمال، وخاصة الأدبية، تعتمدُ مفردات لا يدرك دلالاتها المكشوفة والمبطّنة سوى من تمرّس في العيش بالنطاقات الجغرافية التي تسود فيها تلك المفردات. هذا صحيح كمبدأ؛ لكن كم حجمُ الأعمال التي تلعب فيها هذه المفردات الشاذة دوراً مؤثراً؟ ثمّ لماذا نفترضُ أنّ المترجم آلة روبوتية ستعبرُ تلك المفردات من غير دراسة مرجعياتها المحلية، والمراجع في هذا الشأن كثيرة. المترجم النزيه لن يعبر شيئاً ما لم يتأكد من خلفيته الجغرافية والثقافية.
* مسألة الترجمة عن لغة وسيطة؛ الأصل في الترجمة أن تكون عن اللغة الأصلية التي كُتِب بها العمل؛ لكن يمكن في حالات خاصة الاعتماد على لغة وسيطة. لمِ لا؟ ما الضير في ذلك؟ لماذا نخسرُ وقتاً ريثما تنضج الظروف الملائمة لترجمة العمل عن اللغة الأصلية؟
* مسألة التخصص الترجمي؛ يرى البعض أنّ الترجمة الاحترافية يجب أن تكون احتكاراً حصرياً لخريجي أقسام الترجمة. تعلّمْنا من خبرة ممتدّة سابقة أنّ الشغف هو الشرط الأولي المسبّق لكلّ عمل يتطلبُ انغماساً فردياً في تفاصيله الدقيقة؛ فكيف نضمنُ توفّر هذا النوع من الشغف في خريجي أقسام الترجمة. ثم إن واقع الحال ينبئنا أنّ أكابر المترجمين العرب ما كانوا خريجي أقسام ترجمة؛ بل كانوا متخصصي لغة إنجليزية في أفضل الأحوال.
* مسألة التخصص في الحقل المعرفي؛ يفترضُ البعض أنّ كتب الفيزياء لا يجب أن يترجمها سوى فيزيائي، وكذا الكيمياء وعلم الاجتماع والفلسفة... إلخ. هذا خطل كبير، فضلاً عن أنه ينطوي على أخدوعة. ثمة فرقٌ شاسع بين ترجمة عمل في الفيزياء ينتمي لحقل الثقافة الجمعية العامة وعملٍ آخر ينتمي لحقل الكتب المرجعية Textbook في الفيزياء. صار كثير من موضوعات الفيزياء (مثل ميكانيك الكم والنسبية ونظرية كلّ شيء والطاقات المتجددة وتقنية المصغّرات «النانوتكنولوجي») وكذلك موضوعات الذكاء الاصطناعي من الموضوعات اللازمة لكلّ معرفة جمعية عامة، والشغف بتلك الموضوعات هو الذي يحدّدُ مَن المؤهّل أكثر من سواه لينهض بعبء ترجمة تلك الموضوعات. لا يختارُ مترجم الأعمال العلمية الأعمال التي ينوي ترجمتها عبثاً أو بطريقة كيفية؛ بل يختارُ الكتب التي تخاطب العامّة ذوي الحدّ المقبول من الثقافة مع التركيز على تاريخ العلم وفلسفته ومنهجيته.
من المفيد في هذا الشأن الإشارة إلى أسماء معروفة من المترجمين الذين قدّموا ترجمات متعددة في حقول معرفية مختلفة؛ فكانوا بذلك مثالاً ترجمياً مناظراً للمشتغلين في حقول معرفية متداخلة ومشتبكة.
* مسألة العائد المالي من الترجمة؛ لا أحد يعمل في الترجمة انتظاراً لعائد مالي مجزٍ أو شهرة منتظرة. أقولُ هذا عن معرفة دقيقة بواقع الترجمة في منطقتنا العربية. الشغف هو المحرّك الأوّل والأخير لكلّ عمل ترجمي. توجد جوائز مغرية للترجمة، هذا صحيح؛ لكن لا أحد يعمل فقط انتظاراً لتلك الجوائز. نعرفُ كثيرين من أكابر المترجمين العرب عاشوا وغادروا الحياة ولم ينالوا واحدة من تلك الجوائز، لأنها ما كانت موجودة أصلاً.
كيف نثقُ في الترجمة؟
استكشافات ومساءلات من داخل المشغل الترجمي


كيف نثقُ في الترجمة؟

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة