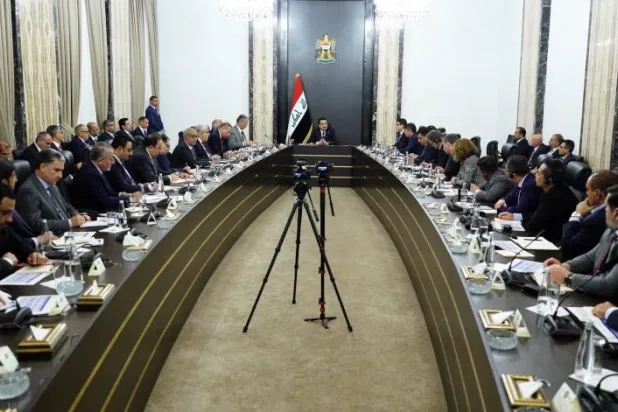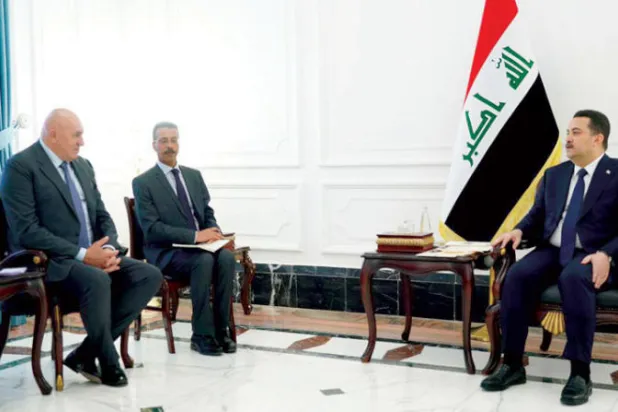بين الحين والآخر يتسيد الوضع المائي أجندة النقاشات على وسائل الإعلام العراقية، ويرتبط ذلك بارتفاع حرارة الطقس وبشدة الندرة المائية في العراق في أوقات الصيف. ولكن من سوء الحظ، فإن النقاشات تخفت مع أول هطول للأمطار أو أي انخفاض ملموس في درجات الحرارة. لذلك، يجري التعاطي الحكومي مع الموضوع لا كمشكلة مستعصية واستراتيجية للبلد، بل كواحدة من المشكلات والتحديات العديدة التي تواجهها البلاد، والتي تشتد ثم تتراجع بعد حين لتبرز محلها مشكلة أخرى ينشغل بها الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. مع ذلك، يبقى الملف المائي العراقي مع دول الجوار ساخناً ومقلقاً وذا طابع حساس على المستوى الشعبي منذ عام 2003.
أما على المستوى الرسمي، فغالباً ما تحصل مناورات وتطمينات وأحياناً إجراءات شكلية تهدف إلى التعايش مع الأزمة، وليس إلى البحث الجاد في معالجتها، ولا في إعادة النظر بالتوجهات العامة في مجال تنمية الثروة المائية، إذ إن المطلوب كأولوية هو إيجاد خيارات أو بدائل مستدامة لموارد المياه التقليدية، أقلها لبعض الأغراض، في مقدمتها سد الحاجة إلى مياه شرب آمنة ومستدامة وقليلة الكلفة.
في الفترة التي سبقت عام 2003، كان «نظام البعث» يحتكر التعبير والتمثيل الرسمي والشعبي، ولم يكن للرأي العام العراقي أي دور خارج الحدود التي ترسمها السلطة حسب أهوائها وتحالفاتها. مع الإشارة إلى أن الدول المشتركة بمياه الرافدين، وبرغم حالات الشد والجذب والخلافات العاصفة أحياناً بينها، قد طورت آليات حكومية لمعالجة العلاقة المائية، مثل اللجان الفنية المشتركة وانتظام اجتماعاتها، التي خَلُصتْ في بعض الأحيان إلى اتفاقات خففت من حدة التوتر، مثلما حصل في النصف الثاني من الثمانينات بشأن إطلاق 500 متر مكعب في الثانية على الحدود التركية - السورية، واقتسام العراق وسوريا لتلك الكمية بنسبة 58 في المائة للعراق، مقابل 42 في المائة لسوريا. وكذلك، فإن الاتفاق الثنائي السوري - العراقي حصل رغم الخلافات المستعصية بين جناحي «البعث» الحاكمين في سوريا والعراق.
لم يجر بعد ذلك التاريخ أي اتفاق يقترب من تلك الترتيبات بين البلدان الثلاثة، ولم تستنسخ، كفكرة على الأقل، لتشمل نهر دجلة أو الروافد الأخرى وفق آلية مشابهة. علينا أن لا نغفل أن الدول الثلاث آنذاك، العراق وسوريا وتركيا، كانت متقاربة في مستويات الاستقرار السياسي والقوة العسكرية وإلى حد ما الاقتصادية. وهذا الأمر مطلب أساسي للاتفاق بشأن كثير من القضايا الشائكة، بضمنها المياه المشتركة. على العكس، عندما يكون طرف ما (أو أكثر) ضعيفاً وغير مستقر سياسياً وأمنياً، فمن غير المتوقع التوصل إلى صياغات اتفاق متكافئ بين الأطراف.
على الحدود الشرقية للعراق كان التفاهم مع إيران عقدة كبيرة، ومثّل الموقف الإيراني خطراً على سلطة «البعث» حينها، خصوصاً بعد استقواء شاه إيران وإلغائه اتفاق عام 1937 مع العراق، وانغماسه في التدخل لدعم بعض أطراف المعارضة العراقية وإضعاف سلطة «البعث». نتج عن ذلك التغول الشاهنشاهي توقيع اتفاقية الجزائر لعام 1975 التي أثمرت دحر الحركة المسلحة الكردية مقابل ثلمة هائلة في السيادة العراقية، واستقطاع أراض من شط العرب لصالح إيران.
في الحقبة الزمنية التي سبقت تأسيس الدول الحديثة في منطقتنا لم يكن أمر المياه ذا شأن، وذلك لسببين: الأول هو أن مياه الرافدين دجلة والفرات والروافد كانت تجري بدون عوائق إلى العراق وتصب في الخليج، بعد أن تكون قد غطت مساحات شاسعة من الأرض تصل في مواسم الفيضان إلى أكثر من 5 في المائة من مساحة العراق. وهذا ما جعل العراق أرض الخصب والاستقرار والازدهار، فاستقرت أقوام من مختلف الأعراق في وادي الرافدين، وانبثقت فيه أولى الحضارات الإنسانية. بمعنى آخر كان موقع العراق الجغرافي من الناحية المائية نعمة كبرى.
أما السبب الثاني، فهو أن الأنهار الكبرى وروافدها من المنابع إلى المصبات لم تكن تقطع حدوداً سياسية، إلا ما ندر. مع ذلك حصلت اتفاقيات عظيمة، بمقاييسنا الحالية، للتعاطي مع تلك المياه قبل وبعد الحرب العالمية الأولى، كما حصل عام 1914 بين العثمانيين والإيرانيين مثلاً، أو في الأعوام التي تلت، إذ حصل الاتفاق التركي - العراقي عام 1946، وهو اتفاق غير مسبوق من حيث الدقة واحترام الحقوق والاستخدامات القائمة والمستقبلية.
في فترة الاستقطابات والتوتر الدولي والحرب الباردة ونزعات السيطرة الشمولية المترافقة مع الهوس الصدامي في الحروب، طورت دول الجوار شبكات السدود والمنشآت الكبرى على منابع النهرين والروافد. أحدث ذلك تغييراً هائلاً في الوضع الطبيعي لها، وأصبح العراق يتلقى نتائج سياسات وأنماط تشغيل لتلك المنشآت لا تتناسب بالضرورة مع مصلحته لأنها تقرر بصورة انفرادية.
لم تكن قرارات بناء المنشآت المائية في تركيا وسوريا وإيران منسقة مع العراق، كما تفترض مبادئ القانون الدولي، وقد أُنشئت في ظل علاقات خصومة وتنافس، فضلاً عن حرب الثماني سنوات مع إيران. خلقت تلك الإجراءات والعلاقات المتوترة وأجواء الحرب وانعدام الثقة واقعاً مائياً محزناً في العراق. فالعراق خرج من مغامرات الحروب والتنافس والاضطهاد السياسي ضعيفاً ومهزوماً ومحتلاً وساحة للنشاط الإرهابي الدولي أمسى معها بكونه «الحلقة الأضعف» في ظرف إقليمي ودولي قاهر.
ومع مرور الوقت وفي الشروط السياسية والاقتصادية والعسكرية السائدة حالياً، تتراجع حظوظ العراق وإمكاناته في حماية حقوقه المائية. لكن الأمر ليس ميؤوساً منه إذا ما أحسنت إدارة الملف. فالعراق كدولة مصب يمكنه تأمين حقوقه عبر السعي لتحقيق شبكة مصالح مع دول المنبع تكون بذاتها دافعاً للعمل من أجل إدارة مشتركة للمياه تقوم على مبادئ الانتفاع المنصف والمعقول، وتجنب الإضرار بالشركاء، والحرص على المصالح الاستراتيجية. فالمعروف أن الدبلوماسية والعلاقات الدولية ليستا لعبة بريئة، ولا يتحقق الإنصاف فيهما تلقائياً، حتى لو كانت الحقوق واضحة شرعاً وقانوناً.
شخصياً أعتقد بضرورة توفر ثلاثة شروط على الأقل، وهي: أن يكون العراق دولة قوية ومتماسكة اقتصادياً واجتماعياً ودبلوماسياً وعسكرياً، ولا يمكن ابتزازها بسهولة، وثانياً أن يكون الموقف التفاوضي سليماً وقائماً على معطياتٍ حقيقية، ويستند على القانون الدولي والمصلحة المشتركة، وثالثا إدارة كفوءة للموارد المائية المتاحة، فلا يستقيم منطق الخصام والصراع على الحقوق المائية، مع الهدر والإهمال وقلة إنتاجية وحدة الأرض أو وحدة المياه.
* وزير الموارد المائية السابق وسفير العراق السابق لدى تركيا