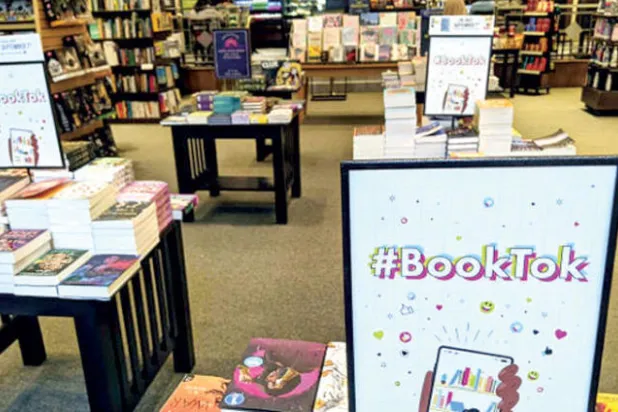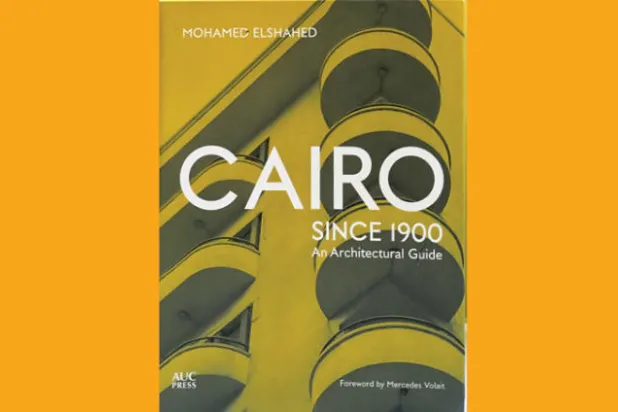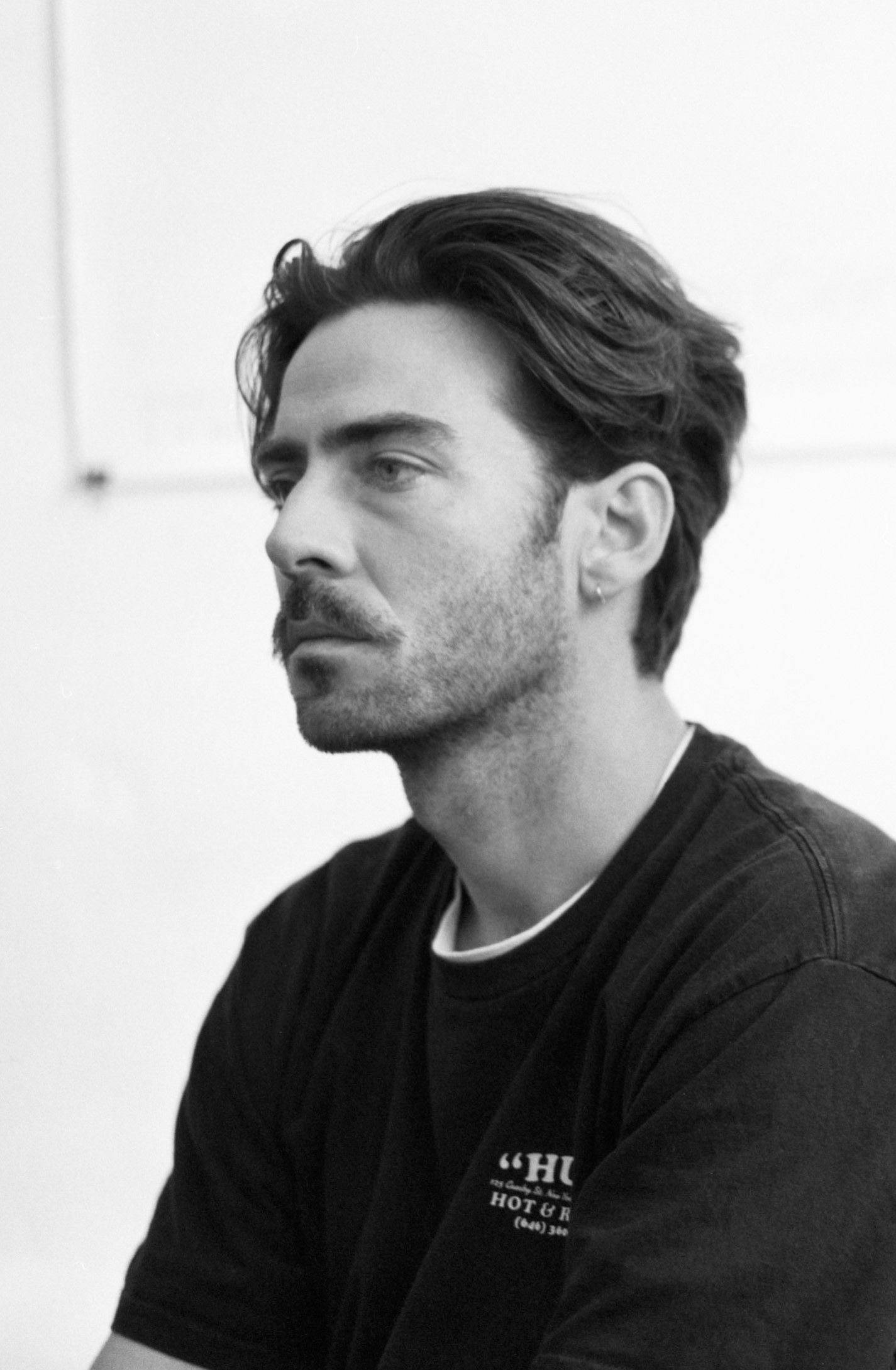تتميز الموسيقى في شمال أفريقيا ومنطقة المغرب العربي خصوصاً بنوع من الانحياز الجمالي لخصوصية المكان في المدى البُعدي للفن، وبحساسية زمنية ترافق حَرَكته على الدوام وتُولد هذا الشكل الإبداعي المركب، الذي يزاوج بين مادتين اثنتين هما: «اللغة التي يغذيها الشعر، والصوت الذي يعكس حركة الإيقاع». إنها حالة توأمة تجمع من جانب بين اللغة والصوت، ومن جانب آخر بين الزمان والمكان.
كثيرة هي الأغاني والإيقاعات الشعبية التي تتغنى بالمكان موضوعاً، غير مجرد بالطبع من عناصره الإيحائية، ومن جمالياته المتنامية، التي لا تكتفي بالبعد الرمزي للمكان، بل تفضي إلى حالات عالية من الأسطورة والتراجيديا في تناولها لفضاءاته المتداخلة، لكن وفق انتظام فني لا يهمل عنصر الزمن الذي يمثل جانبه سياقاً نفسياً واجتماعياً بالغ الأهمية... قد تُمثل هذه القراءة امتداداً لما يعرف بالتنصيف المفاهيمي للموسيقى كمادة، الذي يربط بين التاريخ الزمني وبين المكان، ويعيد في ذات الآن تأطير الفن الموسيقي داخل محور بُعدي سبق لفيلسوف التنوير الألماني لسنج، أن أسس له في كتابه الشهير «لاوكُوُون».
ما يهمنا في هذا الموضوع هو إعادة النظر في موسيقى المغرب العربي، لا باعتبارها لوناً من ألوان الموسيقى العالمية فحسب، بل بالنظر إليها فلسفياً وفق مقاربة ثنائية مزدوجة الدلالة: مادية وبُعدية.
علينا أن ننظر إلى توأمين كُل منهما يحمل توأماً مستقلاً في ذاته، فالزمان والمكان من جهة توأم، واللغة والصوت توأم آخر... نحتاج إلى نظرة ثلاثية الأبعاد ربما!
موسيقى المغرب العربي تؤسس بالفعل لتعلق الكلمة بالإيقاع، فالملحون في شمال المغرب وشرقه، ومثله العاصمي في الجزائر، وموسيقى «المزود» في تونس، والمقامات الحسانية التي تتجسد كنغمات تُدعى «رَدات» في موريتانيا وجنوب المغرب، كلها ألوان رئيسية للموسيقى الأكثر تجذراً في أقطار المغرب العربي، ما يجمعها هو تلك الصلة الوثيقة بين حركة اللغة وحركة الإيقاع، فالشعر المكتوب في هذه الحالة لم يولد من رحم اللغة إلا ليجد له مكاناً في مساحات الإيقاع الشاسعة، فيُغنى ويصبح أنشودة تتجلى وتتوضح في الغناء الذي يحملها حالة ذهنية فتية فيجعلها تختمر داخل فضاء الصوت، ويُخلدها بعد ذلك كخلقٍ إبداعي فني مكتمل الصورة مادياً على الأقل... يعود بنا هذا التصور إلى تصنيف مفاهيمي قديم لأرسطو حين فصل الموسيقى بمادية بديهية تجمع بين اللغة والمسموع الصوتي.
يأخذنا الحديث عن المحليات الموسيقية في المغرب الغربي إلى ألوان أخرى أكثر شيوعاً، إلى موسيقى «المالوف» التي هي من مألوف الطرب المغاربي، ذلك أنها موسيقى تتغنى بروائع الأندلسيات الآتية من زمن الوصل القديم، الذي ظل يحتفظ في ملكوته الخاص بموشحات مغتربة عن ضفة الجنوب المتوسطي، هناك في إيبيريا، حيث التلاقح الثقافي كاد أن يوحد المشرق والغرب... ومثل غيره من ألوان الموسيقى المنتشرة في المغرب العربي، فإن «المالوف» هو الآخر جعل اللغة المتجسدة في الشعر تواقة للغناء، ميالة للإيقاع، فبحركة الصوت ومتعة السماع - لا بغيرهما - تكتمل مادية الفن في هذه الموسيقى، حتى لكأن كل الموشحات الأندلسية ما كُتِبت إلا لِتُغنى!
الحديث عن موسيقى الأندلس في فضاءات المغرب العربي لا يستضيف النوستالجيا فقط، بل يفضي بنا إلى سؤال التوأم الآخر، أي المكان والزمان.
للطرب الأندلسي علاقة مؤثرة بكلا العنصرين، إنه يحتضنهما معاً، فالأندلسيات تتغنى في مقاماتها العديدة بزمن الوصل الذي تُحكى فصوله المتواترة أولاً بأول، لكنها تتغنى أيضاً بفضاء مكاني معروف، هو الفردوس المفقود في وسط الأرض، شمال القارة السمراء غرباً، وجانبَ بحر الظلمات، في المتوسط حيث تفضي الأمواج أخيراً إلى تخوم إيبيريا. كيف لنا ألا نستشعر حالة التراجيديا النابعة من هذا التركيب المكثف للزمان والمكان في لحظة واحدة ونحن نصغي إلى الأندلسيات الكلاسيكية بأصوات مغاربية دافئة النغَم.
ينسحب الأمر على بقية ألوان الموسيقى من شرق المغرب العربي إلى غربه، وفي جنوبه الحساني بموريتانيا، يُعنى أحد المقامات بذكر «النسيب» الذي يجعل الغزل توأماً لعشق المكان والحنين إليه، والواقع أن هذا الغرض قديم في الشعر العربي، فقد دأب الشعراء العرب على تذكر الأطلال نسبة إلى قاطنها «المحبوب»، لكن الطرب الحساني في موريتانيا وجنوب المغرب قد رسخ في موسيقاه علاقة «المَواضِع» بالزمن الغائب، فطالما ترنمت حنجرة الفنانة الموريتانية ذائعة الصيت ديمي بنت آبا بأغانٍ وتوليفات موسيقية تُدعى «الأشْوَار»، تتغنى في صميم بوحها بأماكن لم تكن لِتُذكَر لولا ارتباطها بحقب زمنية بالغة الحساسية في نفوس من يعرفون مآثر الربوع وأهلها وقبائلها وتاريخها الملحمي. وفي المغرب، كثيراً ما عُرفت المدن بأغانيها التي تتغنى بأسمائها وما يميزها من رموز وجماليات. فهذه أغاني مراكش التي تبدأ من أناشيد الصوفية وقصص «السبعة رجال» إلى الأغاني الوطنية التي تفاخر المدن بقدوم الحاكم إلى مراكش البهجة، وفي الشمال نذكر غنائيات «طنجة العالية» و«شفشاون النوارة» وغيرها، وأكثر من أن تُحصى أغاني فاس ومكناس وسائر المدن العتيقة... ولا حاجة للسؤال عن سياق أغنية «وهران رُحتِ خسارة» الشهيرة في الجزائر، التي وصلت إلى ما هو أبعد من ثنائية الزمان والمكان، فما كان يطمح إليه مبدعها الأول أحمد وهبي هو بعث مشاعر الشوق في نفوس من يحن إلى زمن ماض في وهران المدينة، بعد أن توالت مواسم الغربة والفراق، وأقفَرت البلدة من سكانها، لكن العالمية كانت هي منتهى هذه الأغنية الأسطورية... ومثلها «يا الرايح وين مسافر» التي أنشدها دحمان الحراشي في حالة من حالات الأسى على زمن يمر بسرعة ويسرق معه ورود الشباب وصفاء الروح فيه، بينما يسافر الغريب في «بلاد الناس» غير مدرك أن المكان بدلالاته المعروفة ليس هو المشكلة.
حالة أخرى من التوأمة بين الزمان والمكان جسدتها هذه الأغنية التي هي اليوم من أيقونات الطرب الجزائري، ليس في المغرب العربي فحسب، بل في العالم بأسره.
- كاتب وشاعر مغربي