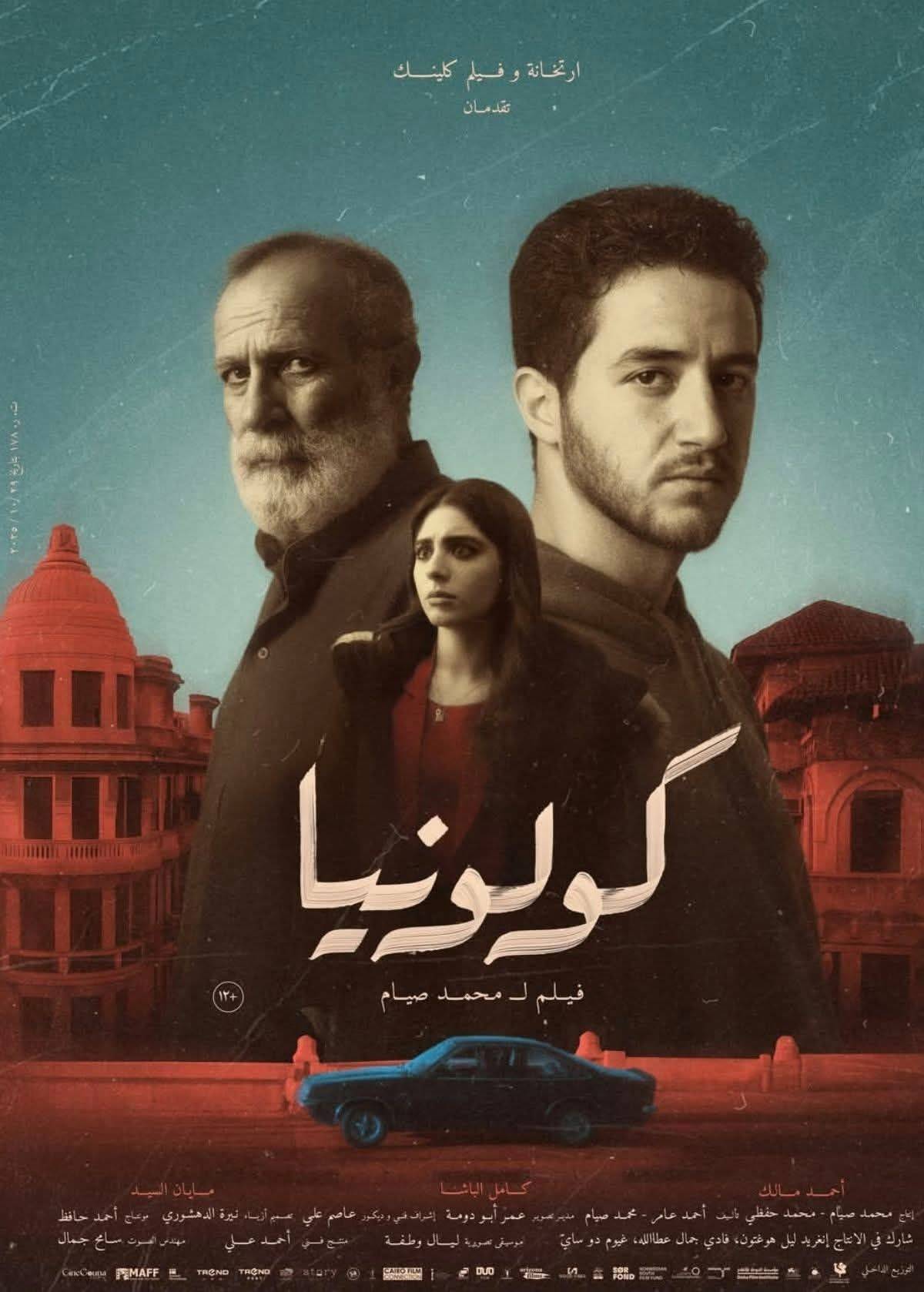متعة عقلية كبيرة (مصحوبة بدهشة تنم عن إعجاب مستحق) اعترتني وأنا أطالع بعض المواد المتاحة للقراءة المجانية في النسخة الإلكترونية من المطبوع الجديد «المجلة السعودية للدراسات الفلسفية» (SJPS)، في عددها الأول لسنة 2021. وقد تكفل الموقع الإلكتروني لمنصة «معنى» الثقافية بهذا المشروع الفلسفي، في سياق جهد ثقافي يمكن الاطلاع عليه في الموقع الإلكتروني لهذه المنصة.
وتمثل «المجلة السعودية للدراسات الفلسفية» الذراع الأكاديمية المحكومة بمقاسات صارمة معروفة في عالم المجلات الأكاديمية المحكمة، لكن هذه الصرامة الأكاديمية هي محض جانب واحد من الحكاية، وليست الحكاية كلها، فثمة أيضاً أبوابٌ أخرى متخففة من هذه الصرامة، رغم أن كاتبيها (عرباً وأجانب) معروفون بقدراتهم الفلسفية العالية، وإمكانياتهم في مخاطبة العقل البشري في كل تشكلاته الذهنية والنفسية، وأشير خاصة إلى النسخة المعربة من مجلة «الفيلسوف الجديد» (NEW PHILOSOPHER). ويضم موقع «معنى» حوارات ممتازة مع بعض الفلاسفة المعروفين على مستوى العالم، وأشيرُ بالتخصيص إلى الحوار مع الفيلسوف دانييل دينيت (Daniel Dennett) الذي يوصف دوماً بأنه الصديق المحبوب للعلماء بسبب أبحاثه التي تلامس الجبهات المتقدمة لبعض أقدم الموضوعات الفلسفية، وأعني بذلك معضلة الوعي.
ومن المثير تاريخياً الإشارة إلى الحقيقة التالية: شاعت في العقود الأولى من القرن العشرين حتى ستينياته جهود عالمية موجهة تسعى إلى إشاعة نمط مما يمكن تسميته (فلسفة علمية)، وقد تجذر هذا المسعى، وتعمقت أدواته لدى بعض أعضاء «حلقة فيينا» (Vienna Circle) الذين أثمرت جهودهم عن نشأة الفلسفة الوضعية المنطقية؛ ذلك الاتجاه الفلسفي الذي أراد أن يكون فلسفة عصر العلم. وسعت الوضعية المنطقية إلى إحداث ثورة على المستوى الفلسفي، طالت الاشتغالات الفلسفية التقليدية، وأثمرت كشوفات فلسفية جديدة، لعل حركة التحليل اللغوي (Linguistic Analysis) والنزعة التحليلية (Analiticity) في الفلسفة بعامة تعد أهم معالمها، وقد ساهم فلاسفة مثل برتراند راسل (Bertrand Russell) ولودفيغ فيتغنشتاين (Ludwig Wittgenstein) في قيادة رَكْب هذه الفلسفة.
وعندما أقرأ مثل هذه الأطروحات ترتسم أمامي أسئلة جوهرية: ما الذي ننشده من الفلسفة؟ وهل المطلوب أن تصبح الفلسفة علمية؟ وهل الفلسفة العلمية هي الشكل الوحيد للفلسفة الذي يمتلك مشروعية البقاء والنمو والسيادة؟
بشر كثير من العلماء بموت الفلسفة (في مقدمتهم الفيزيائي الراحل ستيفن هوكنغ)، وقصدوا بهذا الموت ضرورة ابتعاد الفلسفة عن مقاربة الموضوعات الوجودية الأساسية الثلاثة الخاصة بأصل كل من الكون والحياة والوعي، وفي منطقتنا العربية ساهم فلاسفة مرموقون من العيار الثقيل (في مقدمتهم الراحل زكي نجيب محمود) بالتبشير بسيادة عصر الفلسفة الوضعية المنطقية، وموت كل الفلسفات الأخرى، بصفتها غير علمية، وأظن أن شيوع الجهل والخرافة والأصوليات الدينية هي الأسباب التي دعت هذا الفيلسوف إلى إعلاء شأن هذه الفلسفة، وتسخيف ما سواها إلى حد صارت معه الفلسفة الوضعية المنطقية تمثل أصولية مقابلة للأصوليات السائدة.
ولعل كثيرين منا -خاصة المشتغلين في الحقل الثقافي- يشهدون ملامح الدعوة إلى الفلسفة وتنشيط العقل الفلسفي في بيئتنا العربية. وقد اتخذت هذه الدعوة شكلاً أقرب إلى الصحوة الفكرية التي تسعى إلى وخز مكامن الجمود والاستكانة في العقل العربي الذي عانى كثيراً تحت سطوة المواضعات الثقافية والمجتمعية السائدة. ومثل هذه الدعوة محمودة في متبنياتها العامة، ونبل المقاصد الرامية إليها، لكن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يمكن الإشارة إليها، وفي التفاصيل يكمن الشيطان اللعوب كما تنبؤنا الأمثولة المعروفة.
أولاً: لا ينبغي تصور أن تحريك جذوة الدرس الفلسفي (على صعيد التعليم والثقافة العامة معاً) هو تعويذة «افتح يا سمسم» التي ستفك لنا مغاليق الانسدادات التي نعانيها على صعيد العلم والتقنية، وبالتالي ستمكننا من اعتلاء ناصية اقتصاد المعرفة الكفيل بفتح نوافذ جديدة للتمكين المالي -للدولة والأفراد معاً- بعيداً عن مظاهر الاقتصاد الريعي التي تمسك بخناق معظم مجتمعاتنا العربية. الذائقة الفلسفية التي يحركها عقل فلسفي مدرب على مساءلة الثوابت في كل جوانب الحياة هي ذائقة لازمة لتحقيق تثوير حقيقي في الإنجاز العلمي والتقني، وولوج بوابة اقتصاد المعرفة وعتبة الثورة البشرية الرابعة، لكن هذه الذائقة وحدها ليست كفيلة بتحقيق هذه المقاصد النبيلة التي لا تتحقق إلا بتوافر عناصر أخرى يمكن دراستها في أدبيات التنمية المستدامة. ثمة آفاق واعدة في هذا الميدان، ويمكن الإشارة فحسب إلى المشروع الواعد «رؤية 2030» الذي تبنته المملكة العربية السعودية، وتعمل عليه بجدية مشهودة تقوم على أساس التنمية الخضراء التي تراعي الاعتبارات البيئية.
ثانياً: نسمع كثيراً عن أهمية الفلسفة وضرورتها في إحلال المياه النقية محل المياه الراكدة، لكن أي فلسفة هي المنشودة لتثوير العقل العربي؟ ما يلاحظ في الأدبيات الفلسفية السائدة في جامعاتنا وثقافتنا العربية هو كونها تتموضع في ثلاثة أشكال معروفة: فذلكات تأريخية أقرب إلى الهوامش الخاصة بتدوين الوقائع التاريخية الخاصة بفلسفة محددة، أو فلسفة تتصادى مع بعض جوانب تراثنا الذي ما كانت فيه الفلسفة سوى شكلٍ مضمرٍ من الثقافات السائدة، أو رطانات لغوية هي في أغلبها ترجمات مبتسرة لبعض الفلسفات الموصوفة بـ«ما بعد الحداثية» التي سادت في القارة الأوروبية (فرنسا خاصة) بعد الحرب العالمية الثانية. وقد ادعت هذه الفلسفات إحداث «قطيعة إبستمولوجية» مع الفلسفات السابقة لها، عبر تعشقها مع الثورات الحديثة في اللغة وعلم النفس الإدراكي... إلخ. لكن ما حصل لاحقاً هو انكفاء تلك الفلسفات في مواطنها، بينما لا يزال لدينا بعض من يتوهم في نفسه القدرة على نفخ الحياة في جسم ميت عبر تلال هائلة من الرطانات اللغوية التي لا تكاد تتمايز عن رطانات أخرى تسود قطاعات واسعة في مجتمعاتنا.
ثالثاً: عند إحياء الفلسفة في بيئتنا، لا بد من الانتباه إلى حقيقة شيوع ما أصبح يدعى «الثقافة الثالثة»، تلك الثقافة التي تتجاوز محدوديات كل من الثقافتين الكلاسيكيتين العلمية والأدبية نحو ثقافة تخليقية جديدة، توظف الأفكار المستحدثة في الحقول المعرفية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وأصول الكون والحياة والوعي البشري، والنظم الدينامية المعقدة، والتعلم الآلي، والبيولوجيا التطورية. وهناك دعوة باتت تشيع في العالم الغربي، مفادها أن الفلسفات التي سادت في بداية الألفية الثالثة ما عادت قادرة على التناغم مع متطلبات الثورة الرابعة، وبسبب هذا شاعت مقولة «موت الفلسفة»! إذن، علينا الانتباه منذ البدء إلى ضرورة البدء بتكريس الأطروحات الفلسفية المتناغمة مع الثورات العلمية والتقنية في عصرنا، بدلاً من جعل الفكر الفلسفي ينزوي في جزيرة معزولة.
وأرى أن المسعى الجوهري للفلسفة في عصرنا الحاضر (عصر الثورة التقنية الرابعة) يكمن في تقديم الفلسفة دروساً وأمثولات معيارية للعيش الطيب والحياة الخيرة، فضلاً عن تقديمها عزاءات للإنسان تمكنه من مواصلة حياته المتخمة بألوان التراجيديا الوجودية المؤلمة، وربما يمكن تلمس مصداقية هذه القناعة في حقيقة الزيادة المذهلة لقراء الكلاسيكيات الفلسفية الإغريقية (خاصة المحاورات الأفلاطونية والملاحم الإغريقية المعروفة)، إلى جانب الكلاسيكيات الفلسفية التي سادت عصر النهضة الأوروبية، والتي تشهد قراءات متنامية لم تخفت جذوتها على مر السنوات، كما يمكن الاستفادة من بعض مصنفات تراثنا الفلسفي العربي الذي يزخر بإشراقات فلسفية لامعة لا يمكن تجاوزها من جانب كل عقل فلسفي شغوف.
حياتنا أكبر من أن تكون رهينة لمنتجات العلم والتقنية، ولا بد من إضفاء نكهة فلسفية على وجودنا الإنساني منذ سنوات النشأة الباكرة، وكلما نجحنا في تثبيت أركان التساؤل الفلسفي المقترن بدهشة اكتشاف الأسرار الخبيئة في وجودنا الإنساني كان هذا المسعى استثماراً حقيقياً للرأسمال البشري سنشهد نتائجه في سنوات (أو ربما في عقود) مقبلة.
العقل العربي واستعادة طاقة التفكير الفلسفي
بمناسبة صدور عدد أول من «المجلة السعودية للدراسات الفلسفية»


العقل العربي واستعادة طاقة التفكير الفلسفي

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة