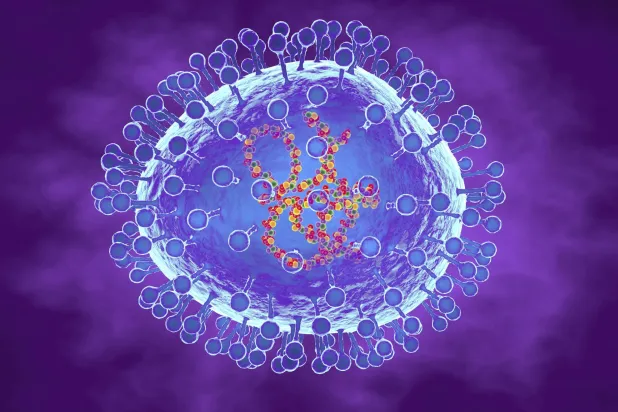بعد أكثر من 3 أشهر من الإقفال التام، والعزلة، والعمل من المنزل... بسبب جائحة «كورونا»، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في بعض المدن والدول (وليس جميعها). في بريطانيا، فتحت المحال التجارية في أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي، وكان يوم 4 يوليو (تموز) الحالي الافتتاح الكبير المنتظر للمقاهي والمطاعم. هذا اليوم انتظره الجميع بعد الشعور بالتعب من الجلوس في المنزل وعيش حياة لم نعهدها من قبل. ولكن المفاجأة الكبرى هي أن المطاعم فتحت أبوابها بعد إجراء كثير من التعديلات للحفاظ على صحة وسلامة الزبائن ومراعاة مسألة التباعد الاجتماعي الذي سيرافقنا إلى أجل غير قصير، ولكن شبح الفيروس يخيم عليها، فهي لا تزال شبه خالية ولم يجرؤ الناس على الذهاب إليها، تخوفاً من الوضع وتفادياً لالتقاط الفيروس، والأهم، وللأسف، هو أن الثقة انعدمت ودخل العالم في سبات عميق واعتاد نظاماً وروتيناً جديداً من الصعب التخلص منه بين ليلة وضحاها.
منذ 23 مارس (آذار) الماضي والصحافة تنادي بأهمية التعود على أسلوب حياة جديد، والتشديد على خلق روتين يساعدنا على التأقلم مع نمط معيشي غير مسبوق، إلا إن العزلة طالت عن حدها، وبعد أن خلقنا لأنفسنا روتيناً اقتصر على ما سمحت به القوانين المتاحة، مثل المشي لمدة ساعة في اليوم، والعمل من المنزل، وتبني هوايات لم نكن نعلم بأننا نلم بها مثل الطهي والرسم والأشغال اليدوية والعمل في الحديقة والزرع، وجدنا أنفسنا لا نستطيع الخروج من هذا الروتين الذي ساعد كثيرين على تخطي الأزمة.
اليوم فتحت المحال أبوابها، وعادت حركة السير إلى زحمتها الخانقة، في لندن على سبيل المثال، إلا إن حركة الاقتصاد لا تزال مشلولة.
خرجت لأول مرة منذ الإقفال التام في مارس الماضي، ليلة الاثنين، والتجربة كانت غريبة جداً؛ بدءاً من تحضير نفسي للذهاب، ووصولاً إلى المطعم والالتزام بجميع القوانين الجديدة، والأسئلة الغريبة من النادل، والكمامات التي تغطي وجوه العاملين... وأصعب شعور كان القلق.
الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته عالمياً، ومن المنطقي أن نقوم نحن المستهلكين بالمساهمة في إنقاذه من خلال زيارة المرافق السياحية والمقاصف الاجتماعية، إلا إن القلق أو ما يطلق عليه في عالم السيكولوجيا الـAnxiety ونوبات الفزع التي تعرف باسم Panic Attacks طالت الجميع من دون استثناء، ولكنها قد تقضي على الذين كانوا يعانون أصلاً من مشكلات نفسية.
الحالة التي نعيشها اليوم بسبب «كورونا» نفسية أكثر منها بدنية... إنه مرض نفسي يقضي على الثقة بالذات وعلى العلاقات الاجتماعية، وستكون نتائجه وخيمة على المديين المتوسط والبعيد، واليوم نرى عدداً كبيراً من الناس بحاجة للتكلم مع إخصائيين نفسيين لمعالجة الخوف المتربص في داخلهم والهلع الذي خلفه الفيروس.
المشهد الحالي في مطاعم لندن، التي كانت تعج في الماضي في هذا التوقيت من الصيف بالسياح والمقيمين في المدينة، مختلف تماماً، فهي شبه خالية، ومن السهل الحصول على حجز فيها، ولم تستطع جميع المطاعم فتح أبوابها بسبب عدم تمكنها من إجراء التعديلات التي فرضتها الحكومة، مثل تأمين مدخل ومخرج منفصلين، وإبعاد الطاولات بعضها عن بعض، وفرض الكمامات على العاملين والطهاة، ووضع حاويات للمطهر عند المدخل وعلى جميع الطاولات، فعلى سبيل المثال؛ لم يستطع مطعم «سوشي سامبا» بفرعه في وسط لندن المالي فتح أبوابه بسبب موقعه في الطابق الأخير من المبنى والوصول إليه عبر مصعد كهربائي، واكتفت الشركة بإعادة فتح المطعم بفرعه في «كوفنت غاردن».
عند وصولك إلى المطعم، تجلس إلى الطاولة التي تبعد مسافة نحو مترين عن الطاولة المجاورة، يسألك النادل عما إذا كنت تفضل سكب الماء في كأسك، ومن ثم يسألك عما إذا كنت تفضل وضع المحرمة بنفسك... وأسئلة أخرى. وأكدت النادلة التي كانت تقوم بخدمتنا أن غالبية الزبائن تمنع العاملين من لمس زجاجات الماء والصحون. وهذا الأمر بديهي بعد الترهيب الذي نعيشه بسبب فيروس لا نراه بالعين المجردة ولكنه حرم العالم بأسره من أبسط الأمور.
فبعد فتح المحال، تعود كثيرون على نمط حياة جديد يقتصر على الطهي والأكل في المنزل، كما جعلهم يألفون هذا الأسلوب المعيشي الجديد، فهناك عدد من الشركات التي فتحت أبوابها لمزاولة العمل من المكاتب؛ إلا إنها لا تزال فارغة؛ لأن الموظفين يفضلون العمل من المنزل، وبحسب القانون وفي ظل هذا الفيروس الذي لم يتم التوصل إلى لقاح له بعد، لا يحق لرب العمل إجبار الموظف على العمل من المكتب.
الصور التي نشاهدها لمواصلات النقل العام لا تبشر هي الأخرى بالخير، لأن مقصورات مترو الأنفاق فارغة، والسبب هو التخوف من استخدامها.
ولم تساعد وسائل الإعلام في معالجة مسألة الترهيب والتخويف، فإذا شاهدت نشرة أخبار كاملة في اليوم فستكون كفيلة بأسرك في المنزل إلى أجل أطول.
وتقول الدكتورة «م.ن» إن الوضع النفسي للناس في حالة صعبة جداً، وهذا ما يجعلها تعمل بشكل مكثف ولديها مواعيد عدة لمرضى جدد يعانون من الخوف والقلق من الخروج والتعاطي مع الغير.
وقدمت الدكتورة بعض النصائح السريعة، وقالت إنه من الضروري البدء في الخروج، ولكن إلى أماكن قريبة من مكان الإقامة وأماكن مألوفة، وعدم تلبية الدعوات والزيارات في حال لم يكن الشخص مرتاحاً للأمر. أما عن الخوف من التقرب من الآخرين، والتباعد الاجتماعي، فتقول إنه «من المهم أن يقول الشخص للآخرين إنه لا يشعر بالارتياح لاقترابهم منه، وفي حال زارك أحدهم في منزلك، فاطلب منه خلع حذائه عند الباب»، وشددت على «ضرورة وضع قوانين تريح نفسيتك». ونصحت أيضاً «بالتكلم عن القلق والخوف وعدم كبته في الداخل، فالتكلم مع صديق مقرب يجعل الأمر أسهل ويخفف من القلق».
كما أشارت إلى أن «الخروج إلى المطاعم قد لا يكون على رأس جدول أوليات البعض، إلا إنه قد يساعد في تغيير الجو والمشهد». وتقول الدكتورة إن «الأشخاص الأكثر تضرراً من الأمر هم الذين يعانون من الوحدة بالأصل، فهم اليوم عرضة لمخاوف إضافية إلى جانب هاجس العيش بمفردهم»، ولهذا نبهت إلى مسألة «مساعدة الغير والالتفات لهؤلاء الذين يتغير سلوكهم، كأن يمتنعون عن الخروج بالكامل أو الذين يعبرون عن خوفهم من ترك البيت».
وفي النهاية؛ من الضروري العودة إلى الحياة الطبيعية السابقة ولكن ببطء، والالتزام بالقوانين الخاصة بالتباعد الاجتماعي؛ لأن الفيروس لم ينته بعد، وهناك مخاوف من موجة ثانية في الخريف المقبل، ويجب في النهاية التنبه إلى مسألة التعود على الكسل والخمول؛ ولهذا السبب ينصح جميع الاختصاصيين النفسيين بالعودة إلى الحركة والخروج من المنزل ببطء.
يوم «استعادة الحياة» يعجز عن كسر روتين التعايش مع «كورونا»
بعد أشهر من الإقفال... المطاعم تفتح أبوابها ولكنها شبه خالية


يوم «استعادة الحياة» يعجز عن كسر روتين التعايش مع «كورونا»

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة