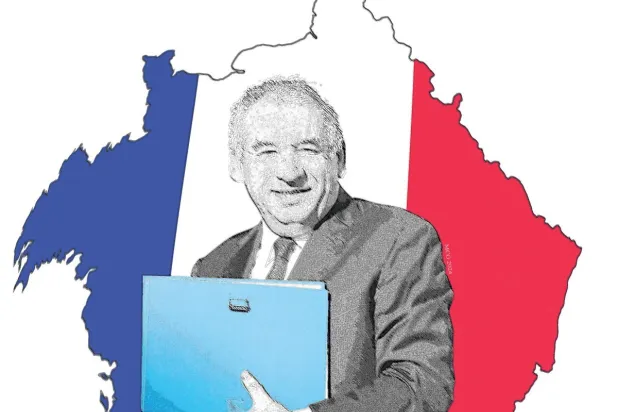كانوا حتى أمس القريب يسمونها «صغيرة المجلس»، لكنها أصبحت اليوم من أهم وجوه السياسة البريطانية.
إنها جو سوينسون، زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار، التي كانت أصغر نواب مجلس العموم سنّا عندما انتخبت عن دائرة شرق دونبارتون شير، في وسط أسكوتلندا، عام 2005، وهي لا تزال في الـ25. لكنها اليوم، وهي تقترب من الـ40، تجد سوينسون نفسها في واجهة الساحة السياسية البريطانية، وقد رفعت شعاراً مثيراً للجدل كان شبه محرّم في أروقة «قصر ويسمنستر» (حيث مقر مجلسي العموم واللوردات) في لندن قبل أسابيع. ألا وهو شعار «البقاء في الاتحاد الأوروبي»، وعكس نتيجة استفتاء يونيو (حزيران) 2016، الذي قرّر خلاله نحو 52 في المائة من الناخبين وضع حد لعقود من عضوية بريطانيا في الأسرة الأوروبية.
قد يبدو رهان جو سوينسون، زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار، وحزبها، مخاطرة كبيرة، إلا أنه يعيد تعريف ذلك الحزب الليبرالي الذي لطالما كان متأرجحاً بين اليمين واليسار، فاتّهمته المعارضة «العمالية» بأنه «مُسهّل» للمحافظين، بينما اتّهمه المحافظون بأنه أوروبي أكثر منه بريطاني. وفي وقت تزداد الثنائية الحزبية المهيمنة على السياسة البريطانية هشاشة، قد تنجح سوينسون في انتزاع أصوات «عمالية»، أو حتى «محافظة» داعمة لمعسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي. فمن هي جو سوينسون؟ وهل تنجح استراتيجيتها الانتخابية المعتمدة على «عكس بريكست» في تغيير الخريطة السياسية البريطانية كما نعرفها؟
طموح سياسي مبكر
جوان كيت سوينسون، سياسية بريطانية وُلدت في مدينة غلاسغو كبرى مدن أسكوتلندا يوم 5 فبراير (شباط) من عام 1980، ودرست الإدارة في كلية لندن للاقتصاد - إحدى أعرق وأرقى جامعات بريطانيا وأوروبا. وبعد التخرّج عملت لفترة قصيرة في مجال العلاقات العامة، قبل أن تُنتخب لعضوية مجلس العموم عن دائرة شرق دونبارتون شير عام 2005، لتصبح أصغر أعضاء البرلمان سناً في ذلك الوقت.
ومع أن سوينسون خسرت مقعدها في عام 2015 أمام جون نيكلسون، مرشح «الحزب القومي الأسكوتلندي»، فإنها استرجعته في الانتخابات المبكرة عام 2017. ثم شغلت سوينسون خلال عملها نائبة منصب الناطقة بلسان «الديمقراطيين الأحرار»، وغطّت قضايا مختلفة شملت أسكوتلندا والمساواة بين الجنسين، وشؤون الخارجية و«الكومنولث».
عام 2010، بعدما دخل «الديمقراطيون الأحرار» في حكومة ائتلافية مع حزب المحافظين، برئاسة ديفيد كاميرون، شغلت سوينسون منصب السكرتير البرلماني الخاص لنائب رئيس الوزراء نيك كليغ، وعُينت لاحقاً وكيلة وزارة الدولة لعلاقات التوظيف.
وبعد وقت قصير من عودتها إلى البرلمان عام 2017، لمع نجم سوينسون، وبدأ أعضاء في الحزب يرونها «وريثة» طبيعية لزعيمه آنذاك فينس كايبل، وبالفعل، انتخبت بالإجماع نائبة لزعيم «الديمقراطيين الأحرار». ثم، خلال شهر مايو (أيار) عام 2019، أعلنت سوينسون نيّتها خلافة كايبل، متحدّية الوزير والمرشح البارز السير إد دايفي. وفي انتخابات الزعامة، فازت بالمنصب في يوليو (تموز) الماضي متغلبة على دايفي، لتصبح أول امرأة وأصغر زعيم لحزب الديمقراطيين الأحرار.
ما يذكر، أنه إلى جانب نشاط سوينسون السياسي، حازت مواقفها الداعمة لحقوق الآباء الجدد، وساعات العمل المرنة، والمعارضة لتخصيص حصص لتوظيف النساء، الكثير من الاهتمام في الأوساط الاقتصادية. كما اختارتها صحيفة «الإيفنينغ ستاندرد»، واسعة الانتشار، إحدى أكثر 1000 شخصية تأثيراً في لندن، خلال أعوام 2011 و2012 و2013 و2014.
حزب الوسط؟
«بلادنا تستحق أفضل مما يُقدّمه الحزبان المحافظ والعمالي المتقادمان والمتعبان، كلاهما يريد (بريكست). (...) لن أضع حدًا لطموحي وطموح (الديمقراطيين الأحرار) لبناء مستقبل أفضل (...)، أستطيع أن أكون رئيسة وزرائكم»، تكرّر سوينسون هذه الشعارات في التجمعات الانتخابية، والقنوات التلفزيونية، وربما الأهم منهما، في منصّات التواصل الاجتماعي، بلا كلل.
ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة المبكرة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ينتهج حزب سوينسون استراتيجية مختلفة عن حزبي اليمين واليسار. إذ جعل حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون - المحسوب على يمين حزبه - «تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي الشعار الرئيسي لحملته الانتخابية»، في حين تعهد منافسه المباشر، حزب العمال، للناخبين بإجراء استفتاء جديد بشأن «بريكست»، مرسلاً إشارات خجولة إلى أنه يفضّل البقاء في الاتحاد.
من ناحية أخرى، تسعى سوينسون إلى تقديم نفسها للناخبين كوجهٍ جديد، غير معروف لدى كثيرين، يطرح نهجاً وسطياً وعقلانياً مختلفاً عن الحزبين التقليديين في وضوحه تجاه قضايا مثل «بريكست»، ونظام الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات التغيّر المناخي.
وتوافقاً مع هذا النهج، اعترفت سوينسون بما اعتبرته «أخطاء» الحزب السابقة، خصوصاً تلك التي ارتكبها بمشاركته في حكومة المحافظين برئاسة كاميرون عام 2010. ولقد أدت مشاركته تلك إلى تعرّض الحزب لهزيمة قاسية في انتخابات 2015، تراجع معها عدد مقاعد الحزب من 57 إلى 8 مقاعد فقط. كذلك، عبّرت عن أسفها لدعم الحزب سياسات اعتبرها البعض تقشّفية، وتغييرات في نظام الرعاية الصحية، وضريبة إضافية على السكن.
واليوم، تأمل سوينسون في إحداث قطيعة مع أخطاء الماضي، وإعادة تعريف الحزب وتوجّهاته ومبادئه، واختارت قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كقضية محورية لتحقيق ذلك.
وفي دعوة حزبها إلى إلغاء مادة 50 من «معاهدة لشبونة»، التي أطلقت عملية «بريكست» رسمياً، تضاعف عدد «الديمقراطيين الأحرار» في الساحة السياسية، وأصبحوا فعلياً «حزب البقاء في أوروبا». وبذا، نجح الحزب حيث فشل آخرون، مثل حزب «التغيير» الذي وُلد من رحم انشقاقات من الحزبين الأساسيين (المحافظون والعمال) لكنه لم يستمرّ سوى بضعة أشهر، ليعلن غالبية أعضائه الانضمام إلى «الديمقراطيين الأحرار».
وفي حين يُحسب هذا الإنجاز لحزب سوينسون، الذي نال المرتبة الثالثة في استطلاعات رأي حديثة، فإن فوزه بغالبية المقاعد مستبعد للغاية، إن لم يكن مستحيلاً. ونقلت صحيفة «الفاينانشال تايمز» أخيراً عن مصادر مقرّبة من دوائر القرار في الحزب، أن قيادييه يُدركون أن الفوز بـ45 مقعداً سيُعدّ انتصاراً بارزاً، يعيد الحزب إلى الحسابات السياسية الدائرة في مجلس العموم. خصوصاً وأن الحزب، رغم تعافيه النسبي من نتيجة تحالفه الكارثي مع المحافظين، لم يحصل إلا على 12 مقعداً في انتخابات 2017 المبكّرة التي دعت إليها تيريزا ماي.
في أي حال، في حال أفضت الانتخابات المبكرة إلى «سيناريو» البرلمان المعلّق - أي من دون غالبية مطلق لأي حزب - كما تتوقع استطلاعات الرأي، واستعاد «الديمقراطيون الأحرار» المقاعد التي خسروها بعد 2010، فإن سوينسون قد تصبح «صانعة القادة» الجديدة... وتحدّد هوية ساكن «10 داونينغ ستريت» الجديد.
تهديد للمقاعد «العمالية»
على مدار الأسابيع الخمسة المقبلة، يأمل «الديمقراطيون الأحرار» في الفوز بأصوات ناخبين يبحثون عن الوسطية، وسط أجواء سياسية مشحونة بين سعي جونسون إلى خروج «قاسٍ» لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبرنامج غريمه العمالي جيريمي كوربن، الذي يوازيه وربما يبزّه في «راديكاليته»... ولكن يساراً.
وعلى الرغم من أن التوقعات، حتى اللحظة، لا ترقى لطموح سوينسون بالفوز برئاسة الوزراء، فإن «الديمقراطيين الأحرار» قد يجدون أنفسهم في موقع قوة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل (تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة). والواضح أن حملة سوينسون تركّز على انتزاع مقاعد «عمالية» في المناطق التي صوّتت للبقاء في الاتحاد الأوروبي، واستغلال غضب بعض المعاقل «العمالية» التقليدية من نهج كوربن المتردد حيال «بريكست». ومعلوم أنه منذ أصبح كوربن داعماً لتنظيم استفتاء ثانٍ على الخروج من الاتحاد الأوروبي، تحت ضغوط من داخل حزبه، فإنه رفض تحديد ما إذا كان سيدعم الخروج أو البقاء.
في المقابل، فإن سوينسون تراهن على أن موقف حزبها كان متماسكاً منذ البداية، وأنه لم يتخلَّ أبداً عن تأييده للاستفتاء وللبقاء في الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك، فإن «الديمقراطيين الأحرار» يراهنون على الفوز بتأييد بعض المحافظين، المعارضين لـ«بريكست»، إلا أن فرص حصول ذلك تبقى ضئيلة.
وفي مقابل هذا التفاؤل، اعتبر أنتوني ويلز، مدير الأبحاث في مؤسسة الاستطلاعات «يوغوف»، أن تحقيق «تقدم حقيقي» يشكل تحدياً كبيراً لـ«الديمقراطيين الأحرار». وهو رأي كرّره بعض المراقبين السياسيين، الذين أعربوا عن مخاوف من أن الحزب حدّ من جاذبيته لناخبي المناطق خارج العاصمة لندن (التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي)، بدعوته الصريحة لنقض الخروج من الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، يشكك البعض الآخر في معارضة «الديمقراطيين الأحرار» للحكومة الحالية، ومن هؤلاء نيكولا ستورجن، وزيرة أسكوتلندا الأولى والزعيمة القومية الأسكوتلندية، التي وصفتهم أمس بـ«حزب ويسمنستر»، لا حزب «معارضة بريكست».
بدوره، قال نيل باريش، وهو نائب محافظ، إن مواقف «الديمقراطيين الأحرار» ضمنت له مقعده في البرلمان. وتابع في تصريحات صحافية: «قد تنجح (استراتيجيتهم) في أجزاء من لندن، لكنها لن تنجح خارجها»، في إشارة إلى أجزاء كثيرة جنوب غربي إنجلترا. ثم أردف: «إن الناس يريدون فقط الخروج من الاتحاد الأوروبي».
التصويت التكتيكي
ولكن، في محاولة لمواجهة نقاط ضعفهم، يدعو مرشحون من «الديمقراطيين الأحرار»، الناخبين، إلى «التصويت تكتيكياً» لقطع الطريق أمام عودة المحافظين، مع أن معارضة سوينسون الشديدة والصريحة لزعيم حزب العمال كوربن، وسياساته، قد تعيق نجاح هذه الاستراتيجية.
ويرى الكاتب السياسي مارتن كيتل، في هذا السياق، أن حزب سوينسون لن ينجح في تعزيز عودته إلى الساحة السياسية سوى عن طريق انتخاب المزيد من نواب داخل البرلمان. ولن يحدث ذلك في نظره، إلا إذا كان هناك «نوع من الاقتراع التكتيكي في الانتخابات العامة المقبلة، شبيه بالذي ساعد بادي آشداون، الزعيم الأسبق للحزب، على زيادة عدد النواب الديمقراطيين الأحرار عام 1997 بأكثر من الضعفين». ويضيف: «أدرك الناخبون التقدميون آنذاك أنه قاد حزباً يمكنه العمل مع حزب توني بلير». بيد أن كيتل استدرك في مقال رأي نشره في صحيفة «الغارديان» فقال: «على النقيض من ذلك، تواجه سوينسون حالياً علاقة أكثر صعوبة مع قيادة حزب العمال الحالية التي لا يدعمها الكثير من مؤيدي الديمقراطيين الأحرار. ومع ذلك، ما لم تتمكن من جعل هذه العلاقة ناجحة، سيكون هناك فائز واحد فقط، ولن يكون الحزب الديمقراطي الحر».
في المقابل، وبينما ترفض سوينسون دعم كوربن، فإنها تسعى إلى التقرّب من الأحزاب المعارضة الأخرى. وحقاً، أعلنت أصغر ثلاثة أحزاب في بريطانيا، أول من أمس، اتفاقاً انتخابياً في محاولة لجذب المزيد من النواب البرلمانيين الذين يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وانضم «الديمقراطيون الأحرار» إلى حزب «الخضر» البيئي و«الحزب القومي الويلزي»، في اتفاق تعاون للحصول على 60 مقعداً من أصل الـ650 مقعداً في البرلمان في الانتخابات المقبلة، ما يعني أن مرشحاً واحداً فقط سيمثل الأحزاب الثلاثة عن كل دائرة انتخابية تخوضها، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وعلقت جو سوينسون، في تغريدة، على الاتفاق بالقول «أنا سعيدة لأننا استطعنا إعلان هذا الترتيب للتأكد من أننا سنحصل على أكبر عدد ممكن من النواب المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي».
وأضافت: «مستقبلنا الأكثر إشراقاً سنصنعه بالعمل معاً، وبالتالي، يمكننا الاتحاد للبقاء (في التكتل الأوروبي)».
بدوره، قال حزب «الخضر» إن الاتفاقية ستسمح له «بالتنافس على 10 مقاعد في إنجلترا وويلز». وأفاد الزعيم المشارك للحزب جوناثان بارتلي، في بيان، بأن «هذا يتمحور حول إدراك كم سيكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مضراً - للأفراد وللبيئة - وضمان أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الأحزاب المنادية بالبقاء في البرلمان المقبل قدر المستطاع». ومن جهته، أكد آدم برايس زعيم «القوميين الويلزيين»، أن حزبه «سيولي أولوية لمصلحة ويلز الوطنية، وينحي السياسات الحزبية جانباً، للحصول على دعم أكبر عدد ممكن من النواب من الأحزاب المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي في هذه الانتخابات الحاسمة».
وعلى أي حال، ستكشف الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كان رهان سوينسون ناجحاً، وما إذا كان حزبها سينهي عقوداً من «الثنائية الحزبية»، ويرجح كفة البرلمان لصالح دعم استفتاء جديد يفضي إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي.