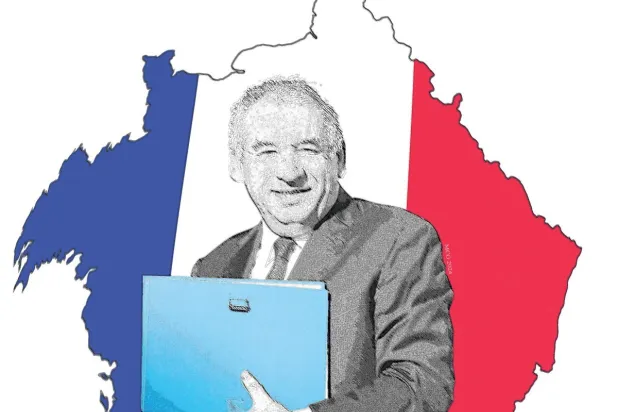صحيح أن العلاقات اللبنانية ـ الليبية مرّت بمراحل صعبة جداً في عهد الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، نتيجة اختفاء المرجع الديني الشيعي الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين خلال زيارة رسمية للعاصمة الليبية طرابلس أواخر شهر أغسطس (آب) من عام 1978، واتهام نظام القذافي بخطفهم وحجز حريتهم، لكنّها لم تبلغ هذا الدرك الذي بلغته الآن؛ إذ إنه يلامس قطع العلاقات نهائياً بين البلدين وفق ما لوّحت به السلطات الليبية، رداً على إنزال علم الثورة في بيروت وإحراقه، ورفع علم حركة «أمل» مكانه، وتحميل المكوّنات الليبية المتناحرة أصلاً وزر ما ارتكبه النظام البائد.
اندفاعة مناصري «أمل» إلى الشارع وتلويحهم بالتصعيد الشعبي فور وصول الوفد الليبي إلى بيروت للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية، قد تكون بالنسبة للبعض أمراً مفهوماً أو مبرّراً، ويمكن ضبطه أو الحدّ من فاعلية تحرّكه من قبل الأجهزة الأمنية المولجة حماية أمن القمّة وسلامة الوفود المشاركة. غير أن ما أثار القلق والريبة، المواقف التصعيدية التي صدرت عن رئيس السلطة التشريعية نبيه برّي (رئيس حركة أمل)، والرسائل التي وجهها ليس ضدّ ليبيا ووفدها فحسب، بل وصلت إلى التهديد بـ«6 شباط (فبراير) سياسية»، شبيهة بانتفاضة «6 شباط» العسكرية، التي قادها في عام 1984 لإسقاط اتفاق «17 أيار (مايو)» الذي أبرم مع الجانب الإسرائيلي غداة اجتياح لبنان في عام 1982.
رغم تحوّل جريمة اختفاء رجل الدين الشيعي السيد موسى الصدر إلى قضية وطنية، تعني جميع اللبنانيين وليس الطائفة الشيعية وحدها، فإنه ربما يتفهّم اللبنانيون مغالاة حركة «أمل» في حمل قضية الصدر، لكونه مؤسسها. إلا إنّ الاستعراضات في الشارع وإطلاق شعارات لطالما استخدمت في زمن الحرب، أيقظت في عقول الناس مشاهد استفزازية توحي برغبة البعض في هزّ الاستقرار الأمني، بتغطية دينية وسياسية، عبر البيان الصادر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي لوّح بالنزول إلى الشارع وقطع الطرق، في حال أصرت الدولة على حضور ليبيا القمّة.
بالنسبة لأصحاب هذه الطروحات توجد مبررات كافية لمنع تمثيل ليبيا في القمّة، في مقدمها «إمعان سلطتها الحالية في طمس معالم هذه القضية»، وفق ما أوضح القاضي حسن الشامي مقرر لجنة المتابعة اللبنانية لقضية الإمام الصدر ورفيقيه. ويشير الشامي إلى أنه «بدل أن تتعاون الأجهزة الليبية مع اللجنة اللبنانية، فإنها وجّهت أخيراً رسائل تهديد للسفارة اللبنانية في طرابلس، رداً على استفسارات لبنان عن مآل التحقيق المفترض إجراؤه مع قيادات أمنية تابعة للقذافي وموقوفين لديها، وهم على دراية كاملة بوقائع إخفاء الإمام الصدر».
- وقائع التواصل مع ليبيا
في حديث لـ«الشرق الأوسط»، قدّم القاضي الشامي ما وصفها بالرواية الكاملة عن مراحل التفاوض مع الجانب الليبي. وقال إنه «بعد أسبوع من مقتل معمّر القذافي وسقوط نظامه، وتحديداً في مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2011، توجّهت إلى العاصمة الليبية عن طريق القاهرة، وكانت قيادة السلطة انتقلت إلى مصطفى عبد الجليل الذي تولى رئاسة المجلس الوطني الليبي». وأردف أن عبد الجليل أبلغه بأن «قضية الإمام الصدر ستكون أولوية وطنية ليبية، وهذه مسؤوليتنا، ونحن شركاء في الظلم معكم». ثم أوضح أن عبد الجليل «شكّل لجنة ليبية لمتابعة القضية معنا، مؤلفة من وزير العدل والمدعي العام وممثل عن مكتب الرئيس (المجلس الوطني)، وقدّموا لنا وعوداً باستجواب موقوفين أساسيين، أبرزهم: عبد الله السنوسي، وعبد الله حجازي، وفرج أبو غالية، وعبد الله منصور، وهؤلاء هم رؤساء الأجهزة الأمنية وقادة عسكريون من الصف الأول وضمن الحلقة اللصيقة بمعمر القذافي، وكان بعضهم في سدّة المسؤولية عند خطف وإخفاء الإمام الصدر». ورغم إعلان السلطات الليبية عن تعاونها الكامل في هذه القضية، فإن الوقائع على الأرض كانت مختلفة، وفيها كثير من اللامبالاة؛ إذ لم تفِ بوعدها باستجواب القادة الأمنيين الموقوفين لديها، ولم تسلّم اللجنة اللبنانية نتائج تحقيقاتها الموعودة. ولفت الشامي إلى أن «وفداً قضائياً ليبياً حضر إلى بيروت مطلع عام 2012، مؤلفاً من ثلاثة قضاة من مكتب المدعي العام، وقابل وزير العدل اللبناني (يومذاك) شكيب قرطباوي، الذي حثهم على تسريع خطوات التحقيق. ثم اجتمعوا بعائلات المخطوفين وتعهدوا بالتعاون المطلق، وطلبوا موعداً لمقابلة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. إلا إن الأخير رفض استقبالهم لأنه يعتبر أن الأزمة موجودة في ليبيا وليست في لبنان، وبالتالي، يجب أن يكون دورهم وعملهم في طرابلس».
اللجنة اللبنانية اليوم تتهم نظيرتها الليبية بـ«المراوغة ومحاولة تضييع القضية، ونقلها إلى مسار الصفقات والتسويات المالية». ويشرح القاضي الشامي، مقرّر اللجنة اللبنانية، أنه «في 16 تموز (يوليو) 2012، أبلغتنا اللجنة الليبية بأنها عثرت على جثّة الإمام موسى الصدر، فانتقلنا مع عائلته إلى ليبيا، وكان معنا الدكتور فؤاد أيوب (رئيس الجامعة اللبنانية حالياً) لإجراء فحوص الحمض النووي (DNA) وجرى إخراج الجثة ووضعها في البراد. وبعد أخذ وردّ لأيام طويلة، قرّروا إجراء هذا الفحص في جمهورية البوسنة والهرسك فوافقنا، وأتت النتيجة غير مطابقة». واستطرد قائلاً إن «هذه المماطلة والاعتراض الذي بدأ من قبلهم، أوصلانا إلى توقيع مذكرة تفاهم في 1 آذار (مارس) 2014». ولفت الشامي إلى أن الجانب الليبي «أقرّ بموجب هذا الاتفاق بأن عملية الخطف حصلت في ليبيا من قبل معمّر القذافي وأركان نظامه، وأن الإمام الصدر لم يغادر طرابلس إلى روما، كما جاء في مزاعم نظام القذافي. ونصّت المذكرة على ثلاثة بنود أساسية، الأول: إجراء تحقيق مشترك والسماح لنا بطرح الأسئلة على الموقوفين الأمنيين. الثاني: البحث في كلّ السجون الليبية. والثالث: التواصل الدائم معنا وتبادل المعلومات».
- مسار التهديدات
القاضي الشامي يشدد على أن الليبيين «لم ينفّذوا واحداً في المائة من هذه المذكرة، وبسبب هذا التلكؤ، ذهبت في شهر آذار 2016 إلى ليبيا، وقابلت بعض الموقوفين من المقرّبين من القذافي، وطرحت بعض الأسئلة، لكني لم أتلق أجوبة كافية. ومنذ ذلك الوقت وفور عودتي من طرابلس قطعوا كلّ الاتصالات بنا»، متابعاً أنه «عندما أتى فايز السراج (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية) إلى السلطة لم يقم بأي خطوة إيجابية تجاهنا». قبل أن يكشف عن أن وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيّالا «أرسل كتاباً إلى السفارة اللبنانية في طرابلس، يتضمّن ما يكفي من التهديد رداً على مراجعاتنا المتكررة، وهذا الموقف يمكن ربطه بموقع سيّالا السابق، حيث كان يشغل موقع وكيل وزارة الخارجية الليبية وهو مقرّب من عائلة القذافي... وانطلاقاً من كلّ هذه الوقائع، تتحمل السلطات الليبية مسؤولية تمييع قضية الإمام الصدر، وعدم التزامهم، وأخلّوا بوعودهم».
- أزمة سياسية داخلية
على صعيد آخر، المفارقة أن الخلاف بشأن قضية الصدر لم يقتصر على الجانب الليبي؛ إذ إنها فجرت أزمة سياسية داخل لبنان، بدأت بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي... ومن ثم، انسحبت على علاقة الأخير برئيس الحكومة سعد الحريري، الذي انتقد بشدّة تصرفات مناصري حركة «أمل»، وبالذات، تمزيق العلم الليبي وإحراقه والتهديد باحتلال مطار بيروت الدولي ومرافق عامة، في حال سمح للوفد الليبي بدخول لبنان للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية. وهو ما أدى إلى اعتذار ليبيا عن عدم الحضور والتلويح بقطع العلاقات مع لبنان... وبالتالي، تخفيض مستوى حضور القيادات العربية في القمّة. وقد أعاد الحريري التذكير بأنّ «العلاقة بين الأشقاء يجب أن تعلو فوق الإساءات».
ردّ برّي على الحريري لم يتأخّر، بيد أنه تعدّى التخاطب السياسي، إلى حدّ التلويح بخيار الشارع مجدداً؛ إذ قال رئيس مجلس النواب: «الأسف كل الأسف ليس لغياب الوفد الليبي، بل لغياب الوفد اللبناني عن الإساءة الأم منذ أكثر من 4 عقود»، في إشارة إلى ما عدّه «إهمال» لبنان لقضية الإمام الصدر. وأضاف برّي: «في السياسة نحن نقوم بواجبنا حيال هذه القضية، وإذا كان هناك إصرار على تخطي رأينا، فإن شبابنا يقومون بالواجب»؛ في إشارة إلى نزول مناصري «أمل» إلى الشارع لمنع دخول الوفد الليبي.
- توضيح القضاء اللبناني
ولكن اتهام برّي بغياب دور الدولة عن قضية الصدر أو الإساءة إليها لم يمرّ من دون تعليق معاكس؛ إذ شدّد وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، على أن الدولة اللبنانية «أنجزت كلّ ما يمكن القيام به، وعيّنت لجنة قضائية وأمنية لمتابعة الملف، وانتقلت إلى ليبيا مرات عدة وقابلت مسؤولين ليبيين، لكن النتيجة لم تكن كما توخيناها جميعاً». وأضاف: «مَن أخفى الإمام الصدر ورفيقيه هو نظام معمّر القذافي، فلماذا نحوّل القضية إلى صراع لبناني داخلي؟ ولماذا نحمّل السلطات الليبية الحالية مسؤولية المأساة وهي غارقة في فوضى داخلية لا تستطيع الخروج منها؟ وهل يعقل الإساءة إلى الدول العربية الشقيقة بهذه الطريقة؟»، مؤكداً أن «وزارة العدل لم تقصّر بدورها، في أي مرحلة من المراحل، حتى قبل رحيل القذافي».
وفي غمرة الصراع على هذا الملفّ، جاء توقيف هنيبعل القذافي، نجل معمّر القذافي، لدى القضاء اللبناني، ليستخدم ورقة ضغط قويّة لإرغام الجانب الليبي على التعاون. وكان القضاء الليبي قد بعث بأكثر من مراسلة يطلب فيها تسليمه هنيبعل لمحاكمته، إلا إن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختفاء الصدر، الذي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه بجرم «إخفاء معلومات تتعلّق بمصير الصدر»، رفض إطلاق سراحه، مستنداً إلى أسباب قانونية تبرّر استمرار توقيفه.
- هنيبعل القذافي أداة ضغط
هنيبعل القذافي، الذي كان يقيم في سوريا لاجئا سياسيا وبحماية نظام بشّار الأسد، كان جرى استدراجه من مدينة اللاذقية إلى العاصمة السورية دمشق، بواسطة سيدة تدعى فاطمة، بالاتفاق مع النائب اللبناني الأسبق حسن يعقوب (نجل الشيخ محمد يعقوب المخطوف مع الصدر). ولدى وصول هنيبعل إلى دمشق، جرى تخديره من قبل مجموعة مسلحة، عملت على نقله إلى داخل لبنان بواسطة معبر غير شرعي، وسلّمته إلى يعقوب حيث جرى احتجازه وضربة وتعذيبه داخل شقة سكنية في منطقة البقاع اللبناني، ما تسبب بكسر في أنفه، وذلك في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015. بعدها اكتشف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبنانية أمر خطفه واحتجازه، وهو يعمل على تحريره، وتسليمه إلى القضاء، بينما جرى توقيف النائب السابق يعقوب و4 آخرين بجرم خطف القذافي الابن وحجز حريته وتعذيبه جسدياً ومعنوياً.
المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة ما زال يرفض الإفراج عن هنيبعل، رغم المطالبات المتكرّرة من النظام السوري، بتسلّمه كونه يتمتع بحق اللجوء السياسي في سوريا. ولقد دخلت موسكو في الأسابيع الأخيرة على خطّ الضغط على لبنان للإفراج عنه، في حين رفض القضاء اللبناني طلبات متكرّرة من القضاء الليبي لاستعادة القذافي بصفته مواطنا ليبيا مطلوبا لبلاده.
كذلك، يوجّه رجال قانون وسياسيون انتقادات للقضاء بسبب استمرار توقيف القذافي الابن، ويسخرون من اتهام هذا الموقوف بالتدخل في جريمة خطف الصدر ورفيقيه، علما بأن هنيبعل «لم يكن يتجاوز السنوات الثلاث من عمره يوم اختفاء الصدر»، لكنّ مصدراً قضائياً مطلعاً على تفاصيل الملف القضائي، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار استمرار التوقيف مبرر قانوناً، بسبب تعمّد القذافي الابن كتم معلومات تتعلّق بالجريمة المتمادية منذ أكثر من 40 سنة». وكشف أن «هنيبعل تدخّل لاحقاً بالجريمة، وهو اعترف صراحة أمام المحقق العدلي بأنه أصبح عضواً باللجنة الأمنية، وأعلن أنه لم تتم تصفية الإمام الصدر، بل جرى نقله إلى سجون عدّة وذكر أسماء هذه السجون».
ويرى مصدر سياسي في قوى «14 آذار» أن مقاربة الثنائي الشيعي «أمل» و«حزب الله» لقضية الإمام الصدر، تندرج في نطاق الاستثمار السياسي، الذي يتعدّى البحث الحقيقي عن مصير الإمام المغيّب. وطرح المصدر عبر «الشرق الأوسط» التساؤل: «كيف نفسّر ليونة هذا الفريق مع حضور ليبيا في القمّة العربية في بيروت عام 2002، عبر علي عبد السلام التريكي رئيس حكومة القذافي، في حين نجد اليوم هذه الانفعالات والتصرفات الميليشياوية ضدّ الذين أطاحوا بالقذافي؟».
ورأى أن هذا الفريق «يتعامل مع القضية بازدواجية تامّة؛ إذ إنه يقاتل من أجل دعوة النظام السوري للقمة، وهو يعلم يقيناً أن نظام الأسد شريك فعلي في مؤامرة خطف الصدر وإخفائه»، مذكراً بأن حافظ الأسد «استقبل القذافي بحفاوة بالغة، بعد أشهر قليلة من اختطاف الإمام الصدر، وعلاقات النظامين ظلّت وثيقة إلى حين سقوط نظام القذافي».