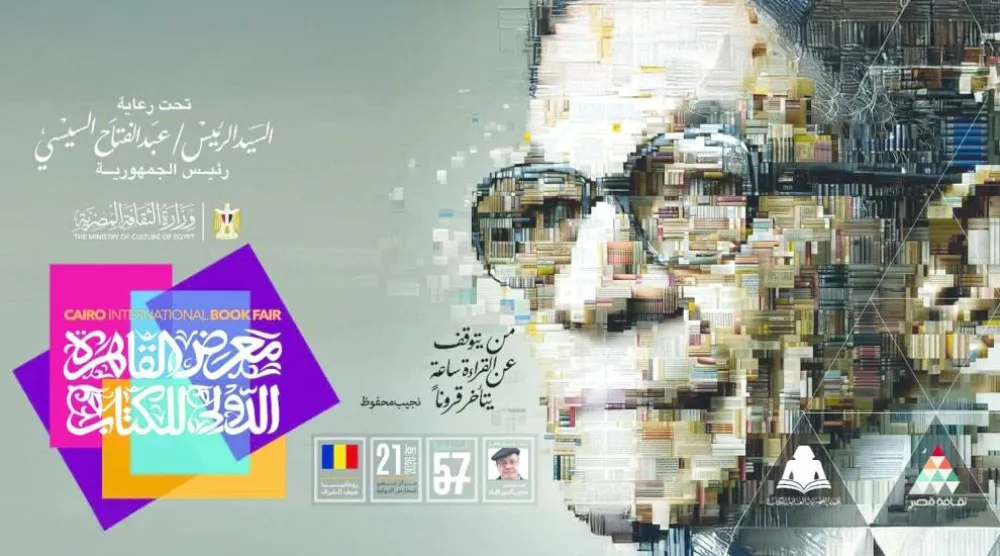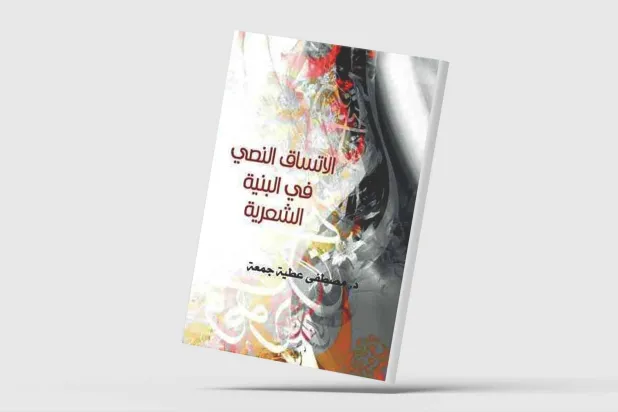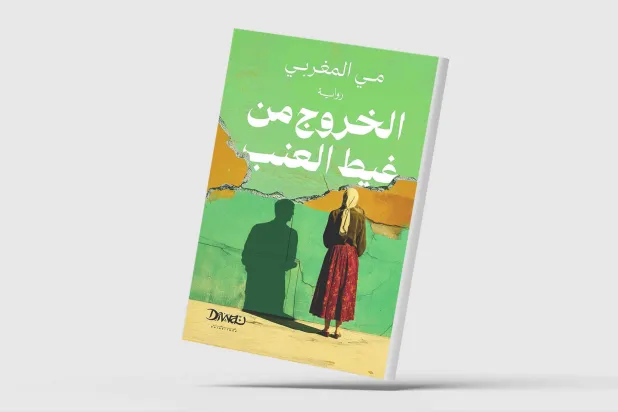يبدأ كتاب بين رودز، الذي يعتبر أشبه بسيرة ذاتية، بعبارة مقتبسة من رواية «العجوز والبحر» لإرنست همنغواي تقول إن «أحداً لا يكون وحيداً قط في البحر». ويتناول رودز عبر 480 صفحة مسيرة شاب دارت في معظمها حول البحر. أما هذا الشاب فهو باراك حسين أوباما، الذي كان رئيس رودز طيلة عقد تقريباً، في البداية عندما كان سيناتوراً صغيراً من إلينوي، وبعد ذلك رئيساً للولايات المتحدة.
في حملة أوباما الرئاسية الأولى تولى رودز مجموعة أدوار متنوعة، لكن بعد ذلك صعد نجمه وأصبح كاتب الخطابات الرئاسية الأول ثم نائب مستشار الأمن الوطني، وهو منصب منحه فرصة نادرة للتعرف على خفايا البيت الأبيض. وقد مكنه ذلك من طرح نفسه مراقباً للمشهد العام الباهت الذي كان أوباما الشخصية الرئيسية به.
ورغم ميله لتمجيد الذات، وهي نزعة سائدة في أوساط كثير من الأميركيين الذين يتولون مناصب عامة، يبدو السرد الذي يقدمه رودز مثيراً للاهتمام.
لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً كي يدرك رودز شخصية أوباما الحقيقية التي تمثل نتاجاً لتناقضات أميركية، وباعتباره شخصاً يعي جيداً كيف يمكنه البقاء، بل والازدهار في ظل نظام سياسي غالباً ما تبدو في إطاره وجهة النظر أهم من الواقع. فليس المهم من أنت وما الذي تؤمن به، على افتراض أنك تؤمن بأي شيء من الأساس، وإنما الأهمية الحقيقية هي للصورة التي يراك الناس عليها، وكيف يمكنك تسويق أفكارك.
يكتب رودز قائلاً: «بدت لغة أوباما صادقة» و«بدت سياساته أخلاقية». وتتركز الأهمية الكبرى هنا في كلمة «بدت».
ويتذكر رودز محادثة جرت بينه وبين أحد كبار مستشاري أوباما، الذي كان يشعر بالقلق إزاء جهل المرشح بالسياسة الخارجية، ووصف الحاشية الشابة المحيطة به بأنها لا تقل عنه جهلاً. واشتكى المستشار لرودز متحسراً: «ليس هناك من يعي أي شيء عن السياسة الخارجية».
ومع هذا لم يشعر رودز بالقلق. وكتب أنه: «رغبت في وجود بطل» في وقت كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى قائد، واعتقد الناخبون الأميركيون أنهم ينتخبون رئيساً.
ولأنه لم يكن لدى أوباما ما يقدمه سوى سحره المصطنع، حاول رودز استغلال «التعقيد» الذي تنطوي عليه حياته كعامل للتمويه على خوائه الفكري. ويذكرنا رودز بأن أوباما ولد في هاواي التي كانت في وقت مضى مستعمرة أميركية، وبالتالي يحمل بداخله جراح الإمبريالية، وأن والده كان مسلماً من قبيلة «لو» في كينيا التي عانت على يد الاستعمار البريطاني. وبعد نيل كينيا استقلالها تعرضت القبيلة للإذلال على يد قبيلة كيكويوس الأكبر حجماً. بجانب ذلك كان زوج والدة أوباما مسلماً من إندونيسيا وهي بلد عانت من الإمبريالية الهولندية، وقضى فيها أوباما فترة صباه وشبابه الأولى. وتبعاً لما ذكره رودز فإن الهويات المتنوعة التي حملها أوباما منحته «رؤية مختلفة للعالم».
وربما تتساءل: مختلفة عن ماذا؟ وهنا يجيب رودز: «لم تعكس وجهات نظره بالضرورة تلك الخاصة بالحكومة الأميركية».
بمعنى آخر فإن الرجل الذي وقع عليه الاختيار لتمثيل الحكومة الأميركية لم يشارك هذه الحكومة وجهات نظرها. وإنما كان رجلاً يتبع مساراً خاصاً به وأشبه بروح حرة بمقدورها فعل ما يحلو لها. إلا أننا اكتشفنا أنه لم يتمكن من فعل ما يحلو له على أرض الواقع بسبب الحكومة الأميركية، خصوصاً مجلسي النواب والشيوخ.
إذن ماذا فعل؟ يقول رودز: «لجأ إلى الخطابات لإعادة توجيه السياسة الخارجية الأميركية». وقد عبرت هيلاري كلينتون التي كانت غريمة لأوباما لفترة من الوقت ثم أصبحت لاحقاً وزيرة خارجيته عن هذا الأمر بوضوح أكبر بقولها: «في أي وقت تقع أزمة يخرج علينا أوباما بخطاب». وقد تولى رودز كتابة معظم هذه الخطابات دون أن تتوافر لديه معلومات عن القضايا التي يتناولها، وإنما كان يكتفي معظم الوقت بالبحث عبر «غوغل».
في وقت مبكر من رئاسته أخبر أوباما رودز أن «المشكلات تتركز في العالم العربي»، وقرر أن يفعل شيئاً حيال هذا الأمر. وكان هذا «الشيء» زيارته الكبرى للقاهرة لإلقاء خطاب هدف إلى إغداق الثناء على المسلمين، ومطالبتهم بإقرار أجندة الشرق الأوسط الكبير التي تولى الرئيس جورج دبليو بوش تنفيذها بعد «تحرير العراق». وكان الاختلاف أن بوش دعا للديمقراطية على نهج جيفرسون، بينما آمن أوباما، الذي لم يشارك الأميركيين مشاعر التحامل الخاصة بهم، بأن الغرب الفاسد ليس نموذجاً، وأن المسلمين عليهم بناء نموذج خاص بهم.
وأثناء خطابه الذي ألقاه من القاهرة، ندد أوباما بالنموذج الغربي على النحو التالي: «في الغرب هناك عنف بلا عقل وجنسية فجة وغياب لاحترام الحياة وتمجيد للمادية». الأسوأ من ذلك أن أوباما أشار إلى الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص باعتبارهما مدانين بمحاولة إملاء مشيئتهما على الآخرين والتدخل في شؤونهم، وهو ادعاء كرره من جديد أثناء محاولته التودد إلى آية الله علي خامنئي «المرشد الأعلى» للجمهورية الإسلامية.
في وقت لاحق أخبر رودز أنه «إذا أقرت الديمقراطية في مصر سيفوز (الإخوان المسلمون)». والآن نعلم أنه كان مخطئاً في هذا الأمر. ونعلم الآن أن هذا التوقع لم يكن دقيقاً. أثناء أول انتخابات رئاسية بعد مبارك حصل محمد مرسي مرشح «الإخوان المسلمين» على أقل من 10 في المائة من أصوات الناخبين المصريين. وفاز مرسي في الجولة الثانية عبر اجتذاب غالبية أصوات المعارضين على خلفية دعم قوي من واشنطن.
ولعب أوباما دوراً محورياً في إجبار الرئيس حسني مبارك على التنحي عن الرئاسة، الأمر الذي أشعل أزمة داخل مصر. ويكشف رودز كيف أن أوباما بعث بمبعوث خاص، وهو الدبلوماسي فرانك ويزنر، إلى القاهرة، لإقناع مبارك بالاستعداد لفترة انتقالية تستمر لأمد غير محدد بدلاً من محاولة سحق المظاهرات. واعتقاداً منه أنه يقود الآن استراتيجية مدعومة من الولايات المتحدة أذعن مبارك للمطالب الأميركية حتى فات الأوان على إحداث أي تحول في سياسته لاحتواء الحشود. في الوقت ذلك اتصل أوباما هاتفياً بمبارك وطلب منه صراحة التنحي عن الرئاسة.
المثير أن رودز يخبرنا أن المبعوث ويزنر لم يكن على علم بالتحركات التي يتخذها الرئيس. ولم يكن هذا مفاجئاً باعتبار أن ويزنر كان يمثل «الحكومة الأميركية» التي نظر إليها أوباما باعتبارها قوة سلبية على الصعيد السياسي العالمي.
وعندما وردت أنباء رحيل مبارك، قال أوباما: «أشعر بارتياح. أنا لم أكن أعرفه». وبعد ذلك أضاف: «لو كان الملك الأردني عبد الله لا أدري إن كنت سأفعل الأمر ذاته».
من ناحية أخرى فإن تعاطف أوباما مع «الإخوان المسلمين» وخلفيته المسلمة لم يجعلاه بالضرورة متعاطفاً مع الإسلام والمسلمين بكل عام، وإنما نبع التعاطف من اعتقاده بأنهم مناهضون للولايات المتحدة.
وذكر رودز قصة كان يسردها أوباما مراراً، وهي أنه ذات مرة كان في باكستان عندما كان صغيراً في السن برفقة صديقة له، وأن هذه الصديقة ركبت معه مصعداً وهي ترتدي ملابس جميلة دون حجاب. وفي أحد الطوابق دخل أحد الشباب الباكستانيين المصعد وعندما رأى الفتاة ترتدي ملابس غير محتشمة بدأ جسده في التعرق بشدة، لدرجة أنه اضطر لترك المصعد. وفي رأي أوباما، فإن الرجال المسلمين مهووسون بالجنس.
ويدعي رودز أن «حزب الله» والفلسطينيين، خصوصاً أنصار «حماس»، أحبوا أوباما، لكنه أشار إلى أن أوباما «لم يفعل أي شيء ملموس من أجل الفلسطينيين». في الواقع عيَّن أوباما السيناتور الديمقراطي السابق جورج ميتشل مبعوثاً خاصاً له للشرق الأوسط، ووجه إليه تعليمات بالمعاونة في إقامة دولة فلسطينية في غضون عام. ومع هذا سرعان ما نسي أوباما الأمر برمته، ولم يعط ميتشل قط الفرصة لتقديم تقرير بخصوص ما يجري. ومن غير المثير للدهشة أن ميتشل لم يرد ذكره في كتاب رودز.
وأوضح رودز أن هناك أمرين استحوذا على الأهمية الكبرى بالنسبة لأوباما. أولاً: أي ميزة يمكنه الادعاء بتحقيقها من وراء أي شيء. ورغم انتمائه إلى عرق مزدوج بين الأبيض والداكن، فإنه قرر خلال فترة ما من الثلاثينات في عمره تقديم نفسه باعتباره رجلاً من أصول سمراء تماماً لضمان الحصول على أصوات الأميركيين أبناء الأصول الأفريقية ككتلة. ولم يدرك أوباما أنه ضحية الاهتمام المفرط بالمظهر، وأن مسألة الانتماء إلى البيض أو السود لا تتعلق بلون البشرة فقط. فمن الممكن أن يكون المرء داكن البشرة في مظهره، لكنه «أبيض» في ثقافته وذوقه وأسلوب استخدامه للغة الجسد بل وفي تحاملاته. ويمكن أن تكون بشرتك داكنة، بينما شخصيتك أكثر تجسيداً لميول البيض عن البيض أنفسهم. إن اختصار رجل أو امرأة في لون البشرة أمر يتنافى مع العقل والمنطق.
ثانياً: رغب أوباما في الظهور في صورة بطل «الضحايا»، هدف حاول تحقيقه عبر سلسلة من الإيماءات الرمزية، بما في ذلك جولته الغريبة عبر مدن لاوس وفيتنام واليابان التي قصفتها الولايات المتحدة خلال حروب مختلفة. وفي كل محطة كان يلقي كلمة يعتذر خلالها عما اقترفته الولايات المتحدة؛ الأمر الذي أثار دهشة أبناء المدن لأنهم يدركون أن الحروب لا تجري من طرف واحد، وأن بلدانهم هي الأخرى لم تكن الضحية البريئة مثلما تظاهر أوباما.
أيضاً اعتقد أوباما أن إيران ضحية الاستئساد الأميركي؛ الأمر الذي أقنعه بأن يضرب بالقانون الأميركي والدولي عرض الحائط عبر المضي قدماً في «الاتفاق النووي» الذي لا بد أنه تحول إلى نموذج كلاسيكي للخداع الدبلوماسي.
أيضاً انطلقت محاولات أوباما للتودد إلى رجل فنزويلا القوي هوغو شافيز وزعيم كوبا راؤول كاسترو من مشاعر «التعاطف مع ضحايا» الإمبريالية الأميركية نفسها.
ومع هذا لم ينس أوباما قط الحاجة لضمان الحصول على الأصوات اللازمة. قبل الانتخابات التي خاضها للحصول على فترة رئاسية ثانية أجرى زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة واستقبلته الملكة. ووفق ما ذكره رودز فإن أوباما اعتقد أن الملكة شخصية «نموذجية وسوف تيسر بصورة هائلة علاقتنا مع البيض».
وأقام أوباما في قصر بكنغهام، واكتشف أفراد الأمن الأميركي أن الفئران تجول في الجناح المخصص لأوباما وزوجته ميشيل. وعلق رودز ساخراً على هذا بقوله: «ربما هذه إمبراطورية محتضرة!»
ورد أوباما: «لا تخبر السيدة الأولى فحسب!».
وحسب التصوير الذي قدمه رودز يبدو أوباما شخصاً أميركياً كارهاً لنفسه. وفي إحدى المرات قارن أوباما بين الولايات المتحدة والزعيم المغولي جنكيز خان الذي غزا جزءاً كبيراً من العالم بسبب عنفه المفرط.
وعلق أوباما على هذا الأمر بقوله: «لم يكن لديهم القنابل التي نملكها لكنهم كانوا بارعين في استخدام الخيول».
ولمح رودز إلى أنه يتفهم كراهية أوباما لأميركا باعتباره هو شخصياً يهودياً كارهاً لهويته.
قرب نهاية فترة رئاسة أوباما، سأل رودز وعدد من الحاشية المقربة منه الرئيس حول تعريف «عقيدة أوباما»، وهو مصطلح اخترعه أنصار أوباما. وبعد تكرار السؤال جاءت الإجابة أنها «لا تقترف الأخطاء الغبية!» لكن هل يعني ذلك أنه اقترف أخطاء ذكية؟
ويقول رودز أيضاً إن أوباما أخبره أن «وظيفتنا أن نسرد قصة جيدة حول من نكون».
حسناً، في كل الأحوال هذا ما فعله رودز الذي يبدو واضحا ًأنه يملك ملكة الكتابة، خصوصاً الأعمال الروائية، فقد طرح عبر كتابه قصة جيدة بالفعل، تذكرنا جميعاً كيف أن الديمقراطية عرضة للأخطار.
أوباما يحمل داخله «الجرح الإمبريالي» ويجسد تناقضات المجتمع الأميركي
كاتب خطاباته الأول بين رودز يكشف عن شخصية رئيسه السابق

«العالم كما هو» مغامرة باراك أوباما: نظرة من الداخل - تأليف: بين رودز - الناشر: بودلي هيد - 480 صفحة

أوباما يحمل داخله «الجرح الإمبريالي» ويجسد تناقضات المجتمع الأميركي

«العالم كما هو» مغامرة باراك أوباما: نظرة من الداخل - تأليف: بين رودز - الناشر: بودلي هيد - 480 صفحة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة