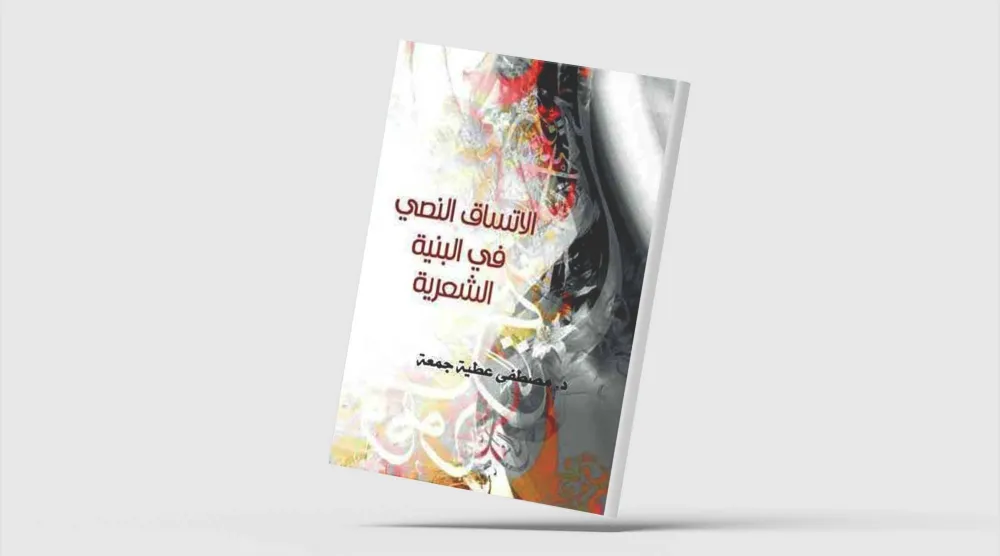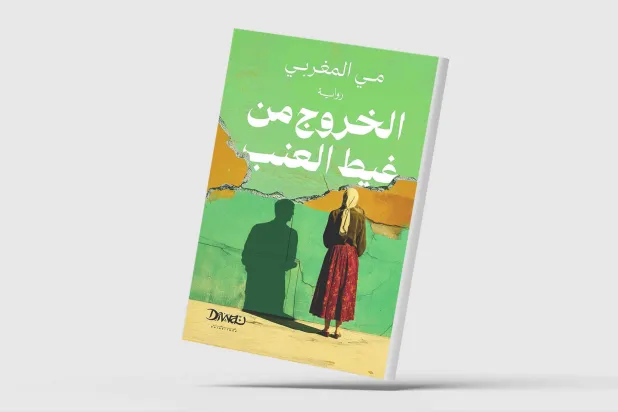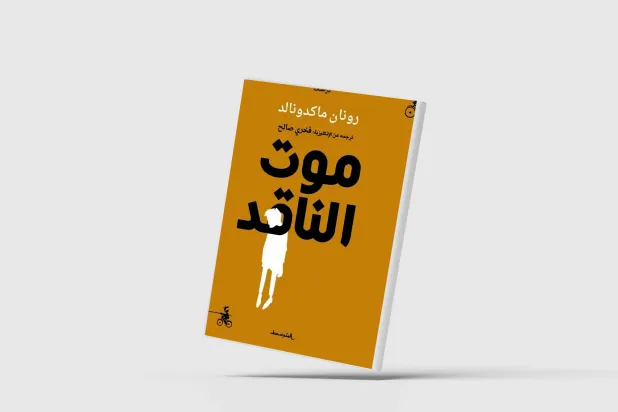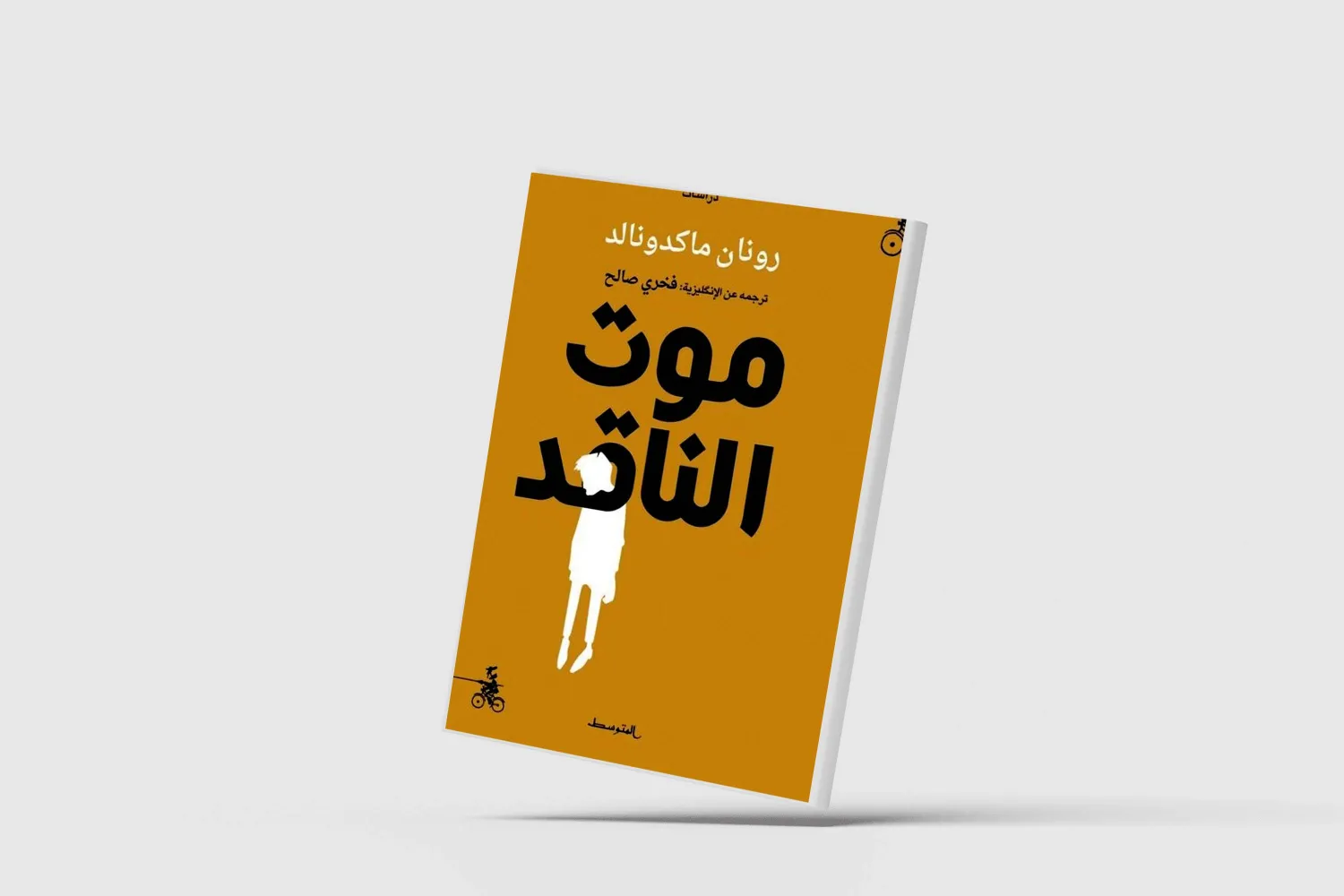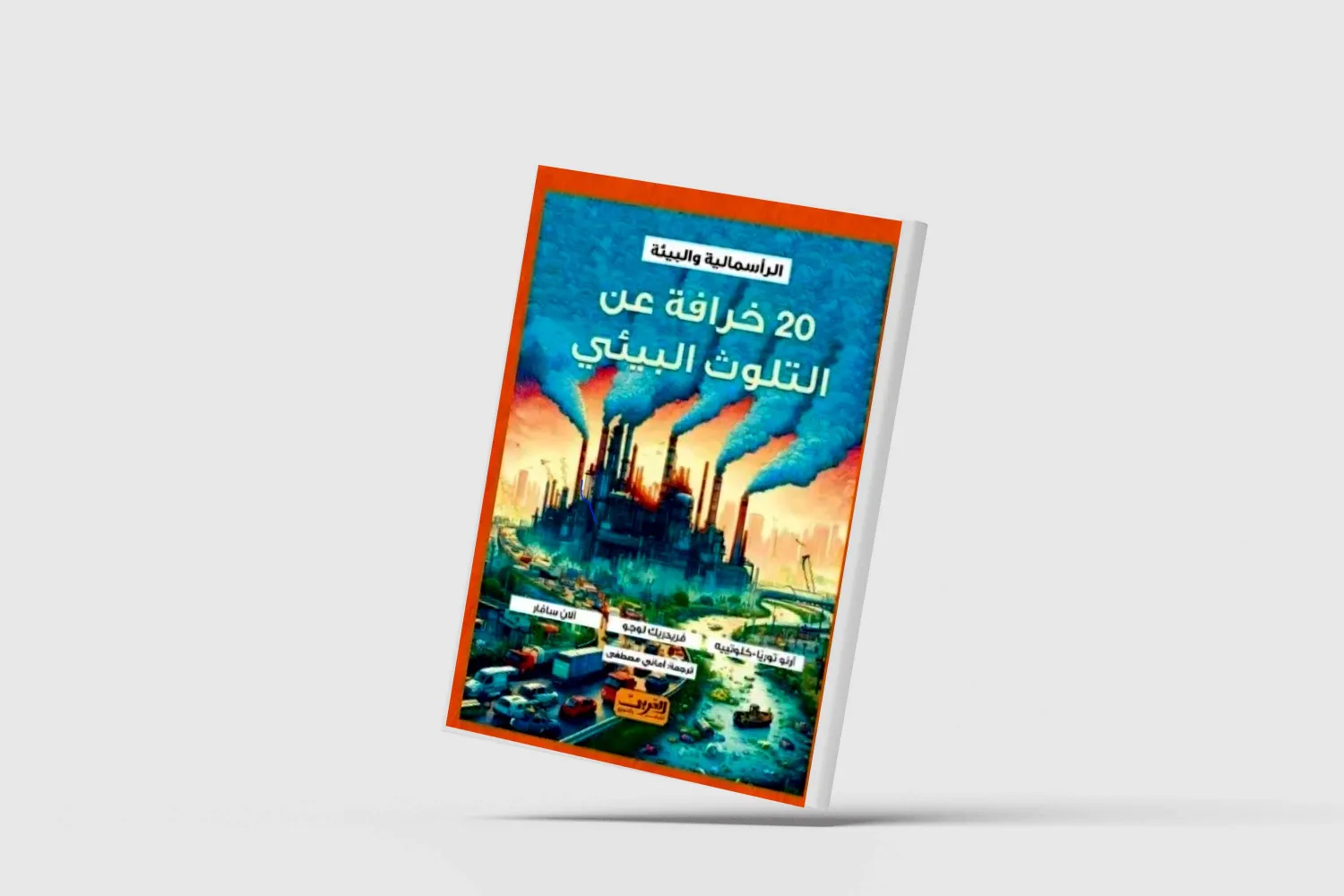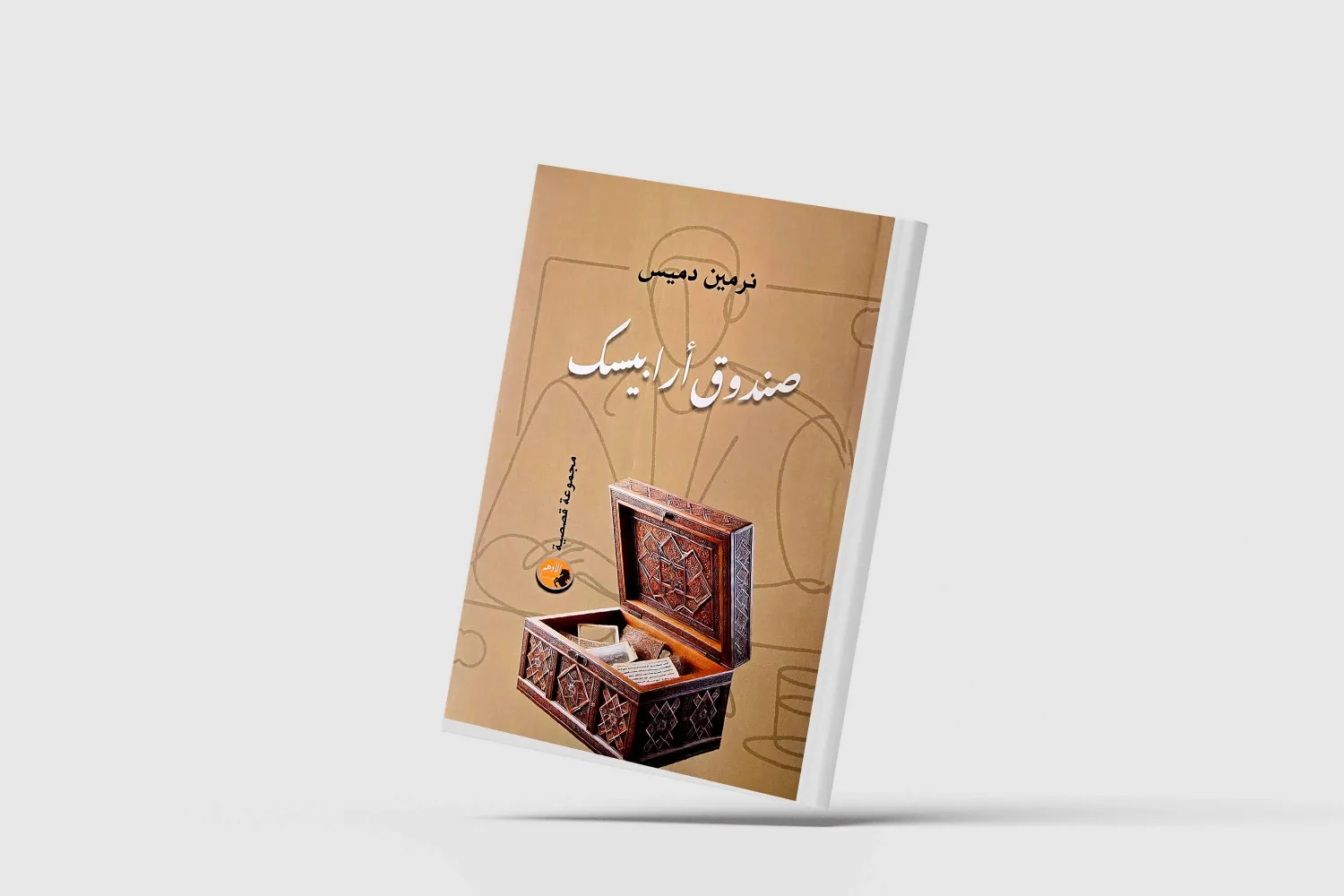يروي الكاتب البريطاني اليهودي «سيمون سكاما» Simon Schama، في كتابه «قصة اليهود» The story of the Jews الصادر عن دار نشر «فينتغ بوكس» في لندن Vintige Books London، تفاصيل حياة اليهود ابتداءً من استقرارهم في منطقة الألفنتين في دلتا النيل في مصر سنة 475 قبل الميلاد حتى نفيهم من إسبانيا سنة 1492 ميلادية. وهو يذكر أنهم في البداية كانوا عبيداً في مصر وطُردوا بشكل جماعي، وهم حتى اليوم يحتفلون بذكرى تحررهم من العبودية في مصر. وقد أمرهم إلههم بعدم العودة إلى مصر لكنهم عصوا أمره وعادوا مراراً وتكرارً إليها. واعتماداً على أسفار موسى الخمسة، وعلى آثار عمليات التنقيب في مصر، كانت بين يدي الكاتب مادة خصبة أعانته على جمع أدلة تفيده في نثر كتابه الذي يتناول مدة زمنية أسهمت في تكوين مصير مَن حُكم عليهم بالعيش حياة الشتات في الشرق والغرب.

ويذكر الكاتب أن اليهود عاشوا حياة الشتات، وأنهم أقلية مسحوقة دائماً بين قطبين، وبين حضارتين عظيمتين؛ بين الحضارة الأخمينية وحضارة الإغريق، بين بابل ووادي النيل، بين البطالمة والسلوقيين، ثم بين الإغريق والرومان.
وهكذا عاشوا منغلقين في قوقعة في أي مجتمع يستقرون فيه ، فمثلاً فترة انتشار الإمبراطورية الإغريقية وجدوا صعوبة في الحصول على المواطَنة الإغريقيّة لأنها كانت تعتمد على ثلاث ركائز: المسرح، والرياضة (الجيمانيزيوم) التي لا يمكن أن تتحقق من دون ملاعبَ العريُ التامُّ فيها إلزاميٌّ، الشيء الذي لا يتماشى مع تعاليم اليهودية، والدراسة الأكاديمية، التي لا يمكن أن يصلوا إليها.
صحيح أنهم عاشوا في سلام مع شعوب المنطقة (سوريين، وإغريقاً، وروماناً، وفُرساً، وآشوريين، وفراعنة، وفينيقيين) لكن دائماً كانوا يشعرون بأن الخطر على الأبواب، حسب الكاتب، وأي حدث عابر قد يتحول إلى شغب ثم تمرُّد ثم مجزرة بحقهم. ومن الطبيعي أن تتبع ذلك مجاعة وصلت أحياناً إلى تسجيل حالات أكل الأحذية وحتى لحوم البشر، ومذابح جماعية تشمل الأطفال والنساء وتدنيس المقدسات. ويضرب الكاتب هنا مثلاً بمحاولة انقلاب فاشلة قام بها القديس ياسون على الملك السلوقي أنطيوخس إبيفانيوس الرابع، فتحول هذا الأخير إلى وحش، وأمر بقتل كل يهودي في شوارع القدس وهدم المقدسات، وقدَّم الخنازير أضحية بشكل ساخر بدلاً من الخراف، وأجبر اليهود على أكل لحم الخنزير، وأخذ آلاف الأسرى لبيعهم في سوق النخاسة. وبعد فترة استقرار قصيرة في القدس، وأفول الحضارة الإغريقيّة لتحل مكانها الحضارة الرومانية، ذهب وفد من اليهود إلى الملك الروماني لمناشدته منح اليهود في القدس حكماً ذاتياً.
طبعاً هذه كانت مماطلة لا تُلغي وقوع الكارثة لكن تؤجلها. حتى إن الملك غاليكولا أمر ببناء تمثال له على هيئة إله وتنصيبه وسط معبد اليهود الذين كانوا يَعدّون ذلك من الكبائر.
حتى جاء اليوم الذي وقف فيه على أبوابها الملك الروماني بومبي الكبير فارضاً حصاراً دام عامين انتهى باصطحابه الأسرى اليهود مقيدين بالسلاسل لعرضهم في شوارع روما، تلت ذلك هجرة جماعية كانت آخر هجرة لهم. وهم فسروا ذلك بوصفه عقاباً إلهياً «لأنه لا يمكن أن يكون الله قد تخلى عنهم في وقت السلم كما في وقت الحرب. لأن السلم لم يكن سلم عزٍّ بل كان ذلاً».
وفي أوروبا العصور الوسطى، كان مفروضاً عليهم ارتداء شعار خاص لتمييزهم أيضاً عن باقي الناس، ومُنعوا من العمل في الوظائف الرسمية الحكومية مثل مهن الطبيب والمحامي والقاضي، حتى المهن الحرفية تم حرمانهم من التسجيل في نقاباتها. هذا بالنسبة ليهود الأشكنازي، أما بالنسبة ليهود إسبانيا السفاردي، فقد أصدرت الملكة إيزابيلا سنة 1492 (نفس سنة خروج الإسلام من إسبانيا) قانوناً لطرد اليهود من إسبانيا، ومنع اليهود من ارتداء الملابس الفاخرة، والتجول فقط في النهار، والعيش في أحياءً منعزلة، كما لا يحق لهم العمل مع المسيحيين أو العكس أو يكون عندهم خادمة مسيحية مثلاً، ومنعهم من امتلاك عقارات أو منح القروض إلا بشروط معينة...
لكن ما سبب هذا الاضطهاد بحق اليهود؟
حسب الكاتب، هناك سببان: أولاً وشايتهم إلى الملك الروماني وتحريضه لمحاكمة يسوع وهتافهم وقت صلبه «اقتلوه... اقتلوه»، أما السبب الآخر فهو أن الملكة إيزابيلا وضعت أمام اليهود الاختيار بين ثلاثة احتمالات: اعتناق المسيحية أو القتل أو الطرد، في حملةٍ لتطهير البلد من اليهودية. القليل من اليهود اعتنق المسيحية؛ خوفاً، وكان يطلق عليهم اسم «كونفرتو»، أو «المسيحيون الجدد»، لكن في السر استمروا في ممارسة طقوسهم اليهودية، وكان يطلق عليهم اسم «Marranos».
كتاب «قصة اليهود» لم يقتصر فقط على ذلك، فإلى إلى جانب فصول عن الحملات والحروب، هناك فصول عن اليهود في شبه الجزيرة العربية فترة النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، ويهود الأندلس، وصلاح الدين الأيوبي، ويهود مصر، وكذلك يهود بريطانيا، ويهود إسبانيا. وكذلك يفتح لنا الكتاب نوافذ على الحياة الاجتماعية والثقافية لشعوب ذاك الزمان، ويسرد تفاصيل الهندسة المعمارية بجماليّاتها خصوصاً لدى الإغريق، حيث اشتهرت عمارتهم بالأعمدة والإفريز والرواق والفسيفساء، الشيء الذي أخذه منهم اليهود.
لكنَّ هناك نقاطاً أخفق المؤلف في تسليط الضوء عليها أو طرحها في سياق المرحلة التاريخية التي يتناولها الكتاب، ومنها مرحلة حياة عيسى، عليه السلام، من لحظة ولادته حتى وقت محاكمته وصلبه، رغم أهميتها في مجريات الأحداث بتفاصيلها التي كانت انعطافاً كبيراً في تاريخ اليهود خصوصاً والعالم عموماً. ثانياً، وعلى الرغم من دقة وموضوعية المعلومات ورشاقة السرد، فإن الكاتب لم يذكر لحظات أو مراحل إيجابية عن حياة اليهود بقدر ما ذكر أهوال الحروب والحملات ضدهم وتوابعها عليهم.
وأعتمد المؤلف على المخطوطات parchments، أو رسائل على ورق البردي، وعلى قطع فخارية أثرية اكتُشفت في القرن الماضي ضمن حملات بتمويل حكومي ضخم لبعثات أثرية بريطانية وأميركية وفرنسية تسمى «Fact finding expenditures»، أي «بعثات البحث عن الحقيقة». وكذلك على وثائق تروي قصص ناس عاديين من عقود زواج أو ملفات دعاوى قضائية، بالإضافة إلى مؤلفات المؤرخ اليهودي يوسيفوس فلافيو.