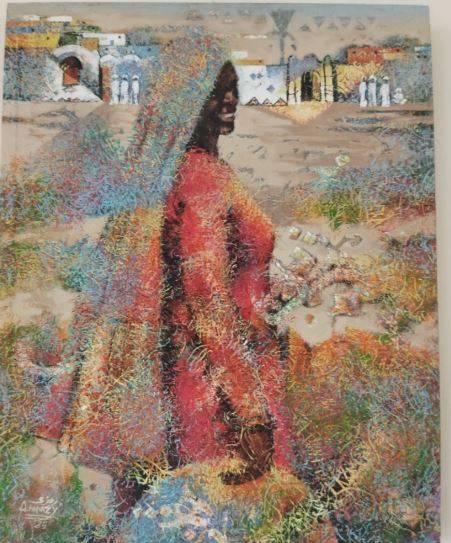في البداية، قد يخطُر في البال أنّ الأبيض الذي طُلِب من الحاضرين ارتداؤه في حفل عمرو دياب الثالث في بيروت مجرّد فكرة مُستهلَكة، درجت في حفلات سابقة وفقدت وهجها، أو ربما فيها شيء من «التفاخُر» بفرض زي موحَّد على الجمهور. غير أنّ ظهور الفنان المصري نفسه مرتدياً الأبيض، ومعه كلّ عازفي فرقته، بدَّد سريعاً هذا الانطباع. بدا الأبيض هنا رغبة في التوحُّد مع الآتين من أجله، وخَلْق لحظة جامعة تبدأ من اللباس، ولا تنتهي إلا حين تختلط الأصوات والأنفاس في وحدة الحناجر.

الآلاف بالأبيض، كأنّه عرسٌ جماعي لبيروت، أو احتفالٌ بحياتها التي تصرّ أن تبقى حيّة، مهما اشتدّت عثراتها.
الأبيض بدا هذه المرة أبعد من مجرَّد لون؛ إذ تحوَّل إلى استعارة عن البدايات، وعن رغبة مدينة تعرف أنّ الغد غير مضمون، لكنها تصرّ على أن تعيش لحظتها كاملة. الأبيض هنا كان وعداً بالنقاء وسط الضجيج، ورغبة في خَلْق فسحة من الصفاء، في مدينة اعتادت أن ترتدي الأسود في محطّات كثيرة من تاريخها.

على الواجهة البحرية، حيث تلتقي المدينة بالبحر وبقَدَرها المُعلّق بين الأمل والخيبة، كان المشهد مهيباً. بيروت التي عاشت هذا الصيف مهرجانات صاخبة، عادت مساء السبت لتُثبت أنها تعرف كيف تَهِب ليلَها إشراقاً من شمس لا تغيب. بدت كأنها تُعلن أمام العالم أنها، رغم جراحها، ما زالت مدينة قادرة على الفرح؛ لا تنتظر مناسبة لتُثبت ذلك، وإنما تصنعه بنفسها.

نظّمت شركة «فنتشر لايف ستايل» لصاحبها ربيع مقبل حفلاً يليق بالأضخم: ديكور واسع، شاشات عملاقة، إضاءة وألعاب نارية، وأجواء لا تهدأ. كلّ شيء كان مُعَدّاً ليُشعر الجمهور أنه في قلب حدث استثنائي، وليس حفلاً عادياً على الإطلاق.
دخل عمرو دياب المسرح وسط عدّ تنازلي من 10 ثوانٍ، مُبدّداً في لحظة انتظاراً امتدّ لدى البعض لساعات. منذ السادسة مساء، بدأ الحضور يتوافدون، واقفين أكثر من جالسين. وعند العاشرة والنصف ليلاً، حين أطلّ، تحوّل انتظارهم إلى رقص وغناء وقفزات لا تتوقّف، كأنّ اللقاء نفسه يكفي ليجعل الناس ينسون تعبهم وحرَّ الصيف. ومع بدء الحفل، بدا كأنّ المدينة نفسها تنفَّست، وأنّ بيروت التي تحيا على وَقْع المفاجآت عرفت كيف تلتقط نَفَساً جماعياً مع موسيقاه.

غنَّى الجديد والقديم. وحين سأل إنْ كان ألبومه الأخير قد وصل إلى الحاضرين، ارتفعت الأصوات تُردّد أغنياته. بدا عمرو دياب هذه المرة كأنه يمنح شيئاً من ذاته، ولا يُغنّي فقط. يتنقَّل بخفّة على المسرح، ليؤكد مع كلّ حركة أنّ العمر يُقاس بالقدرة على الإشعاع، والفنان حين يظلّ متصلاً بالناس يبقى عصيّاً على الذبول.

الوجوه من جميع الأعمار، والغالب كان جيل الشباب. مراهقون حفظوا أغنيات وُلدت قبلهم بسنوات، وردّدوها كما لو كانت تخصّهم. وفي جانب آخر، كان الكبار يستعيدون شيئاً من زمنهم الخاص؛ من سنوات الجامعة، أو من ليالٍ رافقهم فيها صوته في الحبّ والفقد والرحيل. هذه اللحظة الجامعة بين الأجيال جعلت الحفل أكثر من مناسبة فنّية. جعلته برهاناً على قدرة الموسيقى وحدها على ردم الفجوات الزمنية، وعلى أنّ الفنان الذي تحفظ صوته الأجيال المتعاقبة، يبقى أكبر من زمنه.

هذا أحد أسرار عمرو دياب. إنه مغنّي أجيال، يعبُر الزمن من «ما تخافيش»، و«قمرين»، و«تملّي معاك»، و«هي عاملة إيه»، إلى «خطفوني»، في 2025، التي افتتح بها السهرة وختمها. قليلون ينجحون في أن يكونوا صوتاً أكثر من زمن واحد، ودياب أبرز هؤلاء القلّة. وبينما يُغنّي، يُقدّم أيضاً لحظة مشتركة يعيشها جمهور واسع يجد نفسه فيها.
وحين التفتَ إلى أغنياته القديمة، أخبر الجَرْف البشري أنه يُعيدهم إلى الوراء؛ إلى لحظات من ذاكرتهم الشخصية. هنا يكمُن الرابط السحري بين الفنان وجمهوره: النوستالجيا التي تُرجع الحاضر إلى الماضي، وتجعل الحفل حدثاً يتجاوز آنيته ليصبح جزءاً من الذاكرة الجمعية. في تلك اللحظة بدا جلياً تحوُّل الأمسية إلى مساحة شعورية تُعيد الناس إلى أماكن ووجوه وأوقات مضت.

وعند منتصف الليل، كانت الألعاب النارية تُزيّن سماء بيروت، والمدينة لا تزال ترقص. الشوارع امتلأت بزحمة كأنها في عزّ النهار، فيما الناس يغادرون الحفل، وهم يواصلون الغناء. كانت بيروت تلك الليلة تحتفل بذاتها، وتؤكد أنّ الحياة فيها أقوى من الموت، وصوتاً واحداً قادر أن يُعيد إليها صورتها التي تستحق.
في النهاية، بدا الأبيض الذي ارتداه الجميع أشبه بإعلان جماعي: أنّ بيروت، مثل عمرو دياب، تعرف كيف تتجدَّد، وكيف تقول في مواجهة كلّ الانطفاءات. إنها عصيّة على الغياب.