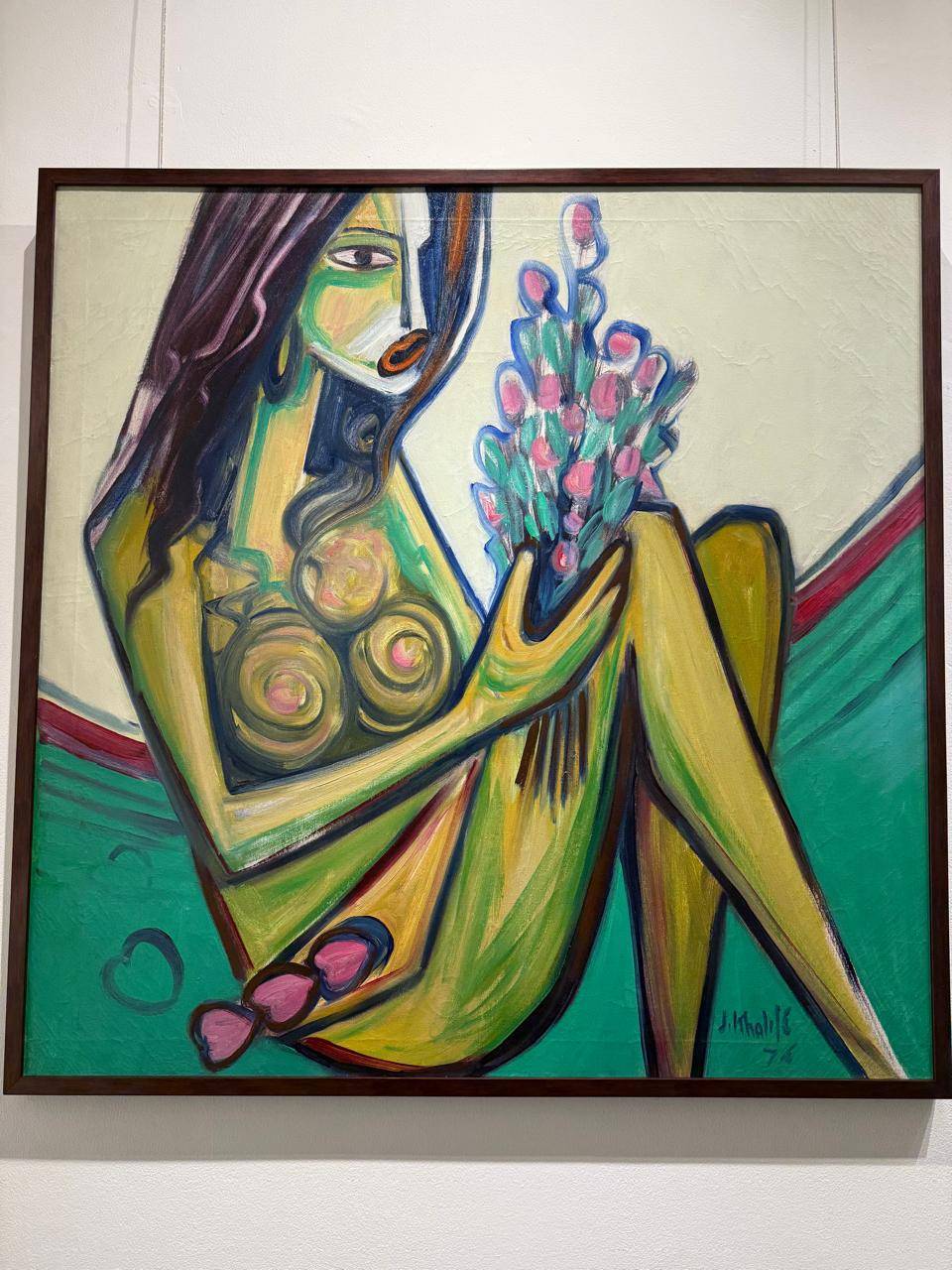كان مُحقّاً مارسيل خليفة حين طرح، بنبرة لا تخلو من القلق، سؤاله: «هل من مكان للقصيدة اليوم؟». ليس هذا السؤال وليد لحظة عابرة أو انفعال مسرحي. إنه امتداد لانشغالات فكرية وفنّية رافقته منذ بداياته، حيث ظلَّ مشغولاً بمصير الشِّعر والموسيقى في زمن التراخي. قُبيل انطلاق حفله في «مهرجانات صيدا»، أراد أن يشارك جمهوره هذا الهمّ، كأنه يضع الحفل في سياقه الوجودي والثقافي منذ اللحظة الأولى. فهو يدرك أنَّ الزمن تغيَّر، وأنَّ المشهد الفنّي لم يعد يُشبه الحلم الذي حمله يوماً عن الأضواء والموسيقى، ومع ذلك لا يزال يؤمن بقدرته على أن يكون الصوت المختلف وسط ضجيج الأصوات المُتشابهة، والطائر الذي يختار التحليق خارج السرب الذي يندفع جماعياً نحو مسار واحد.

لهذا السبب، على الأرجح، قرَّر أن يقيم حفلاً ينطلق منه هو نحو الناس، لا العكس. أراد أن يقود أمسيته وفق إيقاعه الخاص، وأن يفرض ذائقته الفنّية حتى لو خالفت توقّعات بعض جمهوره. لم يُقدّم كلّ ما انتظره الحاضرون منه، وبدا واضحاً إعلانه رَسْم الحفل كما يراه. بعض الحاضرين خلف كاتبة هذه السطور أبدوا تبرّمهم حين طغى العزف على الغناء، فيما أُعجب آخرون بأداء رامي خليفة على البيانو، وإنْ لمحوا فيه إفراطاً في استعراض موهبة الابن في حضرة الأب. لكنَّ مارسيل، الذي خَبِرَ مسارح العالم، لم يكن غافلاً عمّا يدور حوله؛ يعرف تماماً متى يتململ الجمهور، لكنه يصرّ على أن يقوده إلى المرتفعات التي يقيم فيها. والدليل أنه، حين لم تستدعِ إحدى الأغنيات أجواء حماسية، طلب من الحاضرين التوقّف عن التصفيق والاكتفاء بالإصغاء، وعندما سلَّم العزف لابنه تحية لضحايا مرفأ بيروت، ناشدهم أن ينصتوا جيداً، إدراكاً منه لخصوصية اللحظة وصفائها.
وصيدا التي احتفظت بمهرجاناتها وسط واقع سياسي وأمني واقتصادي لا يمنح سبباً واحداً للتمسُّك، جعلت من هذه الأمسية إعلان حياة. في مدينة لم يعُد الأمان فيها مضموناً، يصبح الغناء فعلاً وجودياً، وتغدو المهرجانات جسراً بين الأمل والحاضر، مهما كانت الإمكانات. هنا، ينتفي أيُّ داعٍ للمقارنة مع عروض أخرى ضخمة الإضاءة والميزانيات، لأنَّ ما عجزت عنه التقنية عوَّضه المكان: مسرحٌ لا يبعد سوى أمتار عن البحر، يُجاوره صرح قلعة صيدا التاريخية، ويُباركه قمر مُكتمل يضيف هيبة إلى المشهد. هكذا بدا الحفل كأنه يواجه محاولات تشويه صورة المدينة، ويؤكد أنّ لأبنائها الحقّ في الفرح والاحتفال بالحياة.
وفي ذكرى رحيل محمود درويش، لم يفُت مارسيل خليفة عناق صديقه وشريكه في القصيدة. كان الجمهور ينتظر «ريتا»، وحين غنَّاها، عمَّ شعور خاص بأنَّ الحفل يخصّ كل فرد على نحو شخصي. تحت حرّ أغسطس (آب) ورطوبة البحر، وجد كثيرون أنفسهم يتمنّون أن يفيض الحفل بما جاءوا من أجله من أغنيات محفورة في الذاكرة. «ريتا» كانت من ذلك الصنف المُشتهى، وكذلك «في البال أغنية»، و«منتصب القامة» التي تحوَّلت نشيداً جماعياً، خصوصاً لحاضرين من غزة الجريحة، لوَّحوا بالكوفية وسط التصفيق، كأنهم يلتقطون من حضن موسيقاه عزاء يتيح احتمال عالم لم يعد يُحتمل.
أما «أيها المارّون بين الكلمات العابرة» فتجاوزت كونها قصيدة غنائية أدّاها مارسيل بتأثّر عميق. أرادها موقفاً فنّياً وسياسياً؛ وبصوته، تحوّلت كلمات درويش إلى نداء يهدر بالحق: «اخرجوا من أرضنا/ من برّنا/ من بحرنا... من قمحنا/ من ملحنا/ من جرحنا/ من كلّ شيء». كلماتٌ تُحَسّ، تُلمَس في الصدور، وتمنح السامعين لحظة من عدالة الوجود، لأنها كُتبت لتُحرّك الأعماق.

راحلٌ آخر أصرّ مارسيل على تحيّته هو زياد الرحباني. لم يغنِّ من أعماله، لكنه منحه لحظة موسيقية خاصة، إذ عزف رامي على البيانو وتبعه والده على العود. ومارسيل الذي يُعانق عوده أينما حلَّ، ويغنّي جالساً بصوت لا يزال يتوهّج، بدا كأنَّ العمر لم يمرّ عليه، وكأنه لم يتعب من النداء. حفلُه كان مساحة لتكريم مَن أحبّهم: محمود درويش، وفلسطين، والجنوب اللبناني، وزياد العبقري، وتشي غيفارا الثائر الذي أهداه موسيقى تانغو، وبيروت ومرفأها القتيل، والأوطان التي تؤلم إن اخترناها أو اختارتنا، وريتا بعينَيْها العسليتَيْن، وابنه رامي الذي منح الأمسية لمسة عذبة بانغماسه حتى النهاية في سحر البيانو.

وعلى مقربة من المسرح، استعدّ صيادو صيدا لملاقاته بأغنية «البحرية». هذه الأغنية الأيقونة التي لا يكتمل حفل لمارسيل من دونها، كانت الذروة العاطفية للأمسية. «هيلا هيلا» على وَقْع هدير المراكب، والقمر البدر شاهداً. موج البحر هادئ، لعلّه يتململ من لهيب أغسطس، ولا مزاج له ليشدّ الحيل ويرتفع أكثر. أو لعلّه أجَّل ارتفاعه إلى ما بعد الحفل، حيث «فَقَش» على طول الطريق المؤدّية إلى باصات المُغادرة كأنه يقول للآتين إلى المدينة: «شكراً لزيارتكم، لا تُطيلوا الغياب».
وحين ارتفعت «شدّوا الهِمّة»، سأل الفنان عن «الزلغوطة» لتُعلن الفرح على طريقتها. عندها، تحوّل الختام إلى مهرجان قائم بذاته. فمارسيل خليفة، العارف بأسرار المسرح، يُدرك متى يُعانق عوده ويشرد في النغم، ومتى يُشعل الحماسة ليُنهض كلَّ جالس على مقعده. في الحالتَيْن، يظلّ فناناً يُقدَّر، لأنه يعرف أنّ الفنّ ليس زِينة وقتيّة، وأنه قمم تُرتقى ومكانة لا ينبغي التنازل عنها. وفي صيدا، لم يغادر قمّته طوال الأمسية.