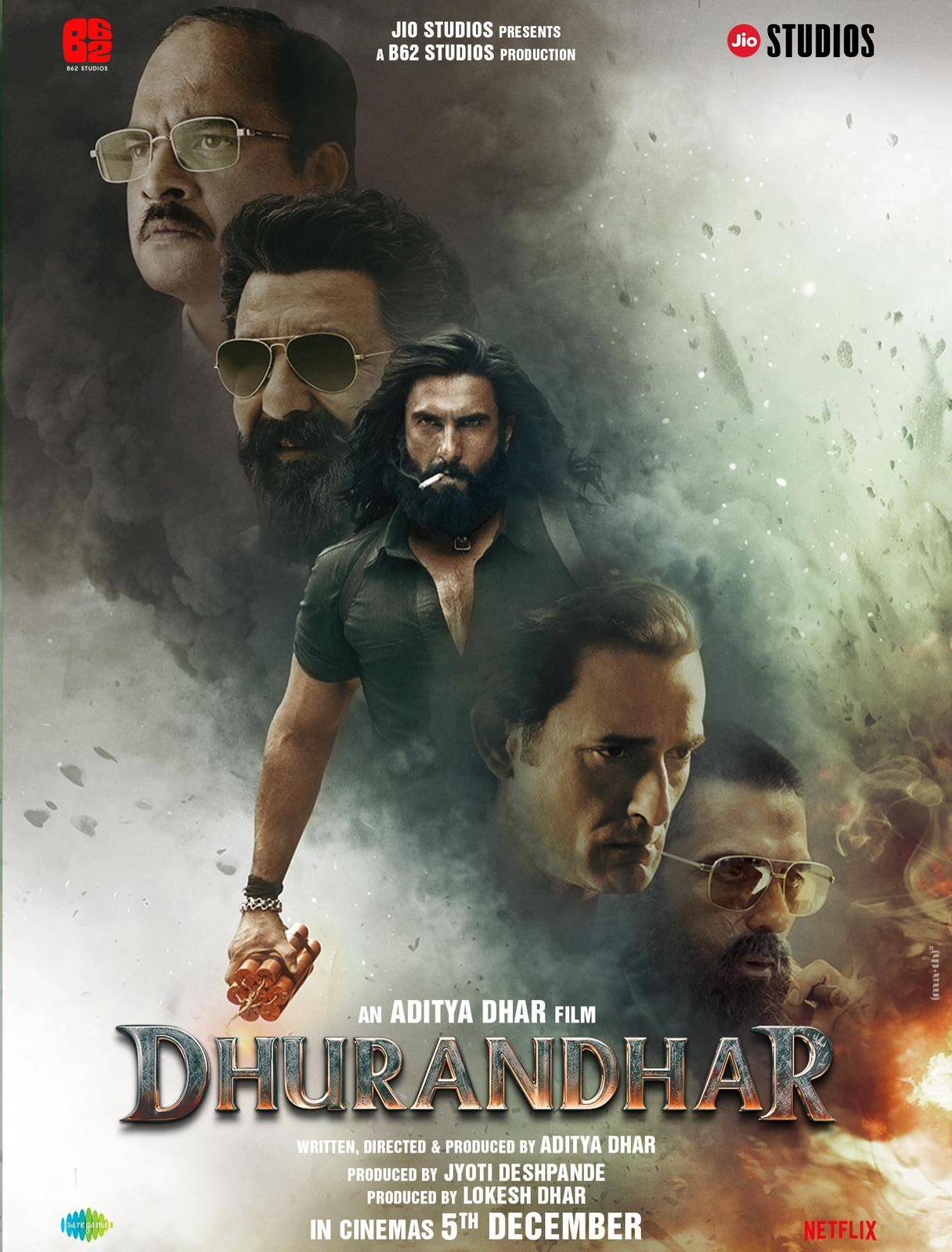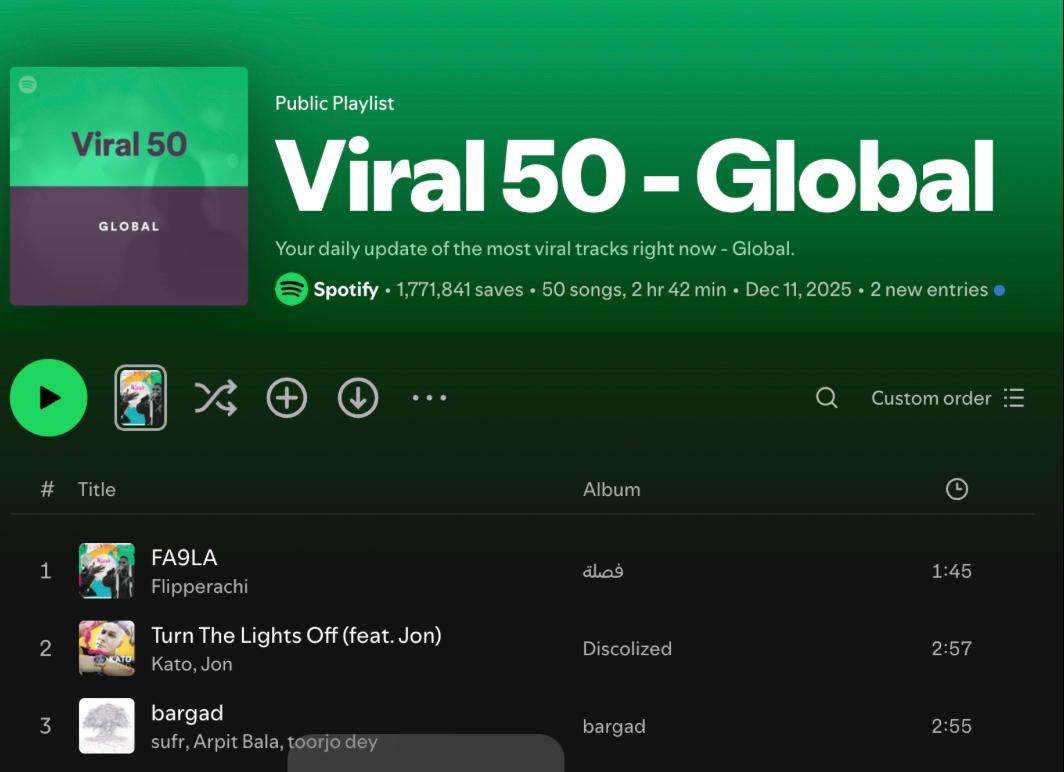بتبنّيه الحكايات الأسطورية حول أصل الحياة، وسردها شِعرياً؛ تتداخل شخصيات الفنان المصري وائل شوقي، بين آلهة ورجال ونساء وحيوانات، لتُشكِّل ما يُشبه رقصة الكون الغامضة. ففيلمه «أنا تراتيل المعابد الجديدة»، المعروض في بينالي الشارقة حتى يونيو (حزيران) المقبل، يُكمل مساره الفنّي الباحث عن تفسيرات للعملية البطيئة والمتضاربة التي اتّبعها العالم لخَلْق توازنه الخاص في خضمّ تراكُم الحروب وغضب الطبيعة. نمطُ الخَلْق هذا يتكرّر إلى ما لا نهاية وسط حلقة مفرغة يسبرها الفنان الشهير بأفلامه المسرحية الثرية واستكشافاته للسرديات القديمة والمعاصرة حول الهوية والتقاليد والإبداع.
ملأ مشاهدون غرفة العرض في «حديقة بومبي» بالشارقة، ومنهم مَن ضاقت به فسحة الجلوس، فتابع فيلمه وقوفاً لنحو ساعة. الشخصيات آسرة بأشكالها وتوظيفها؛ تسرد جَمْعه المذهل بين الخرافة والحقيقة. يتحدّث وائل شوقي لـ«الشرق الأوسط» عن همِّه الفنّي مُمثَّلاً بمحاولة البحث عن أصل الأشياء. فأعماله، أكانت رسماً أو تشكيلاً ونحتاً وتركيباً وأداء وفنَّ عرائس، قوامُها مزج الصور بالتاريخ والأسطورة والخيال والحقيقة.
هذا فيلمه الأول حول تصوّرات مبنية على الأساطير الإغريقية؛ عبره يطرح مفهوم نشأة الكون من وجهة نظرها، حيث البداية من الصمت قبل تحوّله إلى فوضى. يقول: «بتحقُّق تدحرُج الأشياء، بعد حلول الفوضى، تُعلن الأسطورة الإغريقية ولادة السماء والأرض. بحدوث لقائهما، تبدأ مرحلة حكم الآلهة. فالكون مراحل مختلفة، تنتج نشأتُه عن تطوّرها، وجزءٌ منها يمثّله الصراع والسيطرة».

القصة والشخصيات يسيران بالموازاة، لا يسبُق أحدهما الآخر أو يحاول التغلُّب عليه. والمُشاهدة تتّخذ متعتها من عمق معانيها ومن تجانُس الجمال والغرابة في رسم الأشكال. المنحى الآسر للفيلم سرعان ما يفرض نفسه، كاشفاً عن امتلاكه السطوتَيْن: لفت النظر ومحاكاة العقل.
يُسيطر «زيوس»، أبو الآلهة والبشر في معتقدات الإغريق، على الكون لتتبع هذه السيطرة وجودَ الإنسان، مع وجودٍ حيواني أيضاً يشمل الطيور. إشكالية التطوّر تؤرق وائل شوقي، فيطاردها في بحوثه وقراءاته. وبعودته إلى الإغريق، ينقل حكايتهم من دون أن يتّخذ موقفاً منها. لا يُدين ولا يتبنّى. يُنقِّب ويغوص فقط.

ولمّا اقتصر الحضور الأنثوي في الأسطورة الإغريقية على الآلهة، وحُصر أهل الأرض بالذكور، عرفت النساء مساراً نحو الوجود الدنيوي بتجسيد فكرة العقاب. يُخبر الفيلم أنّ «زيوس» عاقب الدنيويين بإسقاط أنثى عليهم، لتشقّ سيرورة الكون اتجاهها نحو التعدُّد.
قصة غريبة جداً، يقول وائل شوقي إنها تلتقي بمسارات مع الحكاية المصرية، وقد وقع على هذا التلاقي بالمصادفة: «ماذا أحاول أن أفعل؟ جوابي هو الوصول إلى أصل فكرة المفهوم البشريّ. نحن البشر، كيف استطعنا فلسفة وجود الحياة؟ تلك الخرافات وما قد نعدُّه هراء، ارتبطت بتكوين مفاهيم البشرية. لا يمكننا إنكار أنها شكَّلت آنذاك واقعاً مهماً. فما نُعامله باستهزاء ونسخر منه في الحاضر، لا بدَّ أنه يحمل تفسيراً للأصول والبدايات».
بالعودة إلى تلك الأصول، تتحقّق محاولته التوصّل إلى إمكان تحليل الإنسان المعاصر: «وسط كمية الخرافات والأساطير، سنجد أنّ جميع الأسباب تُفضي إلى نتيجة واحدة هي البحث عن العدل. فمسألة إبادة (زيوس) للبشرية بكونها ردَّ الفعل الحتميّ حيال فسادها ونفاق حكامها، تُشبه فكرة الطوفان الواردة في الأديان حيث النجاة قدر الجماعة الصالحة. العدالة نشيد البشرية منذ الأزل».
أقام في مدينة بومبي الإيطالية التي لم تبقَ منها سوى آثارها، ولعام استمرَّ يقرأ ويبحث ليقدّم فيلماً مشبَّعاً بالدلالة والرمزية. يراها مكاناً يرمز إلى الموت والبعث. وهو لم يذكُر مصيرها بعدما دمَّرها بركان، وإنما أبقى عليها خلفيةً سينوغرافيةً تُمثّل الموروث الروماني الإغريقي. فغياب الإشارة إلى مسألة البركان يعوّضه في الأذهان الحضور الساطع لحادثة الطوفان الشهيرة.

فنُّ وائل شوقي شديدُ الاهتمام بواقع المجتمعات الآيلة إلى التطوّر والتواقة إلى الارتقاء من منظومة إلى أخرى تتّسم بالعلوّ، وإن كان على هيئة وهم يجافي الحقيقة. يقول: «من الأمثلة، تحوُّل مجتمعات زراعية إلى مدنيّة. فالتحوّلات تحصُل بفعل الرغبة الإنسانية في الارتقاء والتطوّر. حتى فكرة الحروب الصليبية مثلاً، بجزء منها، كانت تنشد الارتقاء، لواقع أنّ الشرق كان المستوى الأعلى لأوروبا المُدمَّرة حينها. لستُ أطارد أيّة أجوبة. رحلتي بحثٌ آدمي تُحرّكه المعرفة، وأفلامي أكبر عملية تعليم أمنحها لنفسي».
حتى أعماله المنضوية على إشارات سياسية، مُغمَّسة بالخيال. يكاد يحضُر في جميع ممارسات وائل شوقي الفنّية بكونه جزءاً من التحليل. فإضافة بُعد خيالي إلى الأبعاد الواقعية يُسقط عن التاريخ صفة «القدسية»، ويحيله إلى المنطق الإنساني القابل للنقد والشكّ. لذا، يتعامل الفنان مع معطيات التاريخ من مُنطلق بديهية أن تكون قد أُخضعت للتحريف عبر تناقلها الزمني، فيُضيف الخيال ليس لغرضٍ تجميلي فحسب، وإنما ليُطمئن المتلقّي إلى أنه طعَّم احتمال عدم اليقين الكلّي بلمسة سوريالية تخصُّه، يواجه بها حقيقة أنّ الإرث التاريخي ليس موثوقاً به تماماً: «أهتم بالتاريخ بكونه نتاجاً إنسانياً. كيف أكتبه فنياً؟ هنا السؤال». أعماله سعيٌّ من أجل ألا يكفَّ عن طرحه.