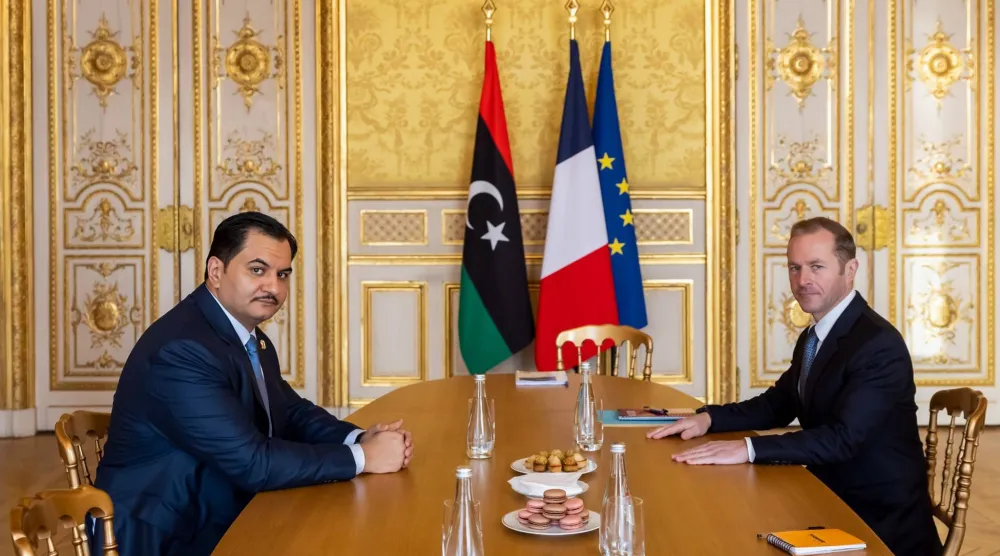دأب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي على التعامل مع المكوّن الأمازيغي في ليبيا طوال فترة حكمه، بين 1969 و2011، باعتبارهم من قبائل «اندثرت وانتهت». إلا أنه بعد أشهر معدودة من كلامه هذا، كانوا في طليعة «الثوار» الذين أسقطوا نظامه في انتفاضة عام 2011، ومنذ ذلك التاريخ استعاد أمازيغ ليبيا «حيوية» ثقافتهم تدريجياً، وبدأوا في الدفاع عما يعدّونها «مكتسباتهم» التي حققوها، مع أنهم ظلوا يشكون من «التهميش».
تتركز الكثافة السكانية الأمازيغية في ليبيا، بدءاً من مدينة زوارة على الحدود التونسية (أقصى شمال غربي البلاد) وامتداداً إلى نالوت وجبل نفوسة وطرابلس وغدامس، مروراً بمدن غات وأوباري وسبها (جنوباً)، مع التذكير بأن الطوارق أمازيغ أيضاً، وصولاً إلى سوكنة وأوجلة نحو الشرق.
ولقد عاد اسم زوارة أخيراً إلى واجهة الأحداث على خلفية أزمة معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، عندما وقع صدام بين قوة تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، والمجلس العسكري لمدينة زوارة الذي يتولى إدارة المعبر، وكاد يتطور إلى اشتباكات واسعة.
على الأثر، اضطرت سلطات طرابلس إلى إغلاق المعبر أمام حركة سير الأفراد والسيارات يوم 19 مارس (آذار) الحالي، ليعلن حينها وزير داخلية «الوحدة الوطنية» عماد الطرابلسي أن المعبر لن يُفتح «حتى استعادة السيطرة عليه، ولو بالقوة، وإعادته إلى حضن الدولة».
الطرابلسي توعّد باللا تراجع عن المواجهة مع ما أسماهم بـ«تجار المخدرات والمهربين مهما كلفه الأمر»، وأكد أنه «لن يُرفَع أي علم على المعبر باستثناء علم الدولة الليبية»، في تلميح إلى علم الأمازيغ.
ما يستحق التنويه أن مدينة زوارة كانت قد تقدّمت الصفوف عقب الإطاحة بنظام القذافي، واستولت قواتها العسكرية - التي تشكّلت أصلاً لمقاومته - على منطقة رأس جدير، وضمّت رسمياً المعبر الحدودي مع تونس إلى المنطقة الإدارية الواقعة تحت سيطرة بلديتها، لتتحوّل المدينة تدريجياً إلى «مركز قوة»، مع أنها بقيت اسمياً تحت سلطة الحكومات المتعاقبة.
هدوء العاصفة
ما بين عهد القذافي، وعهود تلت، شكا الأمازيغ طويلاً من «الإقصاء» و«التهميش»، وهو ما أثاره إبراهيم قرادة، رئيس «المؤتمر الليبي للأمازيغية»، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، عدّ فيه أن حادث المعبر كشف عن «استهداف معلن وصريح» للأمازيغ.
بيد أن أزمة المعبر تبدو أشبه بكرة لهب تتدحرج من حكومة إلى أخرى، وأظهرت الجزء الغاطس من الأزمة على السطح. في حين ظهرت زوارة، الممتدة جغرافيتها على شاطئ المتوسط لمسافة 60 كيلومتراً من مليتة شرقاً إلى حدود تونس غرباً، كما لو كانت قد «تمردت» على سلطة الدولة.
إذ يواصل الطرابلسي - الذي أعلن «مجلس حكماء زوارة» أنهم لا يعترفون به - وعيده. وكذلك تتواصل التحشيدات بعدما وجّه صلاح النمروش، معاون رئيس الأركان التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، 7 ألوية بتجهيز آلياتها وعتادها، قبل تدخل المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، لانتزاع فتيل الأزمة، وهكذا هدأت العاصفة مؤقتاً بعدما كانت البلاد ماضية نحو المواجهة لإحكام السيطرة على المعبر. وحول هذا، قال قرادة: «انكشفت حدة الإقصاء والتهميش للأمازيغ في السنوات الأخيرة بشكل سافر ومستفز... وهذا ما يفسّر ردّ الفعل الأمازيغي الحازم والصارم دفاعاً عن الوجود والنفس».
وسط هذه الأجواء المضطربة أمضت ليبيا الأسبوع الماضي متخوفة من حرب بعدما عدّ المجلس البلدي لبلدية زوارة كلام الطرابلسي «عنصرية وجهوية» ضد المكوّن الأمازيغي. وتابع أن «التصرّفات الفردية والتوجهات العرقية وتصفية الحسابات يجب ألّا يكون لها مكان في سياسات الدولة»، وهو ما عدّه بعض المتابعين رسالة إلى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ضد وزير داخليته.
وبالتوازي، روى الهادي برقيق، رئيس «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، أن الطرابلسي «دفع بقوة تتبع إنفاذ القانون بالتوجه إلى المعبر، وعندما وصلت شرعت في تجهيز بعض الأعمال، ولكننا فوجئنا بالتعدّي على الأجهزة الأمنية... وهنا تدخل المجلس البلدي في زوارة بحكم التبعية الإدارية، ولكن هذا التدخل جوبه بإطلاق النار على الأطراف التي سعت لإنهاء الأزمة». وفي نفيه لسيطرة زوارة بالكامل على المعبر، قال برقيق، في تصريح صحافي، إن العاملين فيه «خليط من كل أبناء المنطقة الغربية، وليس أبناء زوارة فقط التي يوجد المنفذ في حدودها الإدارية».
غير أن هناك من عدّ تصرف زوارة بمثابة «تمرّد وفرض هيمنة بالسلاح وتنازع سلطات الدولة». وبينما كانت مقاطع الفيديو، التي تظهر تحرك آليات عسكرية وأرتال سيارات الدفع الرباعي المُحملة بالصواريخ تنطلق من مناطق الأمازيغ باتجاه زوارة لمواجهة التحشيدات العسكرية التي أمر بها النمروش، كانت راية الأمازيغ - التي وجدت مكاناً لها بعد رحيل القذافي - ترفرف على مداخل معبر رأس جدير نكاية في الطرابلسي.

الأمازيغ أيام القذافي
في الواقع، لم ينس الأمازيغ تعامل القذافي معهم، وكيف عدّهم في أحد أحاديثه قُبيل رحيله بسنة «قبائل قديمة عاشت في شمال أفريقيا، قبل أن تندثر وتنقرض مثل المشواش والليبيو والتحنو». وهنا علّق قرادة - وهو كبير مستشارين بالأمم المتحدة سابقاً - عن أن «مسألة تهميش وإقصاء أمازيغ ليبيا ليست جديدة، بل قديمة... لكن الذروة كانت اضطهادهم في عهد القذافي بشكل ممنهج». وتابع أن «نصيب المطالبين بالحق الأمازيغي على أيام القذافي كان الملاحقة الأمنية والسجون والإعدامات والتضييق السياسي... ولذا عانت مناطق الأمازيغ من تسليط وتسلّط مؤسسات وتوظيف القبلية والعقوبات التنموية على مدنهم».
دراسة لـ«الأمم المتحدة»
هذا، وفي دراسة نشرها مركز «مالكوم كير - كارنيغي للشرق الأوسط»، ورد أن سقوط القذافي وتشظي السلطة المركزية دفعا كثيراً من المجتمعات المحلية إلى التسابق للسيطرة على المواقع كي تصبح مراكز قوة تضمن لها الحصول على الموارد الاقتصادية. وبالفعل، نفخ هذا التنافس على المنافذ الحدودية في رماد التناحرات التاريخية، خاصة بين العرب وبين الأمازيغ.
ورصدت الدراسة أن القذافي استخدم التجارة الحدودية لتعزيز سطوته، واستلحق قبائل وفئات اجتماعية معيّنة وأغدق عليهم الامتيازات على حساب آخرين. و«لذا من البديهي أن تؤدي سياسة (فرّق تسد) هذه إلى بروز تظلمات في صفوف قطاعات من السكان حُرموا من كعكة المغانم. وكان الأمازيغ المجتمع المحلي الأكثر عرضة على نحو متواصل إلى هذا التمييز والحرمان».
ومضت الدراسة إلى أن السيطرة على المعابر الحدودية بعد رحيل نظام القذافي أضحت عاملاً استراتيجياً في مجال التقدم الاجتماعي والسياسي للأمازيغ. وضربت مثلاً بما جرى سابقاً في نالوت، وهي بلدة أمازيغية أخرى، عندما استولت ميليشيا محلية على معبر «ذهيبة - وازن» الحدودي القريب منها. وللعلم، رأس جدير وذهيبة - وازن هما المعبران الحدوديان الوحيدان بين تونس وليبيا، وإن كان المعبر الأول يحظى بعمليات عبور أكثر من الثاني. وبالمثل، أقامت المجموعات المسلحة الأمازيغية نقاط تفتيش على طول خطوط التهريب.
وبعد إغلاق رأس جدير اضطرت عشرات الشاحنات المصطفة على أبوابه إلى تغيير اتجاهها بإذن من السلطات التونسية حيث معبر ذهيبة - وازن، الذي شددت وزارة داخلية «الوحدة الوطنية» على أنه مفتوح ويعمل على مدار الساعة بلا توقف لتأمين حركة السير في الاتجاهين بشكل طبيعي.
أزمة شرعية
متابعون يربطون ما حدث ويحدث في معبر رأس جدير «امتداداً لحالة الفوضى الأمنية» التي تضرب ليبيا منذ إسقاط النظام السابق، لافتين إلى أن الوضع القائم «سهّل للتشكيلات المسلحة السيطرة على المنافذ، التي يفترض أن جميعها يخضع لسلطة الدولة الليبية».
ويُنظر إلى غالبية المعابر (البرية والجوية والبحرية) في عموم ليبيا، بحسب محمد عمر بعيو، رئيس «المؤسسة الليبية للإعلام» (التابعة لمجلس النواب) أنها «غير خاضعة لسيطرة الدولة وأجهزتها القانونية الرسمية»، وكان بعيو أظهر تعاطفه في تصريح سابق مع الأمازيغ في «رفضهم ومقاومتهم لممارسات حكومة الدبيبة».
لكن مسؤولاً سابقاً في وزارة سيادية بالبلاد أرجع ما يجري حول المعابر راهناً إلى «أزمة شرعية». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «عندما تكون شرعية الدولة مهزوزة بشكل أو بآخر، تلجأ الأطراف المتحصنة بالقوة إلى شرعنة الوضع الخاطئ، والإبقاء عليه». وشدد المسؤول على أن «المعابر يجب أن تكون تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة... زوارة لا تعتد بوزير داخلية (الوحدة)، وهناك أطراف تشجع وتغدّي تلك الأزمات لأسباب تتعلق بالتهريب، وهذا الوضع نشأ بعد 2011».
لماذا المعابر؟
لا يبرّر أي من قادة الأمازيغ أسباب تمسّكهم بإدارة معبري رأس جدير وذهيبة - وازن، ولكن إزاء ما يعدّه ناشطون وساسة ليبيون «خروجاً على سلطة الحكومة» التي يخضعون لها إدارياً، ترى صحيفة «لوموند» الفرنسية أن ما يحدث في رأس جدير يعكس «صراعاً على السلطة». ولفتت الصحيفة، يوم الثلاثاء، إلى أن الطرابلسي يريد وضع يده على هذه المنطقة الاستراتيجية التي على الرغم من وجود قوات شرطية فيها تحت قيادة طرابلس، لا تزال تحت السيطرة الفعلية لما سمته «الميليشيات الأمازيغية» التابعة للمجلس العسكري لمدينة زوارة.
وبالمثل، أرجع قرادة الأزمة في جوانب منها إلى الطرابلسي، عندما ادعى أن «تصرّفاته منذ تكليفه قبل عام ونصف عام توضح استهداف حكومته للأمازيغ، بفرض تقسيمات جديدة لمديريات الأمن (بجبل نفوسة - الغربي) رفضاً لكل المناشدات». وعن المعبرين، قال إنهما «يقعان في النطاق الإداري لبلديتي زوارة ونالوت، وهما منطقتان أمازيغيتان». وتساءل: «لماذا يبدأ الطرابلسي بمناطق وجود الأمازيغ؟ أليست هناك مديريات ومنافذ مناطق أقرب إلى العاصمة طرابلس من زوارة ورأس جدير؟»... وخلص إلى القول إن الحكومة «تغفل ولا تجهل خلفيات الصراعات، حين كان وزيرها المكلف في الطرف المقابل للأمازيغ في الحروب السابقة، وخصوصاً حرب 2014».
دعاوى الانفصال
في الحقيقة، تحقّق للأمازيغ بعد رحيل القذافي ما لم يتحقق قبله، فبعد 12 سنة من مقتله عادت اللغة الأمازيغية إلى الفصول الدراسية بعد حظر ومطاردة. وفي مطلع عام 2023، افتتح الدبيبة قناة «الأمازيغية». وفي 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، احتفلوا برأس السنة الأمازيغية 2974 وتلقوا التهاني من رأس السلطة في ليبيا.
ومع أنه لا يوجد إحصاء حديث ومعاصر لتعداد الأمازيغ في ليبيا، تقدّر الموسوعة البريطانية نسبتهم بـ6.8 في المائة من مجموع السكان، المقدّر ما بين نحو 7 ملايين و8 ملايين.
من جهة ثانية، ترافقت الأزمة الحاصلة مع اتهامات للأمازيغ بـ«التمرد» والسعي لـ«الانفصال». لكن قرادة يردّ: «العارف بالتاريخ والجغرافيا السياسية والاجتماعية للوجود الأمازيغي في ليبيا سيتيقّن أنهم ليسوا باسك إسبانيا ولا تأميل سريلانكا ولا شعوب جنوب السودان». ويضيف: «بالدليل المؤكد، إنه في حالة الحرب والانقسام وضعف الدولة لم تظهر أي مطالبة أو نشاط سياسي من الحراك الأمازيغي، يدعو أو يطالب بالاستقلال أو الانفصال».
ومع وجود اتهامات للأمازيغ بكثرة الشكوى من التهميش والنزوع نحو التميّز، أرجع أحد قادتهم ذلك إلى تمسكهم بما أسماه بـ«الحق الأمازيغي من دسترة الهوية والحقوق، وضمان التمثيل السياسي والتنموي العادل... أي أنه ضمان الكيان الليبي». وأردف: «الذين يروّجون لوجود دعوات أمازيغية للانفصال، فهذه دعوات مغرضة وذرائعية سياسية أو عنصرية عرقية قبلية، وهم قلة قليلة... ولكن لا يجب الاستهانة بتأثيرهم السلبي للتأجيج ضد الأمازيغ».
أما قرادة فعدّ «أن التعايش والتشارك الليبي العربي الأمازيغي عميق راسخ وواسع ممتد في كل مناحي الحياة، ولم تؤثر فيه الأحداث الجسام... فالعربية والأمازيغية مترافقتان، والمالكية والإباضية متآخيتان، في الأحياء والمساجد والمدارس والوظائف والأسواق»
.إفطار على بوابة المعبر
في أي حال، تنفس الليبيون الصعداء. فمع أذان مغرب يوم الأربعاء الماضي 27 مارس (آذار)، كانت أزمة معبر رأس جدير قد طُويت، مؤقتاً، بعد الاتفاق على تأمينه بقوة عسكرية مشتركة من رئاسة الأركان التابعة لـ«الوحدة»، وكتائب مدينة زوارة، وجلس أفرادها يتناولون طعام الإفطار الرمضاني معاً. وبعد أسبوع من انتظار الحرب، شدّد الدبيبة، خلال لقائه بالنمروش، على ضرورة أن «يكون الهدف الأساسي لهذه القوة بسط الأمن ببوابة رأس جدير بعيداً عن التجاذبات السياسية والقبلية، وأن تكون هذه الرسالة الأساسية لهذه القوة العسكرية».
زوارة كانت قد تقدّمت الصفوف عقب الإطاحة بنظام القذافي واستولت قواتها العسكرية على منطقة رأس جدير

«سلطة الأمر الواقع» في ليبيا... وسلطة الدولة
> بدا لبعض ساسة ليبيا أن «الأوضاع الاستثنائية» التي نشأت خلال سنوات الفوضى لبعض المناطق ولأجسام سياسية وتشكيلات مسلحة، قد تتغير بمرور الوقت، لكن بعد عقد ونيف على إسقاط النظام السابق تأكد لجُل الليبيين أن هذه الأجسام أضحت كيانات قادرة على الدفاع عن نفسها بمقتضى «سلطة الأمر الواقع». فالانفلات الأمني الذي ضرب ليبيا، وغياب دستور في البلاد منذ رحيل القذافي، أديا إلى استمرار الأجسام السياسية الحالية في عملها، سلطة تشريعية وتنفيذية، على الرغم من انتهاء مدة ولايتها. هذه الأجسام لا تقتصر على المجلس الرئاسي ومجلسه فقط، بل تصل أيضاً إلى المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب في «شرق ليبيا»، بالإضافة إلى الميليشيات المسلحة، التي تنزع سلطتها بقوة السلاح في عموم البلاد، وتتغوّل على سلطة الدولة... الكل استمرأ «الوضع الاستثنائي» وأبقى عليه ليغدو بمضي الوقت «سلطة أمر واقع». ويرى محللون أنه إذا كانت الجهود التي بذلها المجلس الرئاسي الليبي أفلحت في طي صفحة النزاع على معبر رأس جدير، فإن الأزمة كشفت عن نجاح التشكيلات المسلحة في فرض كلمتها على السلطة الرسمية، ما يعد «أمراً خطيراً يقوض دعائم الدولة». وحقاً، يُنظر إلى التشكيلات المسلحة الليبية على أنها «من أكبر معوقات الاستقرار»، ولا سيما تلك التي تنتمي لبعض القبائل، وتدافع عنها، إما لفرض أجندتها وحماية مصالحها، أو لصدّ تغوّل الآخرين عليها. ولقد سبق أن حذر المجتمع الدولي في السنوات الأولى التي تلت إسقاط نظام القذافي من «نشوء مؤسسات موازية في ليبيا، أو فرضها بسياسة الأمر الواقع باستخدام القوة». وأمام كل أزمة، تتجه الأنظار إلى التشكيلات المسلحة باعتبارها «سلطة أمر واقع» فرضت نفسها مع مرور الوقت، سواء في حراسة المعابر وحقول النفط. وفي فبراير (شباط) الماضي، أجبرت المجزرة التي ارتُكبت في حي أبو سليم بالعاصمة طرابلس سلطات المدينة على الاتجاه لإخراج الميليشيات منها وإعادتها إلى مقارها وثكناتها. وأعلن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في وقت سابق أنه بعد مشاورات ومفاوضات، امتدت لأكثر من شهر، أمكن التوصل إلى «اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة بالكامل خلال المدة المقبلة»، التي توقّع أن تكون بعد نهاية شهر رمضان. وكان الليبيون استيقظوا على جريمة مروعة، قبل نهاية الشهر الماضي، وقعت في حي أبو سليم، الواقع جنوب العاصمة طرابلس، راح ضحيتها 10 أشخاص في ظروف غامضة.