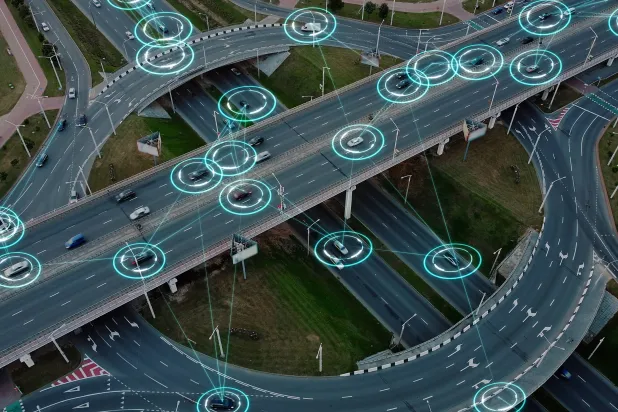تشعّبت الانتماءات والولاءات والخسارة واحدة: الوطن والدولة.
لكن بدايةً وقبل أي إشعار آخر، تبقى غزة، ليس كمساحة بل كشعب فلسطيني يئنّ موتاً ووجعاً وجوعاً وعوزاً تحت وابل الآلة الإسرائيلية التي تحترف القتل وتتقن الغطرسة. إنها لحظة الوقوف تهيباً أمام هول المأساة التي ذهب ضحيتها عشرات آلاف القتلى والمصابين من المدنيين. إنها لحظة اختبار المجتمع الدولي المدعو فوراً إلى وقف جريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، أطفالاً ونساءً وشيوخاً، لا بل ضد الدولة الفلسطينية بالذات.
وهي لحظة اختبار الأمة الفلسطينية المدعوة إلى انبثاق مرجعية وطنية، جامعة محررة ومتحررة، يكون التزامها المجرّد بالقضية، وولاؤها المطلق لفلسطين من دون إشراك. إنها المرجعية المرجوة التي تفرض نفسها حكماً كمُحاور مأذون يمثل حصراً الحق الفلسطيني. هذا هو المدخل الطبيعي لوقف المأساة وعودة الحق إلى أصحابه، وخلاف ذلك لن يكون سوى مُدّعي سلطة، أيّاً كانت إنجازاته وبطولاته، فاقد الثقة الوطنية والدولية، وبالتالي فاقد الفاعلية لارتباطه فئوياً وجهوياً، ولربما وطنياً بما هو أبعد من فلسطين.
المطلوب الآن وبإلحاح لمنع هذه السردية القاتلة للقضية الفلسطينية، وقف الانقسامات في القيادة إيذاناً لتأمين وحدة المرجعية ووحدة الشعب، وإسقاط الـ«إيغو» لضمان انتصار القضية، وإلا تصبح إسرائيل المستفيد الأول والأخير، العائمة على بحر الخلافات الفلسطينية والدم الفلسطيني، والقادرة على إعاقة أي دعم عربي إقليمي ودولي.
والتصريحات الأخيرة للقادة في إسرائيل أصبحت واضحة لجهة رفضها قيام دولة فلسطين بالمطلق. هذه هي الفرصة السانحة وقد تكون الأخيرة للسلطة الفلسطينية وللمجلس الوطني الفلسطيني للالتئام والتحرر من القيود وجمع الشمل الفلسطيني والضغط باتجاه دولة فلسطينية مستقلة تسترجع أبناءها - كل أبنائها - من الشتات كما فعلت إسرائيل منذ قيامها في عام 1948...
أما بعد...
لعلّ تجارب التاريخ واضحة لجهة تفكك بعض الدول والكيانات. إن مشكلة بعض العالم الغربي في الماضي، والعربي في الماضي والحاضر هي مشكلة غموض في الانتماء وعدم ثبات في الولاء لمفهوم الوطن والدولة.
ومهما تلوّن الانتماء يبقى انتماءً سواء للشخص أو للحزب أو للطائفة أو للمذهب أو للآيديولوجية المستوردة أو المستوطنة، على حساب الانتماء للوطن الجامع داخلياً والمعترف به دولياً. الانتماء - الولاء للدولة العادلة والمسؤولة يبقى جامعاً، مشتركاً، موحَّداً وموحِدّاً، يبقى حوكمة لا تحكّماً، يبقى تكريساً لمرجعية السلطة ومركزيتها وحصانتها. أما الانتماء - الولاء للحزب أو للشخص أو للطائفة أو للخارج، فيغدو مثقلاً بمتفرعات قاتلة ليس أقلها تعطيل مفهوم المواطنة المنزّهة واستبدال نزعة التبعية على أشكالها به، والالتزام بعقيدة مستوردة أو مستحدثة، والاستزلام لشخص يسهم أتباعه في تأليهه.
إن انتماء كهذا يبقى مفتقراً إلى الصدقية والفاعلية ولا يَثْبُت ولا يدوم، بل هو مصدر ضرر حضاري وإنساني أكيد. وأنا أكتب كرئيس سابق لحزب، وكابن لمؤسس حزب، فإذا لم يكن الحزب للوطن يصبح عبئاً على الوطن، يصبح فاعلاً في الوطن لكن على الوطن.
إن العقائد الغريبة والتحزّب الرخيص والانقياد الأعمى لا تولّد مجتمعةً وفرادى سوى الموت البطيء للمجتمعات والدول
إن العقائد الغريبة والتحزّب الرخيص والانقياد الأعمى لا تولّد مجتمعةً وفرادى سوى الموت البطيء للمجتمعات والدول. وتجربة الإخوان المسلمين في الزمن الحديث لا تزال ماثلة لجهة الخلافات والانقسامات والحروب التي ولدتها وورثتها، وكذلك الفاشية والنازية والشيوعية التي أرست مفهوم الولاء لحزب، بل لشخص أمثال موسوليني وهتلر وستالين، الأمر الذي استدركه الديكتاتور فرنكو، فأجاز ولو متأخراً الانتقال من نظامه الاستبدادي إلى الشرعية الوطنية التاريخية المتمثلة بالملكية الإسبانية، فاستقرّت إسبانيا حتى اليوم. وينسحب الأمر ولو بشكل مختلف على المواجهة بين الرأسمالية والشيوعية التي ولدت الحروب الباردة والساخنة، والحروب بالمباشر أو بالواسطة (proxy war).
وفي العالمين العربي والخارجي، كم من شعارات وشعبويات أطلقتها بعض الأنظمة، ظاهرها جذّاب وواقعها كذّاب، ترويجها توحيدي وفعلها تقسيمي، دعايتها تنموية، ورعايتها خارجية، وحقيقتها طائفية تدميرية أدّت فيما أدّت إليه إلى شرذمة العالم العربي قبل أن يستفيق بعضه لاحقاً ويقرر ركوب الحضارة والحداثة من الباب الواسع. والعينات كثيرة، من البعث الاشتراكي في الظاهر، الممذهب في الواقع، سنيّاً في العراق وعلوياً في سوريا، إلى الحالة الحوثية في اليمن.

أكتب منطلِقاً من التجربة اللبنانية، هذا الوطن الذي دفع غالياً كلفة جنوحه وانتمائه المتعدد، وفاتورة الأنماط الغريبة المستوردة إليه أو المستوطنة فيه، فوقعت أحياناً بعض الفئات اللبنانية في فخّها، على حساب الاستقرار والسلام اللبنانيين.
ففي عام 1958، هزّت الناصرية مشروع الوحدة في لبنان، فاهتز التوازن الداخلي. وفي عام 1969، أسهم اتفاق القاهرة في اقتسام السيادة بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وسنة 1975، كشر مشروع التوطين عن أنيابه فكانت الحرب وكانت المقاومة اللبنانية. وفي عام 1989، شكل اتفاق الطائف نوعاً من ترميم ناقص للبنيان لم تكتمل أعمدته بسبب تعدد الولاءات التي استفاد منها نظام الوصاية السائد في حينه، وعبّد الطريق لتيار الثورة الإيرانية التي استطاعت أن تحدث خرقاً في البيئة اللبنانية، لا سيما فيما يتعلّق بمفهوم الولاء للوطن.
أفضى تعدد ولاءات اللبنانيين في أفضل تقدير إلى استحداث أنظمة دخيلة على الديمقراطيات وغريبة عنها، وعرقلت حسن سير المؤسسات كنظام الشغور الرئاسي والحكومي وفراغ المؤسسات
إن تعدد ولاءات اللبنانيين أفضى في أفضل تقدير إلى استحداث أنظمة دخيلة على الديمقراطيات وغريبة عنها، وعرقلت حسن سير المؤسسات كنظام الشغور الرئاسي والحكومي وفراغ المؤسسات، بحيث لا ينتخب رئيس إلا بعد مفاوضات خارجية تفضي إلى تسويات داخلية، ولا تؤلف حكومات إلا باستشارات تنحو إلى أبعد من النص الدستوري، ولا يعيّن ناطور إلا ضمن تفاهمات مسبقة.
وبقدر ما أسهم اتفاق الطائف الذي صار دستوراً في إطفاء النزاعات المسلحة، بقدر ما أرسى مشكلة في السياسة، خصوصاً لجهة الحاجة الدائمة إلى مرجعية خارجية، وربما مجموعة مرجعيات لإيجاد التوافق السياسي بين المؤسسات الدستورية الثلاث بفعل الخلاف على الأساسيات؛ مثل الولاء والكيان والهوية والنظام السياسي، وحمل كل طائفة مشروعاً للبنان يستدعي تدخلاً خارجياً، في أحسن الأحوال سياسياً، وفي الغالب عسكرياً، وفي الأغلب مزيجاً من السياسي والعسكري.
هذا ما يحدث اليوم بين اللجنة الخماسية الدولية التي تحاور الداخل اللبناني شكلاً وإيران أساساً، للوصول إلى مساحة مشتركة تتيح انتخاب رئيس للجمهورية. والدرس هنا يفيد بأنه ليس مهماً أن ينسحب التيار الناصري، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والجيشان السوري والإسرائيلي، والباسدران الإيراني من لبنان، بل أن ينسحب اللبنانيون من الخارج ومن التبعية له، وأن يرفضوا نظام الوصاية وتبعاتها على لبنان واللبنانيين.
إن لبنان يحتاج اليوم إلى معالجة ثلاثية الأبعاد لتأمين قيام الدولة واستقرارها:
الأولى تحويل حزب الله إلى مشروع سياسي، ما يفترض نزع سلاحه أسوة بحل الميليشيات التي سبق اعتمادها خلال مرحلة تطبيق اتفاق الطائف، واستبدال الفكر السياسي الذي يحكم حزب الله من منطق استملاك الدولة إلى ثقافة المشاركة النديّة والمتوازنة في الدولة.
الثانية منع توطين اللاجئين الفلسطينيين الذي تذكيه حروب إسرائيل؛ وآخرها الحرب في غزة من خلال تأمين حق العودة عملاً بالقرار الدولي رقم 194، وتوزيع فائض الفلسطينيين على الدول العربية.
الثالثة منع استقرار النازحين السوريين والعمل على إعادتهم إلى سوريا من خلال نقل المساعدات الأممية إلى الداخل السوري بدلاً من صرفها للسوريين في لبنان، كطُعم يبقيهم نزلاء إلى آجال غير مسماة.
تأسيساً على ما تقدّم، نبلغ النتيجة الأساسية وهي مزدوجة: فمن جهة تجب حماية الدين في مكانة جلّى بين المؤمن وربّه، خصوصاً أن التعددية الطائفية والمذهبية هي الغالبة في مجتمعاتنا، والامتناع من جهة ثانية عن «سوق» الله إلى معترك السياسة والاستثمار على اسمه لجني الأرباح السياسية.
ويحضرني هنا نوعان من استغلال الدين لمآرب الشخص أو الحزب؛ النوع الترهيبي والنوع الترغيبي، والاثنان يخدمان المرجعية السياسية بالقوة أو بالحسنى، بالعصا أو بالجزرة على حساب الدين والمجتمع والإنسان كهوية خالصة. الاثنان يُخضعان الإنسان مكرهاً أو مغرراً به، ويستخدمانه باسم الدين أو العقيدة لأغراض مخالفة لأبسط القيم الأساسية التي اعتدنا على تسميتها قيم الديمقراطية وقِيَم الجمهورية.
إن الدين ليس الحل السياسي، بل يصبح مشكلة في الانتماء، بل مشكلة في الوجود إذا أسيء استخدامه أو إذا قُبض عليه بالسياسة.
آن الأوان لسقوط الأنظمة غير الرشيدة...
آن الأوان لسيادة القانون وإعمال الحوكمة الرشيدة بكل مرافقها، وانتصار الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان ورفاهه...
آن الأوان لدسترة الأنظمة وأنسنة السياسة، وقد بدأت طلائعها تثمر ولا عودة إلى الوراء.
فتعالوا نصلح معاً ميثاق الحياة.