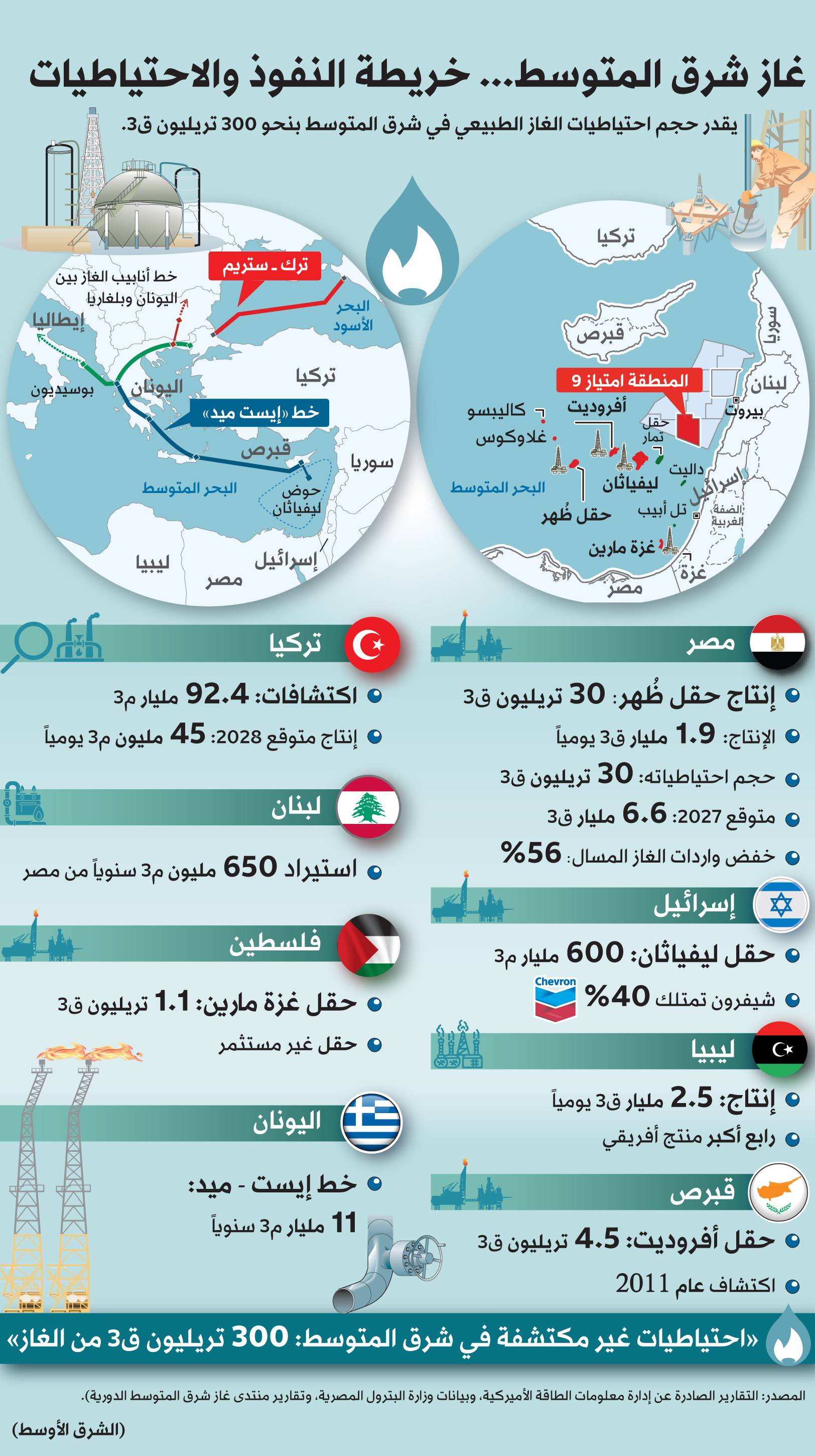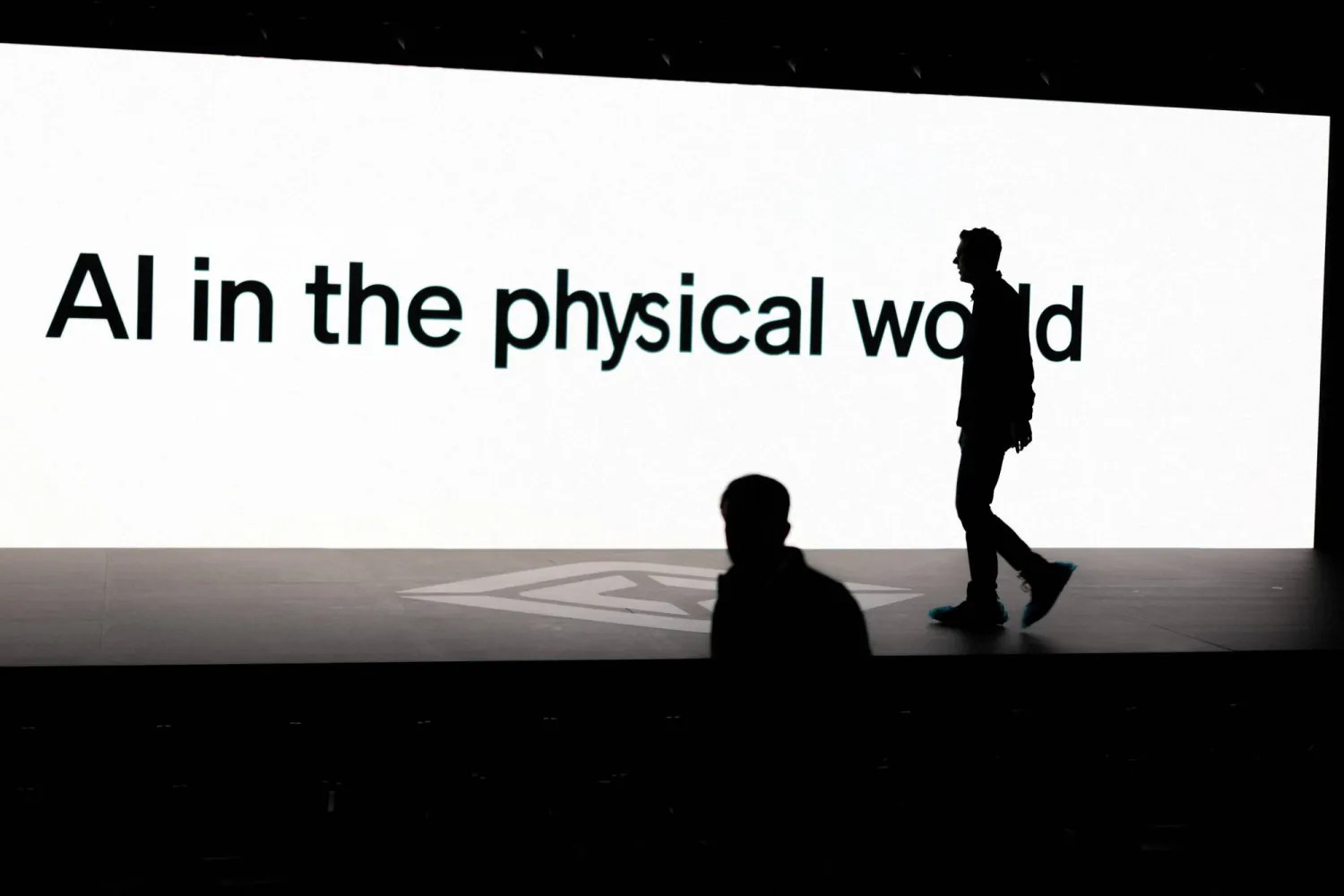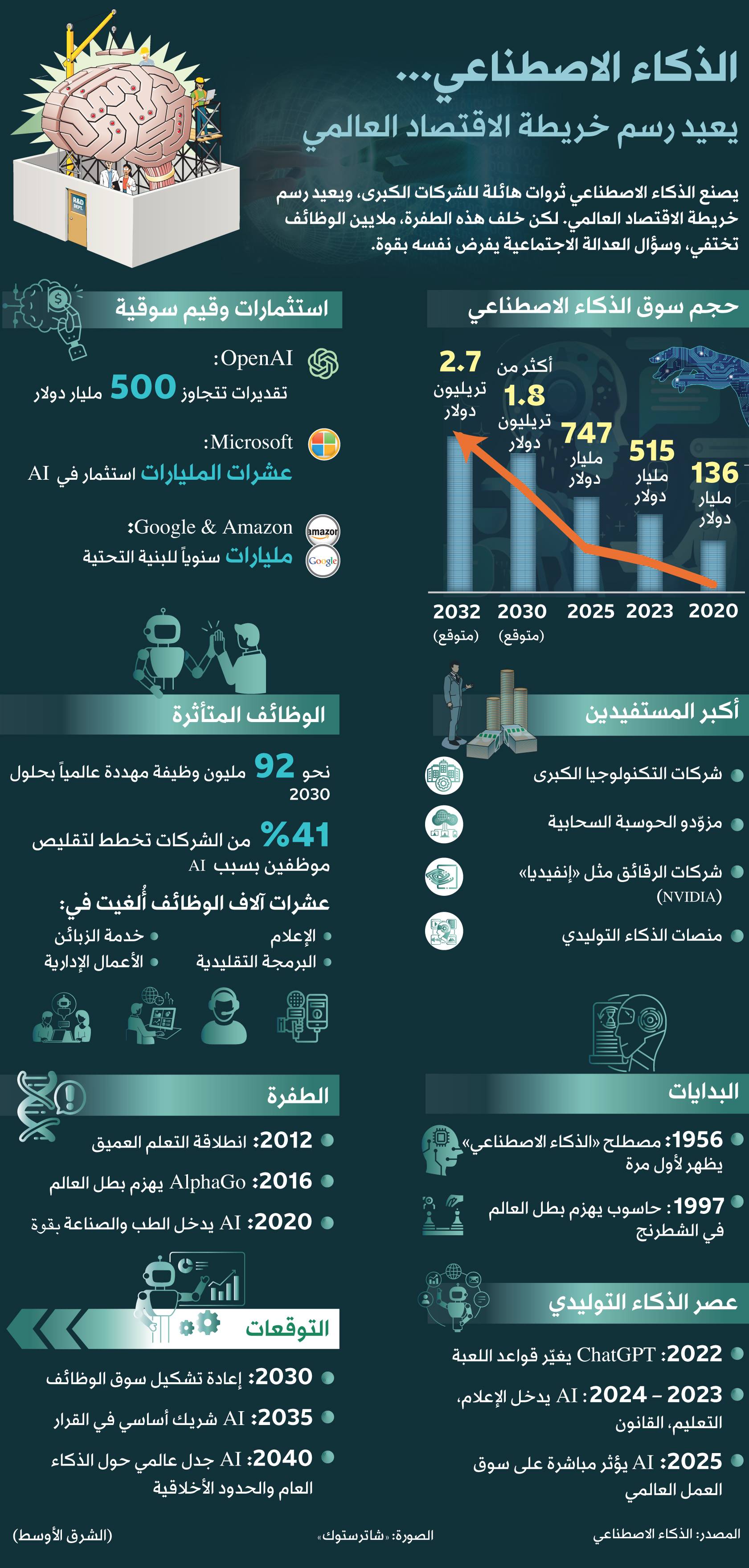لا شك في أن عالمنا المعاصر يتخبط في مشكلات عظمى، ومن أهم هذه المشكلات قضية اغتصاب الأرض الفلسطينية من قِبل الحركة الصهيونية قبل خمسة وسبعين عاماً، حيث شهد تاريخ هذه القضية صراعات وحروباً ومحاولات تسوية من دون نتائج. وأمام هذا المأزق اختلفت وجهات النظر تجاه الحق في الأرض الفلسطينية بين العرب من جهة واليهود من جهة أخرى. هذا الخلاف ما زال قائماً ويشكل تهديداً لأمن المنطقة والعالم بأجمعه.
بالفعل، إن نزاع الشرق الأوسط الذي يضع الدولة الصهيونية (إسرائيل) في مواجهة الشعوب العربية، وبشكل خاص في مواجهة الشعب الفلسطيني، هو من أهم المشكلات التي تشغل العالم بأكمله. إن هذه المشكلة هي صعبة ومعقدة إلى درجة أنها أربكت الفيلسوف الفرنسي جان - بول سارتر نفسه الذي فضل أن يتخذ تجاهها موقفاً حيادياً وأخلاقياً أكثر منه سياسياً. ويمكننا الحكم على ارتباك سارتر، وبخاصة عندما نعرف أنه لم يتردد طيلة حياته في الانحياز واتخاذ موقف واضح تجاه كل مشكلات عصره السياسية، ما عدا هذا النزاع العربي - الإسرائيلي.
بالنسبة إليه، يجب حل النزاع العربي - الإسرائيلي ضمن إطار القانون الدولي من خلال إقامة مفاوضات مباشرة، أو بواسطة منظمة الأمم المتحدة، بين العرب والإسرائيليين. وكان يعتبر نفسه صديقاً للمعسكرين؛ ولذلك نراه أكثر من أي وقت مرتبكاً جداً إلى درجة أن تصريحاته كانت لا تعجب العرب ولا الإسرائيليين أحياناً كثيرة. وفي الواقع، هو حاول أن يكون منسجماً مع نفسه، منطلقاً من التزامه الدفاع عن قضية المقهورين في أي مكان من العالم. ولكنه لم يكن يرى كيف يمكنه الاحتفاظ بالانسجام مع نفسه وهو يحكم في قضية شعبين تعرّضا، في نظره، للقمع والقهر وهما في حالة نزاع. لقد اختار الحيادية وهو الذي كان فخوراً بنزعته الجذرية وباتخاذ مواقف منحازة في كل الميادين. هل كانت لديه أسباب معينة كي لا يتخذ موقفاً واضحاً وملتزماً في هذه القضية؟ هل أخطأ بذلك؟ هذا ممكن؛ ذلك لأنه بذاته صرّح قائلاً: «كلما كنتُ أرتكب خطأ كان ذلك يعود إلى أنني لم أكن جذرياً بما يكفي». كيف أمكن لسارتر أن يكون مرتبكاً في اتخاذ موقف بخصوص هذا النزاع المطروح؟ ولكي نفهم حرَج سارتر تتوجب علينا معرفة شروط وظروف طرح هذه المشكلة، وما هي علاقات فيلسوفنا مع كل من الطرفين المتنازعين؟ في الواقع، إن علاقات سارتر مع الإسرائيليين تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية، حيث كان اليهود مهدَّدين بالتصفية من قِبل النازية والحركة المعادية للسامية بشكل عام؛ وبما أنه يقف دائماً إلى جانب المقهورين فقد دافع عن اليهود من خلال المرافعة من أجلهم، والقيام بحملة كبرى ضد النزعة المعادية للسامية.
وفي كتابه «تأملات حول المسألة اليهودية» عام 1946، يصور سارتر الإنسان اليهودي كائناً ضعيفاً غير مهيأ للعنف، وحتى أنه لا يعرف كيف يدافع عن نفسه، ولكن الحركة المعادية للسامية هي التي خلقت المسألة اليهودية، وهي التي حشرت كل اليهود في وضع معين، حيث باتوا يشعرون بأنفسهم جميعاً متماثلين في إطار وضع مشترك: «إن اليهودي هو إنسان يتعامل معه الآخرون بوصفه يهودياً؛ تلك هي الحقيقة التي يجب الانطلاق منها... إن معاداة السامية هي التي صنعت اليهودي».
من الطبيعي بالنسبة إلى سارتر أن يشعر اليهودي دائماً بأنه في خطر في مجتمع تراوده معاداة السامية بشكل دائم. من المؤكد أن سارتر كان يتحدث في كتابه حول المسألة اليهودية عن اليهود الفرنسيين، ولكن ذلك لا يعني أن ليس لديه المشاعر والمواقف نفسها تجاه يهود إسرائيل الذين كان يكنّ لهم صداقة عميقة على مر السنين. وهذه الصداقة ليست بالفعل سوى التزام أخلاقي تجاه جماعة اليسار الإسرائيلي، ونتيجة لإسقاط ماضي اليهود الشاق على حاضرهم. هذا يعني أن سارتر يحتفظ في أعماقه بصورة اليهودي المذبوح أو المقهور من قِبل النازية والحركة المعادية للسامية؛ وذلك لكي يعترف ليهود اليوم بحق الوجود وبالكرامة. ولكن هناك مشكلة تطرح نفسها: إذا كان اليهود قد تعرضوا للقهر والتشتت في كل أنحاء العالم، فهل يحق لهم فعل الشيء نفسه تجاه شعب آخر من أجل تكريس وجودهم ومن أجل تأسيس جماعة قومية؟ هل لديهم الحق في أن يكونوا ظالمين كي يمحوا ذكريات القهر الذي تعرّضوا له؟
تلك هي المشكلة. لقد وجد سارتر نفسه أمام الوضع التالي: إن اليهود من جهة وعرب فلسطين من جهة أخرى لهم كل الحقوق التاريخية في الوجود على هذه الأرض، حيث كانوا يعملون ويعيشون منذ زمن طويل. ولكن الفلسطينيين تعرضوا للطرد من أرضهم عام 1948 من قبل اليهود في ظروف غامضة وملتبسة. وقد أسس اليهود دولة إسرائيل. وبعد مرور بضع سنوات بدأ الفلسطينيون في تنظيم كفاحهم المسلح والدبلوماسي في سبيل العودة إلى فلسطين تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. إسرائيل رفضت بشكل قاطع الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في فلسطين كما رفضت التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية. عام 1956 شاركت إسرائيل مع الغرب في الهجوم ضد مصر لاحتلال قناة السويس. عام 1967 وقعت حرب الأيام الستة، حيث احتلت إسرائيل أراضي عربية جديدة. عام 1973 انطلقت حرب جديدة استعادت فيها مصر قناة السويس وصحراء سيناء. بعد هذه الحرب فتح باب التفاوض. عام 1979 قام الرئيس المصري أنور السادات بزيارة إلى إسرائيل ووقّع على أثر هذه الزيارة اتفاقية كامب ديفيد مع مناحيم بيغن رئيس الحكومة الإسرائيلية، حيث أدت هذه الاتفاقية إلى عزل شامل لمصر عن العالم العربي. في ذلك الوقت كانت قدرة منظمة التحرير الفلسطينية تزداد بشكل قوي، حيث تمركز الفلسطينيون، بدعم من اليسار اللبناني، في لبنان أثناء الحرب الأهلية، وبنوا بنية تحتية عسكرية اقتصادية وسياسية بحيث أثارت حفيظة إسرائيل وحلفائها، فشعروا بأن الوضع بات يهدد بالخطر.
إذن، كان الوضع شديد التعقيد لدرجة أن سارتر لم يستطع اتخاذ موقف واضح دون أن يستاء منه الطرفان. إن صداقة سارتر لليهود لم تمنعه من أن يكون صديقاً للعرب، وبخاصة لأولئك الذين يؤمنون بالتقدم والذين يحاولون إقامة الاشتراكية في بلدانهم. وبالفعل، فإن سارتر قام عام 1967 قبل حرب الأيام الستة بزيارة لمصر، حيث أُعجب كثيراً بالعمل الذي كان يقوم به جمال عبد الناصر في سبيل بناء بلده على قاعدة الاشتراكية. وإضافة إلى ذلك، فقد أُعجب بشخصية عبد الناصر ووجد فيه رجلاً يريد السلام. وبعد هذه الزيارة لمصر قام بزيارة المخيمات الفلسطينية في غزة، واكتشف البؤس الذي يعانيه شعب يعيش على مسافة قصيرة من أرضه التي طرد منها. وفي ختام جولته في الشرق الأوسط قام بزيارة إسرائيل، ويبدو أنه تأثر بعبد الناصر أكثر مما تأثر بالقادة الإسرائيليين. وعلى أثر هذه الزيارة المزدوجة لمصر ولإسرائيل كان سارتر شبه مقتنع بأن حرباً ما ستنفجر بين العرب وإسرائيل. وهذا الشعور تكوّن لديه بناءً على محادثة مع عبد الناصر. ويوجز سارتر وجهة نظر عبد الناصر كالآتي:
«هناك تناقض لا نصل إلى حله. ولكن الحل بواسطة الحرب لا يبدو حلاً جيداً». بعد كل ذلك يستنتج أن القضية هي قضية حق: «للفلسطينيين الحق القاطع في العودة إلى ديارهم»، وبالتالي «بكل بساطة لأنهم طُردوا يحق لهم أن يعودوا». وإذا كان للفلسطينيين الحق في أن يكونوا في ديارهم وفي أرضهم، فإن اليهود أيضاً لديهم الحق نفسه، ولكن ليس كل اليهود، بل أولئك الذين ولدوا في فلسطين واشتغلوا فيها. يقول سارتر: «إذا كنت أعترف لحفيد أو لابن أحد اليهود الذي أقام في إسرائيل بحق البقاء في وطنه لأنه فيه ولا يجب طرده منه، فأنا أعترف للفلسطينيين وطبقاً للمبدأ نفسه بحق العودة إلى هذا الوطن».
ولكن ما الحل الذي يقترحه سارتر لحل هذه المشكلة المعقدة؟ إنه يلخص اقتراحاته في ثلاث نقاط:
1. يتوجب على إسرائيل إعادة الأراضي التي تحتلها، وقد يكون عليها اتخاذ القرار من ذاتها ومن دون ضغط.
2. يجب الاعتراف بسيادة إسرائيل.
3. يجب أن تكون مشكلة الفلسطينيين مباشرة موضوع المفاوضات الأولى؛ لأن هذه المشكلة أساسية.
في الواقع، إن سارتر يطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تقدم أكثر من الآخرين من أجل حل هذه المشكلة؛ وذلك لأن إسرائيل لديها مسؤولية كبرى في هذه القضية. من هنا هو يعتقد بأن «الكثير من الأمور في يد إسرائيل، وأن السياسة الإسرائيلية خطيرة جداً بشكل خاص؛ لأنها تترك الشك يخيم حول موضوع المناطق المحتلة». وهذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة قد تأكدت من خلال إعلان القدس عاصمةً للدولة العبرية عام 1980، ومن خلال ضم هضبة الجولان المحتلة عام 1981.
لقد كان سارتر يعتبر أنه من المؤسف أن تكون مشكلة الفلسطينيين غير منظورة في بيانات الحكومة الإسرائيلية، وكان يجد أنه من خلال دفع الفلسطينيين إلى اليأس نتيجة رفض إعطائهم حق تقرير مصيرهم بذاتهم، وعدم السماح لهم بالمشاركة عبر ممثليهم الشرعيين في المفاوضات المرتقبة حول قضيتهم، قرر هؤلاء تنظيم كفاحهم المسلح في سبيل العودة إلى ديارهم في فلسطين. وبالفعل هو يبرر الكفاح المسلح الذي يخوضه الفلسطينيون، كما كان يبرر ذلك لجبهة التحرير الوطني الجزائرية.
وهو يحمّل مسؤولية العنف للإسرائيليين الذين أقفلوا كل الأبواب أمام احتمالات أخرى. إذن، بالنسبة إليه: «إن المسألة هي مسألة حق. وما دامت لا تتم مقاربة المشكلة وجهاً لوجه فستكون هناك (حركة فتح) وستكون هناك (جبهة تحرير فلسطين)، وهذا أكيد تماماً. بالتالي سيكون هناك توتر حاد، وفي نهاية الأمر ستقع حرب جديدة». وفي الوقت نفسه يعطي سارتر حقاً لإسرائيل عندما ترد على العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون ضدها؛ لكنه يجد شيئاً من الكذب على الذات (الإيمان الفاسد) في موقف الحكومة الإسرائيلية، عندما تهاجم بلداً مثل لبنان الذي لم يعلن الحرب ضد إسرائيل، بحجة الرد على المجموعات الفلسطينية المقيمة في هذا البلد. إذن، من الصعب بالنسبة لإسرائيل تدمير المقاومة الفلسطينية المنتظمة في مجموعات فردية وتعمل انطلاقاً من فلسطين ذاتها ومن الأراضي المحتلة حديثاً.
في مقابلة عام 1969 في مجلة «l’arche» يعالج سارتر النزاع العربي - الإسرائيلي بطريقة حالمة أكثر منها واقعية. في الواقع، هو لا يعتبر - بخلاف العرب - أن إسرائيل هي رأس حربة «الإمبريالية الأميركية»؛ بل يعتقد، على العكس، أن إسرائيل والعرب هم ضحايا «الإمبرياليتين الكبيرتين الأميركية والسوفياتية»، وأن النزاع في الشرق الأوسط هو نتيجة للتنافس القائم بين هاتين «الإمبرياليتين». وفي إجابة عن سؤال حول هذا الموضوع، قال سارتر: «فيما يتعلق بإسرائيل، فإن التواطؤ الموضوعي بين الروس والأميركيين ليس قابلاً للشك». بالنسبة إليه ما كان يجب على العرب والإسرائيليين أن ينخرطوا في لعبة الأميركيين والسوفيات؛ وذلك لأنه يعتقد أن الاقتصاد الإسرائيلي يجب أن يكون متمحوراً كلياً على الشرق الأوسط. وهو يقول حول هذا الموضوع: «من العبث اعتبار إسرائيل كرأس حربة للإمبريالية الأميركية، ولكن ما هو مؤكد أن إسرائيل الآن هي في حاجة إلى دعم اليهود الأميركيين». إذن، المَخرَج الوحيد لإسرائيل هو أن تتكامل اقتصادياً مع الشرق الأوسط. ولكي يحل السلام تجب إقامة الثقة بين الطرفين، واستبعاد الشروط التي تسبب خوفاً لهذا الطرف أو ذاك. ومن أجل المساهمة في هكذا عملية؛ فإن سارتر طمأن الإسرائيليين قائلاً لهم بأن العرب لا يريدون إلغاءهم كأقلية؛ لأن أقليات الشرق الأوسط، برأيه، تستطيع دوماً إيجاد حلول لمشاكلها بالتكيف مع محيطها. وبهذا المعنى يقول: «باستثناء الشرق الأوسط، إن مشكلة الأقليات غالباً ما تجد حلها في مجزرة...»، ولكن المشكلة تكمن في أن العرب يحقدون على الدولة الصهيونية، ويعتبرونها بمثابة جسم غريب مزروع بينهم من قِبل القوى العظمى، من أجل منعهم من الاتحاد فيما بينهم، وجعلهم يستنفدون قدراتهم الاقتصادية والعسكرية؛ وذلك كي لا يشكلوا في المستقبل خطراً على مصالح القوى التوسعية التابعة للإمبريالية العالمية. ولكن، من أجل طمأنة العرب الذين يرتابون من الصهيونية ويعتبرونها العدو الأول بما تمثل من مشروع توسعي، يقول سارتر لهم بأن الصهيونية أصبحت ميتة. ويصرح بهذا المعنى قائلاً: «برأيي، الصهيونية عاشت حياتها. وهناك سبب وجيه لاعتبار ذلك، هو أنه رغم أن الناس لم يشفوا من معاداتهم للسامية، فليس هناك في الوقت الراهن أزمة معاداة السامية، ولن تكون هناك أزمة كهذه في المستقبل المنظور. إن يهود الشتات يفضلون البقاء حيث هم».
إن سارتر الذي كان يؤمن بنهاية الحركة الصهيونية، وبالنوايا الحسنة لليسار العربي والإسرائيلي، سمح لنفسه بالتعبير عن أمل حالم أكثر منه ممكن التحقق بحلول سلام في الشرق الأوسط، يمكن أن يوحد أولئك الذين يتعرضون للاستغلال، سواء كانوا عرباً أم يهوداً، في الكفاح من أجل الثورة الاشتراكية، وهذا لن يتحقق إلا بدمج الاقتصاد الإسرائيلي في إطار الشرق الأوسط؛ حتى لا يكون هناك أي مبرر للارتياب بين المعسكرين.
وكي يجد صراع الطبقات أفضل شروطه للقيام بثورة حقيقية تستطيع تحرير إسرائيل والعرب من براثن القوى الإمبريالية الكبرى، تجب إقامة اتحاد المستغَليّن من الطرفين في النضال الاجتماعي نفسه. انطلاقاً من هذا الموقف، لم يدخر سارتر جهوده من أجل مباشرة الحوار بين مفكرين عرب وإسرائيليين على صفحات مجلته «الأزمنة الحديثة» من أجل خلق الشروط الضرورية لتقارب محتمل في وجهات النظر بين الطرفين.
والآن نتساءل: ماذا كان يمكن لسارتر أن يقول لو كان ما زال حياً بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982؟ وبعد مجازر «صبرا وشاتيلا» التي ارتُكبت بتواطؤ الإسرائيليين مع بعض القوى اليمينية اللبنانية المتطرفة آنذاك، ضد المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين؟ على أي حال، بالنسبة لأولئك الذين يتتبعون مسار التزامات سارتر، كان من الممكن جداً أن يغير موقفه تجاه إسرائيل، وخصوصاً بعد مجازر «صبرا وشاتيلا»، ويمكننا الذهاب أبعد من ذلك لنقول إنه من أجل تماسك الفكر السارتري، ونظراً لمعطيات المشكلة، كان من الممكن أن يتخذ موقفاً أكثر وضوحاً وأكثر التزاماً، وبالتالي أكثر واقعية، كما كان من الممكن أن يفعل في ظروف سياسية واجتماعية أخرى. بكلمة، يمكننا القول إن موقف سارتر حول الشرق الأوسط هو المثال النموذجي عن التباس أخلاق الالتزام الفردي.
* باحث وأستاذ جامعي لبناني
8:47 دقيقه
جان ـ بول سارتر والحق الفلسطيني
https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/4223551-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A



جان ـ بول سارتر والحق الفلسطيني

يهود يشاركون في مظاهرة ضد أفراد من مجتمعهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي في القدس - 28 مارس 2017 (رويترز)

جان ـ بول سارتر والحق الفلسطيني

يهود يشاركون في مظاهرة ضد أفراد من مجتمعهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي في القدس - 28 مارس 2017 (رويترز)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة