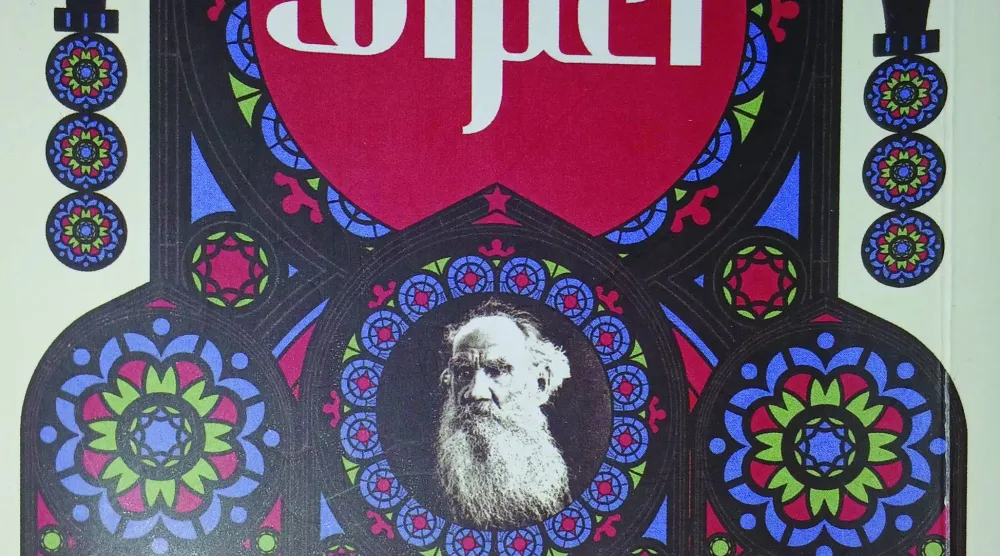لم تكن علاقة الشعراء بالسلطة لتستقر يوماً على حال واحد أو شكل نهائي، بل كانت على الدوام محكومة بالكثير من المفارقات والمشاعر المتداخلة والسلوكيات المتناقضة. وقد وجدت هذه السلوكيات تعبيراتها المثلى من خلال إلحاح الشعراء على رفض السلطة الحاكمة من جهة، وسعيهم المقابل إلى امتداحها والالتحاق بها من جهة أخرى. ومع أنهم يعرفون في قرارتهم أن ما أوتوه من عناصر الإلهام يمنحهم جواز سفر صالحاً للخلود، والسلطة على الأبدية، فإن الطبيعة الملتبسة والمؤجلة لهذه السلطة، تجعلهم دائمي السعي لامتلاك سلطة أرضية ذات معالم واضحة ونفوذ مرئي.
وقد يكون في خطاب الأخطل، وقد تعتعه السكْر، لعبد الملك بن مروان: «أتيت أجر الذيل تيهاً كأنني، عليك أميرَ المؤمنين أميرُ»، ما يؤكد أن العقل الباطني للشاعر، كان مسكوناً بهاجس الحلول محل ممدوحه، الأمر الذي يمكّنه بالتالي من التمتع بامتيازات الحكم ومباهجه وجبروته. أما الدليل الأبلغ على ما يستبد بالشعراء من شهوة الحكم، فيتمثل في سعي المتنبي الحثيث لأن ينتزع لنفسه، ولو رقعة متواضعة من الأرض، يحقق من خلالها تطلعه المزمن إلى السلطة، رغم علمه الأكيد بأنه يتربع على عرش شعري، لم يكف الناطقون بلغة الضاد عن محاولة الدنو منه، أو مقاسمته إياه.

والأرجح أن إقرار الشعراء بعجزهم عن منافسة الحكام فوق حلبات الواقع المحسوس، هو الذي جعلهم ينقلون المنافسة إلى حلبات المجاز، بحثاً عن السبق الشعري والمكانة المتقدمة. ولم يكن سخط كعب بن زهير على النابغة الذبياني، إثر تفضيل الخنساء عليه في مباهلات سوق عكاظ، سوى الدليل الأمثل على رغبته الحاسمة في أن ينتزع لنفسه موقع الصدارة الشعرية. لكن سعي الأقدمين إلى تقسيم الشعراء بين مراتب وطبقات، كما فعل ابن قتيبة وابن سلام الجمحي، لم يدفعهم إلى تنصيب أحد منهم أميراً مطلقاً على أقرانه، بحيث ظل لقب الشاعر الأول موزعاً بين التجارب المتنوعة لشعراء المعلقات في الجاهلية، وصولاً إلى المتأخرين كأبي تمام والبحتري وأبي نواس والمتنبي وغيرهم.
كان من الطبيعي تبعاً لذلك أن يثير تنصيب أحمد شوقي أميراً للشعراء في عام 1927، كل ذلك القدر من ردود الفعل، التي تراوحت دائرتها بين الترحيب الشعبي والوطني الواسع، وبين السخط العارم الذي أبداه إزاء الحدث الاستثنائي بعض الأعلام الكبار. وإذا لم يكن مفاجئاً أن يتخذ كل من العقاد وطه حسين موقفاً سلبياً من تتويج الشاعر، الذي طالما اعتبروه نسخة مكررة عن شعرية الأسلاف، فإن المفاجئ هو أن يشارك في حفل التتويج بعض منافسي شوقي ومزاحميه على اللقب، مثل حافظ إبراهيم وخليل مطران. والأرجح أن الرعاية الرسمية للاحتفال، فضلاً عن البعد الوطني للمناسبة، هي التي حسمت بالنسبة للمترددين وجهة الأمور، دافعة حافظ إبراهيم لمخاطبة صديقه اللدود بالقول:
أمير القوافي قد أتيت مبايعاً
وهذي وفود الشرق قد بايعتْ معي
ورغم أن قصيدة خليل مطران المطولة تضمنت اعترافاً بأهمية شوقي وامتداحاً لشاعريته، فقد حملت في طياتها تعريضاً مبطناً به، ووضعاً لتجربته في دائرة المحاكاة والنسج على منوال الأقدمين، كما في قوله:
لولا الجديد من الحلى في نظمه
لم تَعْزُهُ إلا إلى القدماءِ
كما لا بد من التنويه بأن موقف بعض الشعراء السلبي من الحدث لم يكن ناجماً عن سوء تقديرهم لمنجز المكرَّم الإبداعي، بل بدا اعتراضاً منهم على مبدأ التنصيب، كما هو حال أحمد رامي، الذي كتب في مقالة له: «أعترف أن أحمد شوقي أعظم من قرض الشعر عند العرب، لكنني لا أعترف للشعر بإمارة ولا أمير».
وإذا كانت مبايعة شوقي أميراً للشعراء هي الأولى من نوعها في الشعر العربي، فإنها فتحت شهية الآخرين على مبايعات أخرى مشابهة. وحين وجد الشاعر اللبناني أمين نخلة أن أقرانه الشعراء لم يحركوا ساكناً بشأن تنصيبه، أخرج من أدراجه أبياتاً ثمانية صدّر بها كتابه «الديوان الجديد»، زاعماً أن صاحب «نهج البردة» كان قد خصه بها ذات لقاء حميم جمعهما في لبنان. وإذ أفاد نخلة بأن الأبيات المشار إليها قد كتبت عام 1925، فإن من المفارقات المثيرة للشكوك أن ينصّب شوقي ولياً لعهده، قبل سنتين من حيازته اللقب، وأن يقول مشيراً إلى صاحب «المفكرة الريفية»:
هذا وليٌّ لعهدي وقيّمُ الشعر بعدي
فكلُّ من قال شعراً في الناس عبدٌ لعبدي
ديوانه زفُّ طيبٍ ونشْرهُ نشْرُ وردِ
والعصر عصر «أمينٍ» خيرٌ ومطْلعُ سعْدِ
ومما رفع منسوب الشكوك إلى أقصاه هو كون الأبيات المزعومة لا ترقى إلى شاعرية شوقي المعهودة، حتى في نماذجها الدنيا، بل تبدو شبيهة بأدب المجاملات والإخوانيات الفكاهية المرتجلة. كما أن توصيف المانح للممنوح بالعبد، واعتبار عامة الشعراء عبيداً عنده من الدرجة الثانية، هو أمر يسيء إليهما معاً، وإلى الشعر والشعراء في كل زمان ومكان.
وإذا كان الأمر مختلفاً تماماً مع الأخطل الصغير، الذي حاز اللقب عن طريق المبايعة لا التعيين، فإن الذين أعلنوا مبايعتهم لشاعر «الصبا والجمال»، في سياق الحفل التكريمي الذي أقيم له في بيروت عام 1961، كانوا أقل عدداً وتمثيلاً من أولئك الذين تحلقوا حول شوقي قبل عقود عدة. ومع أن بين من اجتمعوا للمبايعة شعراء من وزن عمر أبو ريشة ومحمد مهدي الجواهري وأمين نخلة وسعيد عقل، الذي استعاض عن الشعر بتطريزاته النثرية المتقنة، فقد اتخذت معظم القصائد الملقاة طابع المجاملة الاجتماعية والكدح التأليفي. وإذ وصف أنسي الحاج الشعراء المشاركين، في مقالة له في «النهار»، بأنهم «أساءوا الأمانة وتعروا من الذوق والصدق، وحتى من البراعة اللفظية»، أبدى بالمقابل حزنه على الأخطل الصغير الذي لم يتكلم عنه أحد، بل جعل المشاركون من تكريمه، حيلة للكلام عن أنفسهم وتلميع نرجسياتهم الفاقعة.
ومع أن صاحب «لن» قد ذهب بعيداً في انتقاده اللاذع لفكرة المبايعة، وتقريعه المرير للمبايعين، فالواضح أن الشعراء المشاركين بالمقابل، لم يقدموا للمكرم ما يتعدى متوفر القول، والصياغات الشائعة، والمعدة سلفاً لمثل هذه المناسبات. فلم يكن الانتشار الواسع لبيت أمين نخلة الشهير «ويقولون أخطلٌ وصغيرُ، أنت في دولة القوافي أميرُ»، ليحجب وقوعه في خانة النظم التقريري. ولم تكن قصيدة صالح جودت في المناسبة سوى ضرب من الأراجيز المسلية والنظم المتهافت، الأمر الذي يؤكده قوله:
كل تلك المعادن المختاره
صاغ منها حبيبنا أوتاره
وجلا من خيوطها أشعاره
فعقدنا له لواء الإماره
وإذا كانت فكرة الإمارة لا تكف عن دغدغة أحلام الكثير من الشعراء، وتعبر عن نفسها عبر أشكال ووسائط وتقنيات مختلفة، فإن ما لا ينبغي إغفاله هو أن الفكرة لم تولد من رحم الاعتبارات الإبداعية وحدها، بل تبلورت في كنف الاعتبارات السياسية والوطنية، التي جعلت من تنصيب هذا الشاعر أو ذاك، مكافأة رمزية لموقع الدولة التي يمثلها. فإذا كان شوقي بالنسبة للكثيرين جديراً بإمارة الشعر، نظراً لتميز تجربته واتساع مروحة موضوعاته، فإن في تنصيبه أميراً للشعراء مبايعة لمصر نفسها كدولة عربية مركزية، ولثقافتها الواقعة من محيطها «في مقام الزعامة»، كما جاء في كلمة أحمد شفيق باشا، رئيس الديوان الخديوي آنذاك. أما حلم أمين نخلة بولاية العهد، ومبايعة الأخطل الصغير «الجزئية» بالإمارة، فقد عكسا إضافة إلى البعد الشخصي، الرغبة الملحة في الاعتراف بشاعرية لبنان، الذي أسهم إلى جانب مصر، وعلى تواضع حجمه الجغرافي والسكاني، في وضع اللبنات المبكرة لما عُرف بعصر النهضة العربي.
إلا أن ما ينبغي التشديد عليه، أخيراً، هو أن الشعراء المتدافعين بالمناكب لكسب السباق على اللقب، إنما يتنافسون في الواقع على خط اللاوصول، أو لبلوغ نقطة دائمة التحول، أو إمارة مستحيلة التحقق. كما أن الشعر، والفن بوجه عام، يظل شأناً نسبياً وحمّال أوجه، وهو بالتالي لا يخضع لقولٍ فصل، بل تختلف معاييره وفقاً لذائقة كل ناقد أو قارئ. ولعل الزمن وحده هو الذي يُصدِر في نهاية الأمر أحكامه وفتاواه، واضعاً بنفسه الحدود الفاصلة بين قمح الشعراء الحقيقيين، وزؤان المقلدين والنظامين. ولذلك فإن الأحجام الحقيقية لشوقي ونخلة والأخطل الصغير، وكثيرين غيرهم، لا يحددها لقب الإمارة وحفلات المبايعة والتنصيب، بل هي منوطة بثراء تجاربهم وتنوع أساليبهم، وعمق مكابداتهم القلبية والرؤيوية.