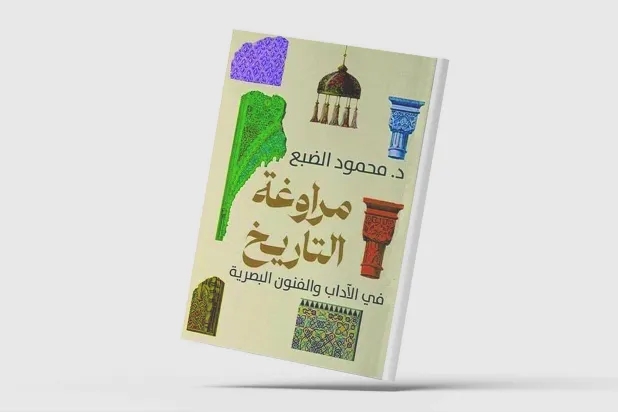لأول مرة، يجمع عمل واحد كل ما قاله نجيب محفوظ حول أسرار فن الكتابة لديه وطقوس الإبداع، من واقع تجربته العملية الخاصة، وهو ما يوضح أهمية كتاب «نجيب محفوظ– عن الكتابة» الصادر عن دار «الكرمة» بالقاهرة، للباحث عمرو فتحي.
في هذا الكتاب، يتحدث أديب «نوبل» عن علاقته بمؤثرات خارجية وداخلية تؤثر على الكتابة لديه، مثل الحالة المزاجية، والموسيقى، وفصل الخريف، وكذلك الإلهام، وهل يخضع له أم لا؟ ومتى يعرف أن الموضوع الذي خطر بباله يستحق الكتابة؟ وما الفارق بين كتابة الرواية والقصة القصيرة؟ وهل يشغل نفسه أثناء الكتابة بتساؤلات وجودية؟ مثل: «هل يُكتب لهذا النص الخلود؟».
يتضمن الكتاب إجابات شافية عن كثير من علامات الاستفهام في هذا السياق التي تكشف عن خفايا وكواليس الإنتاج الإبداعي لعميد الرواية العربية، والأب المؤسس لهذا الفن السردي في ثقافتنا.
يقول محفوظ إنه كتب أغلب أعماله وهو في «دوامة انفعال نفسي وفكري»، فهو لا يحب أن يكتب شيئاً وهو في ظروفه الفكرية الهادئة، فالأحداث والأنباء تثير الأفكار، وبوصفه كاتباً يضع نصب عينيه ألا يتخلف عن الحياة، ويسعى لأن يعايش حياة الناس حوله، ليستشف من وجوههم فهمه لواقعهم، لأسلوب حياتهم، لأفراحهم وأحزانهم وكل قيم وجودهم حتى يصورها ويعبر عنها.
ويشير إلى أنه أحياناً يكون قد مر على الفكرة عام أو عامان دون أن يمسك بالقلم، حتى إذا وصل إلى مرحلة التنفيذ فإن المسألة تتحول إلى عمل يجب أن يُنجز، ولن ينجز إلا بالإرادة والصبر، فهو لا يعرف «دلال الإلهام»، وإنما يعرف أن عليه أن يجلس إلى مكتبه كل يوم ساعة أو ساعتين، حتى يفرغ من الرواية في عام أو عامين.
إنه يكتب الموضوع كتابة أولى غير متمهلة وشبه عفوية، ولكنه لا يبدأ الكتابة إلا بعد اختمار الفكرة في نفسه وكذلك الشخوص، ثم يشرع في كتابتها بتأنٍّ من أولها إلى آخرها. وفي الكتابة الثانية يتغير النص تغيراً كبيراً، ولكن الفكرة لا يصيبها التغيير إلا في أضيق الحدود.
ويوضح أنه عبر تجربته الممتدة، مرت عليه فترة لم يكن يبدأ في كتابة الرواية إلا بعد أن يعايش أحداثها مدة طويلة، إلى أن تتبلور الفكرة تبلوراً نهائياً في ذهنه، بعد أن يكون قد تحدث إلى أشخاص كثيرين، بوصفه نوعاً من البحث وجمع المعلومات واستقراء الأحداث، وعندها يبدأ في الكتابة من منظور واقعي بحت.
وفي فترة أخرى، كان يكتب نصوصاً مدفوعاً بحالة ذهنية، فيشرع في تأليف العمل وليس في ذهنه سوى زاوية صغيرة أو فكرة معينة غامضة، ويترك للقلم أن يتدفق ويسيل عبر توارد الأفكار لاحقاً.
وفي أحيان ثالثة، كان يكتب انطلاقاً من «اللاشيء» بمعنى أنه لا توجد في ذهنه أي فكرة على الإطلاق، سوى الرغبة في الكتابة.
ويرى محفوظ أن عملية الكتابة في حد ذاتها هي فعل متفائل؛ لأنها تؤكد أن الكاتب يعتقد أن العالم رغم كل ما به من مآسٍ يمكن أن يكون أفضل مما هو عليه، وهذا يقودنا إلى أن الكتابة مسؤولية، فلا بد من أن ينطوي النص على ابتكار جديد، وإلا فهو لا يستحق أن يكون عملاً فنياً. والقارئ لا يريد أن يطالع ما سبق أن كتبه الآخرون.
الخلود والسجائر
وعما إذا كان يشغل نفسه بمسألة الخلود الأدبي، يتساءل محفوظ: ولكن ماذا يعني الخلود أصلاً؟ مائة سنة؟ عدة مئات من السنين؟ وماذا تكون تلك الفترة البسيطة إذا قورنت بتاريخ الوجود الإنساني؟ الحقيقة أن أي كاتب يتمنى أن يبقى إنتاجه؛ لكنه لم يشغل نفسه قط بموضوع الخلود أو يفكر فيه أو يتصوره، بالعكس هو دائماً خائف من الموت، ولذلك كتب عنه كثيراً؛ لأن الكتابة عن الشيء تحرر الإنسان من مخاوفه، على حد تعبيره.
ونتيجة انقسام حياته بين الوظيفة والأدب، اقتضى الأمر من محفوظ إخضاعها لنظام دقيق، حتى يتسنى له دائماً وبصفة مستمرة مواصلة الكتابة. ولظروف خاصة وحتمية، اقتصر موسم عمله الأدبي على الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وأبريل (نيسان) من كل عام. ولم يعد ذلك خسارة مطلقاً؛ إذ أخذ من أشهر مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) راحة نسبية، واختلاطاً بالناس والأماكن، فنضجت خبرته بالمكان الضيق الوحيد الذي عاشره على ظهر الأرض، وهو القاهرة.
ومر محفوظ إبداعياً بثلاث مراحل، هي: مرحلة «الوظيفة»، ومرحلة «ما بعد التقاعد»، ومرحلة «ما بعد جائزة نوبل». في مرحلة الوظيفة كان يفرغ من عمله في الثانية ظهراً، ويعود إلى البيت لتناول الغداء، ثم يستريح بعض الوقت عبر نوم القيلولة، ثم يجلس على مكتبه عندما تدق الساعة الرابعة، ويبدأ في الكتابة أولاً لمدة 3 ساعات، ثم تليها 3 ساعات أخرى للقراءات المتنوعة. وفي هذه المرحلة كان يمنح نفسه إجازة من الأدب، يومي الخميس والجمعة.
يقول محفوظ: «لم يكن جلوسي اليومي للكتابة بالأمر السهل؛ لأنه يقتضي أولاً أن يكون موضوع الكتابة قد اختمر في ذهني، وكان هذا الأمر يجعلني في حالة تفكير مستمر أثناء وجودي في الوظيفة، وفي أوقات العمل، وفي أثناء المشي، وحتى وقت تناول الطعام. وفي كل مرة تأتيني تفصيلة من جسم الرواية، وما الراوية إلا مجموعة تفاصيل صغيرة تتجمع وتكون العمل الروائي في صورته النهائية. في بعض الأحيان كنت أسجل بعض الملاحظات والأفكار العابرة التي تأتيني أثناء وجودي خارج المنزل في ورقة صغيرة حتى لا أنساها، وكنت أهتم بتسجيل هذه الملاحظات خلال فترة اهتمامي بالكتابة الواقعية. أجلس على المقهى مثلاً، فتجذب اهتمامي ملاحظات وتفاصيل صغيرة كانت تفيدني أثناء الكتابة».
ويوضح أنه إلى جانب السجائر، يحب أن تكون هناك خلفية موسيقية أثناء الكتابة، يجعلها في هامش الشعور ولا يلتفت إليها، ثم إنه لا يتناول أي مشروبات بما فيها الشاي والقهوة، ويدهشه ما يسمعه عن بعض الكتاب الذين يحرصون على تناول الخمر أو الحشيش حتى يهيئوا أنفسهم للكتابة، فعندما يمسك بالقلم لا بد من أن يكون في أقصى درجات الوعي والتركيز والانتباه، ثم إنه لا يستطيع الكتابة إلا على مكتبه في البيت، أما خارجه فلا يمكنه الإمساك بالقلم. وكل أعماله الروائية كتبها في البيت باستثناء السيناريوهات، فأغلبها قام بكتابته على المقهى، وذلك لأنها لا تحتاج إلى درجة التركيز نفسها التي تحتاجها الروايات.
وعندما خرج إلى المعاش وتقاعد، لم يختلف نظام الكتابة كثيراً. يذهب إلى المقهى مبكراً، ثم يعود ليبدأ الكتابة ولمدة 3 ساعات؛ حيث خصص فترة الصباح للكتابة. أما القراءة فكانت في فترة ما بعد الظهيرة حتى بدايات الليل. وقبل حصوله على جائزة نوبل أصيب بضمور في شبكية العين، ما جعل موضوع القراءة والكتابة من الأمور العسيرة والمرهقة، وسبَّب هذا الأمر له إزعاجاً شديداً وهدم النظام الذي سار عليه طيلة حياته؛ بل لم يعد هناك نظام أصلاً؛ حيث امتنع عن القراءة نهائياً، وأصبح أقصى مدة يجلس فيها إلى مكتبه لممارسة الكتابة ساعة واحدة في اليوم.
ويشير نجيب محفوظ إلى أنه أحب فصلَي الخريف والشتاء، وكان يجد نفسه مقبلاً على الدنيا أكثر في ذلك الوقت من السنة، بينما يتحمل الصيف بصبر، وكأنه يغالب حالة -وإن كانت خفيفة- من الاكتئاب، ويظل ينتظر حلول الشتاء التالي، ويجد نفسه مقبلاً على الكتابة وهو في حالة من الاشتياق.