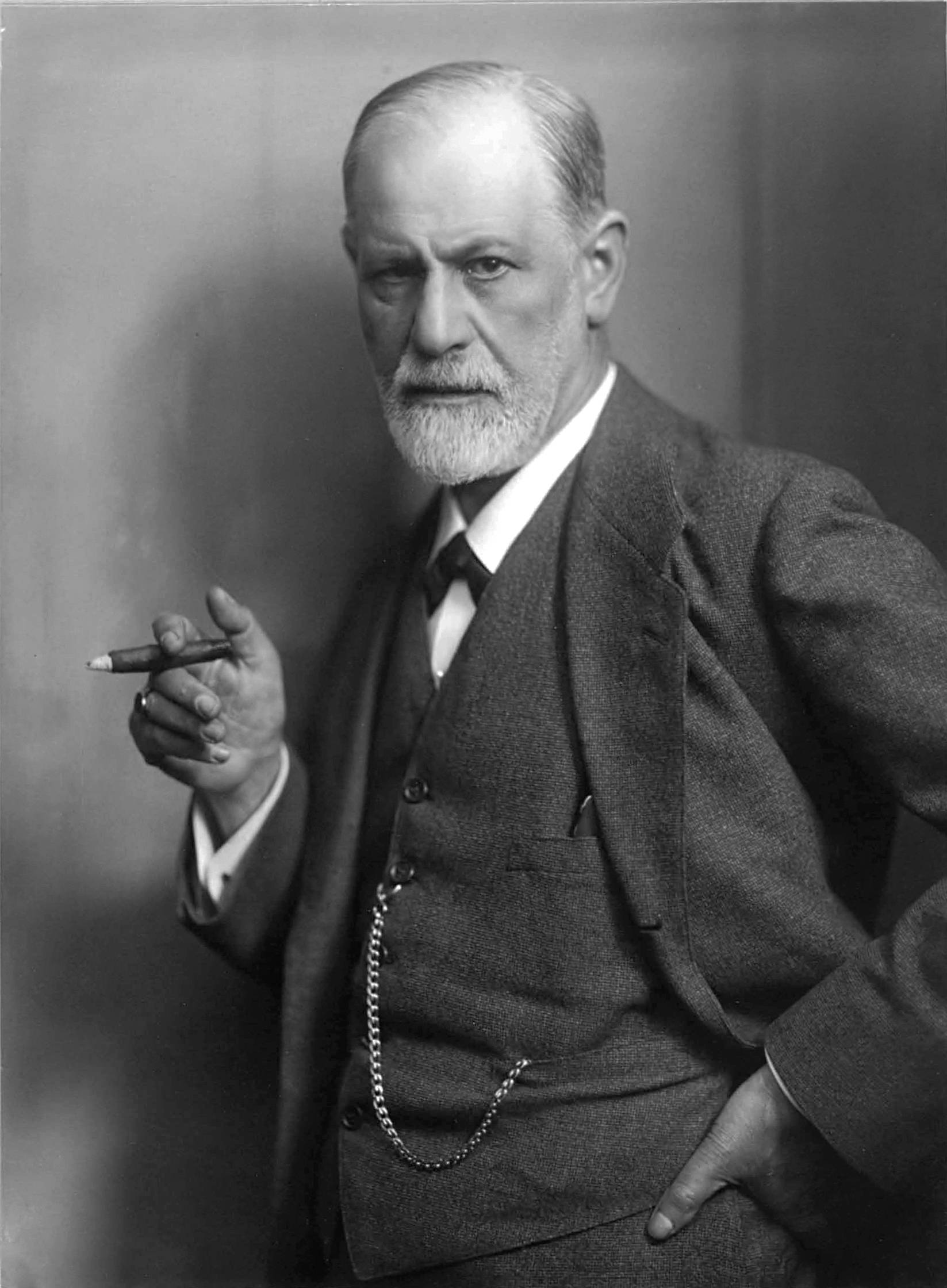ثلاث استراتيجيات سردية أساسية نفترض، ابتداءً، أن الكاتبة العراقية ميسلون هادي قد اعتمدتها في روايتها «ساعة في جيب الملك: وتر/ البصرة، 2023»، وهي تسعى لتفريغ قصة الملك من مظاهر القصة الظافرة المشبعة بالقوة والجبروت، وتحويلها، من ثمَّ، إلى قصة ملك يجري نحره والتضحية به في سياق تراجيديا عراقية، تذكرنا مصائر أبطالها بالنهايات المأساوية لأبطال التراجيديات الكبرى في التاريخ، كما في المسرحيات والروايات المؤسِّسة، وقد غُلب الملوك فيها على أمرهم؛ فصاروا «أمثولات» راسخة يصعب تكرارها شأن الملك أوديب أو هاملت. نتحدث عن سرد الضحية، وقصة العائد المختلفة، ونظام المخطوطة بصيغة التسجيل الصوتي المدمج بقصة قاتل.
لكن سردية «الملك» في الأدبيات العربية «الإسلامية» مشبعة بثيمات الظلم والتعسف، يقابلها الولع بشخصية «الثائر»، أو حتى «المتمرد» على الملك. هذه الثنائية الضدية سعت «روايات» عراقية متعدِّدة للانقلاب عليها، بل وإدانتها غالباً، رواية «الملك في بجامته» لخضير فليح الزيدي نموذج سابق على القراءة المفارقة للتاريخ السردي القريب. ومثلها بالضبط رواية «هادي» التي تحتفي بحياة القصر الملكي وملكه الشاب؛ فتصف ما حدث بأنه «قصة طويلة تستحق أن تُروى». ولتسويغ ذلك «الانقلاب» الحكائي فإن الرواية تخترع حكاية موازية تخصُّ الشخصية الرئيسة، نور ماضي خطاب، وسيجري وصفها بـ«حكايتي معه هي الأخرى قصة طويلة تستحق أن تُروى» أيضاً. لنترك حكاية «نور» مع صاحبها «إسماعيل باشا»؛ فهذه مجرد «ذريعة» للسرد، إنما حكاية «نور» بالدلالات المفارقة للاسم هي الأصل، وهي الاستراتيجية الأولى لتحويل «الملك» إلى «ضحية»؛ لتكون لنا قصة جديرة بالسرد، أو كما قالت «نور» نفسها «تستحق أن تُرى»؛ وكأن الحكايات الأساسية هي حكاية الضحية فحسب؛ إذ لا بد أن يكون هناك ضحية؛ فإذا لم يوجد فيجب إيجاده، أو اختراعه، سوى أن اختراع الحكايات، شأن سردية المظالم والضحايا، ليس بالأمر الهين، وإن تحقق فإن المجاهرة به تستلزم سياقاً تاريخياً وثقافياً مناسباً، وليس هناك أصلح من عراق محتل وديكتاتور لا يترك وراءه سوى قصة بلاد محطَّمة.
سردية العودة
تعود «نور» لبلادها بعد أربعين عاماً من الحياة في لندن، لكنها لا تعود لتحكي لنا قصتها الضائعة، أو تركتها المفقودة، أو حتى الصياغات الأولى لليوتوبيا العراقية كما نجد ذلك في قصة العائد الأول كريم داود في مخاض فرمان؛ أو كما اتخذته قصص العائد المنفي بُعيد عام 2003 من ثيمات وصياغات حكائية متقاربة مثل أن يعود المنفي ليدفن ماضيه كما في عودة حسين الموزاني المبكرة، أو لكتابة القصة المؤجلة كما في رواية «ملائكة الجنوب» لنجم والي، أو للبحث عن الوديعة الضائعة كما في رواية «عودة إلى وادي الخيول» لكريم كطافة، أو لكتابة قصة الدمار المكررة على أصعدة الحياة المختلفة لبغداد كما في رواية «فهرس» لسنان أنطون، إنما نحن هنا إزاء منطق مختلف تمثِّله قصة عائدة مختلفة أيضاً. فما الجديد المختلف المميِّز لرواية «ساعة في جيب الملك» عن سواها من روايات العائد العراقية؟ ابتداءً؛ ليست الكاتبة، ولا بطلتها نور خطاب ماضي، ولا حتى عالم الرواية ومجازها السردي مما اختلف، جذرياً، مع نظام صدام والرواية، من ثمّ، مما لا يمكن أن تصنف من قصص المنفي العائد؛ فـ«نور» ذات الاسم الدال على الضوء الهادي أو الكاشف في ظلمة البلاد بعد عام 2003، سافرت عام 1967 للندن ضمن بعثة المتفوقين، وارتأت البقاء هناك لدراسة الطب والتخصص، وفي الأربعين سنة التي أقامتها هناك، عادت مرة واحدة «في الأقل هذا ما تقوله الرواية»، وقد يعني لنا هذا الأمر أن التعويل على سردية العودة في فهم الرواية وعوالمها السردية أمر لا يحقق الكثير للقارئ، سوى أنها استراتيجية محددة ومقيدة، في الوقت ذاته، بإشكاليات تحويل «الملك» إلى «ضحية».
أفكر، هنا، أن تقييد الرواية بسرد الضحية قد «حرم»، «سردية العودة» من فضاءات متعدِّدة كانت قد رسَّختها روايات عراقية وعربية سابقة، ولا بأس؛ لكن «تيمة» العودة في الرواية قد اقترحت موضوعاً حكائياً جديداً يخالف، وقد نقول يتصادم مع موضوعات العائد المنفي المستقرَّة. إن العودة، في هذه الرواية، تتعلَّق بإعادة سرد قصة الملك، وهي من القصص المنسيَّة أو المهملة. ولنا أن نقول، حسب الاطلاع، إن نص «ساعة في جيب الملك» هو النص العراقي الأول في تاريخ الرواية العراقية الذي يستعيد قصة الملك الضحية وسيرته، ويربط هذه الاستعادة بموضوعات العودة السردية للشخصية العراقية المنفية لبلادها.
القصة المنسية
لا تذكر الرواية أن «نور» قد عادت لبلادها سوى مرة واحدة؛ كان ذلك بعد أن انتهت من دراستها الأولية، وسرعان ما تعود لتكمل دراستها في الطب. لا ذكر، إذاً، لعودة أخرى بعد مصرع «الشقيق» في حرب الثمانينات مثلاً، ولا عودة لـ«نور» بعد موت الأم والأب في أوقات متباعدة. لكن «نور»؛ وهذا بعض المفارقة الكبرى في الرواية، لم تملك بيتاً، أو تستقل به بمفردها، في مغتربها الإنجليزي؛ إذ ظلت، أربعين عاماً، تستأجر غرفة في منزل «المسز وايت» ببرستول؛ فلِم العودة إذاً لبيع البيت إذا كانت العقود الأربعة هناك لم تغرِ «نور» بالاستقرار في بيت خاص؟ وفي المقابل ثمة تقشف حكائي، والأفضل أن نسميه فقراً حكائياً رافق عودة «نور» للبلاد؛ إذ ستجد نفسها مجبرة على الاعتكاف في البيت، فلا تتمكّن من الخروج والتجوال في بغداد؛ وكيف لها ذلك وبغداد، آنذاك، كانت مطحنة كبرى للحكايات والبشر «الأرجح أن نور عادت عام 2007 في ذروة اشتعال الحرب الأهلية في البلاد»! ولا تنتهي مفارقات هذه العودة؛ فنحن «نعود» مع الراوية المتكلمة، غالباً، لنستعيد حياتها اللندنية، أما حياتها البغدادية القصيرة فتكتفي الصور وسرودها المقتضبة بإضاءة جوانب مختلفة من ماضي الراوية؛ وكأن الشخصية «تعود» لتروي لنا حياتها السابقة في لندن فحسب؛ فأي مفارقة أن تكون المساحة النصية لحياة الراوية في لندن أكبر بكثير من حياتها ببغداد!
لِم عادت «نور» إذاً؛ ما دامت سردية العودة لم توفِّر لها المادة الحكائية الساندة؟ الإجابة حاضرة؛ عادت لأجل «بيع» بيت العائلة بعد موت الوالدين وهجرة الأخت الشقيقة الوحيدة. وهذه، كما ألمحنا قبلها، مجرد حجة، أو مسوِّغ للعودة لأجل سرد القصة وهي، هنا، قصة تحويل «الملك» إلى «ضحية».
حكايات متداخلة
تنتمي الرواية لسياق ما بعد الحداثة. وهي رغم ذلك لا تدَّعي الانتماء للمقولات الأساسية لمنظومة الـ«ما بعد»، لكنها تستخدم ما يفيدها بذكاء واحترافية بالغة. نظام المخطوطة، مثلاً، تستخدمه الرواية عبر منظومة التسجيل الحكائي للجدة في سياق حديثها «لنقل وصيتها» الأخير مع حفيدتها. وفي التسجيل الصوتي يجري دمج الحكايات كلها: حكاية الجدة، وحكاية الملك «الضحية»، وحكاية البلاد التي توقفت الحياة فيها بتوقف «ساعة» الملك، وكل هذا نسمعه في لحظة فارقة واستثنائية، إنها لحظة ما بعد الديكتاتور، وهي ذاتها لحظة البلاد المحتلَّة ولكنها، أيضاً، لحظة الخراب الشامل غير المنتهية بموت الجدة بعد أن توقف قلبها خوفاً من قصف طائرة أميركية (2003)، ولا حتى بنهاية كابوس اختطاف «نور» من قبل عصابة «طائفية».
لنستعد مجدداً عنوان الرواية ومفتتح عالمها السردي. يتصدر الرواية عنوان إشكالي غير ذي دلالة مسبقة، وهو ينطوي على الإيهام بوجود إشكال نحوي مقصودة كما أفترض؛ إذ إنه يخالف الأصل في الكلام العربي؛ لأنه يبدأ بالنكرة «ساعة». ثمة قصد مفترض في ابتداء الرواية بـ«النكرة» وليس في الجملة وهم أو خطأ؛ فالعنوان يفترض، مسبقاً، أن الرواية ستتولى مهمة تعريف الكلمة المنكَّرة. وهذا بعض الدلالات المضمرة، لنقل إنه بعض المقاصد غير المعلنة للرواية، كأن تقول لنا إن الساعة هنا هي انتظام الزمن المفقود في بلاد «نحرت» ملكها. لكن الرواية تسرف في ظنونها فتترك شخصياتها تتقوَّل كثيراً. أتحدث هنا عن صفة القاتل وقصصه في الرواية والأدب العراقي مثلاً. وعندي أن «صفة» القاتل ابتدأت وارتبطت «تاريخياً» بمذبحة شباط عام 1963. هكذا سيطلق النقد العراقي صفات متقاربة على قصص مجموعة وروايات عراقية كثيرة انطلقت من توصيف «ثقافي» سردي لشخصية القاتل المتولِّد عن تلك المذبحة الشهيرة. وسنقرأ في المتون النقدية الرئيسة اصطلاحات من قبيل: رواية الجحيم العراقي، ومدونة شباط وغيرهما. وسيقف النقد القصصي/ السردي عند نصوص شهيرة كُتبت عن تلك الأحداث، وفي الطليعة منها: رواية «الرجع البعيد» لفؤاد التكرلي، وقبلها قصص «من قتل حكمت الشامي» لجمعة اللامي، وغيرهما كثير.
رواية «ساعة في جيب الملك»، وغيرها، تعيد موضعة قصص القاتل بعيداً عن مذبحة شباط، وسابقة زمنياً عليها. وربما سيشهد المستقبل توسعاً عراقياً سردياً في موضوعة قصص القاتل. وهذا ما حدث، مثلاً، مع موضوعة المنفى؛ فهو لم ينته بسقوط الديكتاتور. ولنا أن نتذكر أن هناك من أعاد توظيف مقولة الجواهري المختصرة ببيته الشعري الشهير «باقٍ وأعمار الطغاة قصار» في صبيحة إعدام صدام، والتاريخ السيري العراقي طالما حدَّثنا عن صرخات مشابهة قالها ضحايا صدام نفسه، وهم يلفظون أنفاسهم تحت التعذيب أو وهم يتلقَّون الرصاص. نعم، التاريخ العراقي يقول لنا الحقيقة ونقضيها. وحياة الجواهري نفسه نموذج فريد لهذه التحولات؛ علينا فقط، ربما، أن ننتظر ونرى.