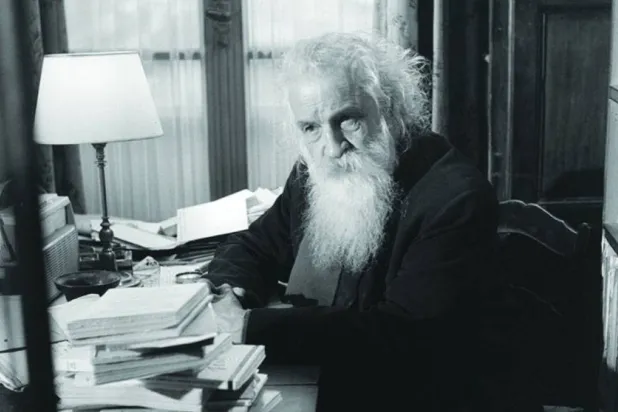بصدور أنطولوجيا القصة التشيلية المعاصرة، الموسومة بـ«لو لمست أوتار قلبي» - دار خطوط وظلال، عمّان - 2024، يكون المترجمان المغربيان سعيد بنعبد الواحد وحسن بوتكى قد أضافا إلى المكتبة العربية كتاباً جديراً بالتنويه والاهتمام. وهو يجيء ضمن سلسلة إنجازاتهما ومبادراتهما المتميزة، بشكل فردي أو مشترك، في مجال ترجمة الأدب المكتوب بالإسبانية أو البرتغالية إلى العربية. تكمن أهمية هذه الأنطولوجيا، بالدرجة الأساس من الحاجة إليها، لمجهولية فن القصة التشيلية، للقارئ العربي عموماً، على الرغم من أهمية المنجز القصصي التشيلي وتميزه، حتى بالنسبة إلى واقع القصة في بقية دول أميركا اللاتينية، وكما تؤكد مقدمة الأنطولوجيا، فإن «القليل هم من يعرفون إسهام الأدب التشيلي في تطوير جنس القصة القصيرة في أميركا اللاتينية»، أي ما يعطي لهذا الأدب دور الريادة. من هنا يكتسب عمل مثل هذا أهمية مضاعفة، ففضلاً عن مهمة التعريف بهذا الجانب الحيوي من الأدب التشيلي، وتقديم نماذج قصصية مهمة في ذاتها، فإنها مثّلت في الآن نفسه، فترة زمنية شاسعة زادت على القرن. وإذا ما بدا عدد الكتاب المختارين محدوداً، وهم أحد عشر كاتباً وكاتبة، بواقع قصة لكل كاتب، فإن ذلك لم يحُل دون تمكين القارئ من إطلالة بانورامية على المشهد القصصي التشيلي المترامي زمنياً، حتى مع الإقرار بوجود بعض النقص، مثال ذلك غياب كاتب مهم وأساسي في المشهد الأدبي التشيلي هو الروائي والقاص «مانويل روخاس» الذي تعرّف عليه القارئ العربي من قبل عبر روايته المهمة «ابن لص». لكن تبقى لكل مختارات ظروفها وأسبابها في حضور كاتب وغياب آخر.
استُهلّت الأنطولوجيا بالكاتب «بالدوميرو ليو»، وهو أحد رواد القصة التشيلية، إذ صدر له منذ عام 1904 أربع مجموعات قصصية، وهو يُحسب، نقدياً، على المذهب الطبيعي، واهتمّ في نصوصه بـ«مواضيع اجتماعية، مثل الظلم، واستغلال العمال في المناجم، والحياة القروية القاسية»، وسوى ذلك، كما جاء في الصفحة التعريفية الموجزة بالكاتب التي سبقت قصته، والتي ذكرت أيضاً، بأنه يصف الواقع بدقة بُغية فضحه. وهو ما كان في قصته المختارة هنا من مجموعته الأولى «تحت الأرض»، والمعنونة بـ«البوابة رقم 12»؛ إذ تتعرّض القصة إلى عالم عمال المناجم القاتم، بالمعنى الحرفي، فالظلام العميق أبعد من أن يُبدّد بمصابيح هي على وشك الانطفاء، بتعبير القصة، والسخام الذي يحيط بالعمال هو من صلب الأجواء الخانقة التي نجح الكاتب في تصويرها بحرفية وعمق كبيرين، وهو يعالج موضوعاته الرئيسية والمتعلقة بعمل الأطفال في المناجم، من خلال شخصية الطفل «بابلو» ذي الثماني سنوات، وما يعنيه ذلك. وينجح الكاتب، فضلاً عن وصف المكان وأجوائه، في وصف المشاعر الإنسانية المتضاربة لكل من «باولو»، وما ينتابه من خوف وأفكار حيال المكان، وما يبعثه فيه من رهبة، ومن ثمّ الأب ومسؤول العمل، وترددهما في تشغيل الطفل من عدمه، كاشفاً عن مقدرة عالية في سبر نفوس أبطاله، وما يعتمل فيها من هواجس والتعبير عن كل ذلك ببراعة.
رهافة وحرفية
امتازت القصص الإحدى عشرة التي شكّلت مادة الكتاب، برهافة الصنعة القصصية وحرفية كتابها العالية، وهو الانطباع الأهم الذي يراود القارئ ما إن يفرغ من قراءة كل قصة من القصص. وإذا كان هناك من تفاوت في الموضوعات، بطبيعة الحال، فلم يكن من تفاوت على صعيد التقنية القصصية المُحكمَة. حتى في حال عدم الاتفاق مع الثيمة الأساس لقصة ما أو الشعور ببطء السرد فيها، كما في قصة الكاتب «خورخي إدواردز»، المعنوَنة «النظام العائلي»، وهي أطول قصة في الكتاب، فقد احتلّت 30 صفحة منه، لكن لم تكن لتخرج، بدورها، عن دائرة الإبداع والإحكام التقني، والضرورة أيضاً تقتضي هنا الإشارة إلى أن هذه هي القصة الوحيدة التي يمكن تسجيل الملاحظة الآنفة عليها. عدا عن ذلك لا يمكن إلا وصف بقية القصص بالتفوّق وبقوة تأثير الموضوعات المتناولة فيها، التي لا يمكن لقارئها نسيانها لما حملته من شحنات إنسانية ولما اتشحت به من إهاب جمالي. وكما تشير المقدمة بما معناه، أن الكتّاب المختارين هنا لم يُولوا اللعب السردي المجاني اهتمامهم، قدر اهتمامهم بما هو إنساني، وكأنهم بذلك «أكثر جدية وأكثر انشغالاً بهموم الإنسان»، من بقية كتاب القصة في مختلف أنحاء القارة اللاتينية.
في هذا الشأن يمكن استحضار عنوان أكثر من قصة، وقد تكون في مقدمة ذلك قصة إيزابيل الليندي، التي منحت عنوانها الشاعري للأنطولوجيا «لو لمست أوتار قلبي»، التي يمكن أن تكون شاهداً متقدماً على شعرية القص، من الناحية الفنية، ومثالاً على توحّد الكاتبة هنا، أو الكاتب عموماً، مع قضايا المجتمع، لناحية المحتوى. لقد قدمت الليندي من خلال نموذج «أورتينسيا» صورة مروّعة لما يمكن أن يؤدي إليه الاستبداد والفساد من مظالم، و«أورتينسيا» هذه يمكن أن تصلح رمزاً لواقع أميركا اللاتينية، عموماً، حيث تُختطف وهي في سن الخامسة عشرة، وتُحتجز لما يقارب نصف قرن في قبو من قبل «أماديو بيرالتا»، الذي يمثّل صورة عن الانحلال الأخلاقي بوصفه فرداً ومثالاً للسلطة المتعسفة، لاحقاً. إذ لفتت انتباهه للمرة الأولى من خلال عزفها، وهو ما قلب حياتها رأساً على عقب. إن السنوات المديدة التي عاشتها «أورتينسيا» في قبو محرومة من ضوء الشمس ومن الهواء النظيف، بل بالأحرى من كل مستلزمات الحياة، حوّلتها إلى نوع من مسخ كما برعت الكاتبة في تصويرها، فقد تحطّم جسدها بالكامل سوى يديها اللتين سلِمتا بسبب مواصلتهما العزف، وما في ذلك من رمزية، وهو شبيه بالإشارة البليغة للكاتبة، لحظة العثور على «أورتينسيا» وتحريرها بأنّ ما كان يؤكد أصلها الآدمي فقط هو آلة القانون التي تحضنها.
تكمن أهمية الأنطولوجيا بالدرجة الأساس من الحاجة إليها لمجهولية فن القصة التشيلية للقارئ العربي عموماً
أجيال متعددة
لقد سبقت الإشارة بأنه لا يمكن لقارئ هذه القصص نسيانها، لطبيعة موضوعاتها أولاً، وللإطار الفني الاحترافي الذي وضعها فيه كتابها وكاتباتها. من بين هذه القصص قصة «سيدة» للكاتب خوسي دونوسو، الذي يتم التعريف به بصفته «أكبر روائي تشيلي في القرن العشرين». بدءاً يمكن القول عن القصة إنها مشوّقة، ذات طابع شعري، وليس المعني بذلك اللغة، فمسألة اللغة قابلة للجدل، لكن المقصود هنا بالشعري هو بنية القصة ذاتها، والروح المبثوثة في القص والتفاصيل الحية التي جعلت حتى من هواجس البطل الداخلية وأحلامه شيئاً مجسداً، مرئياً. تتحدث القصة ذات البعد الفلسفي عن شعور البطل الذي هو الراوي نفسه، بأن المشهد الماثل الذي يعيشه ويصفه للقارئ قد عاشه من قبل أو حلم به. هذه الفكرة الرئيسية التي قامت عليها القصة أو انطلقت منها هي فكرة فلسفية بالأساس، وقد تعرّض لها سبينوزا من قبل، مسمياً هذا الشعور «ذكرى الحاضر». يستثمر الكاتب طاقة هذا الشعور الخفي لينشئ نصاً من أجمل نصوص السرد القصصي، لا سيما العلاقة الغامضة والحلمية بين البطل والسيدة المجهولة التي يصادفها في عربة «الترام»، رغم أنه ليس من علاقة تنشأ بين الاثنين، ولم يتبادلا حتى مجرد كلمة، لتغدو القصة بكاملها مساحة للتعقب والترقّب من قبل البطل، ويتدفق السرد هادئاً حتى النهاية، نهاية السيدة عندما تخيّلَ البطل موتها حين قرأ في الجريدة نعياً لسيدة تُدعى «إستر أرانثيبيا»، رغم أنه لا فكرة لديه مطلقاً عن اسمها، وهذا أغرب موقف في القصة، لينتهي إلى القول إنه يُخيّل إليه أنه قد عاش حدثاً شبيهاً بهذا من قبل، كأن الكاتب أراد الإشارة إلى دورة الوجود الغامضة الملتبسة وحُلمية ما يحيط بالبشر. ومن القصص التي يجدر التنويه بها قصة الأعمى للكاتب «إرنستو لانخير مورينو»، وهو إضافة إلى كونه قاصاً وروائياً فهو شاعر أيضاً، وله عديد من الدواوين الشعرية. في قصته «الأعمى» التي يفيق بطلها ذات صباح ليجد نفسه وقد استردّ بصره، ليكتشف نفسه ويتعرّف على ملامحه ومن ثم العالم، بخروجه إلى الشارع لأول مرة من دون عصاه؛ ليُصدم بالضجيج ولوحات الإعلانات، في إشارة نقد واستهجان، غير أن ذلك لم يفسد سعادته بولادته من جديد، مبصراً. إن الفكرة في ذاتها تنطوي على طاقة شعرية، تجعل القارئ يتذوّق العالم، من خلال العينين المستردّتين لأعمى سابق! وهو يصف ما يرى بمزيج من الحرمان والشغف. وبعد أن أدّى الكاتب هذه المهمة، أي اكتشاف العالم، بمفارقاته، يعيد بطله كفيفاً من جديد، إذ إنّ واقعة استرداده البصر لم تكن سوى حلم، مع الإيحاء بأنه كان أكثر سلاماً في حالته الأولى!
من القصص المميزة الأُخرى التي تشكّل علامة في الأنطولوجيا قصة الكاتب «أنطونيو سكارميتا» صاحب العديد من الروايات المعروفة، وعلى رأسها روايته الشهيرة «ساعي بريد نيرودا»، بالإضافة إلى روايتي «عرس الشاعر» و«أب سينمائي» وسوى ذلك. في هذه الأنطولوجيا اُختيرت له قصة بعنوان «هاتف نقال»، وهي قصة يمكن القول إنها فريدة في موضوعها أو في الأقل في فكرتها الأساس؛ إذ تنبني القصة وأحداثها الأساس على حيازة البطل هاتف شخصٍ آخر، بعد أن نسيه الأخير في محل عام. وبتلقيه بعد ذلك مكالمة من امرأة على علاقة بصاحب الهاتف الأصلي، فيجيبها كما لو أنه هو المقصود، لتترتب على ذلك سائر المواقف والنهاية الفاجعة في القصة. ويحضر الهاتف أيضاً، الذي سيكون له دوره في قصة الكاتب «روبيرتو بولانيو»، القائمة على «المكالمات الهاتفية»، وهذا هو اسمها. والقصة بمجملها ذات طابع بوليسي، وهي تحمل البصمة الأسلوبية الخاصة بكاتبها، الغني عن التعريف. ثمة أيضاً قصة الأب لـ«أليغاريو لاثو باييثا»، وهي قصة عن جحود الأبناء، وأميَل إلى أن تكون تقليدية المضمون، غير أن معالجتها كانت متقدمة. وهي شبيهة بقصة «السيدة» لـ«فيدريكو غانا» التي تتحدّث عن الوفاء عبر سرد ممتع. وتتناول الكاتبة «بيا باروس» في قصتها «طبيعة الأمور» موضوعاً في منتهى الحساسية على الصعيد الأُسري والاجتماعي، وبشيء من الحس البوليسي، مقدِّمةً قصة، تنم عن خبرة ومراس. وللكاتبة روايتان وسبع مجموعات قصصية.
وإذا ما كانت الأنطولوجيا قد افتتحت بكاتب مجهول لدى القارئ العربي، فإن خاتمتها كانت على العكس من ذلك مع الكاتب «لويس سبولبيدا»، وقصته «مصباح علاء الدين». «سبولبيدا» الذي عرفه القارئ العربي من قبل وأحبّه، عبر أعمال عديدة له، أشهرها «العجوز الذي كان يقرأ الروايات الغرامية»، و«قصة النورس والقط الذي علّمه الطيران».
وهكذا فإن هذه الأنطولوجيا متعددة الأجيال كانت فرصة لاستعادة أجواء كتّاب عرفهم القارئ من قبل، إلى جانب كتّاب يتعرّف إليهم للمرة الأولى وهم جديرون بالانضمام إلى ذاكرة أدبية لا تؤْثِر إلّا الجديد والمميز وتحتفي به.