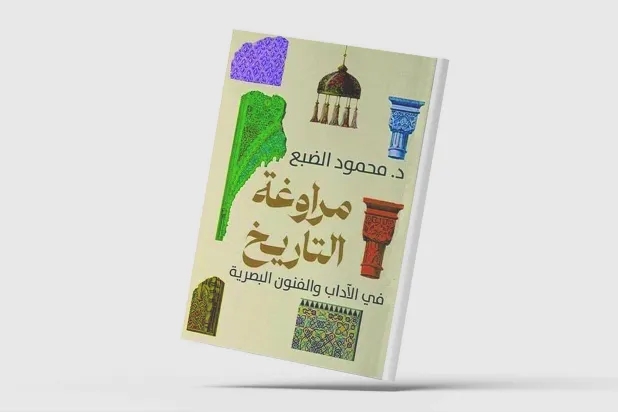تُولي الشاعرة والكاتبة المصرية هدى عمران شغفاً لافتاً بالمغامرة الفنية، والانفتاح على التجريب كلعبة تُعيد بها تشكيل الحكاية، واستكشاف عالمها الشعوري، وأسئلتها حول الذات.
صدر لها أخيراً مجموعتها القصصية «حُب عنيف» عن «الكتب خان للنشر» بالقاهرة، كما صدرت لها رواية «حشيش سمك برتقال» التي حصلت على منحة «آفاق»، ولها عدة دواوين شعرية منها «ساذج وسنتمنتالي»، و«القاهرة»، و«كأنها مغفرة».
هنا حوار معها حول روايتها الجديدة وتنوع الكتابة ما بين الشعر والسرد.
* في مجموعتك «حب عنيف» تمرُّد على الحدود بين القصص؛ حيث تبدو بطلاتها وكأنهن يتعثرن في حيوات بعضهن، فتتقاطع أحلامهن، ويركبن «المركب» نفسه. حدثينا عن لعبة البناء في تلك المجموعة.
- لم يكن دافعي التمرد، بقدر اللعب، واهتمامي المهووس بفكرة بناء «كتاب»، والسعي خلف فكرة الكُلية، حتى في الكتب التي أقرأها. كقارئة انتقائية ومُقلّة، لا أحتفظ بأي كتاب «حلو» في مكتبتي، لا يكفي أن تكون الرواية أو المجموعة القصصية أو الديوان الشِّعري جيداً، لكنني أبحث عن الشمولية، عن عالم متكامل ومعنى عميق ومجاز متعدد وفهم متجاوز للحياة؛ لذلك حين أفكر وأنا في مرحلة التحرير الأولى من أي نصٍ سأنشره في عملية البناء، كيف أنتقل بنصي - سواء كان شِعراً أو سرداً - من كونه مجرد «مجموعة» إلى كونه كتاباً، فمثلاً كلمة «الحب» في حد ذاتها «لا تعني لي شيئاً بعينه، أو قد تحمل دلالات سطحية»، لكنها تكتسب بُعداً آخر داخل كتاب متداخل، فتمتزج بمعانٍ أخرى مثل الأبوة والإيمان والتطهر والعنف والموت والحياة، وهنا يتشكل الحب فلا يصير كأي حب، بل يصبح حُبي الخاص وعنفي المتفرد.

لكن تصعب الأمور أكثر في «مجموعة قصصية» محكومة باستقلالية نصوصها، فلم أرد لـ«حب عنيف» أن تصير متتالية، ولم أرد لها أن تصير مجرد قصص منفصلة لا تشملها فقط وحدة الزمن، لكن أردت لها أن تحتمل شيئاً أكبر شاعرياً وممتعاً، عن سؤال: «ماذا لو نقلنا فلانة في حياة فلان، ماذا لو كانت للمرء حيوات متعددة؟» قد تصبح لعبة المرايا التي هي شاغل أساسي في تاريخ الأدب، ولو أني أعتبرها لعبة أنثوية بالأساس. وهكذا أردت أن ألعب لعبة ذكية مع القارئ، على أمل أن أجعله يبحث أكثر داخل هذا العالم. أن أجعله يعود إليه مرة وربما مرات أخرى، وكل مرة يعود يكتشف شيئاً جديداً كان مخفياً عنه.
* يبدو المتن السردي في المجموعة وكأنه هارب من متن فني موازٍ (لوحة، صورة فوتوغرافية... إلخ) ففي إحدى القصص بدا الأبطال وكأنهم يتعرفون على وجودهم في لوحة غوغان، وبطلة أخرى تستعيد إيميلي برونتي، كيف تُطورين تأثرك بالفنون بصورة متواشجة داخل كتابتك؟
- ككاتبة، أتسلى بمصير شخصياتي، فأنا أيضاً مؤمنة بوجودي كشخصية خيالية داخل تلك الفنون التي أحبها. حين تلمسني وتؤثر فيّ، فتعينني على فهم نفسي، وتجعلني أتواضع أمام جمال الفن وتعدده، ومحدودية قدرتي لخلق كل هذه الفنون، لكن أنا وغيري من الفنانين ما نحن سوى صنيعة هذا الإرث الإنساني من الأدب والحكايات والموسيقى والشِّعر. لي فنانيّ المفضلون، أحب أن أصحبهم معي في رحلاتي. لكن دائماً يُنصَح الكاتب بألا يذكر أسماء كتّاب وفنانين مشاهير حتى لا يبدو «مستعرضاً»، وليظهر كإنسان طبيعي. كأن بذلك تُكتسب المصداقية. لكني في لحظة ما وجدت هؤلاء الأصدقاء يأتون بطرقهم التلقائية الطبيعية داخل القصص، دون تدخل كبير مني.
لا أنفصل عن ذاتي حين أكتب، فالكتابة كلها منبعها أسئلتي الذاتية، وأدواتي المعرفية، وميولي وانحيازاتي الفكرية والإنسانية. لكنها لا تأخذني إلى مدارات شخصية إلا نادراً، فلا أكتب عن مواقف حياتية واقعية، فأفرق جيداً بين الذاتي والشخصي؛ لأنني لست منغلقة على نفسي، وذاتي هي وسيلتي الوحيدة التي أمتلكها لأنفتح على العالم وعلى الآخر، للبحث عن المعرفة، والبحث عن معنى الحياة؛ لذلك طبيعي جداً أن أرى إيميلي برونتي أو غوغان وغيرهم يصاحبون الشخصيات التي أنسجها في قصصي.
* في المجموعة احتفاء بنبرة الحكاية، فالأم تجمعها بابنها آصرة خاصة عبر الحكايات، وهناك تناص مع «ألف ليلة» بغرابة حكاياتها وتحولاتها كما في قصة «صداقات خطيرة» مثلاً. ماذا تحمل تلك اللمحات من علاقتكِ بالحكايات التراثية؟
- الحكايات مُكوّن أساسي في شخصيتي، ليست فقط «الليالي العربية»، بقدر تربيتي في عائلة تجلّ الحكايات والسِّيَر الشعبية وتتغنى بها. وهذا ليس شيئاً استشراقياً كما يبدو لبعض المثقفين، الذين كبروا في أحضان الطبقة الوسطى، لكنه شيء بديهي وفطري في بيئة صعيدية أو في أجواء الدلتا على ما أظن. وكان تحدياً كبيراً بالنسبة لي أن أكسر القواعد والنصائح المتعارف عليها في عالم الأدب؛ لا تكتب حكاية داخل النص، لا تكتب حلماً داخل النص، لا تكتب أسامي المشاهير، لا لا لا... وغيرها.
هذه النصائح لها وجاهتها، وكسرها مغامرة، قد تنقل النص الجيد لمنطقة الرديء. لكن المثل يقول: «من غير المخاطرة مفيش متعة». وهكذا بروحٍ عنيدة، رُحت أكسر كل تلك المحظورات، لكن في الوقت نفسه بأرق المسؤولية ألا أقع في فخ الاستسهال أو الرداءة.
* وُصِفت روايتك «حشيش سمك برتقال» بأنها قصيدة نثر طويلة، ونلتقي في ديوانكِ «كأنها مغفرة» بشكل «القصة القصيدة»، هل تجدين في التحرر من النوع الأدبي وتصنيفاته لمحة من هُويتكِ الأدبية؟
- أظن أن هذا الوصف عن رواية «حشيش سمك برتقال» هو أكثر وصف أسعدني، رغم ما قد يعنيه من متلفظه باعتباره نقداً سلبياً، لكنني أنحو تجاه رأي كبير يقول إن السرد الطموح يتلمس الشّعر. وهذا التلمس لا يكون بنحت اللغة، لكن بفهم أعمق لجوهر الشِّعر باعتباره مجازاً كُلياً، وتكثيفاً شعورياً لسؤال النص، فإن أردت أن أطرح سؤالاً عن الوحدة، كما في الرواية، فليس من الشطارة إغلاق اللغة على نفسها لتصير قطعة أدبية منفصلة، لكن بشحذ هذه اللغة، ناحية الشعور والمعنى والبناء، لتؤدي جميعها إلى مجاز شامل عن الوحدة. قد يختار كاتب غيري كتابة الحكاية بأخذ مسافة محسوبة عن النص. لا عيب في أيٍّ من الأسلوبين. الفيصل عندي هو الأصالة.
هذا يحيلنا لسؤال عن أسلوب الفنان، وأنا شاعرة - بالمعنى الذي أسلفته - في رؤيتي وفهمي للعالم. ولا أتخلى عنه لصالح ذائقة بعينها، تتوجس من الشعراء الذين يكتبون الروايات! وهكذا فإني أرى الشِّعر في كل نص وبكل طريقة. وأسمح لنفسي أن أكتب أي شكلٍ، سواء كانت سطوراً أو كُتَلاً سردية، وبهذه الطريقة أدخل إلى نصوصي. الشِّعر عندي هو الجوهر، وكل نص يؤدي إليه.
* «العنف» ثيمة تلتقطها كتابتكِ بمزيج من الهشاشة والتعقيد؛ حيث «غضب يخبئ الضعف، وعنف يخبئ العنف، وعنف يخبئ الحب»، كيف تستكشف أعمالكِ العنف؟
- العنف سؤال أساسي في أعمالي. وقد أتوسع فيه داخل رسالة الماجستير التي أحضرها حالياً. يمكن بنظرة أنثوية على العنف، باعتباره شيئاً أكبر من حضوره المادي، لكن بمعناه الرمزي، كما يعرفه المفكر الفرنسي بيير بيرديو، حول علاقات الهيمنة والسلطة، وفرض رؤية للعالم. وأحب أن أشرحه بعقل شاعر وفنان، فأجسده في قصصي باعتباره طريقة للتواصل والهزيمة والعاطفية والمتعة. لا من منطقة الرثاء على الذات أو الرثاء على المرأة.
* رغم انتمائك واعتزازك بأصولك الصعيدية، فإن العاصمة القاهرة تبدو مركزية في أعمالِك، هل تجدينها مُعادلاً لمشاعِر الوحدة والتهميش؟
- لا أعتبر القاهرة معادلاً للوحدة والتهميش، بل أراها ملعباً كبيراً، نلهو ونحيا فيه، تحتمل كل معنى وكل شعور، بداية من الوحدة، مروراً بالأُلفة والعنف والفن إلى المعاني الأكبر كجدوى الوجود ذاته؛ لذلك أنا أدخل لعالم القاهرة بقلب دَخيل ومندهش ومغامر دائماً.
* بدأتِ ديوان «كأنها مغفرة» بالحديث عن المحو والنسيان، وصولاً لنقطة «كل ما أريده هو استعادة الزمن، امتلاكه من جديد كأن كذلك تكون المغفرة»... حدثينا عن مجاز الحياة والمغفرة بين المحو والاستعادة هنا.
- تشغلني دائماً فكرة «المغفرة» كمعنى أساسي لوجودي. وكنت سابقاً أفكر في أن النسيان هو وسيلتي؛ لذلك أنحو إلى المحو وتضييع الأشياء والموجودات. لكن رحلتي داخل الديوان جعلتني أستكشف دوراني حول الزمن، في محاولة لاستعادة لحظات الشقاء والحزن واستبدالها بالشِّعر والفن. ولتمام صِدقي، فهمت أن عليَّ المغفرة من منطقة التسليم بضآلة وجودنا في الحياة، وبحقيقة فنائنا، ومحاولة السير مع الزمن لا باستدعاء الماضي. شعور غير مستدرك، قد يُضيِّع الشِّعر نفسه؛ لأن هذه الحقيقة تدعو إلى التخلي. لكن يمكنها أيضاً أن تضعنا في منطقة أكثر تواضعاً وعزاءً.
* تعملين محررة أدبية، كيف تنظرين إلى الجدل حول أهمية دور المحرر الأدبي الذي لا يزال يُثار في عالمنا العربي إلى اليوم؟
- أتمنى أن تُعطى أهمية كبرى لدور المحرر الأدبي في الوطن العربي، فالمُحرر لا يعيد كتابة النص للكاتب، كما يتخيّل البعض، لكنه عينٌ مُخلِصة تنظر للنص مع الكاتب. وفي أحيان كثيرة حين أقرأ نصوصاً أحس بأنها كان ينقصها تلك العين.
* بعين طائر، كيف تتأملين صوتك ومفاوضاتك مع الكتابة، مع بداياتك في «ساذج وسنتمنتالي» وصولاً إلى «حب عنيف»؟
- سؤال صعب جداً، لكني أحب دائماً تأمل كل تجربة بعد الانتهاء منها، رؤية عيوبها قبل محاسنها. ومن الممكن أن أكون قد أدركت أن لي صوتاً مزعجاً، غير مُستأنس، يثير المتاعب؛ لأنه يريد الوصول لحقيقة وجوهر الأشياء، لكن الحقيقة ليست لكل البشر.