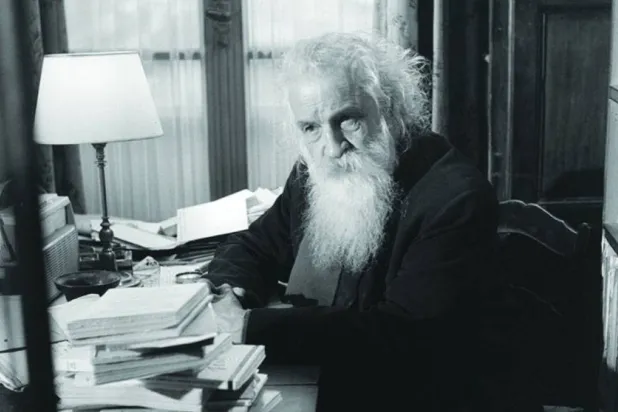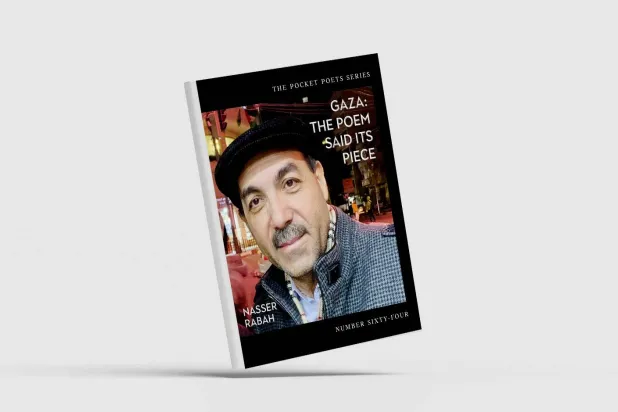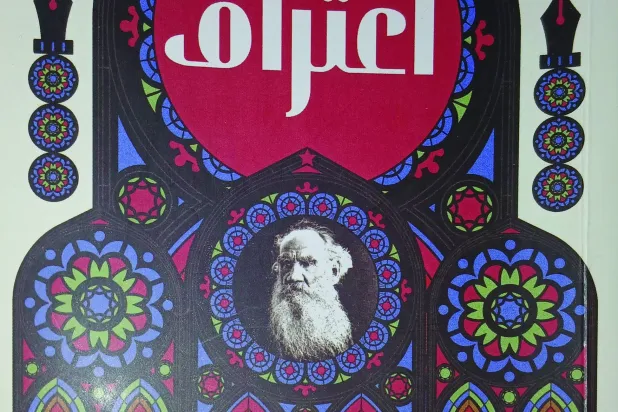إذا كان اتساع لغة الضاد واكتظاظ معجمها بالكلمات المترادفة والمتقاربة، من علامات النعمة والثراء التعبيري، فإن الجانب السلبي من هذا الثراء يتمثل في سوء استخدامه من المشتغلين بالكتابة، حيث إن صعوبة الوقوف على المعاني الدقيقة للألفاظ تُوقِع الكثيرين في فخ المشاكلة واللبس فيما بينها. وأبرز مثال على ذلك هي المشاكلة القائمة بين شعر الحب والشعر الغزلي، اللذين لم يكفّ الدارسون والمعنيون بتاريخ الأدب عن المماثلة بينهما، أو استخدام أحدهما مكان الآخر.

والواقع أن شعرَي الحب والغزل ليسا مسميين للشيء نفسه، وإن تقاطعت سبلهما في غير زاوية. فالأول متصل بالمشاعر الإنسانية والانجذاب الروحي والجسدي إلى الآخر المعشوق، والكلام الذي يصدر عنه لا بد أن يكون منبثقاً عن شغاف القلب ومكابدات النفس وفوران الأحاسيس. في حين أن الثاني يتأرجح بين التعبير عن الإعجاب والعاطفة الصادقة، وبين الاستثمار الحَرفيّ للموهبة بُغية التقرب من المرأة واستدراجها إلى شِباك المتغزل. وهو إذ يبدو في كثير من الحالات تشييئاً للأنثى المطارَدة وتحويلها إلى دريئة رمزية لاستعراض المهارات، تتفاوت تعبيراته ونماذجه بين براعة الابتكار الأسلوبي، وبين الوصف الإنشائي والمعاني المكررة.
وقد تكون العودة إلى الجذر اللغوي للكلمتين بمثابة دليل كاشف عمَّا بينهما من فروق، حيث الحب في «لسان العرب» هو الوداد والمحبة ونقيض البُغض. وحبّة الشيء لُبابه، والقلب سويداؤه. وإذ يضع ابن قيم الجوزية الحب والمحبة في الخانة ذاتها، يصف الأخيرة بأنها «غليان القلب وثورانه عند الاهتياج إلى لقاء المحبوب». أما الغزل فيَرِد عند ابن منظور بمعنى اللهو مع النساء، والمغازلة هي محادثتهنّ ومراودتهنّ، وفي المثل: هو أغزل من امرئ القيس.

وقد يكون الدنوّ والاقتراب أحد أكثر معاني الغزل دلالةً على الدور المنوط به. فإذ تقول العرب: رجل غازل الأربعين، وتعني دنا منها، يبدو الاقتراب من المرأة بدافع الاشتهاء والتملك، من وظائف الغزل الرئيسية وأهدافه. ويذهب بطرس البستاني في معجمه «محيط المحيط»، إلى وجود رابط ما بين الغزْل والمغازلة، حيث الشاعر يغزل كلماته للإيقاع بالمرأة، كما يفعل غازل القطن أو حائك الثوب. ولا بد من الملاحظة أيضاً إلى أن للغزل لغات عدة لا تنحصر في الكتابة الإبداعية وحدها، بل تتسع دائرتها على المستوى الجمعي لتشمل الكلام الشفوي ولغة الإشارة وحركات الجسد، وكل ما يسهم في إيصال رسائل الانجذاب إلى الشخص المعنيّ. وقد يحدث من جهة ثانية، أن يتورط الشاعر المطارِد فيما لم يضعه في حسبانه، وينتقل دون إرادته من خانة الهزل إلى خانة الجد، وفق تعبير ابن حزم، فيغادر نظمه الغزلي خانة اللهو والمجاملة العابرة وإرضاء الذات، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من شعر الحب، بكل ما يكتنفه من عصْفٍ عاطفي وتعبيري.
وإذا كانت البلبلة بين المصطلحين تنعكس بوضوح في تراث العرب الأدبي والنقدي، حيث تِرِد تسمية الغزل لا الحب، في سياق الأغراض المختلفة للشعر العربي، كالمديح والفخر والهجاء والرثاء والوصف، فإن الدراسات النقدية قد توزعت هي الأخرى بين عنوانَي الحب والغزل، فآثر البعض استخدام الأول أو أحد مرادفاته، كما فعل ابن الجوزي في «ذم الهوى»، والسرّاج في «مصارع العشاق»، وابن قيم الجوزية في «روضة المحبين»، وشوقي ضيف في «الحب العذري عند العرب»، ومحمد حسن عبد الله في «الحب في التراث العربي»، وأحمد الجواري في «الحب العذري»، وصادق جلال العظم في «في الحب والحب العذري»، ورجاء بن سلامة في «العشق والكتابة»، في حين أن باحثين آخرين وضعوا مؤلفاتهم تحت عنوان الغزل، كما فعل أحمد الحوفي في «الغزل في العصر الجاهلي»، وشكري فيصل في «تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام»، وج. ك. فاديه في «الغزل عند العرب»، والطاهر لبيب في «سوسيولوجيا الغزل العربي».
ومع أن في كتاب أحمد الحوفي ما ينمّ عن رصانة في التأليف ومشقّة في البحث وإحاطة بالموضوع المتناوَل، إلا أن ما ذهب إليه من مماهاة كاملة بين الغزل والحب لا يطابق سوى جزء من الحقيقة، ويحتاج بالتالي إلى المراجعة والتدقيق. فهو يقول في هذا الصدد: «الغزل وليد عاطفة الحب، وهو يمتاز عن أبواب الشعر الأخرى كالمدح والوصف والهجاء والفخر بالصدق الشعوري لأن هذه الأغراض كثيراً ما كانت تنبعث عن ملق أو ادعاء، فتجيء متكلفة فاترة، أما الغزل فقلما ينبعث عن محاكاة أو تكلف»، في حين أن جميعنا يعلم أن كثيراً من النصوص الغزلية هي وليدة الصناعة والحرفة والمحاباة، بخلاف شعر الحب الذي يولد بشكل تلقائي من تمزقات النفس وجيشان المشاعر. وإذا كان لا بد من تقديم شواهد مناسبة للتدليل على الفروق بين شعري الحب والغزل، فيمكننا أن نستدلّ على الأول بقول عروة بن حزام، الذي يرى في العشق مَرضاً عصياً على الشفاء وعابراً للحياة نفسها:
كأن قطاة عُلِّقتْ بجناحها
على كبدي من شدة الخفقانِ
جعلتُ لعراف اليمامة حكْمهُ
وعراف نجدٍ إن هما شفياني
فما تركا من رقْية يعلمانها
ولا شربة إلا وقد سقياني
فقالا يمين الله والله ما لنا
بما ضُمِّنتْ منك الضلوعُ يدانِ
وإني لأهوى الحشر إذ قيل إنني
وعفراء يوم الحشر ملتقيانِ
أو بقول العباس بن الأحنف معبِّراً عن وحشة النفس وخواء العالم في غياب حبيبته فوز:
لقد كنت أطوي ما ألاقي من الهوى
حذاراً وأخفيهِ وأكتمُهُ جهدي
فنمَّتْ على قلبي سواكبُ عبْرة
تجود بها عيناي سحّاً على خدي
ولو أن خلّقَ الله عندي لخلْتُني
إذا هي غابت موحَشاً خالياً وحدي
أما الغزل فنجد ترجمته النموذجية في قصائد عمر بن أبي ربيعة، الذي لطالما تمنّت اللقاء به جميلات الحجاز، بهدف الحصول منه على قصائد تحتفي بجمالهن وتخلّده مدى الدهر، وبينها أبياته:
مكّية هام الفؤادُ بها
نسي العزاءَ فما له صبرُ
مرتجّة الردفين بهْكنة
رؤدُ الشباب كأنها قصرُ
حوراءُ آنسة مُقَبَّلها
عذبٌ كأن مذاقه خمرُ
والعنبر المسحوق خالَطَهُ
وقرنفلٌ يأتي به النشرُ
كما تقع في الخانة ذاتها أبيات يزيد بن معاوية، التي جرى إدخالها في بعض المناهج الدراسية، شاهداً نموذجياً على البنية الاستعارية للنص، ومنها قوله:
واستمطرتْ لؤلؤاً من نرجسٍ وسقتْ
ورداً وعضت على العنّاب بالبرَدِ
أما النوع الثالث القائم على امتداح الأنوثة بوصفها مشهداً جمالياً، والمجاملة المجردة من الأهواء، فيجد شاهده الأمثل فيما حدث لإيزابيل زوجة شاهين المعلوف، حين سقط فنجان القهوة من يدها باتجاه الأرض، فطلبت من الحاضرين، شاهين وميشال وشفيق وفوزي المعلوف، وجميعهم من الشعراء، أن ينظم كل منهم أبياتاً في وصف الحادثة، واعدة بأن تخص الأشعر بينهم بهدية رمزية، فقال زوجها شاهين:
ثملَ الفنجان لما لامستْ
شفتاهُ شفتاها واستعرْ
وتلظَّت من لظاهُ يدُها
وهْو لو يدري بما يجني اعتذرْ
وضعتْه عند ذا من كفّها
يتلوّى قلِقاً أنّى استقرْ
وارتمى من وجْدهِ مستعطفاً
قدميها وهو يبكي فانكسرْ
وقال ميشيل:
عاش يهواها ولكنْ
في هواها يتكتَّمْ
كلما أدنتْه منها
لاصَقَ الثغرَ وتمتمْ
دأبُهُ التقبيلُ لا
ينفكُّ حتى يتحطَّمْ
قد تكون العودة إلى الجذر اللغوي لكلمتَي الحب والغزل بمثابة دليل كاشف عمّا بينهما من فروق
وقال شفيق:
إنْ هَوَى الفنجان لا تعجبْ
وقد طفر الحزنُ على مبسمها
كلُّ جزءٍ طار من فنجانها
كان ذكرى قُبلة من فمها
وإذ انتبه فوزي إلى أن الفنجان لا يزال سالماً ولم ينكسر، استدرك قائلاً:
ما هوى الفنجانُ مختاراً
ولو خيَّروهُ لم يفارق شفتيها
هي ألقتْهُ وذا حظُّ الذي
يعتدي يوماً بتقبيلٍ عليها
لا ولا حطَّمه اليأسُ فها
هو يبكي شاكياً منها إليها
والذي أبقاه حياً سالماً
أملُ العودة يوماً ليديها!