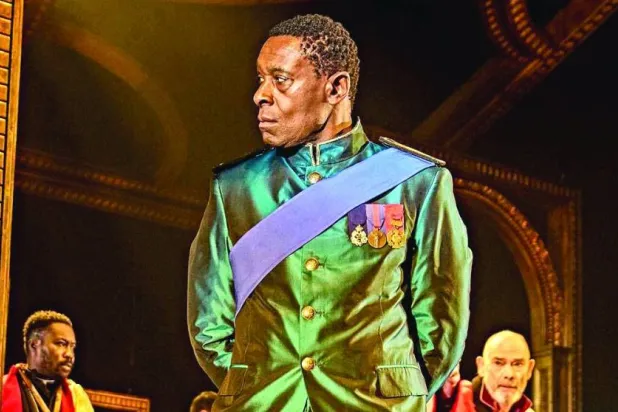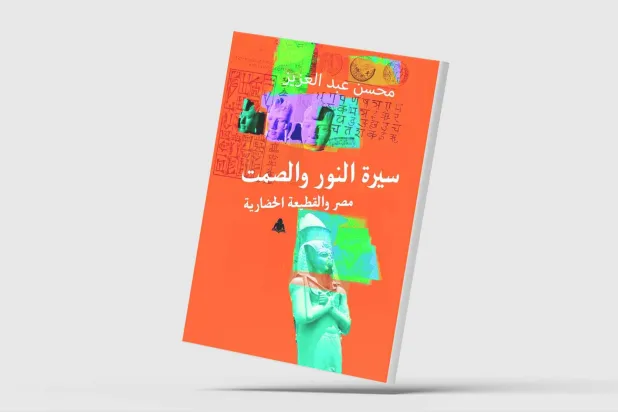إذا كان للعرب الجاهليين من الأسباب والدوافع وظروف الحياة، ما يجعلهم يرون في المرأة الملاذ الذي يوفر لهم سبل الطمأنينة والبهجة، والماء الذي يعصمهم من الظمأ، فإن نظرتهم إلى الحب وتعبيراته العاطفية والحسية لم تنشأ في فراغ التصورات، بل أملتها عوامل مختلفة بينها علاقتهم الملتبسة بالغيب، وشحّ المصادر المولدة للمتعة في عالمهم المحكوم بالقسوة والشظف والتنازع على البقاء، وصولاً إلى تقاليد القبيلة وأعرافها ونظام قيمها الجمعي. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن المعتقدات والأديان السماوية لم تكن غائبة تماماً عن أذهان الجاهليين، كما هو حال اليهودية والنصرانية والحنفية التي لفحت حياتهم ببعض النسائم الروحية والإيمانية، فإن من غير الجائز أن ننظر إلى تلك الحقبة بوصفها موازية للتحلل الأخلاقي الغرائزي، دون أن نغض النظر بالمقابل عن نزوع الجاهليين إلى «جسدنة» العالم وتسييله في المرئيات، لمعرفته بشكل أفضل.
كما أن الحديث عن الحب في إطار من الثنائية المانوية بين الجسد والروح، هو مجافاة للحقيقة الموزعة بين خانات كثيرة، وللطبيعة البشرية التي يتصارع داخلها الكثير من الميول والنوازع. ففي أعماق كل حب شهواني ثمة رسائل قادمة من جهة الروح، وفي كل حب متعفف ثمة توق جارف لمعانقة الآخر المعشوق واحتضانه وملامسة وجوده المادي. ومع أن أحداً لا ينكر التباين القائم بين طبيعتي الحب الحسية والروحية، إلا أنه تباين في الدرجات والنِّسب وليس في المطلق. صحيح أن هاجس اللذة، وفق ابن الدباغ، يلاحق النفوس على اختلافها، ولكن لكل واحدة من هذه النفوس مفهومها الخاص للذة، فضلاً عن أن النفس تتدرج في مستويات شغفها بالآخر، فهي إذ تمعن بداية في الشهوات البدنية ثم «تتوجه إلى حب اللذات الروحانية ويصير حبها للصفات المعنوية أكثر كمالاً».

وإذا كان الجاهليون على نحو عام قد أولوا المرأة عنايةً خاصةً في شعرهم وحياتهم، فهم أظهروا، شأن البشر منذ أقدم العصور، انقساماً واضحاً بين من رفعوا راية التعفف والانقطاع لامرأة واحدة، كما فعل عبد الله بن عجلان وعنترة والمرقّشان الأكبر والأصغر، ومن رفعوا راية الحواس وجنحوا إلى تعدد العلاقات، وأسرفوا في نشدان المتع المبهجة التي يوفرها الجسد الأنثوي، كما كان حال امرئ القيس والأعشى والمنخل اليشكري، دون أن نغفل الرؤية الوجودية العميقة لطرفة بن العبد، الذي لم يجد وسيلة لإبعاد مخاوفه المؤرقة، أفضل من امرأة سمينة يختلي بها في الظلام الممطر.
ولسنا نجافي الحقيقة بشيء إذا اعتبرنا امرأ القيس أحد أكثر الشعراء الجاهليين احتفاء بالمرأة والحياة. وهي ميزة لا تعود أسبابها إلى تكوينه الشخصي وحده، بل أملاها وضعه الاجتماعي المترف، كابن ملك مقتدر، بما يسّر له سبل الانصراف إلى نشدان اللذة وإغواء النساء، بكافة أشكالهن ومواقعهن وأنماط عيشهن. كما أن الفترة القاسية التي أعقبت مقتل أبيه المأساوي، ومحاولاته المضنية للثأرمن القتلة واستعادة ملْكه، لم تقلل من تعلقه بالمرأة، التي رأى فيها الظهير المترع بالرقة الذي يخفف عنه شعوره بالوحشة والخذلان.
ومع أن افتتاحية معلقة الملك الضليل لا تعكس من مشاعره سوى وقوفه الحزين على أطلال فراديسه المنقضية، فإن رغباته الشهوانية الجامحة سرعان ما تكشف عن نفسها في متون المعلقة نفسها، حيث لا يكتفي الشاعر بالكشف عن طرق استدراجه لامرأته المعشوقة، بل عن ميله الملح إلى العلاقات القصيرة والمتعددة. وهو إذ يُظهر خبرة عميقة بطباع النساء، لا يتردد في سرد مغامراته على مسامع حبيباته العديدات، مذكياً نيران الغيرة في دواخلهن، كما فعل مع عنيزة التي لم تكد تبدي القليل من التذمر، بعد أن عقر بعيره ليشاطرها الهودج الضيق، حتى أخذ يتباهى أمامها بمغامراته المتهورة مع النساء الأخريات:
وبيضةِ خدْرٍ لا يُرام خباؤها
تمتعتُ من لهوٍ بها غير مُعجَلِ
فجئتُ وقد نضَّتْ لنومٍ ثيابها
لدى الستر إلا لبْسة المتفضّلِ
فقالت يمينُ الله ما لكَ حيلةٌ
وما أن أرى عنك العمايةَ تنجلي
اللافت أن مملكة امرئ القيس النسائية، لم تكن تقتصر على اثنتين أو ثلاث من النساء، بل تخطت طموحاته هذا العدد بكثير، كما يظهر في سيرته وشعره. وقد عمل بعض النقاد على تعقب النساء اللواتي وردت أسماؤهن في ديوانه، فأحصوا من بينهن أسماء هند وسليمى وماوية وهرّ وفرْتنا وفاطمة وهريرة وليلى وسمية وجُبيْرة وسلمى وأم الحارث وأم الرباب.
الملاحظ أن العديد من الشعراء الجاهليين لم يولوا أهمية تُذكر للأعراف الاجتماعية والأخلاقية، الأمر الذي يفسر تفضيل بعضهم للمرأة المتزوجة على ما عداها من النساء. كأنهم كانوا يجدون في العلاقة المحرمة متعة إضافية لا توازيها المتع السهلة والمشروعة. وهذا النزوع إلى هتك القيم والأعراف السائدة، لم يقتصر على امرئ القيس وحده، بل يكشف عنه الأعشى في العديد من قصائده، ويتحدث في إحداها عن تتبعه المضني لزوج معشوقته الغيور، حتى إذا آنس منه غفلة مؤاتية، أسرع في الحصول على مبتغاه، دون أن يجد حرجاً في تشبيه تلك المعشوقة بالشاة التي غفلت عنها عين الراعي:
فظللتُ أرعاها وظلّ يحوطها
حتى دنوتُ إذ الظلامُ دنا لها
فرميتُ غفلة عينهِ عن شاته
فأصبتُ حبةَ قلبها وطحالّها
حفظَ النهارَ وبات عنها غافلاً
فخلَتْ لصاحب لذةٍ وخلا لها
أما النابغة الذبياني فلم تمنعه سطوة النعمان بن المنذر، من أن ينظم في زوجته الفاتنة قصيدة إباحية يعرض فيها لتفاصيل جسدها العاري، بعد أن سقط ثوبها عنها دون قصد، كما يشير الشاعر، أو بقصد ماكر كما يظهر من شغفها المفرط بالرجال. وإذ أثار تشبيب النابغة بالمرأة شبه العارية، حفيظة النعمان وغضبه الشديد، عمد الشاعر المرتعد خوفاً إلى الفرار بعيداً عن هلاكه المحتوم، قبل أن يستعيد رضا الملك في وقت لاحق. ولا بد لمن يتتبع أبيات القصيدة من الشعور بأنه إزاء رسام بارع يجمع بين التقصي النفسي لأحوال المرأة الماكرة، وبين الوصف التفصيلي لمفاتنها الجسدية.
وإذ افتتن المنخّل اليشكري بدوره بجمال زوجة النعمان، فإن الشاعر المعروف بوسامته، لم يذهب بعيداً في الكشف عن مواصفاتها الجسدية والجمالية، لا بسبب تعففه واحتشامه، بل لأن علاقته الفعلية بالمتجردة جعلته ينصرف عن التغزل النظري بمفاتن خليلته، ليروي وقائع المغامرة الأكثر خطورةً التي قادته إلى حتفه المأساوي.
ولا أستطيع أن أختم هذه المقاربة دون الإشارة إلى نقطتين اثنتين، تتعلق أولاهما بما ذهب إليه الناقد المصري أحمد الحوفي، من أن الغزل الفاحش هو نبتٌ أجنبيٌّ تمّ نقله من الحبشة إلى اليمن وصولاً إلى مناطق الشمال، مدعياً أن الغزل المكشوف لا يمت بصلة إلى أخلاقيات العرب وقينهم وسلوكياتهم المحافظة. وهو تحليل مستهجن ومردود، ليس فقط لأنه يتعارض مع المكونات المشتركة للنفس الإنسانية التي تتشابك في داخلها ثنائيات الجسد والروح، العفة والتشهي، الرذيلة والفضيلة، بل لأنه يعكس بشكل جلي موقفاً إثنياً متعسفاً من الآخر، بوصفه مصدراً للفحش والنزوع الإباحي، مقابل تبرئة الذات الجمعية، أو تقليل حصتها من الدنس.
أما النقطة الثانية فتتمثل في إعادة التأكيد على أن اللبنات الأولى لشعرية المتعة الحسية والعشق الجسدي عند العرب، قد تم تأسيسها في الحقبة الجاهلية بالذات، بحيث تتعذر قراءة عمر بن أبي ربيعة وسحيْم والأحوص والعرجي، إلا في ضوء ما أسس له امرؤ القيس والنابغة والأعشى والمنخل اليشكري وآخرون غيرهم. وهو أمر ينسحب على الحب العفيف أو العذري بالقدر ذاته.