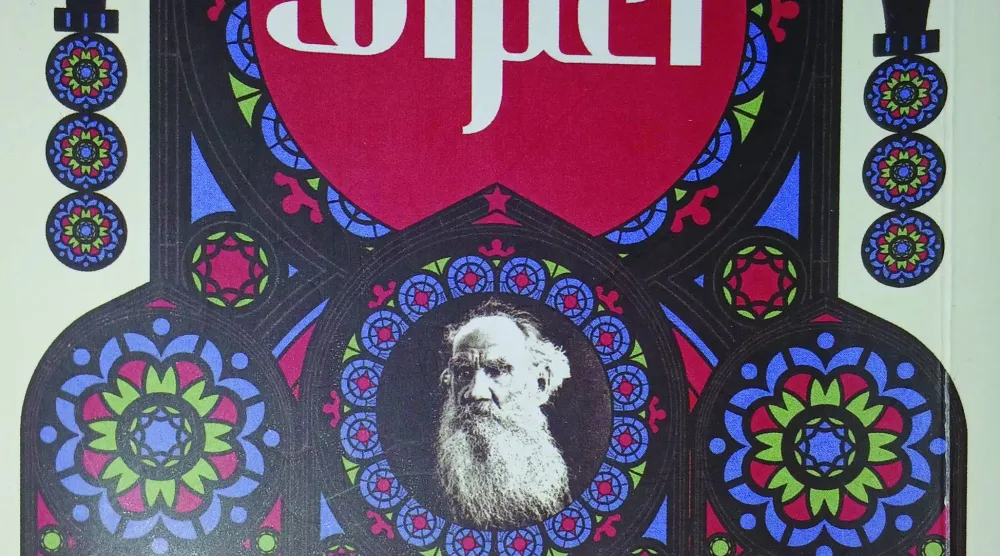تنبّه الطّبيب إلى السّيف المتدلّي من قربوس سرج حصان اليسقجي (الحارس) الذي كان في استقباله. كان الطّبيب يمتطي حماراً أبيضَ، لكنّه خفيف جداً بحيث تطلّب اللّحاق به جهداً من حصان اليسقجي، وكان الطريق هادئاً رغم طوله، وهنالك بعض أشجار الصّفصاف تحني ذؤاباتها حتى تلامس العشب. خفّف الطّبيب من سرعة حماره، ثم سارا متلاصقين يكاد كتف أحدهما يلاصق كتف الآخر. لم يتكلّما بشيء، ولم يكن بإمكان الطّبيب تحاشي النّظر إلى الحربة المثبتة في حزام الحارس. هل ضاقت الأزقّة؟ سارا في درب محصور بين صفّين متقابلين من الأبنية، وظهر لهما كلب ملتفّ على نفسه حين بلغا القنطرة، ولم يعبراها. كانت الطّريق تتحدر انحداراً خفيفاً، وهبطا إلى جرف ينعطف عنده النّهر، وخفّت أقدام الدّابّتين وهي تجري سريعة في نفق ينتهي عند بوّابة قصر الأغا، وكانت الشّمس تسرع لتختفي بين الغيوم.
وقعت عينا الطّبيب على الحرس ذوي الوجوه الملتحية، واضطربت نفسه من جديد. قادوه على رصيف من المرمر الأحمر والأزرق والأبيض والأسود، وكان يتمّ الدّخول إلى القصر عبر ردهة من خزف الميوليق. لأوّل مرّة يرى مزهريّات من الذّهب والفضّة، وقناديل غريبة الأشكال. لأوّل مرة تقع عينه على سقف مزخرف بالأكاليل وغيرها من المنمنمات والزّخرفات والمحفورات. المريض هو الأغا، وكان فاقدَ الوعي، جبهته متغضّنة ويمتلك وجهاً مهيباً مزيّناً بلحية فضّية. كان يرقد على سرير له ذي أعمدة صغيرة، مؤثث بستائر حريريّة حمراء. يُشاع عن الأغا أنه أوقع 15 ألف رأس من الرعايا من رقابها، في حملاته لإرهاب القبائل المتمرّدة الممتنعة عن أداء الضرائب، وكان السلطان يدعوه الخادم الجدير الشديد المستبد؛ لأنه يُهلك سكان بعض القبائل بأكملهم. وكانت الرؤوس المقطوعة تملّح في الحين وتُرسل، لتزيّن أسوار المملكة بأمر السلطان. عندما جسّ الطبيب نبضه، كان طبيعيّاً وقويّاً، بالنسبة إلى رجل فاقد الوعي. كان يرسل شخيراً أجشَّ، ويداه الخشنتان تستلقيان هامدتين فوق الغطاء، عليهما آثار العنان والسلاح. لم يستطع الطبيب منع نفسه من الابتسام ابتسامة داخلية، مفكراً كيف يصل عادة متأخراً لإبعاد شبح الموت.
الأغا، ذو الرأس الضخم والعنق الغليظ والجذع الربيل، كان في حالة اللاّ حياة واللاّ موت، والتي لا تطول كثيراً، وإذا طالت صارت عذاباً للطبيب المعالج، ونظراً إلى ضخامة جسد الأغا فإنّه يتوقع أن يستغرق وقتاً طويلاً في موته، بل هو ربما بقي حيّاً قرناً من الزّمان تلو قرن، إلى درجة أنه لا يموت. «إنه يحتضر!». قال الطبيب، وأتت من ذراعيه حركة دلّت على عجزه عن تقديم المساعدة. امتلأت القاعة في هذه الأثناء من بطانة الأغا وأبنائه حتى ضاقت الأنفاس. كانوا يخلعون صنادلهم عند الباب جرياً على العادة، ويلثمون طرف غطاء الأغا، وراحوا يحيطون بالطبيب، وسيوفهم وحرابهم في أوساطهم. أفهموه، دون كلام، أن عليه أن يعطيه دواءً. قال أحدهم، وكان مستلقياً بلا مبالاة على وسادة عريضة مغطاة بزريبة فارسيّة: «نحن لا نطلب منك أن تعالجه. نحن نأمرك أن تقوم بذلك». كان يبدو أكبر سنّاً من الجميع، يرتدي ثوباً طويلاً أسود اللون، ويمسك بيده سبحة من عاج وعيناه محجوبتان بنظّارتين سوداوين. على الحيطان سيوف معقوفة ذات مقابض من عاج وبنادق ذات سبطانة مرصّعة بالذهب، وحواضنها عليها نقوش بعرق اللؤلؤ والمرجان.
شعر الطبيب بحرقة مفاجئة تجفّف حلقه، وضمّ قبضتيه محاولاً تجرّع هذه الإهانة. الأثاث هنا مثقل بالزخرفة، ومرايا الحيطان منحوتة بأشكال وحوش غريبة. تنانين وسلاحف وأفاعٍ، مع فسيفساء ممزوجة بنقوش عربيّة. بحث الطبيب في حقيبته، واستخرج علبة معينيّة الشكل، على غطائها منظر صيد. تناول منها، بأطراف أصابعه، رقاقة خضراء، ولكنها بدت سوداء في الوقت نفسه. همس أحد الحاضرين في أذن الرجل ذي النظّارتين، الذي وجّه سؤاله بصوت اعتياديّ، ولكن بنبرة غاضبة: «ما هذا؟». وأجابه الطبيب: «لصقة بصل اللّحلاح». كان منظر الرقاقة صلباً، ولكن الحاضرين ظنوا أنها على وشك أن تذوب بين أصابعه. فرشها على جبهة الأغا، ثم وضع اثنتين منها على الوجنتين، وعلى الفكّين، وملأت الجوّ رائحة طيبة وغريبة تشبه رائحة خبزة زعتر، وكان الصمت قد التهم الوجود كلّه، وانكمش العالم على إيقاع يدي الطبيب. الهواء قليل هنا لأن النوافذ محكمة الإغلاق، والرّجل ذو النظارتين السوداوين ينظر إلى الأعلى، ويهزّ رأسه أحياناً. أربعة أصابع من يده اليمنى مشبوكة مع أربعة من يده اليسرى، وراح يدير إبهاميه فيتلاحقان أو يختلفان. ضوء النهار المتدفق من النافذة القريبة اختزنه الخاتم الذي في بنصره في بقعة ضئيلة من لونه البنّي الناصع. قال، وفي نبرة صوته احتقار واضح: «هناك عقار يستقطره الأطباء في الهند من النجم في السماء، ومن اللؤلؤ في المحيط. هل تعرفه؟». عدا صوت شخير الأغا، كان الهدوء في الغرفة شاملاً، وبسبب توتّر الجميع، لا يحسّ به أحد. انتبه الطبيب لأول مرة إلى أبواب الصالة العالية والواسعة والسجاجيد الفاخرة المفروشة، والستائر والوسادات والديوانيّات الموشاة بخيطان من ذهب، وإلى التدويرات والمنحنيات والأزهار الصفراء والبنفسجية المشغولة بنعومة على لحاف الأغا. تمتم مرتعشاً، متيبس الشفتين: «سيدي، أنا لا أملك علاجاً غير ما في حقيبتي. لكن الأغا في حالة خطرة...». وتوقف عن الكلام لأن الحياة انبعثت في الجسد الهامد. ابتسمت عينا الأغا أولاً، وانفتح الفم الضخم على اتساعه، وارتعشت الكتفان برجفات قصيرة ثم سكنت، وتوقف إبهاما الرجل ذي النظارتين عن الدوران.
فتح الأغا عينين سوداوين كبيرتين حولهما إطار أسود من الكحل. صار الآن أكثر طولاً وضخامة. ظلّ الجميع، بمن فيهم الطبيب، يحتفظون بنظرته الرمادية للحظة طويلة، وكانت تمنح انطباعاً غريباً. كلّ شيء يبدو كأنّه في انتظار أمر ما. لكم هو ساكن هذا البيت! كان الأغا يقظاً، ولم يشعر أبداً في السابق بمثل هذه اليقظة. كان يرتدي كسوة حريريّة حمراء، وذراعاه الهامدتان تتحسّسان شرشف السّرير الأبيض. وعلى الفور فاحت في المكان موجة من العطر الرخيص ممزوجة بالرائحة الخاصة لحرير قديم. ودّ الأغا لو يمضغ خبزةً. لم يكن هنالك خبز قريب. رفع أحد الحاضرين ظُلّة النافذة. هو ذاك العالم، تفّاحات خضر صغيرة معلقة بالأغصان، صيحات مكتومة لأطفال يلعبون، هديل حمامات تقف أعلى السلم، الذي يهبط إلى حوش منفصل يسمح بدخول أشعة الشّمس عبر نوافذ واطئة، غير النوافذ الواسعة التي تحتل الأركان، وصار النهار مرتجفاً، ففي الوقت نفسه الذي تشرق فيه الشمس كان المطر يتساقط على النوافذ المغبشة في خيوط ثخينة مثل الدموع. يحدس الأغا ما في الحوش من الصمت الذي يتلألأ فيه المطر. «انظروا، ملاك آخر في السماء». قال الأغا، وكان يصغي إلى صمت مكين شامخ حلّ في الجوّ، وكان محمّلاً برائحة الخبز. ثم سمع تناوح ريحٍ، وكان يشعر أن روحه تتحلّل، ببساطة شديدة، وتغادر عبر النافذة. أراد أن يدافع عن نفسه، لكنه لم يستطع الحراك، وأطلق صرخة لم يسمعها أحد غيره، واعترت بدنه الضخم رجفة، وأخرج صوت آهٍ عريضة لفظ أنفاسه عند نهايتها.
كم تغيّرت هيئة الأغا وهو ميّت! صار شبحاً صامتاً ومهيباً. صار تمثالاً للصمت. «لا أستطيع أن أعبّر عن أسفي لأن جلالته قضى نحبه! لم يكن في وسعي فعل أكثر مما فعلته». كان كلام الطبيب جاهزاً، كأنما قاله مرات عديدة في مواقف شبيهة. لاحظ أن عيون الحاضرين تتحاشى الالتقاء بعينيه. وكان يجمع أغراضه في الحقيبة، عندما أخذ الرجل ذو النظّارتين ينقر الطاولة بأصابعه السمينة والمشغولة بالخواتم نقرات خفيفة جافّة، كأنها تريد القول بأن أمامها عملاً صعباً عليها أن تنجزه. في حركة مباغتة نزع نظّارتيه، فرأى الطبيب عينيه، وكانتا ميّتتين. صرخ: «لماذا قتلتَ الأغا؟ من الذي دفعك للقيام بذلك؟» لم ينتظر الجواب. رفع إبهاميه إلى أعلى، وانهال الحاضرون على الطبيب طعناً، ومزّقوه بالحِراب.