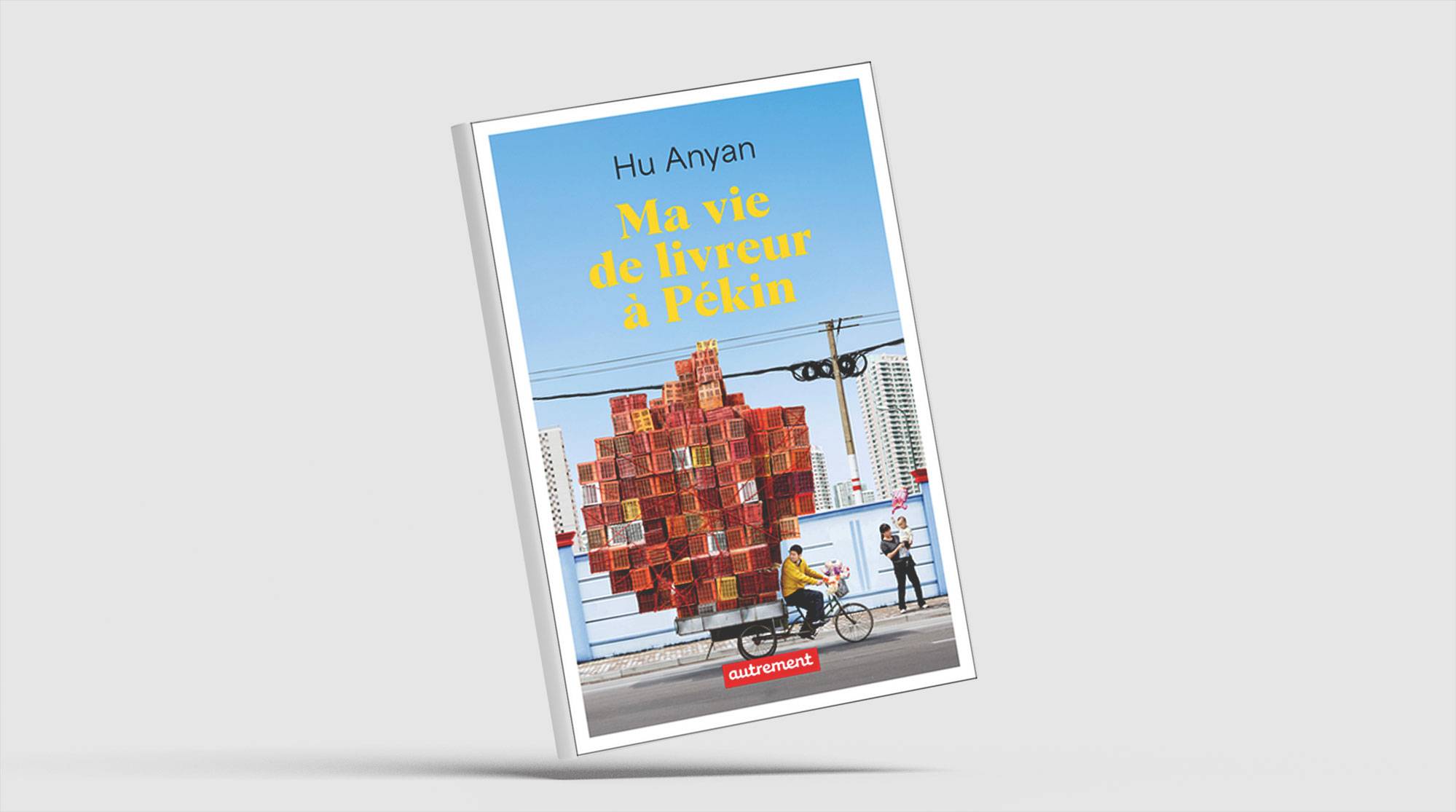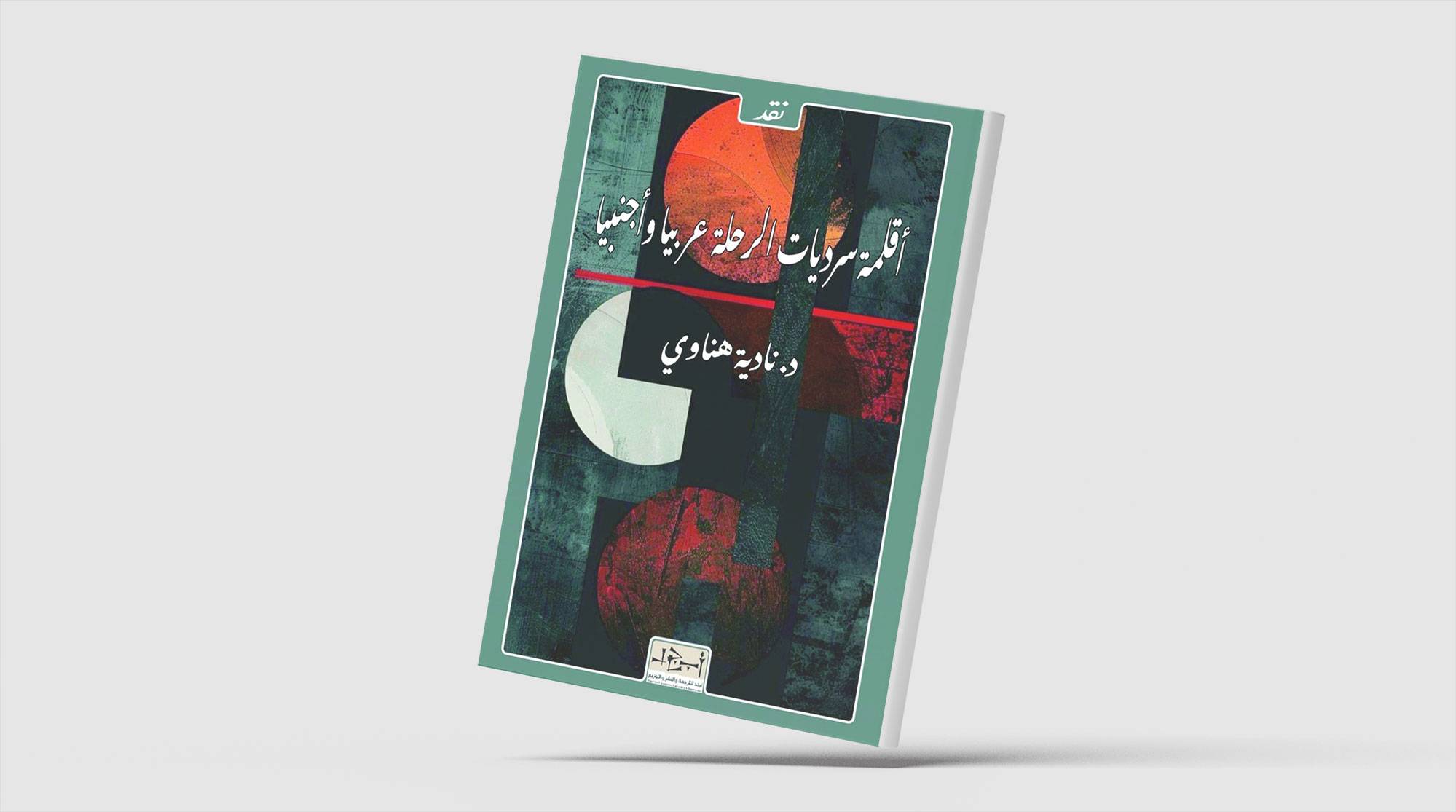لا حدود عند رجاء عالم في روايتها «باهَبَل: مكة 1945 - 2009» - دار التنوير 2023 - بين المحسوس والمتخيل، الراهن والماضي، الدنيوي والأخروي، الحي والميت، عندها كل العوالم متداخلة، لا حدود تقوم بينها، الكل مفتوح على الكل، متداخل فيه، وعلينا، نحن القراء، أيضاً أن ننفتح على هذا كله، وأن نعتاد ونحن نقرؤها الانتقال السريع بين هذه العوالم المتناقضة، والتي تؤلف هي بينها في واعيات شخصياتها، مقنعةً إيانا بأنه لا شيء ينفصل عن شيء.
لاعالم منفصلاً عن عالم، لا زمن مستقلاً عن زمن، إنما يوجد الكل في بوتقة واحدة، منصهرين معاً في كل لحظة من لحظات الوعي.
في عالمها أيضاً تمتزج الرحمة بالقسوة، الحب بالكراهية، الغفران بالانتقام، التحقق بالحرمان، الثورة بالإذعان. في عالمها تجتمع المتناقضات لتصنع أفراح البشر وأتراحهم، مع التركيز على الأتراح، خصوصاً إذا كنتِ امرأة من أهل مكة في النصف الثاني من القرن العشرين؛ فترة التحولات الكبرى في الكيان الاجتماعي للحجاز. نستطيع أن نعمّم وأن نبسّط الصورة على نطاق أوسع، لكن هذا شأننا وحدنا، فالكاتبة ترسم صورة شديدة الخصوصية لمكة، بل لأسرة واحدة في مكة بتشعباتها وأجيالها، برجالها ونسائها وأطفالها، بثباتها وتحولاتها، بأحيائها وأمواتها، هي عائلة السردار، عائلة عريقة ذات سطوة وثروة وهيبة تنتقل من أجيالها القديمة، حين كان أحد أسلافها حاكماً لمكة، إلى الأب الحالي مصطفى السردار، في زمن الرواية. في العائلة يقوم الأب مقام الرب بلا أدنى مبالغة. وللتقريب من عالم الفن الروائي، لنقلْ إنه ينتمي إلى السلالة التي ينحدر منها السيد أحمد عبد الجواد في ثلاثية نجيب محفوظ المشهورة. مصطفى السردار كلمته تُعلي وتخفض، ترزق وتمنع، تُزوّج وتُطلّق، وفي معنى من المعاني تحيي وتميت. يعم سلطان كلمته الجميع؛ الزوجات والإماء، الأبناء والأحفاد، الكبار والصغار، الذكور والإناث، في الدار وفي خارج الدار. في مُلكه يعيش الجميع، يُسبّحون بحمده ويمتثلون لأمره، يطمعون في ميراثه من مال وسطوة إن كانوا ذكوراً، ويعشن ليلعقن جراح ما أنزلته بهن سطوته لبقية العمر إن كُنّ إناثاً.

رواية «باهبل» هي مرثية لأجيال من الحجازيات، هي رواية تَذكُّر، رواية تسترجع فيها الكاتبة، مكيّة المولد، مخزوناً هائلاً من الموروث المحكيّ والمُعايَن من الأجيال السابقة عليها مباشرة، وتلك التي عاصرتها في زمن تحولات كُبرى في المجتمع السعودي عموماً، وفي الحجاز ومكة على وجه الخصوص. ترصد الرواية الحياة الاجتماعية لمكة منذ أربعينات القرن العشرين، حين كانت المنطقة ما زالت على شفا الانتقال من العصر شبه الوسيط إلى العصر الحديث، تكتب عن عصر لا يتجاوز سبعين سنة مضت من يومنا هذا، لكنه كان عصراً ما زال فيه رجال يقتنون الإماء، كما يصنع مصطفى السردار الذي يعترف بأبوة «سكرية»؛ واحدة من أهم شخصيات الرواية، والتي أنجبها من إحدى إمائه، وهو الاعتراف الذي يساويها بأخواتها الحرائر. كان عصراً ما زالت فيه الحمير هي الوسيلة الرئيسية للانتقال، لا السيارات الفارهة، كان عصراً لا تعرف فيه المرأة الطريق ولا التعليم، عصراً لا يطلب فيه الرجال الزواج من فتاة بعينها، وإنما يطلبون مصاهرة مصطفى السردار في أي من بناته، وهو يختار مَن يزوِّج ممن. عصراً تستمر فيه سطوة الأب ذي الجاه على بناته، حتى بعد زواجهن، فهو يستطيع أن يأمر أزواجهن بتطليق بناته متى شاء ولأي سبب يعنّ له. تعيش نساء الأسرة حياة تخلو من الحياة، إن جاز التعبير، حياة مظلمة بين جدران البيت، حياة غاية ما فيها من نور ساعة تُقضى فوق سطح الدار. حياة خالية من التحقق العاطفي أو الجنسي، أو أي لون من ألوان التواصل التعويضي مع العالم الخارجي، وهو ما تُلخّصه سكرية التي تعيش وتذبل وتموت في دار أبيها وبحكمه المتعسف – تلخصه قائلة: «تظن الحنوط سر فرعوني؟ بيوتنا المكّاوية شغلتها تحنيط البنات أمثالي» (ص 225). لذلك أيضاً فإنها حين يموت الرجل الذي زوّجها أبوها الديكتاتور منه، وهو على علم بسُمعته المِثلية الشائعة على الألسنة ولم يدُم الزواج سوى أسابيع معدودة يطلّقها بعدها دون أن يلمسها - حين يموت ذلك الرجل بعد سنين طويلة نسمع سكرية تقول: «لا أسامحه، لا دنيا ولا آخرة، لا هو ولا أبويا ولا إخواني». عبارة تُدين فيها عالم الذكور بكل تشعباته؛ الزوج والأب والإخوة، ففي ذلك الزمن، وكما نرى في الرواية، كانت كل أنثى ضحية، وكل ذكر قامعاً مُضطهِداً متسلطاً بصفة من الصفات، كانت النساء ممتثلات للذكور في كل المواقع الأُسرية، لا يملكن من أمرهن شيئاً، لكن الكاتبة تمثلهن متفوقات عقلياً دون تعليم، أكثر حكمة وصبراً، أكثر مطواعية ومرونة، لديهن الخيال والعطف والتعاطف على الرغم مما يثور بينهن من مشاحنات، وليس لدى الرجال سوى السلطة والقهر والأنانية. تخلق الكاتبة جمهرة من الشخصيات النسائية، جميعهن من محيط أسرة واحدة، وتصورهن تصويراً حياً حميماً وكأنها قد عرفتهن في الحياة معرفة شخصية، ومما يزيد في حيوية تصويرهن أنها تنطقهن باللغة المكية لا الفصحى.
على أنه إن كانت الكاتبة ترسم صورة قاتمة لعالم الرجال بصفة عامة، فإنها لا تتركنا بغير تقديم نموذج صالح لرجل المستقبل، إن جاز التعبير، أو الرجل الذي يُقدّر المرأة ويحبها محبة الند للند، نجد هذا النموذج في شخصية عباس/ نوري، حفيد مصطفى السردار، وابن واحدة من بناته المقهورات. يحتلّ عباس/ نوري مساحة كبيرة في الرواية، مما يتعذر مناقشته دون الإطالة، وهو له اسمان؛ لأنه يعاني نوعاً من فصام الشخصية، فيرمز كل اسم لواحد من جانبيه. الخلاصة أن عباس/ نوري يجمع في تكوينه النفسي بين مواصفات الشخصية الذكورية ومواصفات الشخصية الأنثوية، بين الحس الرهيف والميل للفن والجمال والقدرة على الخيال، وبين الروح العملية القادرة على التعامل مع السوق والنجاح في المشروعات التجارية وتكوين الثروة. يظل عباس/ نوري من صباه إلى رجولته قريباً من عماته وتراثهن النسائي، مشاركاً إياهن في الوجود بالمنطقة الرمادية بين عالم الأحياء وعالم الأموات، لكنه، من ناحية أخرى، لا ينال من أبيه وأعمامه وأبناء أعمامه سوى السخرية واتهامات الخنوثة، لا يشفع له تفوقه الدراسي ونجاحه العملي، لكنه الرجل الوحيد في الرواية الذي يحظى بعطف الكاتبة، والذي يبدو من تصويرها إياه أن الرجل بوصفه جنساً لا يقاس ارتقاؤه إلا بمقدار ما يتسلل في تركيبته من عناصر الأنوثة.
ليست رواية رجاء عالم رواية بوليسية، وإنما هي رواية غنائية رمزية من الطراز الأول، فلم نكن بحاجة لدخولها في الرواية تشرح فلسفتها وثنائياتها وشخصياتها من خلف قناع واهٍ.
الرواية مسكونة بهاجس الموت، لعل السبب هو أن نساءها يعشن حياة غير بعيدة الصلة من الموت، يعشن أسيرات البيوت وأروقتها المظلمة، كما أن الموتى هم أسرى القبور وظلامها، أو لعلها الحياة المكية في دار على مرأى من الحَرَم، حيث لا يتوقف ورود الجنازات وعلى مقربة من دكان «الحانوتي» الذي يُعِدّ الموتى للدفن. أياً ما كان الأمر فإن الكاتبة تنجح نجاحاً مدهشاً في خلق لغة وصور وأخيلة تجعل للموت والموتى حضوراً في الرواية لا يقلّ عن حضور الحياة والأحياء. يتداخل العالمان بشخوصهما تداخلاً تاماً، حتى نكاد أحيانا لا نعرف مَن الحي ومَن الشبح، وهذا لا يتحقق إلا بفضل رهافة لغوية وخيال حسّاس، ما يجعل الرواية رغم رسوخها في التقليد الواقعي تكاد تعطي الذريعة لمن شاء أن يدّعي لها محلاً في تقاليد الواقعية السحرية. لعل الكاتبة تحاول تدجين الموت، تحاول «ألفنته»؛ أن تجعله أليفاً، أن تجعله جزءاً من الحياة، ففي الرواية؛ الذي يموت لا يغادر الحياة، لا يغادر الحدث، لا يهجر الأحياء الذين غادرهم، بل يبقى فاعلاً مؤثراً، رائحاً غادياً؛ لأن رجاء عالم تجد اللغة والأجواء التصويرية التي تتركنا دائماً في حالة شك ما إذا كنّا نطالع ذهنية إحدى الشخصيات الحية، أم أن الشخصية التي ماتت قد عادت تستأنف دورها الحياتي، كما في السابق. فلنتأمل هذا الوصف: «تخترق نورية كثافة الحزن المخيم على البيت (...) تفتح ما يجيء في طريقها من أبواب، (سلامٌ قولاً من رب رحيم). تهتف على كل باب وكلما عبَرَت ممراً أو دَرَجاً لتميزها ملائكةُ الدار عن أخواتها الأموات، أو لتضمن انسحاب الزوار من الأموات قبل دخولها». (ص 250)
أخيراً فإنني لا أريد أن أُنهي مراجعتي لهذه الرواية الجميلة البارعة دون أن آخذ على الكاتبة الإطالة والاستفاضة في الفصول الأخيرة من الرواية (نحو 50 - 60 صفحة من مجمل 336 صفحة). بعد رحيل نورية كان يجب على الكاتبة أن تلملم كل الخيوط وتنهي الرواية في غير تلكؤ، محافظةً على جمالها المركّز وكثافتها الشعرية والتخييلية، إلا أنها، بدلاً من ذلك، تُدخل شخصيات جديدة دون لزوم ودون فرصة لتطويرها (مثل دالية زوجة عباس/ نوري)، كما أنها للأسف تفعل ما يفعله كُتاب الرواية البوليسية؛ من أمثال كونان دويل وأغاثا كريستي، حين يجمعون الشخصيات في مسرح الجريمة ويبدأون تحليل عناصر الجريمة وتحركات الأشخاص ودوافعهم، وينتهون بالكشف عن شخصية المجرم. ليست رواية رجاء عالم رواية بوليسية، وإنما هي رواية غنائية رمزية من الطراز الأول، فلم نكن في حاجة لدخولها دخولاً شِبه مباشر في الرواية، تشرح فلسفتها وثنائياتها وشخصياتها من خلف قناع واهٍ. أرى في هذا تعبيراً عن عدم ثقة بالقارئ من ناحية، وربما أيضاً عن عدم ثقة بأنها قالت كل ما أرادت قوله عن طريق السرد والتجسيد والرمز، لكنني أشهد أنها فعلت بجدارة، وما كانت - ولا كنّا - في حاجة للفضول والزيادة.