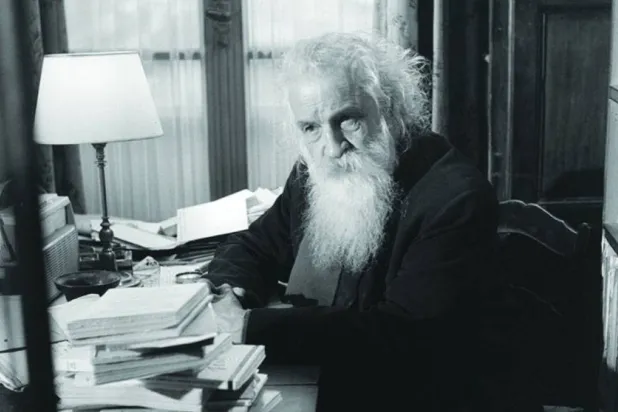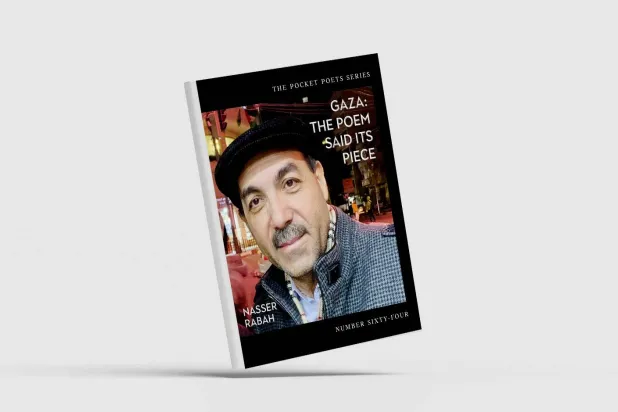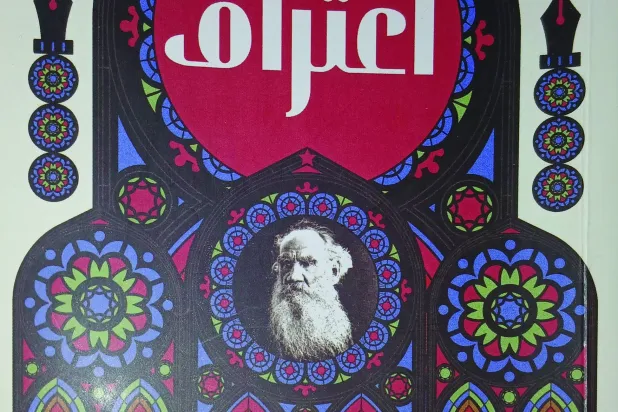- «كيف بتطلعي على واحد خسر كل شيء؟».
- «بشفق عليه».
- «إحنا ماكنش بدنا شفقة من حدا كان بدنا نرجع على بلادنا».

هذا الحوار من فيلم التحريك «البرج» أو («وردي» في النسخة الفرنسية)، وهو عمل من إنتاج نرويجي سويدي فرنسي، للمخرج النرويجي ماتس غرود. هذا العمل الفني يجسّد أحلام اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون على أمل العودة إلى وطنهم بعيون فتاة صغيرة تسمى «وردي»، وكان من المفروض أن يُعرض في عدد من المدارس الفرنسية على جمهور من الأساتذة والتلاميذ، في إطار ما يسمى «مهرجان السينما في التكميليات» إلى أن صدر قرار مفاجئ بإلغاء كل العروض المبرمجة عقب هجوم 7 أكتوبر (تشرين الثاني). عميد أكاديمية باريس المسؤول عن هذا الإلغاء برّر القرار «بالسياق الدولي الشّديد التوتر» وهو ما أثار موجة من الانتقادات، على رأسها موقف «المرصد الفرنسي للإبداع» الذي استنكر في بيان رسمي بعنوان «الأعمال الفنية ليست مُذنبة»، جاء فيه ما يلي: «المرصد يستنكر بشدة إلغاء العروض الثقافية، ويناشد المُبرمجين من مسؤولين على مستوى المؤسسات الثقافية والساسة احترام التزاماتهم بنشر الأعمال مهما كانت جنسية المبدعين أو موضوع الأعمال». صحيفة «ليبيراسيون» التي نقلت هذا الخبر أشارت إلى أن قرار الإلغاء سابقة خطيرة لم تشهدها فرنسا منذ 30 سنة من وجود هذه العروض التي يشاهدها سنوياً مليونا تلميذ. الصحيفة نقلت التعليق التالي: «دعونا نسمي الأشياء باسمها، إنها رقابة... وهو أمر مؤسف، خاصة أن (وردي) فيلم غني بالمعلومات والحقائق التاريخية التي يجهلها الجمهور غير العربي، والتي قد تفسر له حيثيات الوضع الحالي». وفي مقال آخر بعنوان «منع عرض فيلم تحريك عن فلسطين»، نقرأ على موقع «كونتر أتاك» أن مشكلة هذا الفيلم هي أنه يضفي على الفلسطينيين طابعاً إنسانياً، أي أنهم ليسوا إرهابيين مُتوحشين، ليس لهم هدف آخر في الحياة سوى قتل الإسرائيليين، وهذه حقيقة قد تزعج البعض. في حوار مع موقع «أنفيستيغ إكسيون» صرحّت الفلسطينية روان عودة، إحدى منظمات «مهرجان سينما فلسطين»، في مقال بعنوان «كل مبادرة ثقافية على صلة بفلسطين أصبحت مهددة»، أن «قرارات رسمية صدرت بقطع المساعدات المادية عن المخرجين الفلسطينيين، وكل التظاهرات الثقافية والسينمائية والموسيقية التي نوّد تنظيمها لشرح الأوضاع في فرنسا تمنع، بل تُلغى تماماً، ليست لدينا أي أخبار عن المشاركين في الطبعة العاشرة من (مهرجان سينما فلسطين) بسبب الأوضاع، كما أن رفض منح تأشيرات السفر عقّد الأمور أكثر، وبالرغم من ذلك نحن نكتب لهم باستمرار، على أمل أن يروا رسائلنا ولا يفقدوا الأمل».

كما نقلت أسبوعية «تيلي راما»، في موضوع بعنوان «في مرسيليا، وباريس، وتولوز، إلغاء النشاطات الثقافية المرتبطة بفلسطين يثير القلق»، شهادة كثير من مسؤولي المؤسسات الثقافية الذين عبّروا عن استيائهم من موجة الإلغاءات التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر. فلورانس مارفين، رئيسة لجنة التوأمة بين مدينة حلحول الفلسطينية (الضفة الغربية) وأنوبون (شمال فرنسا)، عبّرت عن غضبها بعد قرار البلدية إلغاء تظاهرة فنية حول السينما الفلسطينية، مصّرحة للمجلة الفرنسية: «التوأمة تعزز العلاقات بين المدن مع مراعاة جميع الحساسيات، وهي جمعية غير سياسية، ولذا فلا يوجد سبب لإلغاء هذه التظاهرة، هناك من يمنعنا من الحديث عن فلسطين... إنه أمر مُنافٍ للديمقراطية». معهد العالم العربي، على غرار المؤسسات الأوروبية الأخرى، قرر أيضاً إلغاء التظاهرات المبرمجة على هامش فعاليات معرض «ما تقدمه فلسطين للعالم». مارتان غارايان، مساعد رئيس المعهد شرح سبب هذا الإلغاء في بيان صحافي: «نظراً لعدد الضحايا من المدنيين من غير اللائق الاستمرار في الفعاليات، وخاصة الموسيقية»، مذكراً بأن التحاق المشاركين بالمعرض في باريس أصبح مستحيلاً حالياً بسبب الحصار. وسائل الإعلام الفرنسية نقلت أيضاً قرار عمدة شوازي لو روا (ضاحية باريس) بإلغاء عرض مسرحية البريطاني العراقي حسن عبد الرزاق «ها أنا ذا»، المستوحاة من القصّة الحقيقية لأحمد الطوباسي، وهو شاب فلسطيني ولد في مخيم جنين، وتتّبع رحلته من الكفاح المسلح إلى المسرح كأداة للمقاومة.

وإضافة إلى موجة الإلغاءات، فإن تفاعل المثقفين الفرنسيين مع الأوضاع المأساوية في غزة تباين بين تأييد مُطلق لإسرائيل، واستنكار لما يتعرض له المدنيون في غزة. ففي صحيفة «لوموند»، في موضوع بعنوان «الحرب بين إسرائيل و(حماس) تقسم النخبة الفكرية» يشرح الفيلسوف بيار شاربونيي أنه بعد هجوم 7 أكتوبر تكوّن لدينا معسكران، من جهة من يُتهمون بمعاداة السامية ممن يؤيد القضية الفلسطينية، ومن جهة أخرى من يُتهمون «بالفاشية»، وهم الفريق الذي يؤيد الحرب التي تشنّها إسرائيل.
صحيفة «لومانيتيه» مثلاً نشرت لائحة من إمضاء مثقفين وفنانين، من بينهم الكاتبة الحاصلة على جائزة نوبل للأدب، آني إرنو، جاء فيها أن «هذه الهجمات تشكل عقاباً جماعياً بغيضاً للشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولا تشكل بأي حال من الأحوال ممارسة لحقّ الدفاع عن النفس». في عمود آخر بصحيفة «لوموند»، بعنوان «للدفاع عن السلام يجب الاعتراف بأن حياة البعض تساوي حياة البعض الآخر...» يحذر مجموعة من المفكرين، منهم الباحث في العلوم السياسية برتران بادي ورجان سيناك والفيلسوف إيتيان باليربار والمؤرخ جيروم سيغل من غياب التوازن في التعامل مع أطراف النزاع الفلسطيني والإسرائيلي، فبينما تتعاطف وسائل الإعلام والجهات السياسية مع ما حدث للإسرائيليين، تتجاهل تماماً آلام ومعاناة الفلسطينيين، وكأنهم مجرد أرقام. المجلة الثقافية «لي زاروكوبتيبل» سألت في عددها الـ26 المفكر المخضرم إدغار موران (102 سنة) عن أكثر حدث استاء منه هذه السنة فقال: «لا أشعر بالاشمئزاز فقط، بل بالرعب، بؤرة حرب جديدة ظهرت بعد هجوم (حماس)، والردّ القاسي والمتوحش لإسرائيل على غزة، القضية النائمة لآخر احتلال في الكون، الذي يستهدف الشعب الفلسطيني، استيقظت، نحن أمام خطر اشتعال الوضع في الشرق الأوسط وحرب عالمية جديدة».
في المقابل، عبّرت شخصيات أخرى عن تعاطفها مع إسرائيل، أحياناً بطريقة صادمة كالكاتبة كارولين فوريست، التي أعلنت في لقاء بقناة «بي إف إم تي في» أن «هناك فرقاً بين الضحايا الإسرائيليين والضحايا الفلسطينيين، لأن إسرائيل لم تقصد قتل الأطفال، لأنها كانت تدافع عن نفسها، عكس (حماس)». تصريحات كارولين فوريست انتقدت بشدة، لأنها توحي بأن أرواح الإسرائيليين أكثر قيمة من أرواح الفلسطينيين. النائبة ماتيلد بانو من حركة «فرنسا الأبية» اليسارية تقدمت بشكوى لهيئة «أركوم»، التي تراقب محتوى وسائل الإعلام للاحتجاج على تصريحات الكاتبة الصادمة.
صحيفة «ليبيراسيون»: قرار إلغاء عرض فيلم «وردي» سابقة خطيرة لم تشهدها فرنسا منذ 30 سنة من وجود هذه العروض التي يشاهدها سنوياً مليونا تلميذ
الفيلسوف رافائيل أنتوفن هو الآخر حاول تبرير جرائم إسرائيل بقوله: «هناك فرق بين المدنيين الذين يُقتلون في الشوارع على يد قوات كوماندوز إسلامية، وبين الضحايا العرضيين للتفجيرات التي أعقبت هذا الهجوم، يجب أن ننوه بهذا الفرق، بل من المهم القيام بذلك». الفيلسوف برنار هنري ليفي ذهب أبعد من ذلك، حين شرح في لقاء صحافي ما مفاده أن «المسؤول عن موت الأطفال الفلسطينيين هم آباؤهم، لأن الجنود الإسرائيليين يحذرون سكان غزة قبل إطلاق القنابل». الكاتب المثير للجدل ميشيل ويلبك أكد مرة أخرى مساندته لإسرائيل، حين صرّح في حوار مع التلفزيون الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي يفوز دائماً، وسيفوز هذه المرة أيضاً، منتقداً ردود الأفعال المُعادية لإسرائيل في فرنسا، التي أرجعها لنفوذ اليسار، الذي يحاول كسب أصوات المسلمين من سكان الضواحي.