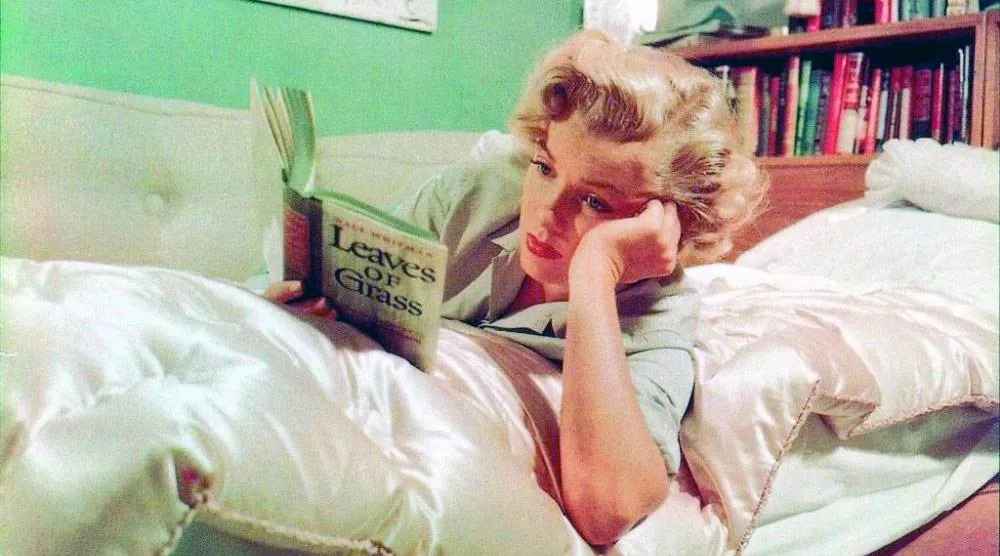لا يمكن للشاعر الفلسطيني أنْ يحتفي باللغة إلّا بوصفها طقساً، ليس للتطهير فحسب، بل لاستعادة الغائب، ووعي وجوده، حتى وإن كان «وعياً شقياً» أو قاسياً، إذ تتحول لعبة التدوين/ الكتابة إلى رغبة حميمة في تقويض ما يصنعه الغياب، وفي التلمّس القصدي لاستيهامات ذلك الوجود، عبر استعادة المعنى والامتلاء به، أو عبر الكشف عن شواظ الجسد المنفي والمطرود، أو عبر ما يعانيه من مكوثٍ قلِقٍ في المكان الطارئ، وكذلك عبر ما يتبدّى من سؤال الكينونة المهجوسة بالخوف، حيث تكون القصيدة هي استعارة كبرى لممارسة فعل الاستعادة، مثلما تكون هي المجسّ والدليل للمعرفة والاستكناه، أو هي العصا المثيولوجية للبصيرة، حيث تعني توظيف ذلك الوعي الشقي، أو القلِق في لعبة التصريح، في تمثيل خطاب الاحتجاج، أو في نفي الغياب والفراغ، أو ربما في ترميم التاريخ المُهدد بالمحو دائماً.
في كتابه الشعري «غرباء بمعاطف خفيفة» منشورات «ملتقى الطرق» (الدار البيضاء/ 2021) يأخذنا غسان زقطان عبر عناوين فارقة، وقصائد مكثفة، إلى عوالم تضجُّ بأسئلته، فهو يستغور عبرها هواجس الفلسطيني المسكون بنقائض ثنائية الحياة والموت، فتحضر فكرة «الطريق» بوصفها بحثاً عن الوجود، أو تعرّفاً على ما يجري، أو على ما يعانيه من فقدٍ وغيابٍ، فتبدو القصيدة وكأنها نصٌ موازٍ للحياة، واضحة، لكنها ضاجّة بأصواتٍ عميقة، تستنفر استعاراتها للإيهام باستعادة الغائب، بوصفه النظير لاستعادة «الوطن»، فضلاً عن كونها مكشوفةً على التفاصيل التي تحتشد بالوجع والانتظار والخوف والموت، إذ يصطنع الشاعر عبر تمثله للغة النثر المتوهجة صوراً تتسع لتلك الاستعارات التي لا تنفصل عن الحياة ذاتها، ولا عن ذاكرةٍ تحفل بسيرِ الموتى والهجرات وأرواح العالقين بدوستوبيا الأمكنة:
لم تكن تنقصهم الشجاعة ولا المرح،
أولئك الفتية الذين رفعوا أيديهم المحترقة بالبارود،
وقمصانهم المدماة في ذلك الفجر من أكتوبر.
كتابة زقطان تنزع إلى ما يشبه الاستذكار، حيث تستعيد القصيدة وجوه الغائبين، المسكونين بالحلم، الذين يحملون معهم ذاكرة المدن المكشوفة على الحرب والضحك والحلم، فيجد الشاعر في ذلك النزوع نوعاً من الشغفِ بسحرِ الاستعادة، وأحسب أنّ قصيدته المُهداة إلى أمجد ناصر«أقف بجانبك» تجاهر بذلك السحر النقيض للغياب، فنجد في لعبة الاستعادة تعرية صاخبة للموت، بوصفه خطفاً مريعاً، ليس للكائن الصديق فحسب، بل للوجود وللتفاصيل الحافلة بالأسرار واليوميات، التي لا يملك الفلسطيني سوى استعادة علاماتها التي تُذكّره بالحياة المطعونة بالغياب..
أقف إلى جانبك ولا تراني،
ولكنك تتذكر شجاراتنا على الفتيات الغيرة التي عضت أحلامنا.
ثيمة التذكّر تكشف عن الشغف بتلك الحياة، عبر الإيحاء برمزية الحضور، إذ يكون الوقوف تشفيراً لذلك الحضور، مقابل الغياب الذي توحي به جملة النفي الفعلية «ولا تراني»، التي يجعلها الشاعر استعارته النفسية لاستيهام مجاز الإشباع عبر استدعاء الغائب، وعبر تحويل هذا الاستدعاء إلى ما يشبه الحفر في التفاصيل التي يمكن لحضورها أن يُقوّض ذلك الغياب.
ولعل قصيدة «الأمل بقلبه المعشب» التي اختارها الشاعر للغلاف الخلفي لكتابه الشعري، توحي، وربما تختصر وجود الشاعر في اللغة، فيجعلها الشاعر عتبته أو مناصته المتعالية، التي تُحرّض على إعادة القراءة، وكأنها هي التحريض العلني على التمسك بالحياة، إذ تبدو رغبة الشاعر مفتوحة على انشغالات فكرية وصورية واستعادية تستفزه لمقاربة أشياء تتكثف فيها دلالات وجوده عند أمكنة غائرة، أو عند حكايات تتسع لاستذكار غائبين، أو لمجازات «قصائد عابرة» تمنحها عنونة «الأمل والقلب المُعشب» نوعاً من الحساسية التي تجعل من وجودها عناداً ضدياً للبقاء إزاء ما يفرضه الغيابُ من فقدٍ أو محوٍ أو موتٍ.
أكتب أشياء لا يحبها أصدقائي،
حواشي لا ينتبه إليها جيراني الذين تسرقهم الحياة كل يوم،
نصوصًا متكتّمة لا يلتفت إليها زملائي في المقهى،
قصائد لا يحبها أحد،
مشغولة بالغياب والافتقاد،
أكتب مراثي للحبّ والأسماء القديمة،
تتخفّى وراء مجازات لا تشي بالرثاء،
الأمل فقط،
الأمل دون غيره،
بقلبه المعشب،
موحشًا وعنيدًا، يدفعها نحو الضوء.
فرادة الكتابة عند غسان زقطان تتكشفُ عبر ما تستغرقه رؤيته القلقة، المشوبة بحذر مَن يبحث عن ذاته، فيجد في تدوين هذا القلق كشفاً فاضحاً عن سلالة الفلسطيني الأسطوري والمهاجر والمنفي والمقتول، وبما يجعل من تدوينه شهادةً لوجوده، وعلى نحوٍ يجعله يستدرج له الاستعارات والأقنعة لكي يصطنع للبقاء/ المكوث وجوداً رمزياً عبر قصيدته الشخصية، تلك القصيدة التي تنأى بنفسها بعيداً عن حرائق التكرار، فسيرة الفلسطيني - كما اعتدنا- لا تحضر إلّا بوصفها سيرةً للغائب، بعيداً عن استيهامات الاحتشاد الشعري، الواقف تحت يافطة «القضية» التي استغوت الكتابة عنها كرهانٍ على القربِ منها، أو في البُعدِ عنها، حتى بدا البعض منهم يُضلل الوجود، عبر تكرار وظيفة المُغنّي العالق بحنجرة الوقت والتاريخ، وهذا ما يجعل شغف غسان بالفرادة ليس بعيداً عن «وعيه الشقي»؛ الوعي المدسوس مثل جرحٍ نازف، يقاوم الاندمال، لكنه يجاهر بالوجع والنزف، وكأنه نظيرٌ لوجع القلق والاغتراب، مثلما يجاهر بالمغايرة، بوصفها حقه الشعري، ليس للخروج النافر عن «السيرة» و«السلالة»، بل لـ«خصخصة» وعي هذه السيرة وسلالتها، وليصطنع عبر طقسه الشخصي، طقس الاحتفاء بحضوره إزاء ما تمور به «سرديات غيابه» في المكان والهوية، فيكتب باستعارة عاليةٍ عن «غرباء المعاطف الخفيفة» بوصفه واحداً منهم، فيكتب عن «الحقائب المنسية في الليل» وكأنه يستعير عصا التائه الشعري الذي أضناه المنفى، فراح يتقصى وضوحه في ليل الاغتراب، ويكتب عن الآخرين والمدن وكأنه يكتب من خلالها عن سيرته الشخصية، بوصفه الشاعر الرائي، الكاشف والعارف بأسرار العابر والغائب وأطراسهما.
ما قاله الشاعر.. ما تحدّث به الغريب
في كتابه الشعري «تحدّث أيها الغريب تحدّث» الصادر عن منشورات المتوسط/ إيطاليا 2019 يستعير غسان زقطان قناع الغريب، ليستدّل على الغائب، يدوّن سيرته، منحازاً إلى تمثيل خلاصه، ومحتفياً بحريته الشائهة، وبشهوة «الحديث» الذي يجعله الغريب قرينه، وهاجساً لوعي وجوده، ودافعاً لمواجهة ذاكرة الوصايا، إذ تكون حريته هي استعارته الكبرى، وهي شغفه في كتابة المختلف، وفي الكشف عن المخفي، فالغريب الذي يشبهه هو ذاته الكائن المتمرد على وجوده ومنفاه، مثلما هي القصيدة التي تستغرقه في سعة ما تراه الأنا، وفي سعة «النص المفتوح» الذي يجعله حراً، لكن ليس للتحرر من ذاكرة الغناء، بل لكي يهب القصيدة «سعة الخبرة» التي تُعطي للشاعر فرادته، ليس للانعتاق من «عباءة محمود درويش»، بل لتكون تلك الخبرة وعياً بالتجاوز، وطاقة بصناعة ما يشبه «معجزة القصيدة» التي تتمثلها أصداء الغربة، وأصداء الذات القلقة، المسكونة باليومي والذاتي، واللا مألوف، وربما المفتوحة على ما تنزفه الذاكرة وهي ترقب ما تصنعه قسوة الغياب، وما يتعطب من الذات النازفة في أمكنة تضيق، لكنها تتحفزُ بعناد، لتقفزَ باستعاراتها ومجازاتها إلى أفقٍ يكون الغريب هو شاهده الأكثر جرأه، وحامل زوادته في البحث عن الغائب.
امكث قليلاً أيها الغريب،
لن أسألك عن اسمك أو وجهتك،
فقط اجلس تحت ضوء الشمعة
التي أشعلتها من أجلك.
لا تذكر الهيئة التي كنتها،
وتحدّث، تحدّث أيها الغريب،
تحدّث لأجدَ صوتي
الذي أخذته الرياح حمالة الرمل..
الشاعر وتقانة الإيجاز
كثافة الشعري في تجربة زقطان لا تكتفي بتقانة الإيجاز، ولا بحيوية الجملة القصيرة، بل تكشف عن هوس الشاعر بالمغايرة، وبما يجعل هذه الثنائية شغفاً بتجاوز السائد، وكتابة القصيدة التي تحتشد بالإشارات، والأصوات التي توقظ المخفي، فيستدعي لها شفرات الصوفي واليومي والمثيولوجي والسيروي، وكأنه يصنع عبر التشكيل ما يُبرر شغفه بالطقس الذي يحتفي بالحياة عبر ما يصنعه الغريب في سيرته وتجواله.
رأيت الكثير من العيون،
تلمُّ صنعتي،
سرقتُ خوفها، ألمها وأحزانها،
وبعتها لأغرابٍ جاءوا للفرجة..
تحتشد هذه الجمل الشعرية الفعلية بإيحاءات لاستحضار الوجع الذاتي، وبهواجس الغربة والقلق، التي تضع الشاعر إزاء محمولات رمزية لما يحمله وجعه الوجودي، حيث الغياب القاسي والحضور الفاجع، وحيث النقائض التي تستلبه، وحيث يكون «الوعي القاسي» تمثيلاً لسؤال الفلسطيني الذي يساكن اللغة بوصفها سحراً للتطهير، وبلاداً للاستعارات، يكون الشاعر فيها باحثاً، ومهجوساً برعب هذا السؤال، والإنصات إلى علاماته الخبيئة، تلك العلامات التي تختصر زمنه النفسي، أو سيرته المفتوحة على تراجيديا الغياب.
اللغة عند الشاعر هي معادل وجوده الغرائبي، وربما معادل غيابه، لذا تضج القصيدة بأصواته الضاجة، جملها المكثفة واخزة ومُستَفِزة، تكشف عن المخفي من النقائض، وعن شهوة البقاء، إذ يعمد عبر «قصيدته الشخصية» إلى اصطناع وعي لمفهوم الحضور بمعناه الفلسفي، أو حتى بمعناه الصوفي، بوصف الكتابة هي التجليات العالية، وهي الحساسية الفائرة، التي تدفعه إلى الكتابة المغايرة، بوصفها مغايرة اغتنت بتجارب واسعة، تسعى للتحرر من عقدة الصوت الدرويشي، بوصف الحرية - هنا - قناعاً آخر للوعي القاسي، الذي لا يبحث عن الوجود المغاير فقط، بل عن الأفق المغاير واللغة التي يصنعها، لتقويل العالم بأشياء مختلفة، تتقشر فيها اللغة عن تاريخها الغنائي والاستعاري، ليبدو عريها مكشوفاً وفاضحاً، صانعاً لدهشة الافتراق، ومكشوفاً على ما هو مغاير في ثنائية التجاوز والمغايرة، وإعادة توصيف «الذات» الفلسطينية، ليس بوصفها التاريخي، بل بوصفها المثيولوجي الذي تستغرقه أساطير الغياب والعودة، وحتى أساطير سرّاق الحكمة، وأصحاب العبث السيزيفي.
لم نكد نتبع الحلم
حتى أفقنا،
وكي أستطيع التذكّر
إنّا مشينا وراء عتمة البئر
حتى وصلنا معاً
وافترقنا..
ولما شربنا من الماء سبعاً،
ولمّا ارتوينا وكدنا
شرقنا!