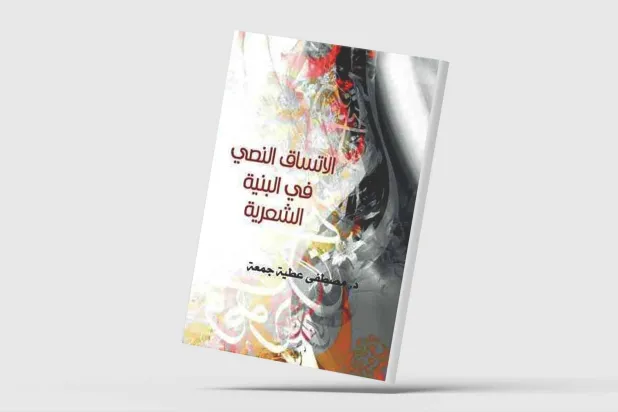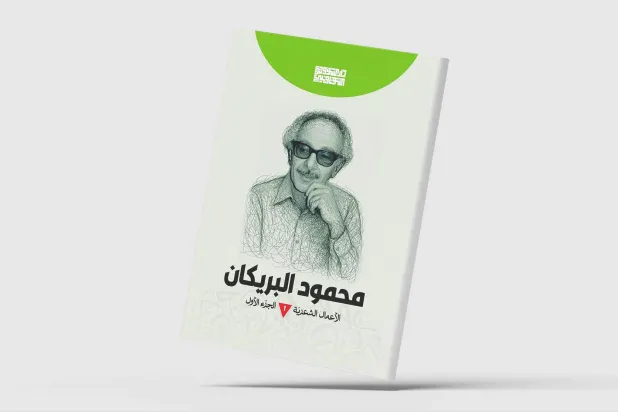فوق ثمانية عقود من الشعر يجلس طلال حيدر. يفرد الأبيات أمامه كلعبة نرد. مع أن العمر سار به إلى السادسة بعد الثمانين، ما زال يتسلّى بالقصيدة، يغازلها ويلوّن بشمسها الحيطان الباردة.
الشاعر اللبناني الذي تفيّأ هياكل بعلبك عُمراً، وراقص سنابل سهل البقاع، وألبسَ الأغنية عباءةً من خيوط القصب، لا يقلقه ثقل الزمن العابر. يروّضه ببيتَين من شعره المَحكيّ: «يمرق العمر ع كتافي أنا شو خصني»، «هيدا الزمان الوهم بيحمل تحت باطه الأرض وبس يروح ما بيرجع».
من دارته المئوية في بدنايل البقاعية التي ورث حجارتها عن أجداده، يقول في حديث مع «الشرق الأوسط»: «أنا فجعان حياة... بدّه يبقى الإنسان متوقّد ويغلب الموت بالحياة». رغم أن معظم الذين رفعوا أعمدة البيت الثقافي اللبناني راحوا، فإنهم بقوا كـ«زهر البيلسان» في بال طلال حيدر.

«وحدُن» وذئاب الثلج في بعلبك
ذخيرته ذكريات مع كبار الأغنية والقصيدة والمسرح والريشة. يتحدث عن صباح كوهجٍ أضاء القلعة، ويرفع فيروز إلى فوق، إلى حيث التيجان التي لا تطالها رؤوسٌ سوى رأسها.
«يوم كتبت لفيروز أغنية (وحدن)، سرق صوتها الكلام وصار هو الأغنية»، يقول طلال حيدر. تضاربت المعلومات والروايات في شأن تلك القصيدة التي خلّدها صوت فيروز ولحنُ ابنها زياد الرحباني. تحدّث البعض عن أنها تروي قصة ثلاثة شبان فلسطينيين نفّذوا عملية داخل الأراضي المحتلة عام 1974، في حين تردّدت معلومات أخرى تقول إن القصيدة نُشرت في صحيفة «النهار» اللبنانية عام 1966، أي قبل 8 سنوات على تلك العملية.

«لا تسأليني من أين أتت القصيدة، بل اسأليني إلى أين ذهبت»، يبدو حيدر قاطعاً في جوابه. لا يريد تشريح الماضي ويكتفي بالمجد الذي ذهبت إليه الأغنية بصوت فيروز. أما نسخته المفضّلة من قصة «وحدن» فتعود به إلى أيام الطفولة، وإلى الصفوف الابتدائية في موسم البرد وذئاب الثلج في بعلبك.
«كنت شارداً في الصف، أشاهد الثلج من الشبّاك وأصغي إلى الذئاب. ناداني الأستاذ، لم أردّ فضربني بالمسطرة. مرّت الأيام والسنوات ثم جاءت القصيدة... يا ناطرين التلج ما عاد بدكن ترجعوا... صرّخ عليهن بالشتي يا ديب بلكي بيسمعوا».
ليس اللحن والصوت فحسب ما يمنح الشعر خلودَه برأي حيدر. يصرّ على أنّ «وحدن» كانت لاقت المجد ذاته لو بقيت قصيدة ولم تتحوّل أغنية. فـ«لا شيء يقف في وجه القصيدة المرشّحة لتبقى في الزمان».
«من وين بتجيبهم يا طلال؟»
ها هو طلال حيدر يضرب مواعيد مع الزمان الآتي، ويستعد لنشر ديوانين جديدين. تتكدّس الأوراق في غرفته، وفوقها حبره أو خبزه اليومي. يشبّه نفسه بالشجرة اليابسة في اليوم الذي يمضي من دون كتابة: «بدي ضل اكتب لحتى غمّض عيوني ونام ع شي مخدّة من تراب لبنان».
مع أن هذا الزمن ضاق في وجه الشعراء، لا يفقد حيدر إيمانه بالقصيدة الحقيقية ذات الأسوار العالية، والعصيّة على التَداعي أمام عصر السمعي البصري ووسائل التواصل الحديثة. بابتسامةٍ واثقةٍ بسرمديّةِ الشعر، يؤكد: «حتى وإن غاب المتلقّي الشعري في بعض الأزمنة، فإن الشعر لا يغيب والزمن الشعري دائم الوجود».
لكن من أين يأتي بالسرمديّة للمدن التي سكنت شعره، ولم يبقَ من بعضها اليوم سوى حجارة مبعثرة؟ يكفيه أن تلك المدن التاريخية كتَدمُر وحلب لم تتغيّر في داخله، بل «بقيت فعلاً حضارياً، وإن تعرّضت للدمار».
يحلو له تكرار بيتٍ من قصيدة «طقس»: «بس تفرحي بيطير من صدري الحمام وبس تزعلي ع مصر باخدلك الشام». يحبّها بصوت الفنان مارسيل خليفة الذي خلّد شعر طلال حيدر في أغنيات مثل «ركوة عرب»، «بيتي»، و«سجر البن» وغيرها. تندهُه جملة «ع كتر ما طلع العشب بيناتنا بيرعى الغزال» الموسيقية من أغنية «قومي اطلعي عالبال». استوقفت تلك الجملة الكبير منصور الرحباني الذي سأله مرةً على جلسة غداء: «من وين بتجيبهم يا طلال؟».

بين البيت الرحبانيّ وطلال حيدر، لم يتخطّ التعاون أغنيتَين، هما «وحدُن» و«يا راعي القصب». لكن ذلك لا يعني أن العلاقة بينهما خلَت من الألفة. جمعته بمنصور جلسات خبز وملح كثيرة، وبقيت في باله مشاهد عن عاصي الذي أغدق على المساكين من مال جيبِه وعلى الفن من عبقريته.
الوراثة الشعرية ممنوعة
عن سابق تصوّر وتصميم، لم يورّث طلال حيدر الشعر لأبنائه وأحفاده. يقرأونه بالعربية وباللغات التي تُرجم إليها، كالإيطالية والإسبانية والفرنسية، لكنه يسعى كي يتوقف الأمر عند حد القراءة: «هدفي أن يبتعد أحفادي عن امتهان الشعر لأني لا أحب أن أغلب ابني وحفيدي». يقول إن محبته لهم هي التي تدفعه إلى انتشالهم من أي موهبة شعرية محتملة.

يؤمن بمعادلة النعمة والنقمة في الشعر. تكمن النعمة في «القدرة على الخلق»، أما النقمة فهي أن الصراع الوحيد هو صراع مع النفس: «ما بدي إغلب حدا بالشعر، بدي إغلب حالي»، يقول طلال حيدر؛ «أي قصيدة تكون إيقاعاً للقصيدة التي سبقتها هي لزوم ما لا يلزم».
بنبرةٍ صارمة يدعو اللاهثين وراء الكمية وكثرة الكلام في الشعر، إلى الصمت: «إذا ما كانت رحلتك الشعرية تصاعدية، السكوت أحسن... لمعة شعرية واحدة بتكفي حتى تضوّي المكان». أما القصيدة التي تلمع في قلبه من بين كل قصائده فهي «عتمة خياله».
«في ناس قالوا قتِل
في ناس قالوا مات
في ناس قالوا فتح عتمة خياله وفات»
بعلبك «الآه والآخ»
تعود به تلك القصيدة إلى حبه الأول، ابنة راعي الغنم التي سرقت قلبه في بعلبك. لم يبقَ من الراعية الصغيرة سوى ذكرى عاطفة بريئة، أما من مدينة الروح التي طرّزها طلال حيدر بشِعره، فبقيت «الآه والآخ» وفق تعبيره. يفصّل التنهيدتين الطالعتين من الأعماق: «آه على الزمان الذهبي الذي كان في بعلبك، وآخ من الزمان الذي نحن فيه الآن».

تسكنه بعلبك وتستوطن كل بيتٍ من شعره. يقول إن لا أحد يستطيع أن يسرقها منه: «كل ما كتبت وسأكتب هو لملمة معانٍ من طفولتي في بعلبك أنا وماشي حفيان بالكروم، بنهر راس العين، بفيّة الصفصاف، لاحق العصافير بالبساتين».
بعلبك هي كذلك الوالد الذي تتوسط صورته الدار، والوالدة التي قالت عنه «مجنون» عندما أسمعَها تلك القصيدة:
«مشتاق إيديي غمر مفتوح متل النون
معجّل متل جملة ما فيها سكون ولا بنهدى
والوقت ما عندو وقت ينطر حدا
يمكن أنا مجنون».