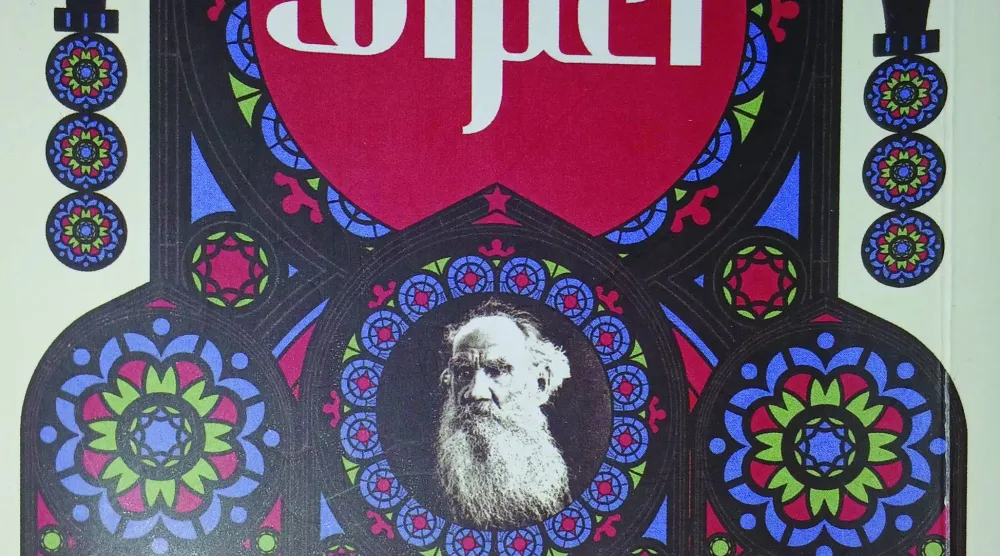ينظر الجميع إلى الوطن بعين تفسّر الأمور على نحو ميتافيزيقيّ، فهو يمثّل لدى البعض الراية التي ترفرف أو التربة التي نمشي عليها، والنهر والشجر والأم والأب، وفي عالم الفن ثمة جانب غير واقعي في صورة الوطن، أو قل إنها صورة خرافيّة يرسمها الفنان لبلده ويتمسك بها، وإن كانت بعيدة عن فهم الجميع، لكنها قريبة من قلب الفنان وعينه، فهو لا يرى غيرها، وأثبتت الوقائع أن هذه الصورة هي كلّ ما تبقّى من دول قامت ثم ماتت، وانطوت عليها صفحات الزمان. «ملحمة غلغامش» هي صورة خرافية لبلاد سومر، لكنها باقية تعاند رياح الزمان آلاف السنين. وكذلك الأهرامات، صورة خرافية أخرى، ويجري القول نفسه عن أسد بابل والمئذنة الملويّة ونصب «أبو الهول»، وبانتقالنا إلى العصر الحديث تبرز لنا لوحة الغرنيكا صورة خرافيّة عن عصرنا، وكذلك برج إيفل وتمثال الحرية، وغيرها.
كما يمكن للصورة الخرافيّة أن تكون حكاية أو قصّة أو رواية، مثلما خلّدت حكايات بيدبا في كتاب «كليلة ودمنة»، وكذلك قصص «ألف ليلة وليلة»، والصورة الخرافيّة التي أختارها لبلدي العراق في العصر الحديث هي قصة قصيرة لفرج ياسين عنوانها «غدا في الصدى»:
«كانت هناك سعلاة، وكوخ من القصب يسكنه شيخ وعجوزه. سمعت السّعلاة صوتَ البقرة، وقالت تحدّث نفسها: لقد وجدتُ صيدا. خاف العجوزان من السعلاة، لكنّ البقرة طردتها في الحال وهدّدتها بالقول: إذا أتيتِ مرة ثانية، وجرُؤتِ على دخول البيت، فإنني سأغمزك بعيني وأنطحك بقرني وأرفسك برجلي. عادت السعلاة في اليوم الثاني، وكانت البقرة هي الحامي، وتكرّر مجيئها في تالي الأيام، وفكّر العجوزان أنهما أصبحا هدفاً مستمراً للسعلاة بسبب البقرة، فقاما بذبحها، وظنّ الاثنان أن كل شيء انتهى، لكن السعلاة عادت في الليل، وسمع الزوجان البقرة تردّ عليها: سأغمزك بعيني وأنطحك بقرني وأرفسك برجلي.
- ولكن البقرة ذُبحت، من الذي كان يجيب، أهي الشياطين؟
يسأل الصبي أباه في القصة، ويجيبه الأب:
- كلاّ إنه رأسها، لقد أخفاه العجوزان في فناء الدار وقلبا فوقه طشتاً، لئلا يلمحه أحد، لأنهما أرادا طبخه في اليوم التالي.
- وهل جاءت في اليوم الثالث؟
- تماماً كعادتها، أول الأمر.
- وهل ردّ عليها أحد؟
- أجل، لقد سمعت الإجابة ذاتها: سأغمزك بعيني وأنطحك بقرني وأرفسك برجلي.
- كيف؟
- ثمة قطرة دم واحدة بقيت عالقة في الجدار بعد تنظيف الفناء من دماء البقرة، هي التي تكلّمت الآن.
- قطرة دم؟
- نعم.
- وماذا فعلت السعلاة؟
تملّكها الذّعر ثم ولّت هاربة، لكن العجوزين كشطا قطرة الدم في اليوم التالي، فجاءت السعلاة عند منتصف اللّيل والتهمت الاثنين».
نشر فرج ياسين القصة في التسعينات، وكان المغزى السياسي فيها واضحاً، فقد تكالبت جميع بلدان العالم على العراق في سبيل عزله وحصار حكومته وتجويع شعبه، وكانت هذه واحدة من العقوبات التي فُرضت بسبب احتلال الكويت. البقرة هي الوطن، والسعلاة هي القوى الظالمة التي حاولت الإجهاز عليه، لكنّ قطرة دم واحدة تبقى حيّة يمكنها الدفاع وصدّ الأعداء إلى خارج الحدود. تأتي الروح من الروح، ويأتي الدم من الدم، وهذه روح خالدة في المكان وفي الزمان، وهي رمز بقاء الحياة على أرض الوطن. إنها صورة خرافيّة أخرى...
نُشرت القصة في مجموعة فرج ياسين القصصيّة «رماد الأقاويل» عام 2006. وكنتُ أعود إلى القصّة دائما بالقراءة والتأمل، وأودّ هنا أن أمضي في قراءتها، وفق الفذلكة النقدية على أن القارئ مؤلّفٌ ثانٍ للنصّ. إن نقطة إطلاق السهم واحدة والنهايات كثيرة، واخترتُ لهذا السّهم خواتيمَ ثلاثًا، وربما طلعت لي بمرور الزمان آفاق جديدة.
غاب وعي قطرة الدم لأن العجوزين أزالاها من الحائط، واحتلّ قوم السعلاة البيت، وهدموه وبنوا خرائب ترتاح فيها نفوسهم وتبرد أنفاسهم الوحشيّة. مرّ زمنٌ وعادت النضارة إلى قطرة الدم، وأخذت تنشد في الليل والنهار ترنيمها السّابق، مهدّدة قومَ الغزاة: «أغمزكم بعيني وأنطحكم بقرني وأرفسكم برجلي». إن ليل السعالى يشبه النهار، فهي لا تنام بسبب تهديد البقرة الذي لا يُعرف مصدره، وتفتش في كل مكان دون جدوى.
الاحتمال الثاني أن السعلاة أكلت العجوزين وغادرت، وبقي البيت فارغاً إلا من شبحَي العجوزين الغائبين، تحرسهما قطرة الدم، فلا يقرب المكان أحدٌ. البيت كذلك بقي قائماً، تدلّ على الحياة فيه زهرة تخرج مع أوراقها من جدار، وعشبٌ يشقّ طريقه في الأسيجة...
يمكن للصورة الخرافيّة أن تكون حكاية أو قصّة أو رواية مثلما خلدت حكايات بيدبا في كتاب «كليلة ودمنة» وكذلك قصص «ألف ليلة وليلة»
القراءة الثالثة للقصة هي الأقسى على النفس، وكلّما راودتني شعرتُ بضيق في صدري، ورأيت الدنيا ظلاماً يلفّني من كلّ جهة. بعد أن أقامت السعالي خرائبها، ظلّت تتكاثر كما في غمرة حلم، وملأت الأرض وحوشاً تلتهم كلّ شيء، حتى الشجر اليابس وجذوره، بل حتى التراب. صارت البلاد بلقعاً خاوية، والزمن يسير فيها إلى الوراء باطّراد، إلى أن بلغت الحقبة التي تُدعى من قبل التاريخيّين بما قبل التاريخ، فصار قوم السعلاة ينادون ويعيدون إلى الحياة وحوشاً اضمحلّت وبادت منذ العهود الجيولوجية الأولى، مثل الديناصورات والماموث والتنين الطائر. ثم جرت في أبدان هذه الوحوش نقلات جينيّة تحوّلت فيها إلى مخلوقات متوحشّة عليها سمات البراءة والجبروت في آن واحد، فهي وحوش بهيئة بشر أو العكس، إنسان عاد إلى الوراء ملايين السنين وانبثق ثانية من تلك العهود الدفينة، ثم تكيّف مع الحياة الحديثة، وصار يحمل من تاريخه الوحشي صفات، ومن عيشته الجديدة صفات أخرى. لا أشدّ من تكاسل إنساننا الجديد، وبطئه في الحركة، فهو يعيش في حالة من السبات، لا ينتقل من مكانه إلا في سبيل الحصول على مزيد من القوت، ولا يدلّ تكاسله على أنه يعيش حياة حلوة حالمة سعيدة، لأن هذا المخلوق المسخ في حالة حرب مستمرة مع الجميع، ومع نفسه. عندما يتكلّم تُسمع منه أصوات مضمّخة بذلك الهدير البدائي، فهو يهدّد ويتوعّد دائماً بالانتقام من الآخر، وأحياناً يكون هذا الآخر ضمنياً يعيش في داخله. للبعض منه أذناب طويلة وأعراف، بينما يمتلك البعض الآخر رؤوساً كثيرة أو أقداماً كثيرة أو أيادي أو ألسنة أو أفئدة أو مُعيًّا لا تُحصى تنتهي بأدبار لا تُعدّ، فهو يأكل طوال الوقت من أجل إشباع بدنه الديناصوري الذي ما فتئ يتضخّم يوماً بعد يوم، بالغاً حجم عشرة أمثال الديناصور الذي يشبهه كثيراً، ومحققاً بذلك أحلام جميع الرسّامين السرياليّين وخيالاتهم الإبداعيّة. ومن صفاته العجيبة أنه لا يمرض ولا يهرم، ولديه قدرة عجيبة على التناسل، ويتمدّد في الأرض التي يسكنها مثل العشب، وإذا قُطع أحدهم إلى نصفين التحم أحدهما مع نصف يعود إلى كائن آخر، ثعبان أو حمار أو تمساح، وصار لدينا مخلوق جديد يتناسل وينقسم ويتّحد.
من كلّ ما تقدّم نفهم أن إنساننا الجديد في هذه البلاد ودّع طبيعته البشريّة وانتقل إلى جبلّة جديدة، حتى إن العلماء لا يستطيعون تصنيفه في أي نوع وجنس، واختلط الأمر كذلك على قطرة دم البقرة، لأنها ترى ما ترى ولا تفهم ما يجري على الأرض وفي السماء. هل المكان هو المكان، أم أن رحيلاً مدمّراً حدث واستُبدلت كائنات من كوكب آخر بالمخلوقات عليه؟ منذ زمان قرّرت قطرة الدم الكفّ عن المنافحة والدفاع والنشيدِ، وسكتت. إنها تصغي طوال الوقت إلى ما يجري من فظائع تقوم بها مخلوقات عجيبة ليس هناك من سبيل لإصلاحها أو التخلّص منها بأي صورة.