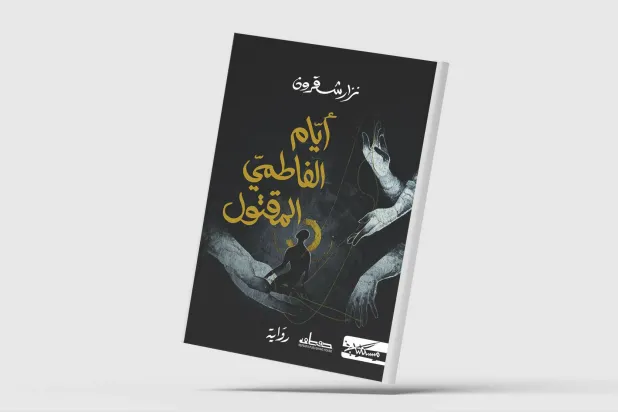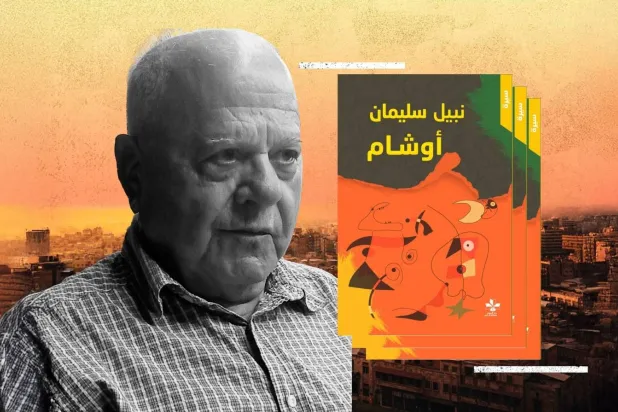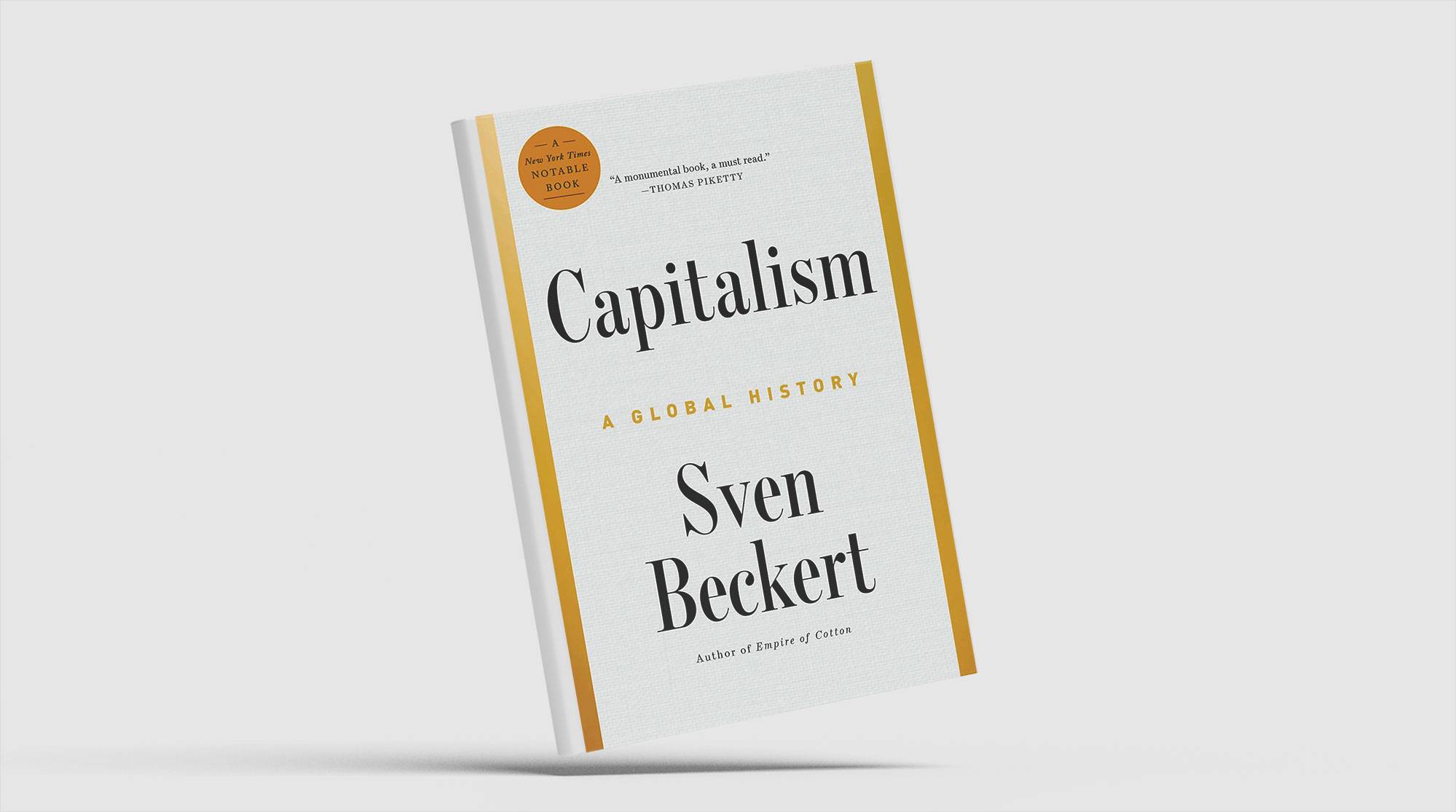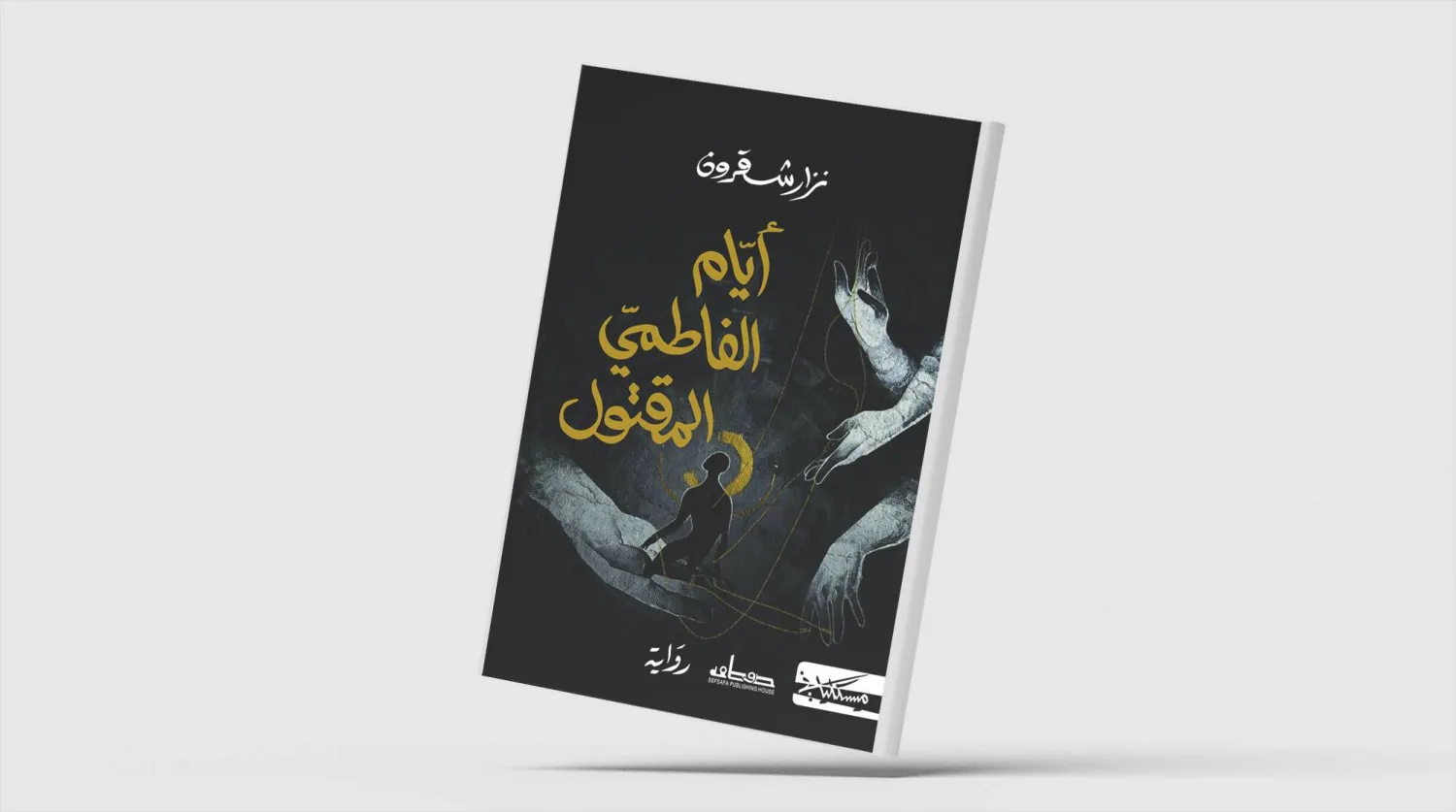تتدفق في رواية «المنسيون بين ماءين» للكاتبة البحرينية ليلى المطوع (دار «رشم للنشر والتوزيع» - 2024) محفزات تثير مشاعر مختلطة لدى المتلقي، خصوصاً في أبرز عنصرين من عناصر البيئة المحلية: البحر والنخيل. وهي رواية تعيد الشعور بنشوة ارتطام الماء بالأقدام على السواحل، وتعود بنا إلى مباهج الطفولة من التقاط الأصداف. إنها تذكرنا بطعم «الخلال» اللاذع، وبأصوات العصافير وهي تلتقط الرطب الجني. وترجعنا إلى مواسم الاصطياف في بِرَك الماء الارتوازية وسط مزارع النخيل.
لقد نسجت الكاتبة بلغة رشيقة بساطاً سردياً تداخلت فيه الأزمنة وتقاطعت. وحبكت خيوطه من حكايات تربط سيرة النساء في صراعهن المرير لعيش مشاعر الأمومة، مع غموض وكرم الماء والنخيل سواء بسواء، في معالجة سردية تستمد نسغها من الفانتازيا. فتارة تقدم النذور للبحر، وأحياناً يتم الاستعانة به لقضاء الحوائج.
وتنجح المؤلفة في إصدارها الثاني هذا على إيجاد صيغة فنية وإبداعية تؤكد من خلالها الارتباط المصيري بين عنصري النخلة والبحر في هذه الرقعة الجغرافية وانعكاسهما على الإنسان، تكويناً وحياة. ورسمت داخل هذا الإطار تاريخاً مفصلاً ضارباً في القدم منذ أرض الخلود: «دلمون» ذات المياه العذبة، في شكل ينابيع وعيون فوارة بعد مباركة الإله أنكي - كما تقول الأسطورة.
تشكل الرواية جهداً لافتاً أفصح عن امتلاك الكاتبة للأدوات اللازمة لتقديم رؤية جديدة ومن منظور مختلف لحكايات البحر الكثيرة، التي قال عنها الشاعر علي عبد الله خليفة: «مَلَّها الليل ومَجَّتها الظهيرة»، النخلة، كما يقول الناقد الدكتور علوي الهاشمي للنخلة هي الأم الحقيقة، والبحر هو الأب الشرعي مانح الخير والرزق، رغم قسوته وتجهمه وغدره من ناحية أخرى.
تتحرك أحداث «المنسيون»، وفق توجيه من البطلة «ناديا»، التي تعيش في جزيرة اصطناعية، نتيجة دفن البحر وتطويقه، وإثر القضاء على الينابيع الطبيعية. وذلك بين الماضي والحاضر، في صورة قصص مستلَّة من مذكرات جدتها نجوى عاشقة البحر والنخل، التي كشف عنها زميلها (آدم)، بعد أن كانت مجهولة.
تبدأ الرواية بقصة «سليمة»، المرأة التي تمّت التضحية بابنتها الوحيدة قرباناً حتى تتدفق المياه في عيون الماء من جديد، وتصف من ثم شقاءها. وتعود بعدها إلى الماضي السحيق في حكاية «إيا ناصر» فتصور مشاهد وطقوس عبادة إله الماء، بدراما حسية، لترسيخ فكرة ارتباط النوع البشري بمصدري الحياة على الجزيرة المتمثل في الماء والنخيل.
ومع تقدم أحداث الرواية، تحيك في قصة «درويش» مسار العادات القديمة بين أهالي الجزيرة وانتقالها إلى مَن استوطنها لاحقاً. فتصور مشاهد نقل الأحجار من بناء المعابد إلى بناء المساجد لحظة دخول أهالي الجزيرة في الإسلام. وتضيف إلى ذلك بعض العادات والتقاليد مع لمسة خاصة منها، مثل إلقاء الأطفال النبتات الصغيرات التي تُزرع في سلال الخوص في البحر، للترفق بحالهم وإعادة آبائهم. وملاقاة النساء للبحر بغرض ترويضه، زجراً ورقصاً.
وفي منعطف آخر من الرواية، تتم في قصة «مهنا» إعادة رسم مشاهد المعاناة في مهنة الغوص على اللؤلؤ، وما يصاحبها من شظف، وإعياء.
لقد ضفَّرت الكاتبة روايتها بعناية من مادة التاريخ، ومواد التراث، فضلاً عن طاقة خيالية وأسطرة أسبغت على العمل أبعاداً إضافية وكأنها تسطر سفر تكوين جديد خاص بهذه اليابسة المحاطة بالماء. وتمكنت في المحصلة النهائية من تقديم رؤية بدأت مع نقطة الصفر في التاريخ حتى وصلت بحركة دائرية إلى خلق أسطورة جديدة تمثلت في انتقام الماء لنفسه، وذلك بعد الاعتداء على البحر ومحاصرته في مكانه «بحيث لا سبيل له حتى يجزر بمائه فيفرّ، ولا سبيل ليمد موجه فينتقم، أو تعود فيه الحياة» صفحة 195.
تعيد الرواية الماضي المعيش في كنف البحر والنخل، والحكايات والميثولوجيا الموثَّقة التي تداولتها ألسنة الآباء والأجداد: بودرياه، وأم السعف والليف، وأم حمار، والحوتة التي ابتلعت القمر. وتبسط الأناشيد التي لازمت مرحلة الطفولة. ولكنها لم تكتفِ بذلك، بل جعلت البطلة تأخذ بزمام الحكي وتوجهه إلى أقصى نقطة في التاريخ حتى اللحظة الراهنة، من خلال تتبع سيرة البحر والنخلة، وما يحملانه من قيمة رمزية ومادية. لتتداخل ما حملته الأجيال من عادات وتقاليد موروثة.
واختارت أن تتكئ على أساطير دلمون، من خلال ناديا البطلة والشاهدة التي سجلت على صفحة الماء، بفراته وأجاجه، حيوات متعددة لأجدادها على مر العصور. شريط ذكريات سطرها الأسلاف في علاقتهم بالبحر والعيون العذبة وحب النخيل، لتدون ذاكرة الماء وذكريات لا يمكن قراءتها إلا حين يكون دمها «نخلاوياً». دم ورثته من جدتها «نجوى» وجدها «مهنا» الذي امتهن الغوص على اللؤلؤ. لتعرض بشكل مفصّل أهوال ما يتعرض له الغاصة في رحلة «الهولو واليامال»، ولتسطر تلك المشاهد من وسط «الهيرات»، حيث تتدفق المياه العذبة والمالحة. وتدخل، من ثم، فيما يسمى في علم النفس بـ«الديجافو»، مشيرة إلى أهمية هذه الينابيع العذبة ودورها المهم لمهنة الغوص على مر العصور: «هناك ينابيع عذبة متدفقة تقع على مقربة من الجزيرة الطاهرة، هناك سر الخلود، ومكامن القوة، فامنح البحر آلهتك»، صفحة 116.
تتنقل الكاتبة إذن في روايتها بين أزمنة متفرقة، وتتلمس في هذا التجوال الإسهام المهم لينابيع المياه العذبة ودورها في استيطان الجزيرة بوصفها مقصداً مغرياً. وهو ما حدث من قبل جميع الحضارات التي تركت أثراً، كاشفة عن طقوس كل حضارة، مستعينة بخيال ميثولوجي وآخر مستمَد من ذخيرة الثقافة الشعبية «كانت الجزيرة تحوي نساء دُفِنّ تحت الرمال، وتحولن إلى عُيُون، وحين تشرب من كل عين، ستجد طعمها مختلفاً كطعم صاحبتها» صفحة 56.
وحول هذه المسألة، نلحظ التفنُّن في استنبات هذه الأساطير، مثل تقديم قرابين البنات الصغيرات كي تبتل الأرض بدموعهن ويرتوي التراب بمائهن، فتتدفق المياه ويهلل الناس فرحاً في مواسم القحط. وتعرض لوحة لفتيات يغنين لإله المطر كي تبتلّ أرضهن، ويصاحب الغناء رقص تتحرك فيها شعورهن يميناً وشمالاً. وتستحضر في سياقات أخرى الحكايات المخيفة الخاصة بالبحر، من خرافة «بودرياه» خاطف الصيادين الذي كان يعيش في العالم السفلي، إلى حكاية البحر الغدار في صورة ملك متربع على عرشه، ومن حوله ترقص النسوة ويلفحن شعورهن أمامه، لعله يعيد الغائبين، وإلى عين سمّتها «حوز»، دمجت فيها عدة أساطير معاً، فهي امرأة تخرج حين يسود الليل، تختطف الرجال والأطفال، ذات جلد يشبه الحراشف، وعين حمراء مرعبة، وشعر ذي أفاعٍ صغيرة، وقدم حيوان، دمجاً لأسطورة «ميدوزا» التي تحوِّل مَن يقع نظره عليها إلى حجر، وخرافة أم حمار، وهي من أشهر الخرافات المرتبطة بذاكرة أهل البحرين.
وسلَّطت المطوع الأضواء على الوجود المهم للنخلة بشكل موازٍ مع الماء/ البحر. فقد سنّت القوانين لحمايتها على مدى عصور، فالأرض طُوّعت لتغرس فيها جذورها، لدرجة من يقطع نخلة أو يمس سعفها يُلعن وتطارده الآلهة، لتمنحهن بذلك خلال السرد ذاكرة، ذاكرة وقوفهن على الساحل ورؤيتهن جميع الوقائع التي حدثت على هذه الأرض؛ فهن شواهد، وعمرهن يتجاوز آلاف السنوات، ولهن ذاكرة واحدة، ووجع واحد، وكل نخلة تشعر بالأخرى، وينقلن ذاكرة بعضهن إلى بعض من خلال الماء، ويُوصى سابقاً بعدم النوم على أرض لا نخلة فيها، فهن حارسات الجزيرة. «حين لم تكن الطبيعة تعترف بالتقسيمات التي وضع حدودها البشر، تتمدد الأشجار في كل الاتجاهات، جذورها في قرية وثمرها يسقط في قرية أخرى» صفحة 74.
تتقاطع «المنسيون بين ماءين» إذن بين المستقبل والماضي. وناديا البطلة تعيش حاضراً ومستقبلاً فقد اتصاله بالماء، وتعوض ذلك بحالة ولادة وانبعاث لحيوات متعددة وتجارب سابقة وذكريات بتفاصيلها، كتذكر تلك الجزيرة الصغيرة في شرق الجزيرة الأم (النبيه صالح)، التي يحذرون الجميع من مد يدهم إلى أي فاكهة تُزرَع فيها، مهما كانت رغبتهم بها كبيرة، فالبحر سيعلم وسيطالب بها، وسيقلب أي قارب يخرج من الجزيرة والفاكهة على متنه. ولترى ذاكرة الماء، تنقيباً وبحثاً، ولتسطر سيرة البحر الذي أتت الحضارة الجديدة على موجه. إلا أنه غدر بجميع من يحبونه رافضاً التوبة حتى عندما تردد له النسوة: «توب توب يا بحر». تقول الكاتبة: «عليك قراءة البحر، فلكل شيء ملامح تختلف عن ملامح البشر، ولكن عليك إجادة قراءتها، كل شيء على وجه البحر من الممكن قراءته» صفحة 26.
«المنسيون بين ماءين» رواية كُتِبت لتسطر من جديد علاقة جميع من استوطن هذه الأرض بمائه وترابه، لتعيد أمجاد اسمها المرتبط بالماءين، وتدوّن ذاكرة أديان انطلقت من معابدها، وتعيد صياغة قصة المليون نخلة على أراضيها.
تتنقل الكاتبة إذن في روايتها بين أزمنة متفرقة وتتلمس في هذا التجوال الإسهام المهم لينابيع المياه العذبة ودورها في استيطان الجزيرة