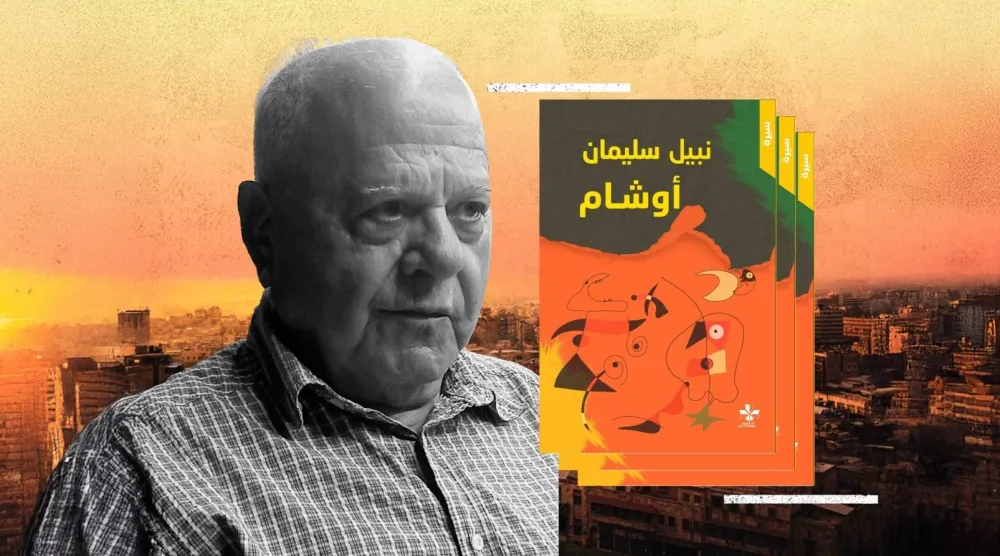في روايتها «جزء ناقص من الحكاية» تسير الكاتبة والروائية المصرية رشا عدلي على تخوم الذاكرة والتاريخ والفن البصري، لتنسج سرداً متشابكاً تتقاطع فيه الحكايات مع الصور، والهامش مع المتن، والماضي مع الحاضر. في هذا العمل لا تبحث الكاتبة عن الحكايات المكتملة، بل عمّا يتسرب منها، يهرب ويتوارى خلف الظلال، وتعيد عبره مساءلة الوجود الإنساني في لحظاته الأضعف: الفقد، والهزيمة، والغياب.
صدرت الرواية في طبعة مشتركة عن «الدار العربية للعلوم ناشرون» في بيروت، ودار«الشروق» في القاهرة، وتنهض على بناء سردي مُتعدد الأصوات، يستند إلى خمس شخصيات رئيسية، كل شخصية لها حيواتها وأحلامها وذكرياتها الشجية الخاصة، يتنقّل بينهم السرد ذهاباً وإياباً كطائر محلِّق بين زمنين: ستينيات القرن الماضي، والحاضر. بيد أن هذه الحركية الزمنية لا تفضي إلى خط سردي أحادي تقليدي، بل إلى دائرة زمنية مُفرغة، لا تُغلَق بغياب أصحابها، بل تظل مرهونة بالذكرى التي تُجدد الزمن وتُفتته إلى ومضات، وشرائح سردية تشبه شرائح الكولاج في اللوحة. بهذه الطريقة تطرح الرواية قراءة لمفهوم الزمن بوصفه كياناً يتراوح بين الحكائية والمراوغة، وبينهما يتم إعادة تشكيل الواقع، والإطلالة عليه من نافذة أخرى، أو بمعنى آخر من نافذة زمنها الخاص، أو كما وصفته الناقدة الأميركية الراحلة سوزان سونتاغ بأنه «فن امتلاك العالم».
بنية الصورة
تقع الرواية في 441 صفحة من القطع المتوسط، وتشتق من مفردات عالم الفوتوغرافيا بنيتها السردية الخاصة، فتقسّم الفصول إلى «لقطات»، وتُراهن الكاتبة على لغة مكثفة في مقاربة لزمن اللقطة، أو زمن «الومضة» الهارِب الذي يُشبه كما توحي عناوين القصص أو اللقطات: «رفرفة طائر، وخطوة امرأة، وابتسامة طفل، ودمعة فارة» كما يصفه العمل.
لا تبدو اللقطة بهذا التكثيف مجرد تقنية سردية أو عنصر جمالي، بل معادل ومدخل للحكايات التي لم تُروَ، وتنطلق الرواية من قاعة عرض فني مُكتظة بالحضور في نيويورك، حيث يُعرض بها أرشيف فوتوغرافيا المُصورة الأميركية الراحلة فيفيان ماير، التي لم تعرف الشهرة في حياتها، لكنها أصبحت بعد وفاتها واحدة من أهم مصوري الشوارع في القرن العشرين، ومن خلال صورة تظهر بها ماير على متن قارب شراعي بصحبة رجل مجهول، تنفتح الرواية على القاهرة في عام 1967، لتقودنا إلى علاقتها بهذا الرجل «سيف القرنفلي»، الضابط المصري الذي قادته الهزيمة العسكرية في «النكسة» إلى هزائم نفسية عميقة تُعيد الرواية عبرها طرح أسئلة عن الفقد، ومعنى الخسارات.
تمنح رشا عدلي المصوّرة فيفيان ماير حضوراً تخييلياً لافتاً، وصوتاً روائياً بضمير المتكلم. وتستفيد الرواية من محطات غامضة ومثيرة في سيرة ماير الذاتية، مثل تنقّلها بين العواصم، وتعدد أسمائها، واتهامها بالجاسوسية، لتقترب من عالمها النفسي والإنساني، من خلال تتبّع موضوعات صورها، وزوايا التقاطها، وما تعكسه من رؤيتها للعالم ولنفسها: «مأوى المشردين كان بالنسبة إليّ الأكاديمية الحقيقية لدراسة فن التصوير. فلو لم أقم في ذلك المأوى ما تبدلّت نظرتي إلى الحياة والعالم من حولي، ولخرجت ألتقط الصور للوجوه المبتسمة، وللشمس وهي تشرق، وللقمر وهو مضيء، كأي فنان عادي لا يبحث عما وراء الأشياء» كما تقول ماير عن نفسها في الرواية.
انعكاسات المرايا
يتقاطع حضور فيفيان ماير مع ثلاث شخصيات نسائية في الرواية «روان، وكوليت، وناريمان،» لُيشكل هذا التقاطع النسيج السردي للعمل؛ «روان» الباحثة التي تنغمس في مشروع علمي عن العالم الفوتوغرافي لفيفيان ماير، فتقودنا إلى إعادة النظر في كل صورة التقطتها الأخيرة، ويتحوّل تتبعها لعالمها الفوتوغرافي إلى شغف واسع بشخصيتها المختبئة وراء الصور، تقول روان عنها: «لم تُحاول أن تُجمّل شكلها كما تفعل النساء عند التقاط الصور، ولم تحاول أن تبتسم. بل كانت تلتقط انعكاس صورها على المرايا، وعلى زجاج الأبواب والنوافذ، وعلى المعدن المحيط بإطارات السيارات. كانت تلتقط انعكاس ظلها الطويل في الطرقات فتبدو شبحاً يرتدي قبعة».
أما كوليت، فلا تحضر في الرواية كشخصية مُكتملة، بل تظهر كطيف، ولغز يتردد صداه عبر صورة عابرة التقطتها لها عدسة فيفيان ماير في لحظة مصيرية؛ بعد هروبها من بيتها وعائلتها. تتحوّل هذه الصورة إلى الخيط الوحيد الذي يربط عائلتها بها، ويغدو غيابها سؤالاً مُعلّقاً يمتد على مدار السرد.
لا تُروى حكاية كوليت بشكل مباشر أو مُتسلسل، بل تتشظى كما تتشظى «اللقطة» نفسها، فتغدو استعارة عن «اللقطة الناقصة»، وعن كل ما لا يقوله «الكادر»، الذي يسعى إلى تثبيت اللحظة زمنياً بملامحها وهواجسها، بصرف النظر عمّا يتخفى في هذه الملامح، وما يكمن وراءها. من هنا، يتقاطع حضور كوليت مع فيفيان ماير لا فقط لأن كلتيهما على هامش الصورة، بل لأنهما أيضاً تهربان من الظهور الكامل، وتكتفيان بما تقوله الظلال، حيث الحضور الخافت يكشف أكثر مما يخفي.
وفي زمن آخر، وفي مواجهة يخلقها العمل مع زمن الصورة الرقمي، تظهر شخصية «ناريمان القرنفلي»، امرأة عادية في منتصف العمر، تتبدّل حياتها على وقع إحباط عائلي كبير، فبعدما كانت امرأة خجولة تُقصي وجهها عن عدسة الكاميرا، تقودها صدفة لتجد نفسها ضمن عالم «المؤثرات» على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط هوس كبير بعدد الإعجابات وعدّادات المشاهدة.
تستثمر الرواية هذا التحوّل لتطرح سؤالاً عن التسليع، وصناعة الصورة، وكيف يُعاد تشكيل الهوية داخل فضاء رقمي لا يحتمل الغياب، ولا يقبل ما لا يُرى، وهنا تظهر المفارقة بين زمن فيفيان ماير، حيث كانت الصورة انعكاساً ذاتياً، وزمن ناريمان، حيث تتحوّل الصورة إلى قناع يُخفي الأصل أكثر مما يكشفه.
في الختام، لا تراهن رشا عدلي في الرواية على تقديم حكاية مكتملة، بل يبدو النقص ذاته هو جوهر السرد، فلا تكتمل الصوة إلا بظِل ما لا يظهر فيها، وتستثمر الكاتبة السيرة الذاتية الغامضة لفيفيان ماير لتنسج منها عالماً روائياً تحضر فيه الصورة بوصفها فضاءً حيّاً، لا يرنو لتجميد اللحظة، بل لاستعادتها، ومُحاورتها، وربما تحريرها مما فاتها. ففي عالم ماير، كما في عالم الرواية، لا تُروى كل الحكاية، وإنما يُلمّح لها، وربما في هذا النقص يكمن جمالها.