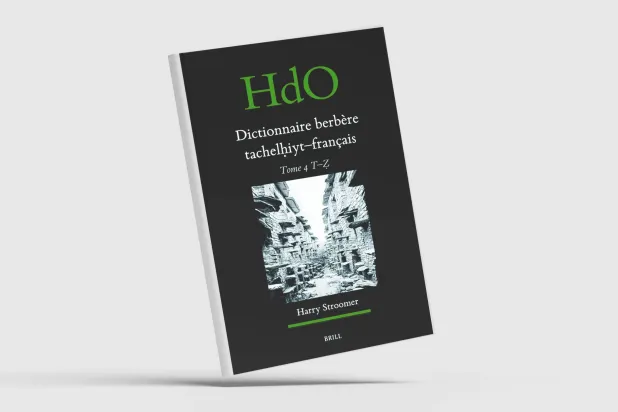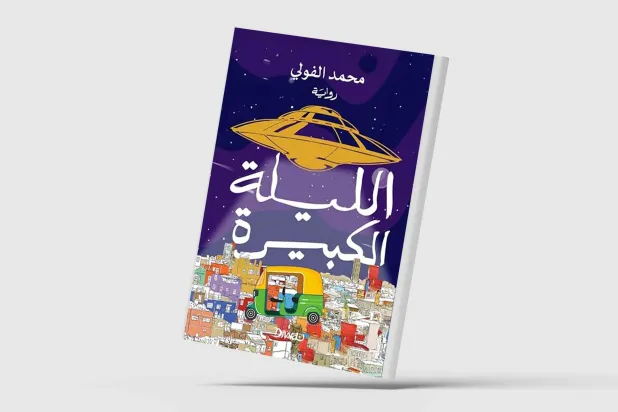صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب «دراسات في ثورة التحرير الجزائرية» (1954 - 1962). وهو مؤلف جماعي يضم مقدمة وخمسة عشر فصلاً لخمسة عشر باحثاً أكاديميّاً عربياً من اختصاصات متنوعة، منها التاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة والاقتصاد والأنثروبولوجيا، فضلاً عن ملاحظات ختامية.
ويحاول الكتاب تقديم قراءة جديدة للثورة الجزائرية تلقي الضوء على موضوعات لا تزال مطموسة المعالم في تجربة ثورية قلَّ نظيرها، وشكَّلت منعطفاً تاريخياً لا في تاريخ الجزائر المعاصر فحسب، بل في المنطقة العربية برمتها.
فالثورةُ الجزائرية لا تقلّ أهميةً عن الثورات العالمية الكبرى، لكنّ إجحافاً متعمَّداً لحقها من الكتّاب والمؤرخين الفرنسيين، تمثَّلَ في فصلها عن تاريخ الجزائر الأشمل وعَدِّها «أحداثاً»، أو «حرباً» تجري من خلالها المساواة بين الضحية والجلّاد، متجاهلين بُعدَها التحرري. وفي ذكرى انتصار الثورة الجزائرية الستين، نظم المركز العربي للأبحاث مؤتمراً علمياً عربياً جامعاً، بعنوان «الثورة الجزائرية في ذكرى انتصارها الستين: إعادة قراءة لمسارها، ومكانتها، وما تراكم من سرديات عنها» (عُقد في 28 و29 مايو/ أيار 2022)؛ وجُمعت وحُررت أبرز أوراق المشاركين في هذا المؤتمر، وأضيفت إليها فصول أخرى محكّمة. وتولّى المؤرخان الجزائريان نصر الدين سعيدوني وفاطمة الزهراء قشي تحرير الكتاب تحريراً علمياً.
وأجمع المساهمون على أن الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي (1954 - 1962) مثلت حدثاً رئيساً في تفكيك المشروع الاستعماري في الشرق والغرب، فتجربتها النضالية ضد الهيمنة الاستعمارية الممتدة منذ القرن التاسع عشر كرَّست قطيعة مع أساليب النضال السابقة؛ إذ جعلت هدفها الاستقلال التام، اعتماداً على طلائع ثورية مصممة على إنهاء الواقع الاستعماري مهما بلغت التضحيات، مع قلة الوسائل المادية واختلال موازين القوى.
ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام. يناقش القسم الأول فلسفة الثورة الجزائرية وبعدها الآيديولوجي. وهو يتعلق بالأبعاد الفكرية والمفهومية والفلسفية والجانب التنظيري لأحداث هذه الثورة وحيثياتها، ويندرج ضمن محاولات تفسير طبيعتها، من خلال طرق موضوعات كانت ولا تزال محل تجاذب بين رؤية الجزائريين للثورة الجزائرية وتقييم الآخرين لها ونظرتهم إليها. ويتضمن هذا القسم ثلاثة فصول: «الثورة الجزائرية من منظور الفلسفة الاجتماعية» للزواوي بغورة، و«مؤتمر الصومام: بين البعد الآيديولوجي والرؤية الاستراتيجية» لناصر الدين سعيدوني، و«الثورة الجزائرية: نشأة نقد الاستشراق وميلاد صراع الحضارات» لياسر درويش جزائرلي.
بعد ذلك، يناقش القسم الثاني موضوع الثورة الجزائرية في الروايات الشفوية والتقارير والكتابات التاريخية؛ إذ يهتم بالجانب التوثيقي في هذه الثورة وبأدبياتها وسردياتها، من خلال الروايات المحلية أو الكتابات الأجنبية أو التقارير الدبلوماسية. ويشتمل هذا القسم على خمسة فصول: «من الذاكرة إلى التاريخ: قراءة في عيّنات من الأبحاث التاريخية في الجزائر» لفاطمة الزهراء قشي، و«الثورة الجزائرية بين القطيعة والتواصل: قراءة في شهادات بعض الفاعلين ومذكراتهم» لأحمد صاري، و«الثورة الجزائرية في اللسان الشعري النسوي في الولاية الثالثة (1954 - 1962)» ليسمينة سعودي، و«إشكالية التأريخ لحرب الجزائر وذاكرتها في فرنسا» لمسعود ديلمي، و«حرب التحرير الجزائرية في التقارير الدبلوماسية والكتابات الأكاديمية الأميركية» لمحمد مزيان.
أما القسم الثالث فيضمّ فصولاً تخص مجالات تفاعل الثورة الجزائرية وتأثيرها في محيطَيها القريب والبعيد، وكلّها تبرز قدرة هذه الثورة على التحكم في معطيات هذا المحيط، وكسب التأييد الدولي، خصوصاً تأييد البلدان المغاربية والعربية، واستمالة القوى العظمى، وكذلك العمل على نقل الثورة إلى ديار المستعمر واستغلال تناقضات المجتمع الفرنسي في فرنسا واستغلالها في الضغط على الحكومة الفرنسية، كما حدث بعد مسيرات 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961. ويضم هذا القسم خمسة فصول، هي: «مظاهرات أكتوبر 1961 وتطور الموقف الفرنسي: من الإنكار إلى الاعتراف» لخالد منّه، و«فرق المهاري الصحراوية في ثورة التحرير: رهان فرنسي لفصل صحراء الجزائر عن شمالها» لأحمد بوسعيد، و«تفاعل الثورة الجزائرية مع محيطها المغاربي (1954 – 1958)» لجمال برجي، و«تفاعل النخب الليبية مع الثورة الجزائرية» لصالح أبو الخير، و«تفاعل فدائيي فلسطين مع الثورة الجزائرية (1954 - 1962)» لبلال محمد شلش.
أخيراً، يتناول القسم الرابع إشكاليات العلاقة بين السياسي والعسكري قُبيْل الثورة الجزائرية وبُعيْدها، أي خلال السنوات التي قادت إلى تفجير الثورة، والتي شهدت تجاذبات بين تيارَي العمل المسلح والعمل السياسي ضمن الحركة الوطنية الجزائرية، وخلال السنوات التي تلت الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي وتأسيس الدولة الجزائرية. ويضم هذا القسم فصلين: «تحوُّل الكفاح الجزائري من النضال السياسي إلى العمل المسلح (1939 - 1954)» لرشيد ولد بوسيافة، و«أزمة صيف 1962: مؤسسات جبهة التحرير الوطني واتفاقيات إيفيان» لعمار محند عامر.
وتقدم خاتمة الكتاب جملة من التأملات بشأن آفاق البحث التاريخي، العابر لاختصاصات العلوم الاجتماعية، في الثورة الجزائرية في ذكرى انتصارها الستين. ويبرز فيها سعيدوني أن موضوعات الكتاب، في مجملها، تظهر تنوع الإشكاليات المتعلقة بهذه الثورة وتشعبها، وغنى المقاربات والمنهجيات. فدراسة أحداث الثورة تمثل فضاءً بحثياً واسعاً لا يزال في حاجة إلى جهود المؤرخين خصوصاً والباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية عموماً، بخاصة بعد مرور أكثر من ستين عاماً على انتهائها وتوافر المدى الزمني الكافي الذي يتيح للباحثين من الأجيال التي لم تعش أحداثها تناول مواضيعها بمنهجية علمية مجدّدة بعيداً عن الخطاب الحماسي والتسييس، لتقدم وجهة النظر الجزائرية الوطنية الأصيلة، وتخلق نوعاً من التوازن بين الإنتاج الأكاديمي في ضفتَي المتوسط كماً ونوعاً؛ إذ لا تزال الكفّة حتى الآن لفائدة الضفة الشمالية.
يقع الكتاب في 528 صفحة، شاملةً ببليوغرافيا وفهرساً عامّاً.