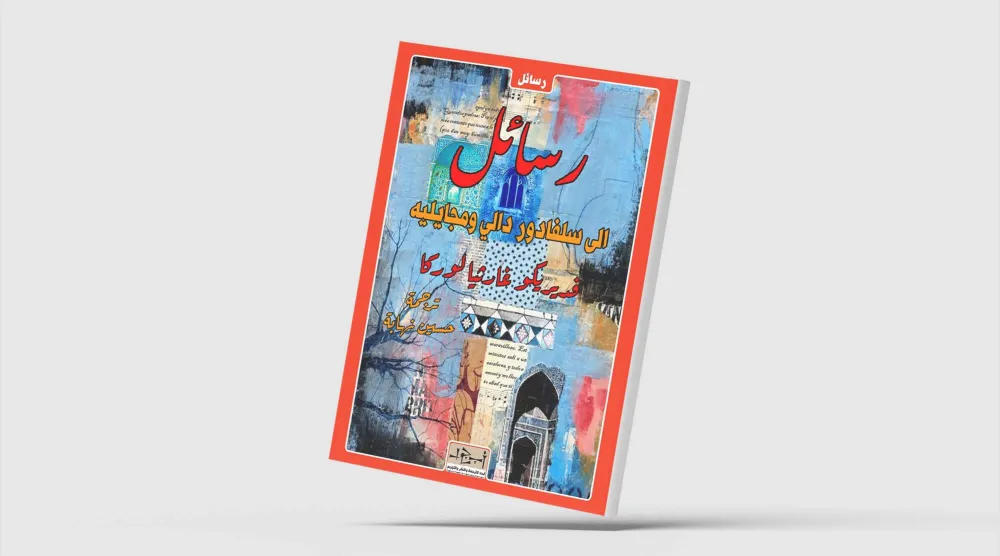يُعتبر الفيلسوف أندريه كونت سبونفيل أحد فلاسفة فرنسا الكبار حالياً. وقد كان أستاذاً في السوربون ومحاضراً لامعاً في أهم الجامعات الأوروبية والعالمية. وبعض كتبه حظيت بنجاح شعبي كبير في المكتبات الفرنسية. وهذا شيء مدهش لأن كتب الفلسفة عويصة عادة ولا تباع إلا للنخبة. وهو يرى أن الحضارات والثقافات لا تتساوى فيما بينها، وأن حضارة ما قد تكون متفوقة في فترة ما ثم تصبح مسبوقة ومتأخرة في فترة لاحقة أو العكس. الحضارات دوارة لا تدوم لأحد. من سره زمن ساءته أزمان... وأكبر دليل على ذلك الحضارة العربية الإسلامية. فقد كانت متفوقة على جميع الحضارات البشرية بين القرنين الثامن والثاني عشر للميلاد. كان ذلك إبان العصر الذهبي المجيد. كانت بغداد آنذاك العاصمة الثقافية للعالم. كانت تشع بأنوارها على الكرة الأرضية بأسرها. وكانت غرناطة وقرطبة عاصمتي الأنوار والتسامح والإبداع وسط أوروبا الظلامية المتعصبة. كان ذلك أيام الخليفة الأموي الكبير عبد الرحمن الثالث وابنه الحكم الثاني. كانت مكتبة قرطبة آنذاك تضم ما لا يقل عن أربعمائة ألف كتاب. هكذا كانت قرطبة الحضارية الأنوارية. أين منها باريس أو لندن أو أكسفورد الغارقات في ظلام عميق؟
عندما يقول أندريه كونت سبونفيل هذا الكلام هل يعني ذلك أنه يكره المسيحية دين آبائه وأجداده؟ هل يريد أن يبخسها حقها أو يزدريها؟ أبداً لا. فهي أحد الأديان الكبرى للبشرية بالإضافة إلى الإسلام. إنه فقط يعترف بالحقيقة التاريخية، الحقيقة الموضوعية. العالم الإسلامي آنذاك كان متفوقاً على العالم المسيحي. ولكن الآن دارت الدوائر علينا نحن العرب والمسلمين وما عدنا مركز الحضارة العالمية. هيهات! لقد حلت محلنا تلميذتنا السابقة: أوروبا. لقد أصبحت مركز الفلسفة والعلم والإشعاع الحضاري منذ القرن السادس عشر وحتى اليوم. وهكذا أصبح المتخلف متقدماً والمتقدم متخلفاً. ثم يضيف الفيلسوف الفرنسي قائلاً:
«الآن أصبح العالم العربي والإسلامي كله مرتعاً لحركات التطرف والظلام والتعصب الديني الأعمى. لقد ابتلي بها ابتلاءً شديداً مثلما ابتلينا بها نحن سابقاً أيام محاكم التفتيش وفتاوى التكفير اللاهوتية الكهنوتية التي تذبح الناس بالملايين. كما وابتلينا بالحروب المذهبية الكاثوليكية - البروتستانتية المدمرة. أما هم فيكتوون بحر نارها حالياً في عز القرن الحادي والعشرين! وهذه هي مسافة التفاوت التاريخي بيننا وبين المسلمين: أربعة قرون فيما يخص الطائفية وحل المشكلة الدينية. ولا يتوقع أن يخرج العالم العربي من هذا المغطس الرهيب في المدى المنظور. هذه مشكلة خطيرة، مشكلة عويصة، مشكلة أجيال». ثم يتساءل الفيلسوف الفرنسي قائلاً: هل إسلام العصر الذهبي البغدادي - الأندلسي هو ذاته إسلام بن لادن والملا عمر والزرقاوي والخليفة المشؤوم الخنفشاري البغدادي و(داعش) و(القاعدة) و(جبهة النصرة) و(الطالبان) وعشرات التنظيمات الأخرى التي فرختها عصور الظلام؟ والجواب: أبداً لا. ولا ننسى أحفادهم الحاليين الذين يبثون أشرطة نارية مصورة يهددون فيها حكوماتهم وشعوبهم العربية ويريدون إعادتها قروناً إلى الوراء باسم ثورات رجعية، قروسطية، متخلفة. ولذا نقول ما يلي: ينبغي الاعتراف بأن العصور الوسطى لا تزال متغلبة على العصور الحديثة عندنا على عكس أوروبا التي خرجت كلياً من العصور الوسطى. ولكن شعوبنا الطيبة الفقيرة الجائعة لا تزال غارقة فيها. أنا شخصياً نتاج العصور الوسطى. والدي كان شيخاً ظلامياً مكفهراً يرعب العالم كله (بين قوسين: ما عدا امرأته التي كانت ترعبه!).
يقول لنا الفيلسوف أندريه كونت سبونفيل في آخر مقابلة له مع مجلة «الإكسبريس» الباريسية ما فحواه:
«أعترف بأني خائف من الأصولية الإسلامية حالياً. خائف من رعبها وتكفيراتها وتفجيراتها. هذا لا يعني نسيان المتطرفين الإنجيليين في أميركا أو المتطرفين الهندوسيين في الهند. أنا ضد كل الأصوليات والأصوليين دفعة واحدة. ولكن ينبغي الاعتراف بأن الأصوليين الإسلاميين هم الأكثر عنفاً وترويعاً في هذه اللحظة بالذات. وهم الذين يفجرون العالم منذ 11 سبتمبر بل وحتى قبلها. من المعلوم أن فولتير حارب بكل قوة محاكم التفتيش الكاثوليكية التي كانت سائدة في عصره على الرغم من أنه كان كاثوليكياً أباً عن جد. وهذا من أعجب العجب. فلم يكن يعاني شخصياً من أي تمييز طائفي لأنه ينتمي إلى مذهب الأغلبية الراسخة. ومع ذلك فقد تحداها ووقف في وجه هيمنتها الساحقة وتكفيرها للآخرين وقمعهم واضطهادهم. لنتفق على الأمور هنا: من السهل جداً أن تهاجم طوائف الآخرين، وبخاصة إذا كانوا أقليات ولكن من أصعب الصعب أن تدخل في صدام مباشر مع طائفتك الخاصة بالذات، بخاصة إذا كانت هي طائفة الأكثرية المهيمنة تاريخياً والواثقة من شرعيتها أو مشروعيتها. هنا تكمن عظمة فولتير».
ثم يردف أندريه كونت سبونفيل قائلاً:
«أنا مع الأنوار، مع التقدم، مع المفهوم العقلاني الحديث للدين والتدين. وهو مفهوم يؤمن لك الحرية الدينية بشكل كامل: أي أن تتدين أو لا تتدين على الإطلاق، ومع ذلك تبقى مواطناً لك كافة الحقوق وعليك كافة الواجبات. أنا لا أراقب جاري فيما إذا كان يذهب إلى الكنيسة يوم الأحد أم لا ولا أحاسبه على ذلك. هذا ليس شأني. ولكني أحاسبه إذا ما غش أو سرق أو اعتدى على حقوق الناس. أحاسبه إذا ما أخل بعمله كطبيب أو كمعلم أو كمهندس أو حتى كرئيس جمهورية!». ثم يضيف: «أنا ضد الطائفية وضد العنصرية وضد التعصب الديني الأعمى الذي يجتاح بعض مناطق العالم الإسلامي حالياً. وبالتالي فلا أستطيع أن أقول بأن كل الحضارات تتساوى. الحضارة التي تضمن احترام حقوق الإنسان وكرامته وعدم التمييز بين المواطنين على أساس طائفي أو عنصري هي الحضارة الحقيقية ذات النزعة الإنسانية. وهي الآن الحضارة الأوروبية أو الغربية بشكل عام. والحضارة التي لا تؤمنها ليست حضارة. لماذا نقول ذلك؟ لأننا في أوروبا انتقلنا من عصر الظلامية الدينية إلى عصر الأنوار الدينية والعلمية والفلسفية. ما عدنا نفهم الدين بطريقة تكفيرية طائفية كما كان يفعل أجدادنا في العصور الوسطى. في الماضي كنا نذبح بعضنا بعضاً على الهوية: هذا كاثوليكي وهذا بروتستانتي لا يطيقان بعضهما بعضاً. بل ولا يستطيعان أن يعيشا في ذات الحي أو حتى في ذات الشارع. كانت أحياء الكاثوليكيين منفصلة كلياً عن أحياء البروتستانتيين. والآن انحسر كل هذا التعصب الأعمى ولم يعد له أي وجود في فرنسا أو إنجلترا أو ألمانيا أو هولندا أو بقية أوروبا المتحضرة التي تعامل كل مواطنيها على قدم المساواة أياً تكن أديانهم ومذاهبهم. الدين لله والوطن للجميع. لهذا السبب تفوقت أوروبا على العالم العربي الإسلامي الذي لا يزال يتخبط في صراعاته الطائفية والمذهبية والذي لا يزال يشتمل على شرائح واسعة من المتعصبين الدمويين».
ثم يضيف أندريه كونت سبونفيل قائلاً:
«لقد انتقلنا في أوروبا من عصر محاكم التفتيش والحروب الصليبية والمجازر الطائفية إلى عصر حقوق الإنسان والمواطن ودحر الطائفية التي كانت تمزقنا... لقد انتقلنا من مجازر سانت بارتيلمي ضد الأقلية البروتستانتية التي كان قادة الأصولية الكاثولكية يكفرونها ويزندقونها ويبيحون دمها إلى عصر الأنوار والتسامح والمواطنة الحقة التي تشمل الجميع على قدم المساواة ودون أي تمييز على أساس طائفي أو مذهبي. هل هذا قليل؟»، ونحن نجيبه: هذا كثير بل وأكثر من كثير. هنيئاً لكم. نحن نحسدكم على كل هذا التقدم والتطور والاستنارة. ولكن هنا نحب أن نطرح على الفيلسوف الفرنسي هذا السؤال:
هل استطعتم تحقيق ذلك بسهولة ويسر يا ترى؟ هل استطعتم القضاء على الطائفية والمذهبية بين عشية وضحاها؟ هل استطعتم تحقيق الوحدة الوطنية برمشة عين؟ أم أن ذلك استغرق منكم ثلاثة قرون أو حتى أربعة: منذ القرن السادس عشر وحتى العشرين؟ فلماذا تطالبون العالم العربي أو الإسلامي كله بأن يحقق ذلك في ظرف سنوات معدودات؟ مستحيل. إنه لا يستطيع يا سيدي. إنه لا يستطيع. هذا فوق طاقته وإمكاناته في الوقت الحاضر. بالطبع لن ننتظر ثلاثة أو أربعة قرون لكي نحل المشكلة الطائفية والمذهبية ونحقق الوحدة الوطنية الحقيقية التي تشمل جميع المكونات على قدم المساواة. ولكننا لن نستطيع تحقيق هذا الهدف الغالي المنشود بالسرعة المرجوة. أعطيكم موعداً بعد عشرين أو ثلاثين سنة قادمة!
ثم يقول لنا أندريه كونت سبونفيل هذه الفكرة الجوهرية التي فاجأتنا وأسعدتنا:
«أشعر بالتقارب مع المسلم الحداثي المستنير أكثر من التقارب مع الفرنسي العنصري المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف على الرغم من أني فرنسي مثله. ولكن لا أطيق آيديولوجيا التمييز العنصري التي يعتنقها. وهناك مثقفون عرب كثيرون من أمثالي لا يطيقون الآيديولوجيا الأصولية الدموية لأتباع الدواعش والقواعد».
ثم يختتم أخيراً بهذه الفكرة:
كما أن فولتير هزم الأصولية المسيحية في نسختها الكاثوليكية التي كانت ترعب عصره، فإننا سوف نهزم الأصولية الداعشية التي ترعب عصرنا. هذه حقيقة مؤكدة. ولكن متى سيحصل ذلك؟ الله أعلم. سوف يستغرق بعض الوقت. في النهاية لا يصح إلا الصحيح. وبالتالي فمعركة الأنوار التي دشنها فولتير في القرن الثامن عشر لا تزال مستمرة حتى الآن. ولهذا السبب هرع الناس إلى المكتبات لشراء مؤلفاته بعد أن ضرب «داعش» في قلب باريس!