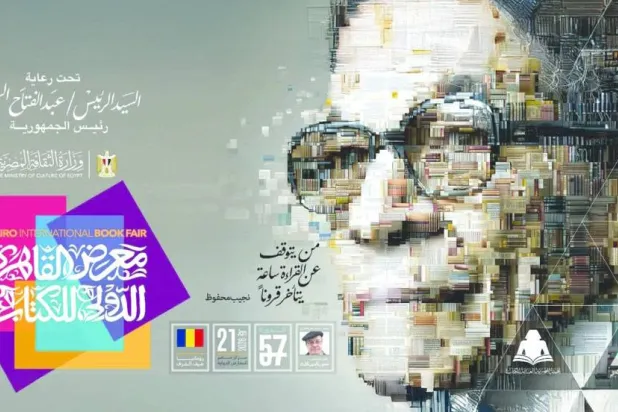ما من شك في أن الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرَّض لها لبنان في السنوات الأخيرة، غير مسبوقة في تاريخ البلاد. لا بل هي حسب البنك الدولي واحدة من أسوأ الأزمات، التي شهدها العالم، منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا. ومع أن لبنان كان يُفاخر بأنه يفي دائماً بالتزاماته، إلا أنه قرر، إثر هذه المحنة الاستثنائية، وللمرة الأولى في تاريخه، أن يعلّق دفع ديونه، مما أثار جدلاً واسعاً في البلاد، بين مؤيد ومعارض. لكن الواقع فرض نفسه، ودخل لبنان في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأيضاً وسط أخذ وردّ، وفي سابقة، قدّم لبنان خطّة تعافٍ اقتصادي ومالي شاملة، حملت اسم «خطّة لازارد»، كما وقّع لبنان عقد تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.
خلال هذه الفترة الحرجة، وقعت على كاهل وزير المالية د. غازي وزني، مهمة وضع خطة لإنقاذ لبنان. عشرون شهراً قضاها وزني في حكومة د. حسّان دياب التي واجهت صعوبات لا تُحسد عليها، ومعارضات بالجملة، طغى فيها السياسي على النظرة العلمية، والأفكار المسبقة على مصلحة البلاد والعباد.
وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على استقالة حكومة د. حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، ها هو د. وزني يسجل بلغة هادئة، تجربته المالية والشخصية، ويضع النقاط على الحروف، في كتاب صدر حديثاً عن «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» تحت عنوان «الانهيار المالي في لبنان تجربة ووقائع». يروي المؤلّف ما حدث في مرحلة «كانت حافلة بالأحداث والتطوّرات والوقائع، سيبقى لبنان نموذجاً لدراسة يمكن أن تستفيد منها المؤسّسات الماليّة، العربيّة والدوليّة عبر المقاربات التي طُرحت ومعوّقاتها».
لكن ليس ذلك فحسب. فهذا الكتاب، هو أيضاً يأتي دفاعاً رصيناً، في وجه الاتهامات التي رُميت بها حكومة حسان دياب، إذ حُمّلت مسؤولية انهيار يُرينا الكتاب أنه كان يختمر لثلاثة عقود قبل مجيئها، وأنها سعت جهدها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكنَّ الموجة المعاكسة كانت عاتية، ويصعب صدّها.
وهو يشرح بشكل وافٍ للراغبين في الأسباب التي أدت إلى فشل معالجة الأزمة المالية اللبنانية، التي انفجرت عام 2019 عندما تعثر القطاع المصرفي وانهار سعر صرف الليرة اللبنانية، حتى إنها خسرت في نهاية المطاف نحو 90 في المائة من قيمتها. وكانت المديونية قد بلغت حداً قياسياً، بعد أن راكم لبنان مصاريف وهدراً، وسوء إدارة، انتهت به إلى انهيار اقتصادي شامل. وإثر الأنباء المتوالية عن سوء الوضع، تهافت المودعون على البنوك يريدون سحب أموالهم، أو مطالبين بتحويلها إلى الخارج. وازداد الأمر سوءاً حين بدأت المصارف ترفض الاستجابة لطلبات المواطنين، فأخذوا يشترون الدولار الأميركي متخلصين من الليرة اللبنانية، واحتفظوا بما وصل إلى أيديهم في بيوتهم.
في المقابل عجزت الدولة عن إيجاد حلول أو إجابات شافية. وتصاعد السخط على الطبقة السياسية، واستقالت حكومة سعد الحريري حينها. وفي محاولة لإرضاء الشارع جرى اختيار حسان دياب لتشكيل حكومة جديدة، جاءت بوزراء تكنوقراط لكنهم محسوبون على القوى السياسية، حيث تولى فيها د. غازي وزني عبء وزارة المالية، وكان من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري. مهمة استمرت عشرين شهراً وضع خلالها خطة متكاملة للخروج من النفق الأسود، لكنه اصطدم بالخلافات السياسية، واعتراضات الأحزاب والقوى الاقتصادية ذات السلطة والنفوذ. وبعد أن خرج من الوزارة، عكف على بدء كتابة تجربته ويقول: «أجزم بأن سرد التجربة مفيد للمؤسسات المالية الدولية، وللأسواق المالية العالمية، وللمجتمع الدولي... لأنها تتيح لها تقييم حجم الأزمات التي ألمَّت بلبنان والحكم على طرائق المعالجة التي طرحتها الحكومة».
ويخصص الكاتب صفحات لمسألة «الكابيتال كونترول»، وهي الإجراءات الفورية التي كان يفترض أن تُتخذ لضبط السحوبات والتحويلات وتنظيم عمليات الاستيراد، وطمأنة الأسواق والحد من الانهيار المالي، في حينه. وهذا ما فعلته دول عصفت بها أزمات مشابهة لما حدث في لبنان، مثل قبرص واليونان.
لكنّ القوى السياسية اللبنانية منعت الحكومة من اتخاذ هذه الإجراءات. يقول الكتاب إن «حكومة سعد الحريري هربت من مسؤوليتها التاريخية، وأنكرت حجم الأزمة، وتلهّت بخلافاتها السياسية، كأن شيئاً لم يكن، وراحت تُطمئن الناس إلى الوضعين المالي والنقدي، دون الاستناد إلى الواقع، ثم تركت المودعين لمصيرهم المجهول».
ومصرف لبنان أيضاً فعل الشيء نفسه حين ادّعى أن «الوضع تحت السيطرة».
يذكّر الكتاب بأن المصارف أغلقت أبوابها 14 يوماً من 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ولغاية الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وحاولت التنسيق مع السلطة لوضع خطوات قانونية دون جدوى، فاتخذت إجراءات من تلقاء نفسها، فقيَّدت السحوبات ومنعت التحويلات، بشكل استنسابي، وهو ما زاد من الفوضى.
ويشرح د. وزني بالتفصيل كيف عارضت القوى السياسية «الكابيتال كونترول»، بينهم، بل على رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن زاره رئيس جمعية المصارف سليم صفير، إذ رأى بري أنه أمر يُلحق الضرر بالمودعين لا سيما صغارهم، وأنه مخالف للدستور.
وكذلك رفض حزب «القوات اللبنانية» المشروع وعدَّه غير مفيد، ولم يصدر عن «تيار المستقبل» أو «حزب الله» موقف واضح، كذلك لم يعبّر جبران باسيل، رئيس «التيار الوطني الحر»، عن رأي واضح.
ويلفت الكاتب إلى أن النائب الوحيد الذي عبَّر عن رأيه صراحةً مؤيداً قانون «الكابيتال كونترول» هو النائب ياسين جابر، على أن يكون ذلك ضمن خطة شاملة. «ذلك لأنه يعد بين الأقرب إلى الفهم الاقتصادي والمالي، وهو مطَّلع على تجارب بلدان أخرى».
وبالتالي بقي الوضع المالي يراوح مكانه، ولم تتمكن حكومة دياب من تنفيذ ما سعت إليه، ثم رحلت وبقي لبنان في ضياع البحث عن حلول ولا يزال.
اتُّهمت هذه الحكومة بالكثير، منها أنها أساءت إلى سمعة لبنان حين قررت عدم سداد الديون. وأُلقيت عليها مسؤوليات كان يفترض أن يُسأل عنها آخرون. وعن هذا يقول الكاتب الكثير. رأيه أن قرار التخلف عن السداد ليس المسؤول عن الأزمات التي انفجرت نهاية عام 2019، وليس هو سبب وقف التدفقات المالية وفقدان الثقة بالقطاع العام، كما يدّعي البعض، وليس هو سبب انهيار الليرة، والكساد الاقتصادي، وعدم قدرة الدولة على اللجوء إلى الأسواق المالية العالمية... وذلك على عكس ما صرح ّ ويصرح به عدد من المسؤولين السياسيين والماليين والمصرفيين والخبراء، الذين يُحمّلون تلك الحكومة التداعيات، للهروب من مسؤولياتهم.
وفي الكتاب استعراض لتفاصيل كاملة، بالأسماء والتواريخ وتسلسل الأحداث، يفيد بأن الأزمة كانت مستفحلة ومتفجرة ومتدحرجة التداعيات الخطرة قبل تشكيل حكومة حسان دياب.
وبالتالي فإن «ما اتُّخذ من قرارات بعد تشكيل الحكومة، لا سيما التخلف عن السداد، كان صائباً لو نُفِّذ كما يجب، مستنداً إلى خطة التعافي المالي والاقتصادي، وإلى التفاوض مع الدائنين، وإلى إقرار (الكابيتال كونترول)، وغير الصائب هو ما تعرضت له الحكومة وخططها من ضربات من جهات صديقة وغير صديقة أدت إلى ما أدت إليه في عام 2020 وما تلاه».
الكتاب هو مرجع قيّم لفهم الأزمة المالية اللبنانية؛ مسبّباتها، ونتائجها الكارثية، وفيه تقييم لخطط الإصلاح الاقتصادي التي طُرحت في السنوات الأخيرة لإنقاذ الوضع. وموقف المجتمع الدولي وصندوق النقد، والدور الذي لعبته المصارف اللبنانية، وخسائر المودعين وضياع جنى أعمارهم. يقدم الكتاب توصيات مستقبلية للحلول وتوجهات السياسة الاقتصادية التي يمكنها أن تساعد في تجاوز الأزمة.