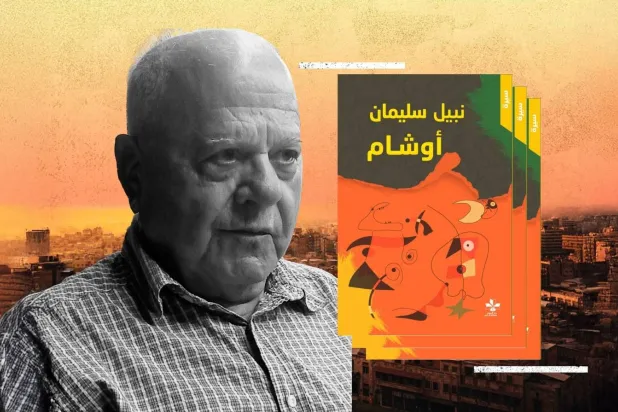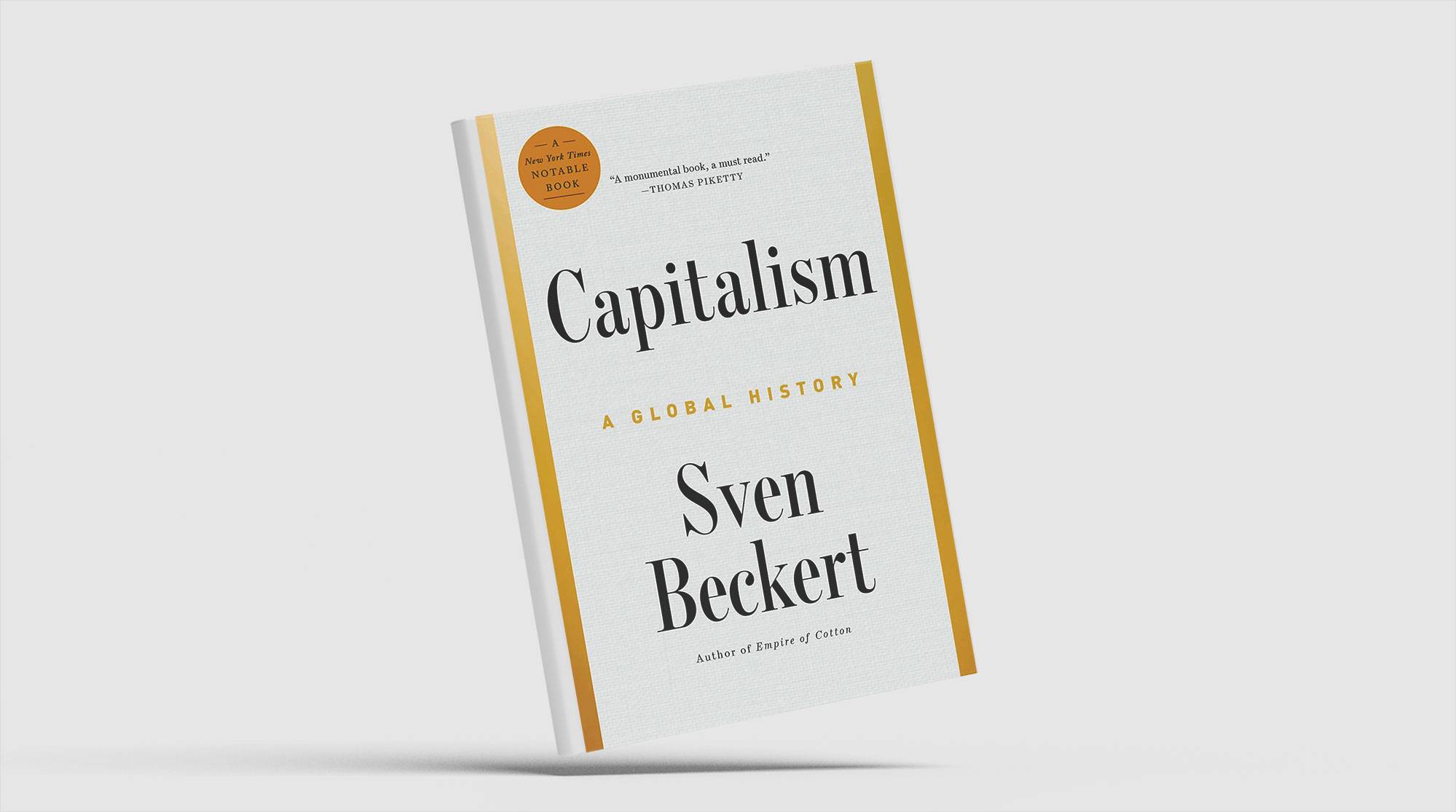مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض زعيماً لدولة العالم العظمى، يبدو مسرح السياسة الدّوليّة خالياً من شخصيات يمكن أن تكون نِدّاً تاماً له، باستثناء الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي يقود ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمنافس الرئيس للولايات المتحدة.
لكن بينما يملأ ترمب الدنيا ويشغل الناس، ويتابع الملايين في الولايات المتحدة وحول العالم يومياته وتصريحاته وتغريداته، فإن هنالك الكثير عن الزعيم الصيني شي غير متداول، ولا توجد مصادر حديثة عنه تتوفر للقارئ العادي المعاصر، ولذلك؛ فإن كتاب الصحافي البريطاني مايكل شيريدان الجديد «الإمبراطور الأحمر: شي جينبينغ والصين الجديدة» يأتي في وقت مناسب لإلقاء الضوء على الشخصيّة التي ستكون الثقل المقابل لـ«الرجل البرتقالي» طوال السنوات الأربع المقبلة.
النفَسُ الحاكم للكتابِ، المنسوجِ على خط التقاطع بين النص الأكاديمي والتغطية الصحافيّة، يقدّم الزعيم شي بوصفه شخصيّة شديدة التعقيد ورجلاً عنيداً وصلباً، لكنّه عانى مع ذلك من تجارب قاسية في مرحلة الطفولة، وقائداً براغماتياً لا يزال يحتفظ بتقدير عميق للآيديولوجية الماركسيّة - اللينينية، وصعد إلى أعلى مراتب القيادة في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم مع أنّه تعرّض هو ووالده - شي تشونغشون - لاضطهاد السلطات الشيوعية إبان مرحلة الثورة الثقافيّة (1966 - 1976).
يكرّس شيريدان كثيراً من الاهتمام لـ«شي» الأب الذي كان شريكاً للرئيس ماو تسي تونغ، وترقى إلى رتبة نائب رئيس الوزراء قبل تطهيره في عام 1962، حيث سُجن وأُجبر على القيام بنقد ذاتي، وكُلّف بعمل يدوي في مصنع للجرارات، فقضى 16 عاماً متتابعة متوارياً عن أضواء السياسة، قبل أن يعاد تأهيله السياسيّ في عام 1978 ويستأنف نشاطه الحزبي.

في تلك الأثناء وجد شي الابن نفسه منفياً إلى قرية فقيرة في الريف لمدة 7 سنوات يمارس العمل الشاق في الحقول مع المزارعين، فتذوق طعم الفقر والإذلال العلني - بصفته ابناً لمسؤول كبير فقد ثقة الحزب - بعيداً عن رعاية والديه. على أن أقسى لحظاته على الإطلاق كانت خلال عقد قلاقل الثورة الثقافية، عندما دشّن الزعيم الصيني ماو تسي تونغ «ثورة البروليتاريا الثقافية الكبرى» ضد من سماهم «ممثليّ البورجوازية» الذين اخترقوا الحزب الشيوعي، معلناً أنه سيعمل على اجتثاثهم؛ إذ خضع شي المراهق وقتها لأكثر من 12 «جلسة مراجعة»، كانت نوعاً من الإذلال العلني للأشخاص الذين عُدّوا «أعداء طبقيين». وقد سُجن حينها أيضاً، وأصيب بالجوع، وغزت ثيابه البراغيث. ويروي شيريدان أن «شي نجح في الفرار من السجن في إحدى الليالي المظلمة، وركض عبر أزقة بكين الغارقة في الأمطار إلى منزله متأملاً الحصول على وجبة ساخنة، وملابس نظيفة جافة. لكن والدته؛ التي ارتجفت هلعاً على سلامة أشقائه، رفضت استقباله، وأبلغت السلطات عن هروبه؛ لأنها كانت تعلم أن منزلها مراقب، وعقوبات لا نهاية لها ستطولها وأسرتها».
يقول المؤلف إن هذه المرحلة من حياة شي؛ على دورها التأسيسي لشخصيته لاحقاً بصفته زعيماً سياسياً لدولة عظيمة، لم تكن سوى واحدة من كثير من المحن التي مرّ بها في عصر التقلبات الثوريّة، والتي صقلت عناده، وشكلّت مرجعيات أدائه المهني. ولاحقاً تبدو مرحلة انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 حدثاً تأسيسياً آخر له، وهي لحظة من التاريخ ترددت أصداؤها في أروقة «الحزب الشيوعي الصيني» أكثر من غيره، وعدّها شي نتاج هفوات في اتباع الآيديولوجيّة الماركسيّة من قبل الرّفاق في موسكو، قائلاً، وفق محضر اجتماع رسمي طبق وثائق الحزب: «كان أحد الأسباب المهمة هو أن الصراع في الإطار الآيديولوجي كان شديداً للغاية، حيث نُفي تماماً تاريخ الاتحاد السوفياتي، ونُفي تاريخ الحزب الشيوعي، ونُفي لينين، ونُفي ستالين، وخُلقت عدمية تاريخية وتفكير مشوش». ويزعم شيريدان أن جوزيف ستالين؛ الزعيم البلشفي الذي تولى حكم الاتحاد السوفياتي بعد فلاديمير لينين، يمتلك التأثير الأكبر على شي وكثير من الشيوعيين الصينيين؛ إذ بالنسبة إليهم كان هو باني الجسر الذي نقل الماركسية اللينينية إلى رفاقهم مؤسسي «الحزب الشيوعي الصيني»، والاتحاد السوفياتي في عهده (1922 - 1953) يعدّ نموذجاً ملهماً للثورة والمقاومة والبقاء.
يرى شيريدان أن الحلقة الأعلى دراميّة في سيرة شي ربما تمثلت في قراره عام 2014 إطاحة تشو يونغ كانغ، الذي أصبح أعلى مسؤول يجري إسقاطه بسبب الفساد منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949. فالرجل كان مديراً لوكالة الأمن الصينية الهائلة وعضواً في المكتب السياسي لـ«الحزب الشيوعي»؛ أي نواة القوّة الحاكمة في الصين، مما أثار لدى اعتقاله موجة من الذهول على كل المستويات. لكن تبين في المحاكمات أنّه استغل منصبه لمآرب جنسيّة، وصودرت أصول امتلكها بطرق ملتوية تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار أميركي؛ بما في ذلك مئات الشقق والعقارات، و60 سيارة فاخرة، ومقتنيات من الذهب، والفضة، والمجوهرات، والتحف، واللوحات، والمشروبات الكحوليّة المعتّقة، ناهيك بمبالغ نقدية ضخمة بعملات أجنبية. وبينما حُكم على تشو بالسجن مدى الحياة، تكرّست زعامة شي، في المقابل، شعبياً ورسمياً.
يقدّم الكتابُ الزعيمَ شي بوصفه شخصيّة شديدة التعقيد ورجلاً عنيداً وصلباً... لكنّه عانى من تجارب قاسية في مرحلة الطفولة
شيريدان، الذي كان مراسلاً لـ«صنداي تايمز» البريطانية من الشرق الأقصى لنحو 20 عاماً، واستفاد من هيوارد تشانغ، الرئيس السابق لـ«الخدمة الصينية» في «بي بي سي» للوصول إلى مواد قد لا تتوفر للعموم باللغة الصينية، كما من علاقات واسعة متشعبة له مع خبراء غربيين وصينيين عملوا في الغرب، وضباط استخبارات، أضاء على حياة شي الشخصيّة والمهنية، متجنباً بحذق السقوط في شرك التحليل النفسي وفرض المواقف الذاتية للمؤلف كما في كثير من الكتب الغربيّة عن قادة الصين. على أنّ السرد لا يتصدى على نحو كافٍ لتوصيف المزاج الفكريّ للرئيس شي، ربما انعكاساً لفهم خاطئ متفشٍّ في بعض الدوائر الغربيّة عنه بوصفه سياسياً براغماتياً مع قليل من القناعات الآيديولوجية.
ولكن الحقيقة أن ثمة فلسفة مؤدلجة تحكم أداء شي العام منذ توليه عام 2012 المنصب الأهم في هيكلية القيادة بالصين ضمن ثلاثية «الحزب والدولة والجيش»، وهي أقرب ما تكون إلى نسخة قومية صينية من «الماركسيّة - اللينينية»، تمنح الزعيم الحافز والدافعية لقيادة نهضة جديدة لبلاده على أسس تعزيز المركزية في صنع القرار، ودور الدّولة الرئيس في توجيه الاقتصاد وتنظيم الأسواق، وتدعيم قدرة الجيش على مواجهة التحديات الغربيّة في إطار نهج من السياسة الخارجية الأشد حزماً وتقبلاً لفكرة «التصادم مع الأعداء إن تطلب الأمر».
بالاعتماد على القصص المتداولة في العالم المغلق للعائلات الرائدة في الصين، كما وثائق وسجلات لا تتوفر للأكثرية من المراقبين، يقدم كتاب «الإمبراطور الأحمر» بانوراما غنيّة عن تاريخ الصين المعاصرة، وسياساتها في العقد الأخير، عبر سيرة وافية لشخصية زعيم كبير يدرك تماماً طبيعة لعبة السلطة، ويمتلك سلطات نافذة على شؤون 1.4 مليار من البشر؛ مما يدفع القارئ إلى الاستنتاج أنّه خلف واجهة «الحزب الشيوعي الصيني» اليوم ثمة «سلالةٌ حديثةٌ» لديها شعور عميق باستحقاق حكم البلاد - بناء على انتصارات أسلافهم - والأهم «إمبراطورٌ جديدٌ»، ابن للأرض الصفراء، قد عقد العزم على أن تتبوأ الصين دور الهيمنة على الشرق.
The Red Emperor: Xi Jinping and His New China» by Michael Sheridan, Headline Press, 2024»